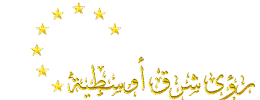ظلّ مفهوم “الإمبريالية” أحد المفاهيم المحورية في فهم بنية العلاقات الدولية من زاوية نقدية تربط التوسّع الجغرافي بالاقتصاد السياسي للرأسمالية. ورغم أن هذا المفهوم ارتبط تاريخيًا بالممارسات الاستعمارية المباشرة، فقد شهد تحوّلات عميقة في دلالاته وتطبيقاته مع تغيّر البنية العالمية منذ السبعينيات، وبشكل أخص بعد انهيار النظام ثنائي القطبية.
لقد أعادت هذه التحوّلات إنتاج أنماط من الهيمنة لا تنتمي إلى النموذج الإمبراطوري الكلاسيكي، لكنها تحتفظ بجوهر العلاقة الإمبريالية: التبعية البنيوية، وعدم تكافؤ القوة، وتمركز القرار. في هذا السياق، تظهر “الإمبريالية الإقليمية” كمفتاح لفهم ديناميكيات جديدة في النظام العالمي، تمارس فيها قوى صاعدة نفوذها ضمن فضاء جغرافي محدد، دون أن تدخل في مواجهة مباشرة مع النظام الكوني القائم.
تتمثل أهمية هذا التحول في أنه لا يُلغي منطق السيطرة، بل يعيد تشكيله عبر أدوات غير استعمارية، وعبر أنماط أكثر نعومة ومركّبة من التدخل والهيمنة. كما أن تعدّد الفواعل الإقليميين، وتنوّع أدوات التأثير، يتطلب مقاربة جديدة للإمبريالية لا تقتصر على الغزو المباشر أو الاحتلال، بل تشمل إعادة إنتاج التبعية عبر الاقتصاد، الإعلام، الثقافة، والهياكل الأمنية والسياسية.
لكن الأهم من كل ذلك، أن الإمبريالية الإقليمية لا تُفهم بوصفها مجرد تكيّف ظرفي مع التحوّلات الجيوسياسية، بل باعتبارها أحد تجليات أزمة الإمبريالية العالمية وتشظّيها البنيوي. ففي ظلّ تآكل المركز الإمبريالي التقليدي وتراجع قدرته على فرض الهيمنة الكونية المباشرة، ظهرت قوى إقليمية تؤدي أدوارًا توسعية محدودة النطاق، تمارس السيطرة بأدوات مرنة، وتقدّم نفسها أحيانًا كقوة مناهضة للإمبريالية ذاتها.
بهذا المعنى، لا تمثّل الإمبريالية الإقليمية استمراريةً للإمبراطورية العالمية، بل تشظّيًا لها: إذ تُجزّأ آليات السيطرة، وتُوزّع شبكات التبعية، ويُعاد إنتاج منطق الهيمنة في صورة لا مركزية، لكن بوظيفة واحدة. إنها ليست بديلاً للتحرّر، بل تكثيف لأزمة السيطرة، حين تنكسر الإمبراطورية وتُعاد صياغتها في مراكز فرعية تتبنى المنطق ذاته، وتلبسه قناعًا جديدًا.
من الإمبريالية الكلاسيكية إلى الإقليمية – تحوّلات في منطق الهيمنة
يمثّل المفهوم الكلاسيكي للإمبريالية، كما طوّره فلاديمير لينين في عمله الشهير “الإمبريالية: أعلى مراحل الرأسمالية” (1916)، مرحلة متقدمة في تطوّر النظام الرأسمالي، تُصبح فيها الرأسمالية الاحتكارية عاجزة عن تحقيق تراكم رأس المال داخل حدود الدولة القومية، مما يدفعها إلى تصديره خارجيًا عبر أدوات مالية واستثمارية، لا سلعية فحسب. من هذا المنطلق، تُفهم الإمبريالية بوصفها نتيجة ضرورية لبنية النظام الرأسمالي، لا مجرد خيار سياسي.
هذا التصور يربط بين التوسّع الجغرافي والسيطرة الاقتصادية والسياسية والعسكرية، ويؤكد أن التنافس بين الدول الإمبريالية نابع من منطق التراكم نفسه، لا من دوافع ثقافية أو قومية. فالنظام الرأسمالي، بطبيعته، غير متكافئ ويُنتج باستمرار مراكز مهيمنة وأطرافًا تابعة.
لكن نهاية الحرب الباردة، وما تلاها من تشظٍّ في البنية العالمية، لم تُفضِ إلى نظام عالمي متجانس تحت الهيمنة الأمريكية، بل إلى إعادة تشكيل “مناطق نفوذ” تتنافس فيها قوى إقليمية على فرض أشكالها الخاصة من السيطرة. هذه القوى—إيران، تركيا، روسيا، إسرائيل، وغيرها—لا تسعى إلى الهيمنة العالمية، لكنها تعمل على إعادة إنتاج التبعية داخل فضاءها الإقليمي، بما يخدم مصالحها الأمنية والاقتصادية والأيديولوجية.
تُمارَس هذه الهيمنة الجديدة من خلال مزيج من الأدوات الناعمة والصلبة: دعم جماعات محلية، التأثير الإعلامي، نشر الخطاب الديني أو القومي، القروض التنموية، بل وحتى إعادة تشكيل النخب السياسية في الدول المجاورة. إنها استراتيجية لا تقوم على الاحتلال، بل على “إدارة التبعية” بشكل غير مباشر، عبر أدوات فعّالة وقليلة التكلفة من حيث الموارد والمواجهة السياسية.
من هذا المنظور، لا تُعدّ الإمبريالية الإقليمية قطيعة مع المفهوم الكلاسيكي، بل امتدادًا له في شروط دولية جديدة. إنها تمثل شكلًا فرعيًا من الإمبريالية، تتناسب مع محدودية الطموح الجيوسياسي لبعض الدول، ومع صعوبة فرض هيمنة كونية في عصر التعدد القطبي والمقاومات المتعددة.
تُعرّف الإمبريالية الإقليمية، انطلاقًا من المقاربة الماركسية، على النحو الآتي:
“هيمنة جيوسياسية محدودة النطاق تمارسها دولة رأسمالية صاعدة ضمن فضاءها الحيوي، تهدف إلى إعادة إنتاج علاقات التبعية من خلال أدوات مركبة تشمل النفوذ الاقتصادي، التدخل غير المباشر، والتحكم الرمزي، دون التورط في مشروع إمبراطوري عالمي.”
بهذا المعنى، تمثّل الإمبريالية الإقليمية تكيّفًا مع التناقضات البنيوية للنظام الدولي: فهي تعبّر عن استمرار الحاجة إلى الفضاء الخارجي لتفريغ الفائض الرأسمالي، لكنها تفعل ذلك عبر سياسات أمنية وتنموية وثقافية لا تتصادم مع مراكز الهيمنة الكبرى، بل تتناغم معها في كثير من الأحيان، أو تشاركها تقسيم النفوذ.
سمات الإمبريالية الإقليمية
تختلف الإمبريالية الإقليمية عن نظيرتها الكلاسيكية من حيث الشكل والوسائل، لكنها لا تقل عنها فاعلية في إنتاج علاقات التبعية وإعادة إنتاج الهيمنة الطبقية داخل الفضاء الجغرافي المحيط. فبينما كانت الإمبريالية الكلاسيكية تقوم على الغزو، الاحتلال، والإدارة المباشرة، فإن الإمبريالية الإقليمية تعتمد على أدوات أكثر مرونة، تتجنب الكلفة السياسية والمادية المباشرة، وتسعى لتحقيق نفس الغايات من خلال السيطرة غير المباشرة، والتأثير طويل الأمد على البُنى الاقتصادية والسياسية للدول التابعة.
تتحدد السمة الأساسية لهذا النمط من الإمبريالية بانحصارها في “المجال الحيوي” للدولة الصاعدة؛ أي في تلك الرقعة الجغرافية التي تربطها بها علاقات تاريخية أو دينية أو قومية أو استراتيجية. هذه الروابط لا تُستثمر لأغراض التضامن أو التكامل، بل تُعاد صياغتها في إطار مشروع توسّعي يسعى إلى إنتاج فضاء خاضع سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا.
في هذا السياق، تتّبع القوى الإقليمية مجموعة من الأدوات المركّبة، تمزج بين النفوذ الصلب (العسكري والاستخباراتي) والناعم (التمويل، الإعلام، الخطاب الرمزي). كثيرًا ما يتم اللجوء إلى “الوكلاء المحليين” من أحزاب سياسية، ميليشيات، أو منظمات مجتمع مدني، لتجنّب التدخل المباشر، وتقليل الكلفة الأخلاقية والدبلوماسية. بذلك، تُستبدل السيطرة الكلاسيكية بعلاقات تبعية تتمظهر في أشكال تبدو محلية، لكنها مرهونة ببنية دعم خارجي قوي وموجّه.
الاقتصاد يلعب دورًا حاسمًا في تكريس هذه التبعية. فالدولة الإمبريالية الإقليمية غالبًا ما تستخدم أدوات مثل القروض المشروطة، السيطرة على سلاسل التوريد، بناء البنية التحتية، أو التحكم في الأسواق والعملة. هذه الآليات تخلق اعتمادًا متبادلًا غير متكافئ، حيث تعتمد الدولة التابعة على الدعم الخارجي في القطاعات الحيوية، دون أن تمتلك سيطرة حقيقية على شروط التنمية أو مسارات السيادة.
أما على المستوى الثقافي، فتُمارس الإمبريالية الإقليمية تأثيرًا رمزيًا يمتد من الإعلام إلى التعليم والخطاب الديني أو القومي، ما يخلق هوية إقليمية هجينة تُبرر النفوذ وتُضفي عليه طابعًا “أخويًا” أو “حضاريًا”. هذا التداخل بين القوة المادية والقوة الرمزية يُنتج نوعًا من الهيمنة المستقرة، حيث يُعاد تشكيل الوعي السياسي للنخب والجماهير على حد سواء بما يتماشى مع منطق التوسّع.
أخيرًا، يجدر التنويه بأن الإمبريالية الإقليمية لا تمثل مجرد استراتيجية هجومية، بل كثيرًا ما تُقدَّم كآلية دفاعية “لحماية الأمن القومي” أو “مواجهة الفوضى في المحيط”. لكنها في جوهرها إعادة إنتاج لنمط الهيمنة الرأسمالية في صيغة مموّهة، تُخفي منطق السيطرة خلف أقنعة التحديث، أو الاستقرار، أو الأخوة الدينية والقومية.
توازي السلوكيات وتحولات الجوهر: الإمبريالية الإقليمية بين السيطرة والتمثيل
تتجلى الإمبريالية الإقليمية بوصفها نموذجًا هجينيًا للهيمنة، يُمارس ثلاث سلوكيات متوازية ومترابطة، تشكّل مجتمعة بنيةً معقّدة تعيد صياغة مفهوم السلطة في ظل التعدد القطبي. أولًا، على الصعيد الداخلي، تسلك الدولة الإقليمية سلوكًا قمعيًا أو شبه قمعي، يعتمد على مركزة القرار، ضبط المجال العام، وتكريس سرديات سياسية أو أيديولوجية تمنح الشرعية لاحتكار القوة. هذه الهيمنة الداخلية لا تنبع من فائض أيديولوجي فقط، بل تُعد شرطًا مسبقًا لتفعيل المشروع الخارجي، إذ أن أي توسّع إقليمي يحتاج إلى جبهة داخلية مُحكمة ومُنقادة.
ثانيًا، تنخرط هذه الدولة في ممارسة إمبريالية تجاه محيطها الحيوي، لا من خلال الاحتلال المباشر بل عبر أدوات غير مباشرة: وكلاء سياسيين، أدوات اقتصادية مشروطة، تدخلات رمزية وثقافية، وهيمنة أمنية ناعمة. هذا الامتداد لا يُسعى إليه باعتباره مشروعًا كونيًا، بل كآلية لتثبيت موقع إقليمي متقدّم ضمن شبكة النفوذ الدولية. في هذا السياق، تُعاد صياغة الفضاء المحيط بوصفه امتدادًا وظيفيًا للمركز السياسي، لا بوصفه كيانًا مستقلًا.
ثالثًا، تقدم هذه الإمبريالية الإقليمية نفسها—وهنا المفارقة—كقوة مناهضة للإمبريالية العالمية، غالبًا باستخدام خطاب التحرر من الغرب، أو معاداة الاستعمار، أو رفض الهيمنة الأحادية. لكن هذه الخطابات، وإن حملت في لحظات معينة طابعًا تحرريًا، تُوظّف اليوم في خدمة مشروع توسّعي آخر، يُمارَس باسم المقاومة لكنه يُعيد إنتاج منطق التبعية وإن بمفردات مغايرة.
هنا يبرز البُعد الفلسفي الأعمق للمسألة، وهو علاقة الجوهر بالمظهر، كما عبّر عنها جان بودريار في تأملاته حول “محاكاة الواقع”، حيث تصبح السلطة محاكاة لذاتها، وتغدو مظاهر القوة أدوات لإنتاج الجوهر لا مجرد انعكاس له. فمظهر الدولة الإمبريالية في الخارج، وتموضعاتها الخطابية والاستراتيجية، يعيد تشكيل جوهرها السياسي. إن التوسع الجيوسياسي لا يُترجم فقط في تغيرات في السياسة الخارجية، بل يُنتج إعادة تكوين للهوية الداخلية، بحيث يُعاد تعريف الذات السياسية للنظام تبعًا لصورتها الإقليمية.
وإذا أخذنا بفوكو، فإن السلطة لا تُمارَس فقط عبر المؤسسات بل تتخلل الأجساد واللغة والنظرة للعالم. لذلك، فإن بروز الدولة كمركز إقليمي يُعيد تشكيل شبكات الخطاب والسلطة في الداخل، وينتج ما يمكن تسميته بـ”هندسة سيادية جديدة”، حيث لا تعود السيادة مفهومًا قانونيًا صرفًا، بل تقنية لإعادة إنتاج الهيمنة الرمزية على كل من الداخل والخارج.
أما غرامشي، فقد نبه إلى أهمية “الهيمنة الثقافية“ بوصفها عملية لا تفرض السيطرة عبر القوة المباشرة فقط، بل من خلال بناء إجماع قيمي وفكري يُشرعن التبعية. وفي هذا الإطار، تستخدم الإمبريالية الإقليمية أدوات الهيمنة الثقافية والإعلامية لتكريس سرديتها في الإقليم، وفي الآن ذاته، تُعيد هذه السردية تشكيل الوعي الجمعي الداخلي، فتغدو الشرعية السياسية مُنتَجة من الخارج بقدر ما هي مشروطة بالداخل.
من هذا المنظور، فإن الإمبريالية الإقليمية تُنتج علاقة جدلية مزدوجة: فهي تمارس نفوذها خارج الحدود لتأمين الداخل، وفي المقابل، تستبطن هذا النفوذ كجزء من هويتها السيادية. جوهر الدولة لم يعد ذاتيًا أو مستقلاً، بل بات قائمًا على تمثلات خارجية تتحول تدريجيًا إلى عناصر بنيوية داخلية. وهذه العلاقة الدائرية بين المظهر والجوهر تُفرغ خطاب السيادة من مضمونه التقليدي، لتعيد تعريفه كأداة مرنة تُستخدم لتبرير التوسع، لا لضبط الحدود.
نماذج تطبيقية للإمبريالية الإقليمية
من أجل مقاربة الإمبريالية الإقليمية بوصفها ظاهرة ملموسة لا مفهوماً نظريًا فحسب، من الضروري تحليل بعض النماذج الواقعية التي تُجسّد هذا النمط من الهيمنة. لا تدّعي هذه النماذج تمثيلًا شموليًا، لكنها توضح كيف يمكن لقوى إقليمية مختلفة—من حيث البنية السياسية والخلفية الأيديولوجية—أن تتبنّى استراتيجيات توسّعية تندرج ضمن منطق الإمبريالية، وإن بصيغ محلية أو غير مباشرة.
- إيران: التوسّع من بوابة الثورة
منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، سعت إيران إلى تصدير نموذجها السياسي والأيديولوجي خارج حدودها القومية، مدفوعة برؤية تمزج بين الطموح العقائدي والمنطق الجيوسياسي. اعتمدت طهران على بناء شبكات من الوكلاء المحليين في دول مثل العراق ولبنان وسوريا واليمن، مستندة إلى خطاب ديني طائفي، لكنه وظيفي في خدمة التوسع.
الأداة المركزية في هذا المشروع كانت “الحرس الثوري”، ولا سيما “فيلق القدس”، الذي لعب دورًا مباشرًا في بناء قدرات الميليشيات الحليفة وتوجيهها سياسيًا وعسكريًا. هذا النفوذ لم يكن مجانيًا، بل أُعيدت عبره صياغة علاقات تبعية متشابكة تمكّن إيران من فرض حضورها في ملفات إقليمية أساسية، دون الحاجة إلى جيوش احتلال أو إدارة مباشرة.
- إسرائيل: الهيمنة عبر الأمن والتطبيع
تمارس إسرائيل نوعًا مركّبًا من الإمبريالية الإقليمية، يرتكز على التفوق العسكري، والدعم الغربي اللامحدود، والتحالفات المتزايدة مع أنظمة عربية من خلال ما يُعرف بـ”اتفاقيات التطبيع”. تقوم هذه الهيمنة على أساس إنتاج التبعية الأمنية والاقتصادية، حيث تصبح دول الجوار شريكة في استراتيجيات “إدارة الصراع” بدلًا من تغييره.
عبر التغلغل في الأسواق، التعاون الاستخباراتي، والتنسيق العسكري، تبني إسرائيل نمطًا من العلاقات الزبائنية مع بعض دول الخليج وشمال إفريقيا، يسمح لها بلعب دور المرجعية الأمنية الإقليمية، خاصة في مواجهة إيران، دون التورّط في مغامرات احتلال جديدة.
- تركيا: العثمانية الجديدة بصيغة هجينة
مع صعود حزب العدالة والتنمية، تحوّلت تركيا من استراتيجية “صفر مشاكل” إلى مشروع توسّعي إقليمي يعتمد على مزيج من التدخل العسكري، النفوذ الثقافي، والدعم السياسي للفصائل الموالية. تتجلّى هذه الاستراتيجية في سوريا والعراق وليبيا، كما في إفريقيا والقوقاز.
النفوذ التركي يُمارَس بأدوات صلبة مثل القواعد العسكرية والعمليات العسكرية، وأخرى ناعمة مثل الإعلام (المسلسلات، القنوات الناطقة بالعربية)، والتعليم، والمؤسسات الدينية. هذا الدمج بين الخطاب القومي والإسلامي وبين الطموح الإقليمي يخلق مشروعًا هجينيًا يُعيد صياغة المجال الحيوي العثماني في صيغة رأسمالية قومية هجومية.
- روسيا: إعادة إنتاج المجال السوفيتي
منذ صعود بوتين، انتهجت روسيا سياسة خارجية تسعى إلى استعادة النفوذ في الفضاء السوفيتي السابق، مع التوسّع إلى ساحات استراتيجية في الشرق الأوسط وإفريقيا. يتجلّى ذلك في التدخل العسكري في جورجيا، أوكرانيا، وسوريا، وفي دعم الأنظمة الموالية، وتوظيف أدوات كـ”فاغنر” في مناطق النزاع.
روسيا تُمارس إمبريالية هجينة تستخدم القوة الخشنة (الاحتلال، القواعد، العمليات العسكرية) إلى جانب الحرب الإعلامية، والعلاقات الاقتصادية، والعقود الأمنية. هذا التمدّد يعكس سعيًا لإعادة تعريف مركزية روسيا في نظام دولي لا يسمح لها بالهيمنة الكونية، لكنه يمنحها هامشًا واسعًا لتوسيع نطاق التبعية الإقليمية.
- مصر في عهد عبد الناصر: مشروع الوحدة
تمثل مصر في عهد جمال عبد الناصر حالة نموذجية لإمبريالية إقليمية ذات خطاب “تحرري”، حيث ارتبط مشروعها التوسّعي بمصطلحات التحرر القومي والوحدة العربية، لكنه انطوى، في الممارسة، على منطق مركزي يعيد إنتاج الهيمنة الإقليمية بأدوات أيديولوجية وسياسية.
لم تكتفِ القاهرة بتصدير الخطاب القومي، بل لعبت دورًا مباشرًا في دعم حركات التغيير في دول عربية عدة، أبرزها انقلاب 1963 في العراق الذي أطاح بنظام عبد الكريم قسم الذي رفض التبعية لمشروع عبد الناصر، الذي سعت مصر من خلاله إلى إلحاق العراق بمشروع “الجمهورية العربية المتحدة”، وإعادة إنتاج خريطة سياسية تحت قيادة ناصرية واضحة. هذا التدخل في الشأن العراقي لم يكن حادثًا منفصلًا، بل كان جزءًا من استراتيجية أوسع لإعادة رسم التوازنات داخل المشرق العربي عبر دعم الانقلابات، وبناء شبكات ولاء حزبية وأمنية ترتبط بمركز القرار في القاهرة.
حتى التجربة الوحدوية مع سوريا (1958–1961) كشفت عن مفارقة بنيوية: فقد قُدمت كخطوة نحو وحدة عربية تقدمية، لكنها اصطدمت بسرعة بـهيمنة الجهاز الإداري والاقتصادي المصري على مؤسسات الدولة السورية. فالسوريون رأوا في السيطرة المركزية القادمة من القاهرة شكلًا جديدًا من التبعية، ما أدى إلى توترات حادة داخل الكتلة البيروقراطية والاقتصادية السورية، وساهم في فشل المشروع الوحدوي في نهاية المطاف.
عليه، فإن مصر الناصرية، رغم طابعها المعادي للاستعمار العالمي، مارست إمبريالية إقليمية “من نمط جديد”—لا تقوم على الاحتلال، بل على إعادة تشكيل المجال العربي ضمن مركزية قاهرية، تستند إلى التفوق الرمزي، السياسي، والأمني. فخطاب التحرر لم يُلغِ منطق الهيمنة، بل أضفى عليه شرعية جديدة، جعلت من المشروع الوحدوي ذاته أداة للتمدد والتوسّع تحت راية قومية.
الإمبريالية الإقليمية كتعبير عن أزمة التوسّع في النظام الرأسمالي المعولم
ما تكشفه هذه الدراسة، من خلال التحليل النظري والمقارنة التطبيقية، هو أن الإمبريالية، بوصفها بنية مترسخة في النظام الرأسمالي، لم تختفِ بانتهاء الاستعمار الكلاسيكي أو تفكك الأقطاب الكبرى، بل وجدت في التحولات البنيوية للنظام الدولي فرصة لإعادة إنتاج ذاتها في صورة أكثر مرونة وتعددًا. لقد أُعيد تشكيل منطق السيطرة والتبعية عبر وسائط جديدة، فظهرت الإمبريالية الإقليمية ليس كبديل عن الإمبريالية العالمية، بل كأحد تجليات أزمتها وتفككها البنيوي.
فالدول الإقليمية الصاعدة، في لحظة تراجع الهيمنة المركزية الغربية، ملأت الفراغ عبر بناء فضاءات سيطرة محدودة، تستخدم فيها أدوات ناعمة وصلبة لتكريس التبعية، وتوجيه السياسات، وإعادة إنتاج نخَب تابعة ضمن حدود المجال الحيوي. لكن هذه السيطرة لا تتم خارج النظام العالمي، بل تُمارَس في الغالب ضمن هندسة تقاسم النفوذ التي تضمن استمرار البنية الرأسمالية، حتى في ظل غياب مركز موحد للهيمنة.
بهذا المعنى، فإن الإمبريالية الإقليمية هي نتيجة لأزمة الإمبريالية الكونية، إذ تكشف حدود الإمبراطورية العالمية، وتعجز عن تعويضها بالكامل. إنها ليست مشروعًا تحرريًا، بل نمط توسّعي بديل، يُمارَس غالبًا عبر أقنعة قومية، دينية، أو رمزية، لكنه يحتفظ بجوهر العلاقة الإمبريالية: عدم التكافؤ، إعادة إنتاج التبعية، واستغلال الفائض الجغرافي والسياسي لتجاوز أزمات الداخل.
اللافت في هذه الظاهرة أن الطموح الإمبريالي الإقليمي لا يتعارض بالضرورة مع المراكز العالمية، بل يتكامل معها في كثير من الأحيان، ضمن علاقة “التابع المُفوَّض”. تُمنح الدول الإقليمية “حق التصرف” ضمن فضائها الجغرافي، ما دامت لا تُهدد البنية الكبرى للنظام العالمي أو ترتبك بمنطق الاستقلال الراديكالي. هذه العلاقة تُعيدنا إلى مفهوم غرامشي حول “الهيمنة المتعددة الطبقات”، حيث تُمارَس السيطرة ليس بالقوة وحدها، بل من خلال توافق نسبي بين المراكز الكبرى والوكلاء الإقليميين.
كما أن الأمثلة التاريخية، وفي مقدمتها الحالة الناصرية، تُظهر أن حتى المشاريع التي اتخذت طابعًا وحدويًا أو تحرريًا، قد انزلقت إلى منطق مركزي أعاد إنتاج الهيمنة الإقليمية، تحت شعارات قومية أو تقدمية. وهذا يكشف أن المشكلة لا تكمن في الشعارات، بل في البنية العميقة التي تحكم منطق التوسّع والسيطرة، والتي تظل خاضعة للمنطق الرأسمالي وإن تغيّرت واجهته الأيديولوجية.
بالتالي، فالإمبريالية الإقليمية ليست مجرد ظاهرة سياسية عارضة، بل تعبير عن مأزق مزدوج: مأزق التوسّع الرأسمالي الذي لم يعُد قادرًا على فرض الهيمنة الكونية من مركز واحد، ومأزق الدول الإقليمية التي تطمح إلى النفوذ لكنها لا تستطيع تجاوز شروط التبعية البنيوية المفروضة عليها.
هذه الدراسة لا تدعو إلى استبدال مركز هيمنة بمركز بديل، ولا إلى الانخداع بإقنعة المقاومة الشكلية، بل تسعى إلى تفكيك كيف تُعاد إنتاج التبعية داخل بنى السيطرة الجديدة، وكيف تُمارس الهيمنة بلغة تحرّرية. وحده التحليل البنيوي، والنقد الطبقي، والمساءلة الفكرية الصارمة يمكن أن تُعيد توجيه النظر من ظاهر التحوّلات إلى جوهرها، ومن سرديات التحرّر إلى منطق التبعية الذي يعيد إنتاج نفسه في صور متغيرة.
في النهاية، لا يكمن الخطر في بقاء الإمبريالية، بل في قدرتها على التخفّي داخل أشكال سياسية جديدة، تُعيد إنتاج السيطرة في قلب ما يُقدّم كتحرّر. الإمبريالية الإقليمية، بهذا المعنى، ليست فقط ظلًا لأزمة الرأسمالية العالمية، بل علامة على مرونتها الفتاكة، وقدرتها على التكيّف في كل مرة تظن فيها أنها انهارت.