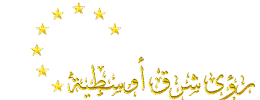منذ أن صاغ أنطونيو غرامشي مفهوم “الهيمنة الثقافية” (Cultural Hegemony)، لم يعد بالإمكان اختزال سلطة الطبقة الحاكمة في أدواتها القمعية الصلبة وحدها. الهيمنة، بحسب غرامشي، ليست فقط تفوقاً مادياً بل قدرة الطبقة المسيطرة على فرض رؤيتها للعالم باعتبارها “الطبيعية” و”العقلانية” و”المشتركة”، بحيث تقبلها الطبقات الخاضعة دون عنف ظاهر. إنها آلية ناعمة ولكنها فائقة الفعالية، تُمارس من خلال المدارس، الإعلام، الدين، الثقافة، وحتى مناهج التعليم، لتشكيل الوعي الجمعي وإعادة توجيهه بما يخدم مصالح الطبقة المسيطرة، بما يضمن إعادة إنتاج التراتب الطبقي دون الحاجة إلى القمع المباشر المستمر.
في سياق الرأسمالية المعولمة، اتخذت هذه الهيمنة أبعاداً أكثر تعقيداً واتساعاً. لم تعد الهيمنة الثقافية محصورة ضمن حدود الدولة القومية، بل غدت شبكة فوق-قومية تعمل على ترسيخ قيم السوق، والنزعة الفردية، والتنافس، وتقويض الروابط الاجتماعية المشتركة، وتفكيك البنى الجماعية، وتدجين النزعات الثورية. أصبحت الثقافة أداة مركزية في يد الرأسمال العالمي، وهي الفكرة التي سنعود لتفصيلها لاحقًا ضمن تحليل آليات الإعلام والصناعات الثقافية لا لتبرير الوضع القائم فحسب، بل لإنتاج الوعي الذي يحميه ويجدد ولاء الشعوب له. في عالم ما بعد الحرب الباردة، حيث لم تعد الإمبريالية تسوّق ذاتها بالسلاح وحده، ظهرت الثقافة كأداة تأثير خفية لكنها أشد تسللًا وفعالية من الوسائل التقليدية.
تقتضي الضرورة البحثية تحليل الكيفيات التي تُستخدم بها الهيمنة الثقافية لإخفاء الصراع الطبقي، وتحريف المفاهيم التقدمية، وإنتاج خطاب خادع يبرر الاستبداد أو يغذّي التضامن الزائف مع سلطويات مضادة للثورة تحت شعار “معاداة الإمبريالية”. سننطلق من الإطار النظري الماركسي.
آليات الهيمنة الثقافية في خدمة الرأسمالية المعولمة
إحدى أبرز وظائف الهيمنة الثقافية في زمن الرأسمالية المعولمة هي التمويه على الصراع الطبقي باعتباره محورًا للصراع الاجتماعي. يجري ذلك عبر ترسيخ تصور للعالم قائم على الأفراد لا الطبقات، وعلى “الفرص” لا البنى. تعيد الثقافة السائدة تشكيل الخطاب العام بطريقة تُخفي علاقات الإنتاج وتُعيد تأطير المفاهيم الاجتماعية فتختفي مفاهيم مثل “الاستغلال”، “القيمة الزائدة”، أو “تراكم رأس المال”، لتحل محلها لغة النجاح الشخصي، والتنمية الذاتية، والمرونة (resilience).
يُسَوَّق الفقر كفشل فردي، لا كنتيجة حتمية لعلاقات الإنتاج. يُقدَّم العامل في مصنع بنغلادشي أو عامل التوصيل في باريس أو المعلّمة في مدرسة عامة بلندن كـ”أشخاص عاديين” يعانون بعض التحديات، لا كأعضاء في طبقة مضطهدة تعيش علاقات اغتراب وقهر. هذه إعادة تشكيل للواقع المادي تُنتج شكلاً متجددًا من الوعي الزائف، يتجاوز البنية الاقتصادية إلى تمثيلات الحياة اليومية، كما شرح ماركس، حيث “لا يدرك الناس العالم كما هو، بل كما تم تصويره لهم”.
حيث تعمل الأجهزة الأيديولوجية للدولة (المدرسة، الإعلام، الدين…) على “مناداة” الأفراد (interpellation) كذوات حرة، في حين أنهم فعليًا خاضعون لبنى لا يسيطرون عليها. بهذا الشكل، تصبح الهيمنة الثقافية أداة لإخفاء التناقض الرئيسي بين العمل ورأس المال.
إعادة تأطير النظريات التقدمية وتحييد فعاليتها الثوريةتتجلّى الهيمنة الثقافية أيضًا في الاستيلاء على المفاهيم الراديكالية وإعادة إنتاجها بشكل مفرغ من جوهرها. لم تسلم حتى الماركسية من هذه الآلية، حيث تُدرّس أحيانًا في الأكاديميات الغربية كـ”نظرية نقدية” باردة، لا كمشروع ثوري. كذلك الأمر مع “النسوية”، التي جرى إعادة تشكيلها في نسخة ليبرالية فردانية تنادي بتكافؤ الفرص داخل النظام بدلًا من تفكيك النظام الأبوي الرأسمالي نفسه.
البيئة، العدالة العرقية، حقوق الإنسان، التحرر الجندري… جميعها مفاهيم تحررية تم استيعابها ضمن منطق السوق الاستهلاكي ووتسليع رموزها عبر شعارات تسويقية سطحية. شركة نفط ترعى فعالية بيئية أو بنك عالمي يروّج لتمكين النساء، أمثلة صارخة على تفريغ الرموز الثورية من معناها.
كما يشير المفكر الكولومبي أرتورو إسكوبار، فإن الحداثة الرأسمالية لا تواجه خطاب “الآخر” بل تبتلعه، وتعيد إنتاجه في قالبها. وهذا يضعنا أمام تحدي مزدوج: فضح ليس فقط الاستغلال المادي، بل وأيضًا التواطؤ الرمزي الذي يجعل من النقد سلعة.
يلعب الإعلام دورًا محوريًا في صياغة هذا الوعي الزائف، عبر بناء سرديات تشرعن التفاوت الطبقي، وتعيد توصيف القمع باعتباره “ضرورة أمنية” أو “إصلاحًا اقتصاديًا”. كما أوضح نعوم تشومسكي في كتابه “السيطرة على الإعلام” (Manufacturing Consent)، فإن وسائل الإعلام الكبرى لا تعكس الواقع بل تنتجه، عبر “فلترة” الأخبار، وتحريف الأطر المرجعية، واختزال العالم إلى ثنائيات سطحية: ديمقراطي/استبدادي، متحضّر/متخلّف، تقدّمي/رجعي.
في هذا السياق، يُسوّق الاستغلال باعتباره “تنمية”، والخصخصة كـ”كفاءة”، والتفاوت الطبقي كـ”حافز”. هذا الخطاب لا يهدف فقط إلى دعم النخبة، بل إلى نزع مشروعية الاحتجاج ضدها، وتجريم أي حركة تحررية باعتبارها تهديدًا لـ”الاستقرار”.
وتبرز هنا أيضًا أهمية “الصناعات الثقافية”، حيث تتحوّل الثقافة إلى أداة لإنتاج الامتثال، لا الوعي النقدي، حيث يتم تقديم الترفيه المفرغ والمحتوى المتجانس ضمن بنية سوقية تعزز الرضا الطوعي، كما أشار غرامشي، وتؤسس لثقافة جماهيرية متكيفة مع الهيمنة، على النحو الذي حلله أدورنو وهوركهايمر.
حين تتقن الرجعية ادعاء التقدم: تشويش الوعي من بوابة “مناهضة الإمبريالية“
في المشهد الجيوسياسي المعاصر، تتفنن أنظمة سلطوية في تسويق نفسها كقلاع للمقاومة ضد الإمبريالية الغربية. هذه الأنظمة، التي تمارس القمع الداخلي وتمنع التنظيم السياسي المستقل وتحاصر الحريات، تتلبّس خطابًا “مناهضًا للاستعمار” يفتن بعض التيارات التقدمية في الجنوب والشمال على حد سواء. ويحدث هنا ما يمكن تسميته بـ”تشويش البوصلة الثورية”، حيث تختلط معاداة الإمبريالية بالدفاع عن بنى سلطوية رجعية.
بفعل نزعة مشروعة لدى اليسار العالمي في معاداة الإمبريالية، تنجح الأنظمة السلطوية في تقديم نفسها كقوى مقاومة في معاداة الإمبريالية الأمريكية والأوروبية، فتُقدّم نفسها كقوى “مقاوِمة”، حتى وهي تطبّق سياسات نيوليبرالية، وتضطهد العمال، وتقمع الحريات. فتُبنى سردية زائفة يُختزل فيها الصراع العالمي إلى معسكرين: الغرب الإمبريالي في مقابل “محور المقاومة”، دون مساءلة جوهرية لطبيعة هذا المحور، وموقعه من الطبقة العاملة، ومن مشروع التحرر الحقيقي.
في هذا السياق، نجد مفكرين يساريين عالميين – بل حتى حركات احتجاجية – يتضامنون مع أنظمة قمعية بدعوى أنها “تتصدى للهيمنة الأمريكية”. هذا التضامن القائم على الانفعال الجيوسياسي لا الطبقي، يؤدي إلى تبرئة السلطة المحلية من مسؤولياتها، وتبرير قمعها بوصفه جزءًا من “المعركة الكبرى”.
إنها حالة من “الاستلاب الجيوسياسي”، حيث تصبح معاداة الغرب غاية بحد ذاتها، حتى ولو جاءت على يد أنظمة تابعة لرأس المال العالمي (ولو من موقع “الصراع”).
كما أشار إدوارد سعيد، فإن الاستشراق لم يكن مجرد خطاب خارجي عن “الشرق”، بل بنية معرفية تنتج ذاتًا خاضعة. في السياق المعاصر، يُعاد توظيف خطاب “مناهضة الاستشراق” كآلية تبريرية لإدامة السلطوية، وكأن الاستقلال عن الغرب يعني بالضرورة العودة إلى شكل من أشكال الطغيان الثقافي والسياسي المحلي.
هنا يُجبر اليسار على الوقوع في فخ ثنائية خادعة: إما أن تقف مع الإمبريالية الغربية (الديمقراطية الليبرالية) أو تدافع عن الأنظمة “الممانِعة” (وهي في كثير من الأحيان مجرد نُسخ من النيوليبرالية السلطوية).
لكن هذه المعادلة تتجاهل الجذر المشترك لكلا القطبين: خضوعهم لمنطق السوق، ورفضهم للتحرر الجماعي الحقيقي. كما قال ماركس: “التاريخ يعيد نفسه، أولاً كمأساة، ثم كمهزلة”، وها نحن أمام مهزلة تحوّل أنظمة قمعية إلى رموز “تقدمية” بسبب مجرد خلافها مع واشنطن.
الاستبداد “المقاوم” وتفتيت اليسار: عندما تُختطف الجغرافيا من الطبقة
يؤدي الادّعاء المتكرر للأنظمة السلطوية بأنها تقف في مواجهة الغرب إلى توفير غطاء أيديولوجي فعال لممارساتها القمعية في الداخل. فالاعتقالات، وتقييد الحريات، وحظر الأحزاب، تُقدَّم لا كأدوات سلطوية بل كـ”إجراءات دفاعية” في إطار مواجهة “المؤامرات الغربية”. وبهذا، يتم تحويل القمع من جريمة إلى “ضرورة وطنية”.
هذا المنطق يفرض على القوى التقدمية المحلية أن تخفف من انتقاداتها أو تصمت عن الانتهاكات، بحجة “أولوية الصراع ضد الإمبريالية”، مما يؤدي إلى تآكل استقلالية اليسار، واستنزافه في معارك لا تخص مشروعه التحرري المباشر، بل تخدم شرعية سلطة قائمة على النهب والكبت.
إنها بنية تُشبه إلى حد بعيد ما وصفه غرامشي بـ”الهيمنة من خلال التواطؤ”، حيث يجري استدراج الفاعلين المعارضين إلى قبول السردية السائدة، ولو جزئيًا، مما يفقدهم قدرتهم على إنتاج خطاب بديل جذري.
هذه الأنظمة لا تكتفي بتوظيف خطاب “مناهضة الإمبريالية”، بل تدفع أيضًا باتجاه خلق انقسامات داخل الصف اليساري والتقدمي، بين من “يتفهّم” موقف النظام ويبرّره، ومن يرفضه بشكل قاطع. وهنا ينشأ صراع داخلي يستنزف الطاقات ويضعف التنسيق بين مكونات القوى التقدمية، مما يعيق تشكيل جبهة موحدة في وجه السلطوية.
ويزداد هذا التشظي تعقيدًا مع بروز نمط جديد من الهيمنة على المستوى الإقليمي، يمكن تسميته بـ”الإمبريالية الإقليمية”. إذ لم تعد الهيمنة حكرًا على القوى الغربية، بل باتت بعض الأنظمة في موقع “الهامش” تمارس أدوار “المركز” في محيطها الجغرافي. تمارس هذه الأنظمة تناقضًا وظيفيًا: تعلن مناهضة الهيمنة الغربية، بينما تعيد إنتاجها إقليميًا عبر سياسات توسعية، وسنوضح هذا النمط في تجارب إقليمية محددة لاحقًا عبر التدخل السياسي أو الاقتصادي أو حتى العسكري.
يمكن رصد هذا السلوك في تجارب متعددة: فمصر في عهد جمال عبد الناصر تبنّت خطابًا مناهضًا للاستعمار والهيمنة الغربية، لكنها في الوقت نفسه مارست تدخلًا سياسيًا وثقافيًا واسعًا في محيطها العربي والأفريقي، مُروِّجة لنموذجها القومي المركزي كمرجعية إقليمية. أما إيران، فقدّمت نفسها منذ الثورة الإسلامية كمناهض شرس للهيمنة الأمريكية، لكنها مارست نفوذًا إمبرياليًا إقليميًا واضحًا من خلال أدوات عسكرية وأيديولوجية، خصوصًا في العراق وسوريا ولبنان واليمن، ما حوّلها إلى قطب سلطوي داخل الفضاء الإقليمي. تركيا، بدورها، تموضع نفسها كقوة “مستقلة” عن الغرب، لكنها تنخرط في مشاريع توسع سياسي واقتصادي – من سوريا إلى ليبيا إلى القوقاز – تكرّس نوعًا من التبعية والهشاشة لدى الدول المجاورة. أما إسرائيل، فرغم تحالفها العضوي مع الغرب الإمبريالي، فإنها تمارس إمبريالية إقليمية مباشرة عبر الاحتلال والاستيطان، والسيطرة الأمنية والاقتصادية، وتفرض توازنات قسرية على مجمل المنطقة باسم “الردع” و”الحرب على الإرهاب”.
هذه الإمبريالية الإقليمية تُربك التحليل الثوري، لأنها تلبس ثوب “المقاومة” أو “الاستقلال”، فيما تمارس القمع والهيمنة، مما يؤدي إلى تضامن انتقائي وغير نقدي معها من قِبل بعض أطياف اليسار العالمي. وبدلًا من تشخيص دقيق لتموضع هذه الأنظمة في علاقتها بالطبقة العاملة، يُختزل الصراع إلى ثنائية مضلِّلة: مع الغرب أو ضده، بصرف النظر عن طبيعته الطبقية والاستغلالية في الداخل.
وقد دفعت الأحزاب الشيوعية في بعض هذه الدول ثمناً باهظًا نتيجة هذا الخلط. ففي كلٍّ من سوريا ومصر وإيران والعراق، انخرطت تلك الأحزاب في تحالفات أو مواقف مؤيدة للأنظمة القائمة تحت ذريعة “مناهضة الإمبريالية العالمية”، من دون فهم واضح لموقع هذه الأنظمة كقوى إمبريالية إقليمية. النتيجة كانت كارثية: سحقها سياسيًا وتنظيميًا، واستخدامها كأداة ثم التخلص منها حين انتهى دورها.
يتحوّل الخلاف من نقد مشترك للرأسمالية المعولمة – التي تشمل الإمبريالية الغربية والسلطوية المحلية – إلى تخوين متبادل بين تيارات اليسار، واتهامات بـ”الرجعية” أو “العمالة”، مما يؤدي إلى إضعاف الجبهة التقدمية، وترك الشارع مفتوحًا إما أمام الأنظمة أو أمام اليمين الديني أو القومي الشعبوي.
في أمريكا اللاتينية، مثلًا، شهدنا كيف تحوّلت بعض الأنظمة الشعبوية التي نشأت على قاعدة مقاومة النيوليبرالية إلى سلطويات تقمع الحركات العمّالية والمجتمعات الأصلية بحجة “الاستقرار الثوري”. وفي الشرق الأوسط، تمّت شيطنة كل معارضة للنظام السوري مثلاً على أنها “أداة للغرب”، في حين كانت المطالب في بداياتها اجتماعية طبقية خالصة.
النتيجة: تفتيت قوى التغيير الحقيقي، وتحويل المعركة من مواجهة رأس المال والسلطة إلى صراع داخلي بين ضحاياهما، في ظل غياب خطاب أممي واضح الطبقة والبوصلة، يستطيع أن يُميّز بين مقاومة حقيقية للتحرر، وممانعة زائفة تُعيد إنتاج الهيمنة باسم السيادة.
نحو خطاب طبقي أممي يحرّر اليسار من فخاخ الهيمنة الجيوسياسية
إن ما سبق من تحليل يُبيّن بوضوح أن الهيمنة الثقافية، كما تتجلى اليوم، تمضي أبعد من مجرد تحريف الوعي، إذ تُعيد تشكيله بالكامل ضمن منظومة رمزية معولمة، كما وصفها غرامشي، لم تعد مجرد أداة في يد البرجوازية المحلية، بل تحوّلت في ظل العولمة الرأسمالية إلى شبكة معقّدة عابرة للقوميات، تُستخدم لتدجين الشعوب، وتحريف الوعي، وتحييد الثورات. وقد تمكّن رأس المال العالمي، عبر تحالفاته مع الإعلام والنخب الثقافية والأنظمة السلطوية، من خلق بيئة تزييف كلي يُعاد فيها إنتاج القمع باسم المقاومة، والاستغلال باسم التنمية، والرضوخ باسم الواقعية.
إن الخطورة الكبرى التي نواجهها ليست فقط في العدو الإمبريالي الواضح، بل في تشويش الرؤية التقدمية، وتشظي الذات اليسارية بين خطابين زائفين: النيوليبرالية الديمقراطية التي تروّج للحرية فيما تخضع لمنطق السوق، في مقابل السلطوية “الممانِعة” التي ترفع راية المقاومة بينما تمارس القمع والتسلط باسم السيادة.
هذه الثنائيات لا يجب أن تُحرج اليسار بل أن تُستفزّه لتأكيد استقلاليته الجذرية. فالمطلوب اليوم ليس تحالفًا ظرفيًا مع هذا الطرف أو ذاك، بل إعادة بناء خطاب تقدمي أممي يرفض الخضوع لمنطق “العدو الخارجي أولًا”، ويفهم أن الإمبريالية والاستبداد ليسا نقيضين، بل شريكين في تقويض تحرر الشعوب.
وهنا يعود نداء ماركس مجددًا: “يا عمال العالم اتحدوا!”، باعتباره دعوة متجددة لتشكيل جبهات تضامن عابر للحدود تستند إلى المصالح الطبقية المشتركة لا إلى الانفعالات الجيوسياسية لا كصرخة مجردة، بل كوعي جديد يتجاوز الاصطفافات الجغرافية والولاءات الهوياتية، ويرتكز على رؤية طبقية تفضح رأس المال أينما كان، وترى أن معركة العامل المصري أو الفلبيني أو الكولومبي هي واحدة، سواء كان خصمه شركة أمريكية أم جهازًا أمنياً “وطنياً” يدّعي حماية السيادة.
إن التحرر من الهيمنة الثقافية يتطلّب تفكيك آليات إنتاجها: من الإعلام إلى التعليم، من الخطاب الديني إلى خطاب “الأمن القومي”، ومن سرديات المقاومة المزيّفة إلى تمثيلات “العقلانية” الليبرالية. ويتطلب كذلك امتلاك الجرأة على أن نقول: لا لهذا ولا ذاك – لا للإمبريالية ولا للاستبداد المحلي – نعم للعدالة، للحرية، وللثورة.
فقط عبر هذا الوضوح، يمكننا استعادة زمام المبادرة، وتجديد مسؤولية اليسار في بلورة خطاب تحرري فعّال يتجاوز الشعارات، ويتجه نحو بناء بدائل عملية تعبّر عن مصالح الأغلبية المقهورة، وخلق يسار جديد لا يُبتزّ باسم السيادة، ولا يُضلّل باسم التقدم، بل يُعيد تعريف كليهما ضمن أفق تحرر طبقي شامل لا يعرف حدوداً. وتحويل المعركة من مواجهة رأس المال والسلطة إلى صراع داخلي بين ضحاياهما، في ظل غياب خطاب أممي واضح الطبقة والبوصلة، يستطيع أن يُميّز بين مقاومة حقيقية للتحرر، وممانعة زائفة تُعيد إنتاج الهيمنة باسم السيادة.