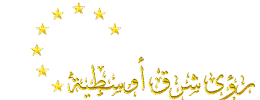إنّ الماركسية، بوصفها منهجًا نقديًا ماديًا جدليًا، لا تنظر إلى التاريخ كحصيلة لتراكم الوقائع العفوية أو الإرادات الفردية، بل كصيرورة تتشكّل بفعل التفاعل الدائم بين البنية التحتية (قوى وعلاقات الإنتاج) والبنية الفوقية (الأيديولوجيا، الثقافة، الدين، السياسة)، في إطار جدلية الذاتي والموضوعي. وانطلاقًا من هذا التصور، يمكننا أن نؤسس لفهم عميق للعلاقة المعقّدة بين تطوّر الوعي البشري، السيطرة على الطبيعة، أنماط الاستغلال، الهيمنة الأيديولوجية، ودور العامل الذاتي في التغيير التاريخي.
فإنّ الفهم الماركسي للتاريخ لا يقوم على الحتمية الاقتصادية الجامدة، بل على جدلية حية بين الذاتي والموضوعي، بين تطوّر قوى الإنتاج وتشكّل الوعي الجمعي، بين الهيمنة والمقاومة، بين الطليعة والجماهير. ومن خلال هذه الجدلية المعقدة تنبثق كل إمكانات التغيير والتحرر، وتتشكّل السيرورات التاريخية ليس كتحصيل حاصل، كما عبر عنها فردريك انجلز برسالته إلى جوزيف بلوخ (Joseph Bloch) بتاريخ 21 سبتمبر 1890 “وفقًا للمفهوم المادي للتاريخ، يشكّل إنتاج وإعادة إنتاج الحياة المادية العنصر الحاسم… ولم نؤكد لا ماركس ولا أنا أكثر من هذا أبدا. وبالتالي فإذا شوه شخص ما هذا الموقف، ليزعم أن العنصر الاقتصادي هو العنصر الحاسم الوحيد، فإنه يحوّل هذه الموضوعة إلى جملة مجردة لا معنى لها ولا مضمون”
تطوّر الوعي وتعاظم العامل الذاتي
إنّ العامل الذاتي، في التحليل الماركسي الجدلي، ليس مجرّد انعكاس سلبي للبنية المادية، بل قوة فاعلة في التاريخ. فكلما تطورت التناقضات داخل نمط الإنتاج، وكلما تراكمت الخبرات الجماعية في الفعل السياسي والاجتماعي، تعاظم دور العامل الذاتي وأصبح الوعي الطبقي قوة مادية قادرة على التنظيم والتغيير. فالوعي لا يتكوّن في الفراغ، بل ينبثق من الممارسة، ومن الاحتكاك المباشر مع بنية الاستغلال، ومن الصراع اليومي ضد آليات الإخضاع. وكما علّمنا ماركس، فإنّ الحياة الاجتماعية هي التي تحدد الوعي، لكن هذا الوعي، حين يتحوّل إلى وعي طبقي منظم، يصبح بدوره قوة تغيير نوعية.
وهنا تبرز العلاقة الجدلية بين الذاتي والموضوعي، بوصفها سيرورة لا حتمية: فكلما تطوّر العامل الموضوعي (قوى الإنتاج، التناقضات الطبقية)، كلما توفرت شروط الارتقاء بالوعي، والعكس صحيح: كلما ارتقى الوعي، تعاظم أثر العامل الذاتي بوصفه قوة تاريخية فاعلة. هذه العلاقة التبادلية بين شروط الواقع واستجابة الذات الواعية هي ما يمنح للتاريخ ديناميكيته الجدلية.
السيطرة على الطبيعة وتوسّع الوعي البشري
يمثّل تطوّر قدرة الإنسان على السيطرة على الطبيعة، من منظور ماركسي، انعكاسًا مباشرًا لتعاظم الوعي البشري وتقدّم قوى الإنتاج. فالانتقال من الفلاحة اليدوية إلى الصناعة الآلية، ومن التجربة العفوية إلى العلم المنهجي، لا يُعبّر فقط عن تطور معرفي، بل عن تحوّل في علاقة الإنسان ببيئته، قائم على التراكم التاريخي للمعرفة الناتجة عن الاحتكاك المادي بالعالم الطبيعي، وعن نمو الوعي بالسببية والعلاقات البنيوية التي تحكم الظواهر. وهكذا، استطاع الإنسان – تدريجيًا – أن يحرّر نفسه من بعض ضرورات الطبيعة، ويُخضعها لحاجاته المادية عبر أدوات وتقنيات تُجسّد العقل الجمعي في سيرورته التاريخية.
لكنّ هذه السيطرة لم تكن محايدة، ولم تتجه دومًا نحو التحرر. فمنذ أن تداخلت التقنية مع منطق تراكم رأس المال، باتت أدوات السيطرة على الطبيعة في قبضة الطبقات المالكة، تُستخدم لتعظيم الأرباح وتعميق التفاوت الاجتماعي. وهكذا، تحوّل التقدم التقني، في كثير من الأحيان، إلى أداة قمع واستلاب، بدلًا من أن يكون أداة تحرر. فبدلًا من أن تُوظّف الثورة التقنية في تقليص ساعات العمل وتحسين شروط العيش، استُخدمت لإخضاع الإنسان لمنطق السوق، وتسليع حاجاته، وتعميق اغترابه.
غير أنّ هذا التناقض لا يُلغي الإمكانات التحررية الكامنة في تطور قوى الإنتاج. فكل قفزة تكنولوجية تحمل في طياتها إمكانية تاريخية مزدوجة: أن تُكرّس الهيمنة، أو أن تُحدث قطيعة مع البنية الطبقية القائمة. ويتوقف الأمر على وعي الطبقات المقهورة بهذه الإمكانيات، وقدرتها على توجيه أدوات السيطرة على الطبيعة باتجاه مشروع تحرري شامل، يُعيد وصل الإنسان بعالمه الطبيعي لا بوصفه خصمًا له، بل حليفًا وشريكًا في إعادة إنتاج الحياة على أسس إنسانية وجمعية عادلة.
تحوّلات نمط السيطرة – من العنف المباشر إلى الهيمنة الرمزية
تميّزت أنماط السيطرة الطبقية، عبر التشكيلات الاجتماعية، بتغيّرات نوعية في أدوات الإخضاع. ففي التشكيلات العبودية والإقطاعية، كانت السيطرة تقوم على العنف المباشر، حيث يُسلب العامل – سواء كان عبدًا أو قنًا – جسده وإرادته. أما في الرأسمالية، فقد انتقل مركز السيطرة من المجال الفيزيائي إلى المجال الرمزي، ومن الإكراه العلني إلى الإقناع الأيديولوجي.
فالعامل في الرأسمالية “حرّ” من حيث الشكل، لكنه مستلب من حيث الجوهر، إذ يُجبر على بيع قوته العاملة في سوق تحكمه قوى لا شخصية. وهنا تظهر أهمية مفهوم الهيمنة الثقافية لدى أنطونيو غرامشي، الذي بيّن كيف أن البرجوازية لا تفرض سلطتها بالقوة وحدها، بل من خلال خلق توافق أيديولوجي يجعل من استغلالها أمرًا “طبيعيًا” ومقبولًا. وهذه الهيمنة لا تُمارس من خلال الدولة فقط، بل أيضًا عبر المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية، التي تشكّل جميعها ما يُعرف بـ”أجهزة الدولة الأيديولوجية” (ألتوسير).
لكن الهيمنة، مهما بدت متماسكة، ليست مطلقة. فهي في جوهرها علاقة صراع، تتضمّن دومًا إمكانية المقاومة. وكلما تعاظمت هذه الهيمنة، كلما تحفّزت ديناميات نقيضها: وعي نقدي، وخطاب بديل، وتنظيم ثوري. فالوعي، إذ ينكشف على الطابع الأيديولوجي للهيمنة، يصبح أداة لتفكيكها.
من هنا تتجلى أهمية التربية النقدية، والممارسة الثقافية التقدمية، والعمل الفكري المرتبط بالحقل الاجتماعي، بوصفها وسائل لتحرير الوعي من الاستلاب، وتمكين الجماهير من إنتاج سردياتها الخاصة. فالتحرر لا يبدأ بإسقاط النظام السياسي فحسب، بل بكسر البنية الأيديولوجية التي تُعيد إنتاج القبول به. وهذا يتطلب انخراطًا يوميًا في صراع ثقافي حاد، من أجل نزع الشرعية عن المفاهيم التي تحكم الوعي الجماعي، وزرع بذور وعي بديل متجذر في المصلحة الطبقية.
توسّع البناء الفوقي واشتداد الصراع الأيديولوجي
لقد أدّى تطوّر الرأسمالية، وخاصة في مرحلتها المتأخرة (النيوليبرالية)، إلى تعقيد غير مسبوق في البنية الفوقية، كما يظهر في اتساع تأثير الإعلانات التجارية، وانتشار المحتوى الثقافي عبر منصات مثل نتفليكس وتيك توك، التي تلعب دورًا مركزيًا في صياغة الخيال الجمعي وإعادة إنتاج الطبقات الاجتماعية. فالنظام لم يعُد يكتفي بأجهزة الدولة الصلبة، بل بات يعتمد بشكل متزايد على أجهزة رمزية – ثقافية، إعلامية، فنية، قانونية – تُعيد إنتاج الطبقات الاجتماعية عبر التأثير في الوعي والخيال الجمعي.
وقد أفضى هذا التوسّع إلى تصاعد الصراع داخل الحقل الفوقي، إذ لم يعُد مجال الثقافة محايدًا، بل بات ساحة معركة تُدار فيها أهم جولات الصراع الطبقي المعاصر. وهذا ما يستدعي من القوى التقدمية والماركسية إعادة النظر في وسائلها، وعدم الاكتفاء بالنضال الاقتصادي والسياسي، بل الانخراط في معركة شاملة ضد الأيديولوجيا السائدة، من خلال النقد الجذري للخطاب الإعلامي، وإنتاج خطاب ثقافي ثوري قادر على التأثير والتجذير في الوعي الجمعي.
في الرأسمالية المعاصرة، لا يُعد الإعلام مجرد وسيط ناقل، كما يتجلى في نماذج مثل TikTok وNetflix اللتين تمثلان أدوات مركزية في إعادة إنتاج الثقافة الاستهلاكية وتوجيه الذوق العام بشكل يعكس أولويات السوق للمعرفة أو الخبر، بل يُمثّل جهازًا أيديولوجيًا بالغ التأثير، يُعاد من خلاله تشكيل الوعي الجمعي وفق منطق السوق وأولويات رأس المال. وقد ازدادت خطورته في طوره الرقمي، حيث بات الإعلام يمارس الهيمنة لا فقط عبر الترويج للأيديولوجيا السائدة، بل من خلال إعادة تشكيل الحاجات، وتوجيه الذوق العام، وصياغة أنماط التفكير والخيال الاجتماعي.
الإعلام يُعيد إنتاج البنية الطبقية حين يُزيّف الواقع، ويُسطّح الوعي، ويُفرغ المفاهيم التحررية من مضامينها، ليُقدّم الفقر بوصفه فشلًا فرديًا، والتفاوت الطبقي كنتاج طبيعي للكفاءة أو الجهد، لا كنتيجة لبنية استغلالية ممنهجة. ومن خلال ذلك، يتحوّل إلى أداة خطيرة لإعادة إنتاج النظام القائم، عبر تطبيع اللامساواة وتهميش الخطابات النقدية.
كما إنّ خطورة الإعلام لا تكمن فقط في تسطيح الوعي الجماهيري وتزييف الواقع، بل تتعداه إلى التأثير في الوعي الناقد ذاته، عبر تطويقه داخل أطر خطابية مأذون بها، لا تُهدد البنية العميقة للنظام. فحتى حين يُسمح بظهور خطابات نقدية، فإنها غالبًا ما تُفكّك وتُحتوى، سواء عبر تحويلها إلى صيغ فردية غير مؤطرة طبقيًا، أو عبر دمجها في سوق الأفكار كمجرد “رأي آخر” داخل تعددية شكلية. وبهذا المعنى، يساهم الإعلام في إعادة تشكيل النقد ضمن حدود النظام، وتحويله من قوة تغيير إلى طاقة معزولة أو منزوعة الدلالة الجذرية.
غير أن هذه السيطرة ليست مطلقة. إذ تفتح الوسائط الرقمية ذاتها، على تناقضاتها، إمكانيات جديدة للمقاومة، شرط أن يُعاد توظيفها في سياق مشروع تحرري واضح المعالم. فالإعلام، بوصفه حقلًا للصراع، لا يُواجه فقط بالدفاع والتفكيك، بل يتطلّب استراتيجية هجومية ثقافية، ترتكز على إنتاج مضامين بديلة، وتأطير الوعي الجماهيري، وبناء شبكات تواصل ثوري بين الفاعلين المناهضين للهيمنة.
إنّ خوض الصراع الإعلامي ليس ترفًا تكميليًا، بل مهمة تستدعي أدوات واستراتيجيات جماعية لبناء سرديات مضادة، تُستثمر فيها الوسائط الرقمية والمنصات البديلة كمساحات للتثقيف السياسي والتعبئة الجماهيرية بل ضرورة استراتيجية. فالمعركة ضد الرأسمالية لا تكتمل إلا بتحرير الفضاء الرمزي من قبضة رأس المال، وتفكيك أدوات التزييف، وبناء سرديات مضادة تُعبّر عن المصلحة الطبقية للمضطهَدين، وتعيد صياغة الوعي الجمعي في اتجاه ثوري جذري.
نحو طليعة مجتمعية – من الحزب إلى الحقل الثقافي الجماهيري
لم تعد الطليعة، في سياق الصراع الطبقي المعاصر، محصورة في نموذج الحزب المركزي كما نظّر له لينين في شروطه التاريخية، بل بات الواقع الاجتماعي المعقّد يفرض تصوّرًا أوسع وأكثر تفاعلية لمفهوم الطليعة. فقد أفضت تحولات الحقل الاجتماعي، وخصوصًا توسّع المشاركة الجماهيرية في الفعل السياسي والثقافي، إلى إعادة تعريف الطليعة بوصفها شبكة متداخلة من الفاعلين الثوريين، كما يتجسد ذلك في تجارب مثل الزاباتيستا أو الحركات القاعدية المعاصرة التي تربط بين الفعل السياسي والمجتمعي من الأسفل المنتشرين عبر مختلف الحقول: من منظمات جماهيرية، واتحادات نقابية، وحركات نسوية، إلى مبادرات ثقافية، ومنصات إعلامية، وتشكيلات قاعدية محلية.
بهذا المعنى، لم تعد الطليعة مجرد قيادة مركزية تُوجّه الجماهير من علٍ، بل غدت فضاءً حيًّا تتلاقى فيه الطاقات الاجتماعية والسياسية، وتتشكل فيه بدائل الهيمنة، ويُعاد داخله بناء الوعي الطبقي على أسس نقدية وجماعية. إنها طليعة موزّعة ومنغرسة في البنية المجتمعية، لا تلغي التنظيم السياسي بل تعيد صياغة ضرورته: فبدلًا من أن يكون سلطة بيروقراطية مغلقة، يتحوّل التنظيم إلى مركز تنسيق تعبوي، وإطار حاضن للمبادرات الذاتية، وأداة لإنتاج المعنى والقيادة من داخل الحقل الشعبي نفسه.
وهكذا، فإنّ الطليعية الجديدة تدمج بين الفعل الثقافي والتنظيم الاجتماعي، بين الممارسة الجماهيرية والتأطير السياسي، بما يُمكّنها من مواجهة الهيمنة الأيديولوجية في مستواها الأعمق، لا فقط في بُعدها المؤسساتي، بل في بنيتها الخطابية والرمزية. إنّها طليعة تُستعاد من قلب الجماهير، لا تُفرَض عليها من الخارج، بل تُبنى عبر آليات ديمقراطية شعبية، مثل انتخاب القيادات من القاعدة، وتمكين الصوت الجماهيري من التأثير في القرار السياسي والتنظيمي.
خاتمة: من وعي الضرورة إلى ضرورة الوعي
إنّ المشروع الثوري، كما تفهمه الماركسية في صيغتها المادية الجدلية، ليس حدثًا منفصلًا أو قفزة خارقة لإرادة فردية، بل سيرورة تاريخية مركّبة، تنبثق من التفاعل الجدلي بين البنية والذات، بين الضرورة والحرية، بين الشروط الموضوعية وإرادة التغيير. فالثورة ليست مجرد انفجار لحظة، بل هي تراكم للوعي النقدي، وبناء متدرج لبنية ذاتية جماعية قادرة على التأثير في الشروط وإعادة صياغتها.
في هذا الإطار، فإنّ الفعل الثوري هو فعل مزدوج: تفكيك للبنية القائمة، وبناء لوعي بديل. وهو لا يتحقق إلا عبر التفاعل الحي بين العامل الذاتي والعامل الموضوعي، بين الممارسة السياسية والنظرية النقدية، بين الطليعة والجماهير. فكلما تعمّق الصراع داخل البنية الفوقية، كما في لحظات الانفجار الثقافي التي شهدتها ثورات مثل ماي 1968 أو الانتفاضات الإعلامية الحديثة، وتكشّفت تناقضات الهيمنة، ارتفع منسوب الرهان على الوعي، لا بوصفه انعكاسًا سلبيًا، بل كقوة مادية، كحركة واعية، كمجال للصراع والإبداع وإعادة التأسيس.
ومن هنا، فإن التحرر لا يُقاس بمدى زوال نظام قائم فقط، بل بمدى قدرة القوى الثورية على تحويل الهيمنة إلى مجال نزاع مفتوح، وعلى تحرير الحقول الرمزية من قبضة الرأسمال، وعلى إعادة إنتاج الذات الجماعية بوصفها فاعلًا تاريخيًا، لا مفعولًا به. إنّ الانتصار على الهيمنة لا يتم عبر كسر أدواتها فقط، بل أيضًا عبر تنظيم الفعل الجماهيري داخل الحقول الثقافية والإعلامية، وتأسيس منصات بديلة تُعيد بناء الوعي الجمعي على أسس نقدية وطبقية، وتُمكّن الفاعلين من ابتكار أدوات مقاومة جديدة متجذرة في الحياة اليومية. بل عبر إعادة تشكيل البنية الفوقية ذاتها كساحة مفتوحة للصراع الطبقي الواعي والمنظم.