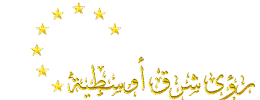شهد مفهوم الإمبريالية تحولات عميقة منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى بدايات القرن الحادي والعشرين، بحيث لم يعد محصوراً في صورته الكلاسيكية المرتبطة بالاحتلال العسكري المباشر، بل أخذ أشكالاً جديدة أكثر تركيباً ونعومة. ففي حين ارتبطت الإمبريالية التقليدية بتوسع الدول القومية الكبرى عبر الجيوش والأساطيل والسيطرة على الأراضي، برز في السياق المعاصر نمط جديد يمكن تسميته بـ “الإمبريالية الشركاتية“. هنا لم تعد الدولة الفاعل الوحيد في فرض الهيمنة، بل دخلت الشركات متعددة الجنسيات، بما تمتلكه من قدرات مالية وتكنولوجية وإعلامية، لتصبح أدوات رئيسية لإعادة إنتاج السيطرة على الدول الأضعف.
إن هذا التحول يعكس انتقال مركز الثقل من القوة الصلبة إلى القوة الناعمة، حيث تحل الاستثمارات، والتكنولوجيا، والعقود التجارية، محل الاحتلال العسكري المباشر كوسائل أكثر فاعلية لترسيخ التبعية. وبذلك، صار فهم الإمبريالية الحديثة أشبه بمحاولة قراءة ديناميكيات شركة عابرة للحدود تتحكم في مصائر اقتصادات بأكملها، قادرة على إعادة تشكيل النظام العالمي دون الحاجة إلى رفع أعلام أو إقامة قواعد عسكرية.
هذا الانتقال لم يكن مجرد تبدّل في الأدوات، بل نتاجاً لتطورات أوسع في بنية الرأسمالية العالمية: من الثورة الصناعية الثانية التي أتاحت وسائل غير مسبوقة للسيطرة، إلى صعود الرأسمالية الاحتكارية والمالية التي جعلت من تصدير رأس المال شرطاً لبقاء المراكز الرأسمالية. وبالموازاة مع ذلك، شكّلت أطروحات هوبسون ولينين وسمير أمين وغيرهم من المنظّرين الاقتصاديين مرجعيات أساسية لفهم الإمبريالية باعتبارها ضرورة بنيوية في النظام الرأسمالي وليست خياراً سياسياً عابراً.
ومع بروز مفهوم “الإمبريالية الشركاتية”، تُطرح إشكالية نظرية محورية:
هل تمثل “الشركاتية” مرحلة جديدة من تطور الرأسمالية يمكن اعتبارها أعلى مراحلها بعد ما حدده لينين؟
أم أنها مجرد توصيف معاصر للمرحلة الإمبريالية نفسها، التي استعادت إنتاج أدواتها بما يتلاءم مع شروط العولمة والتكنولوجيا الحديثة؟
تسعى هذه الدراسة إلى تتبّع مسار التحول من “إمبريالية الدولة” إلى “إمبريالية الشركات”، وتحليل آثاره على السيادة الوطنية والعلاقات الدولية وحقوق الإنسان. كما تحاول الكشف عن المفارقة الجوهرية في التجربة المعاصرة: فبينما يتقدّم خطاب العولمة بوصفه خطاباً عن الحرية والانفتاح والازدهار، تتجلى في الواقع أشكال جديدة من التبعية والهيمنة أقل صخباً لكنها أكثر رسوخاً. من هنا تأتي أهمية هذا البحث في طرح السؤال المركزي: هل نعيش في عصر ما بعد الإمبريالية، أم أننا إزاء إعادة إنتاج الإمبريالية في ثوب اقتصادي–شركاتي جديد؟
السياق التاريخي
تُعَدّ الحرب الإسبانية–الأمريكية عام 1898 محطة مفصلية في مسار السياسة الخارجية للولايات المتحدة. فقد شكّلت لحظة انتقال من وضعية العزلة النسبية إلى ممارسة نفوذ إمبريالي مباشر، إذ انتهت بضم بورتوريكو وغوام والفلبين، وفتحت الباب أمام نقاشات واسعة حول الدور الجديد لأمريكا في النظام الدولي الناشئ. لكن خلف هذا التحول الجيوسياسي برزت دوافع اقتصادية لا تقل أهمية، إذ ارتبطت الحرب ارتباطاً وثيقاً بمصالح الشركات الصناعية والتجارية الأمريكية التي سعت إلى فتح أسواق جديدة وتأمين مصادر خام أساسية. ولذلك اعتبر بعض المؤرخين أن هذه الحرب دشّنت ما سُمّي لاحقاً بـ “الانحراف العظيم”، أي اللحظة التي تخلّت فيها الولايات المتحدة عن خطابها المناهض للاستعمار، لتتبنى سياسة توسعية قائمة على الربح الاقتصادي وتوسيع النفوذ.
ومع نهاية القرن التاسع عشر، برزت ما عُرف بـ “الإمبريالية الجديدة”، التي قامت على السيطرة الاقتصادية بدلاً من الاحتلال العسكري المباشر. وقد ساعدت الثورة الصناعية والتطورات التكنولوجية على تعزيز هذا النمط من السيطرة، إذ وفّرت أدوات أكثر فعالية للاستغلال المالي والتجاري. ويمكن تشبيه هذه المرحلة بشركة عملاقة لا تحتاج إلى إرسال جيوش إلى الخارج، بل تعتمد على نفوذها المالي والإعلامي والتجاري لفرض هيمنتها على الأسواق والموارد.
الأسس الفكرية والاقتصادية للتحول
شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين صعود أيديولوجيات متشابكة أعادت تعريف الإمبريالية من جديد. في مقدمة هذه الأيديولوجيات برزت فكرة الدولة–الأمة التي ارتبطت بصعود النزعة القومية، حيث جرى تبرير التوسع الخارجي بوصفه ضرورة لحماية مكانة الدولة وتعزيز قوتها في النظام الدولي. لكن هذه المبررات القومية لم تكن وحدها؛ فقد ترافق معها بعد ديني–ثقافي تجسّد في خطاب “رسالة التمدين”. القوى الغربية قدّمت نفسها آنذاك على أنها حاملة للحضارة والقيم الحديثة إلى الشعوب المستعمَرة، بينما كان هذا الخطاب، في جوهره، غطاءً يخفي مصالح اقتصادية واضحة. ويمكن تقريب الصورة بمثال معاصر: كأن تُسوّق شركة كبرى نفسها على أنها تجلب “التقدم والتنمية”، بينما هدفها الحقيقي هو السيطرة على السوق المحلي.
في هذه المرحلة، ظهرت أيضاً نظريات اقتصادية حاولت تفسير الإمبريالية وتقديم إطار نظري لها. فقد جاءت نظرية التبعية لتؤكد أن اقتصادات الأطراف في دول الجنوب ستظل مرهونة للمراكز الرأسمالية العالمية بسبب التبادل غير المتكافئ. أما الاقتصادي البريطاني هوبسون (1902) فاعتبر أن الإمبريالية ليست سوى نتاج لفائض الإنتاج في الاقتصادات الصناعية، وأن التوسع الخارجي يشكل وسيلة لتصريف السلع الفائضة. من جانبه، ذهب لينين إلى أبعد من ذلك حين رأى أن الإمبريالية تمثل “أعلى مراحل الرأسمالية”، حيث يسعى رأس المال المالي إلى السيطرة على العالم من خلال القروض والاستثمارات. ببساطة، يمكن القول إن هذه النظريات قدّمت صورة واضحة: الإمبريالية ليست خياراً سياسياً عابراً، بل ضرورة اقتصادية ملازمة لبنية النظام الرأسمالي ذاته.
ولا يمكن تجاهل دور الثورة الصناعية الثانية في دفع الإمبريالية نحو مسارات جديدة. فقد جاءت الابتكارات التكنولوجية في النقل (مثل السكك الحديدية والبواخر) والاتصالات (مثل التلغراف) لتوفّر أدوات غير مسبوقة للسيطرة الاقتصادية. لقد جعلت هذه الابتكارات استغلال الموارد الطبيعية في أفريقيا وآسيا أكثر كثافة وفاعلية. وللتوضيح، يمكن أن نتخيل كيف غيّر التلغراف قواعد اللعبة: فقد صار بإمكان القوى الكبرى التحكم في مستعمراتها البعيدة بسرعة ودقة غير مسبوقة، أشبه بما يفعله الإنترنت اليوم في ربط الأسواق العالمية لحظة بلحظة.
ومع ذلك، لم يكن الطابع الاقتصادي وحده كافياً لفهم طبيعة الإمبريالية الحديثة. فقد ارتبطت أيضاً برغبة الدول الكبرى في تثبيت مكانتها داخل التوازنات الدولية. التوسع الاقتصادي كان في الواقع قاعدة لتعزيز النفوذ العسكري والسياسي. يتضح ذلك في السياسات الأمريكية في الفلبين وكوبا، حيث تداخلت المصالح التجارية مع الأهداف الجيوسياسية. بكلمات أخرى، لم تكن الإمبريالية الحديثة مجرد “تجارة مربحة”، بل مشروع متكامل يجمع بين الاقتصاد والجغرافيا السياسية، ويوفر للقوى الكبرى موقعاً متفوقاً في النظام العالمي الناشئ.
الانتقال من الإمبريالية الدولتية إلى الإمبريالية الشركاتية
مع نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، بدأت الإمبريالية تأخذ شكلاً جديداً أكثر تعقيداً من النماذج الكلاسيكية التي عرفها العالم. فبعد أن كانت الدولة القومية هي الفاعل المركزي في بسط النفوذ الخارجي، أخذت الشركات الكبرى، وخاصة متعددة الجنسيات، تفرض نفسها بوصفها أدوات رئيسية للهيمنة. أطلق الباحثون على هذا النمط الجديد اسم “الإمبريالية الشركاتية”، حيث لم تعد الجيوش وحدها هي التي تفتح الأسواق وتؤمن الموارد، بل غدت مصالح الشركات الصناعية والتجارية القوة الدافعة خلف السياسات الخارجية. ببساطة، يمكن القول إن الدولة لم تتراجع عن دورها، لكنها تحولت تدريجياً إلى “حارس لمصالح الشركات”، تتدخل عسكرياً وسياسياً متى اقتضت الحاجة ضمان استمرار نفوذها. وكان هذا النموذج بارزاً بوضوح في التجربة الأمريكية بعد الحرب الإسبانية–الأمريكية، حيث لعب النفوذ العسكري والسياسي دوراً مباشراً في تمهيد الطريق أمام التوسع التجاري والاستثماري.
ولتوضيح هذا التحول بالأرقام، تكشف المقارنة التاريخية بين أكبر الشركات العالمية والناتج المحلي الإجمالي (GDP) للدول الإمبريالية الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) عن مسار صعودي متسارع في قوة الشركات. ففي عام 1920 بلغت القيمة السوقية لشركة US Steel نحو 2 مليار دولار، أي ما يعادل 2.2% من الاقتصاد الأمريكي و8% من الاقتصاد الفرنسي. ومع منتصف القرن العشرين ارتفع الوزن النسبي للشركات، حيث شكّلت قيمة IBM عام 1970 نحو 20% من اقتصاد فرنسا. ومع بداية الألفية، صارت Microsoft (600 مليار دولار) تعادل حوالي 40% من اقتصاد بريطانيا. أما في العقدين الأخيرين فقد وصل الأمر إلى أن شركة واحدة مثل Apple بلغت قيمتها في 2023 نحو 3 تريليونات دولار، أي ما يعادل كامل الاقتصاد الفرنسي تقريباً (100%)، ويقارب اقتصاد بريطانيا (93.8%) وألمانيا (71.4%)، بينما لا تزال أقل من 12% من الاقتصاد الأمريكي.
| السنة | أكبر شركة | القيمة السوقية | % من اقتصاد الولايات المتحدة | % من اقتصاد بريطانيا | % من اقتصاد فرنسا | % من اقتصاد ألمانيا |
| 1920 | US Steel | 2 مليار دولار | 2.2% | 6.7% | 8% | 5.7% |
| 1970 | IBM | 5 مليار دولار | 5% | 16.7% | 20% | 12.5% |
| 2000 | Microsoft | 600 مليار دولار | 6% | 40% | 42.9% | 30% |
| 2020 | Apple | 2 تريليون دولار | 9.5% | 66.7% | 69% | 52.6% |
| 2023 | Apple | 3 تريليون دولار | 11.5% | 93.8% | 100% | 71.4% |
تولت الشركات متعددة الجنسيات مهمة إعادة إنتاج الهيمنة الإمبريالية بأساليب جديدة. لم يعد الاستعمار يتجسد في رفع أعلام على أراضٍ وفرض إدارات استعمارية مباشرة، بل بات يظهر في السيطرة على الموارد الطبيعية والأسواق المحلية عبر التفوق المالي والتكنولوجي. في هذا السياق، تحولت بعض الشركات إلى ما يشبه “دول داخل الدولة”، تمتلك من النفوذ الاقتصادي والسياسي ما يجعلها قادرة على التأثير في مصائر شعوب بأكملها.
فعلى سبيل المثال، سيطرت شركات النفط الأمريكية والبريطانية على اقتصادات الشرق الأوسط وأفريقيا، ليس فقط من خلال استخراج الموارد، بل أيضاً عبر التحكم بمسارات التوزيع والأسعار. وقد جعل ذلك العديد من هذه الدول في موقع التبعية الدائمة. وفي أمريكا اللاتينية، لعبت الشركات الزراعية، وعلى رأسها شركات الموز، دوراً مشابهاً؛ إذ استحوذت على مساحات شاسعة من الأراضي حتى باتت بعض الدول تُعرف اصطلاحاً بـ “جمهوريات الموز”، في إشارة إلى حجم سيطرة الشركات الأجنبية على القرار السياسي والاقتصادي المحلي.
من المهم الإشارة هنا إلى أن توسع هذه الشركات لم يكن ممكناً لولا الغطاء الذي وفرته الحكومات الغربية. فهي لم تكن تعمل في فراغ، بل كانت تحظى بدعم مباشر من دولها الأم. في كثير من الحالات، تدخلت الولايات المتحدة عسكرياً في أمريكا الوسطى والجنوبية لحماية استثمارات شركاتها الزراعية، والأمر ذاته انطبق على القوى الأوروبية التي اعتمدت على أساطيلها البحرية لتأمين مصالحها في آسيا وأفريقيا. هكذا، بدا أن العلاقة بين الدولة والشركة علاقة تبادلية: الدولة توفّر الحماية العسكرية والدبلوماسية، بينما تؤمّن الشركات موارد مالية تعزز قوة الدولة في النظام الدولي. لذلك يصعب الفصل تماماً بين الإمبريالية الدولتية والإمبريالية الشركاتية؛ فهما متشابكتان إلى حد كبير.
ما يميز الإمبريالية الشركاتية عن سابقتها هو الأدوات الجديدة التي استخدمتها للهيمنة. لم يعد الاحتلال العسكري المباشر الوسيلة الوحيدة، بل ظهرت آليات أكثر مرونة وفاعلية. أولها الهيمنة المالية التي تجسدت في القروض والديون الدولية، حيث جرى إخضاع اقتصادات الدول النامية لشروط قاسية جعلتها رهينة لمؤسسات مالية مرتبطة برؤوس الأموال الغربية. هذه الديون لم تكن مجرد التزامات اقتصادية، بل آلية لإعادة إنتاج التبعية على نحو مستمر.
إلى جانب ذلك، برزت التبعية التكنولوجية كسلاح جديد. فاحتكار الشركات الغربية للتكنولوجيا والمعرفة جعل الدول النامية عاجزة عن بناء اقتصادات مستقلة، بل تابعة دائماً لما تنتجه المراكز الصناعية. كما فرضت القوى الكبرى اتفاقيات تجارية غير متكافئة أُبرمت تحت ضغوط سياسية واقتصادية، أجبرت الدول الضعيفة على فتح أسواقها أمام السلع الأجنبية دون امتلاك أدوات لحماية صناعاتها المحلية. ويمكن تشبيه هذه الاتفاقيات ببوابة واسعة تُفتح أمام المنتجات الغربية، بينما تبقى صادرات الدول النامية محصورة ومقيدة.
لقد أعاد هذا التحول تعريف الإمبريالية من جديد. فهي لم تعد مشروعاً عسكرياً–سياسياً خالصاً تديره الدولة، بل أصبحت مشروعاً اقتصادياً–شركاتياً، تدعمه الدولة عند الحاجة. وبذلك تحولت الشركات متعددة الجنسيات إلى فاعلين دوليين مستقلين نسبياً، يتجاوز تأثيرهم في أحيان كثيرة تأثير بعض الدول الصغيرة أو المتوسطة. غير أن هذا النفوذ لم يكن بلا تبعات؛ فقد أسهم في إعادة صياغة موازين القوى داخل النظام العالمي، بحيث صار الاقتصاد – وليس القوة العسكرية وحدها – الميدان المركزي للصراع والهيمنة. بهذا المعنى، يمكن القول إن القرن العشرين شهد ولادة مرحلة جديدة من الإمبريالية: مرحلة أقل وضوحاً من حيث الاحتلال العسكري المباشر، لكنها أكثر عمقاً وتأثيراً في إعادة تشكيل النظام الدولي.
الأطر التنظيمية والمساءلة في مواجهة الإمبريالية الشركاتية
مع اتساع نفوذ الشركات متعددة الجنسيات وتزايد ما يرتبط بأنشطتها من انتهاكات لحقوق الإنسان والبيئة، برزت الحاجة الملحة إلى وضع أطر قانونية وتنظيمية قادرة على ضبط هذا النفوذ. فهذه الشركات غالباً لا تخضع إلا لقوانين بلدانها الأم، بينما تمارس أنشطتها في بيئات تعاني هشاشة قانونية أو سياسية، الأمر الذي يترك لها مجالاً شبه مطلق للتأثير على السيادة الوطنية. يمكن القول إن هذه الوضعية خلقت فراغاً قانونياً على المستوى الدولي، سمح للشركات بأن تمارس شكلاً من أشكال “الاستعمار الاقتصادي” دون محاسبة فعلية. والسؤال الجوهري هنا: من يحاسب كيانات عابرة للحدود لا تخضع لسلطة دولة واحدة؟
في محاولة لمعالجة هذا الفراغ، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2011 ما يُعرف بـ المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGPs). وقد شكّلت هذه المبادئ نقطة تحول مهمة، لأنها مثّلت حتى الآن الإطار المرجعي العالمي الأكثر شمولاً لتنظيم العلاقة بين الشركات وحقوق الإنسان. قامت هذه المبادئ على ثلاث ركائز أساسية:
الأولى، واجب الدولة في حماية حقوق الإنسان من أي انتهاكات ترتكبها الشركات ضمن نطاق سلطتها.
الثانية، مسؤولية الشركات ذاتها في احترام حقوق الإنسان وعدم التورط في أي انتهاكات مباشرة أو غير مباشرة.
الثالثة، توفير سبل انتصاف فعّالة للضحايا، سواء عبر آليات قضائية أو غير قضائية.
ورغم أهميتها من الناحية النظرية، فإن هذه المبادئ تظل غير ملزمة قانونياً، وهو ما يضعف كثيراً من فعاليتها. فهي أقرب إلى “إعلان نوايا” يوجّه السياسات العامة أكثر من كونها أداة قادرة على فرض التزامات عملية على الشركات.
إلى جانب ذلك، ظهرت مبادرات طوعية هدفها تعزيز الشفافية والالتزام الأخلاقي لدى الشركات. من أبرزها مبادرة الإبلاغ عن الاستدامة (GRI)، التي تدفع الشركات الكبرى إلى نشر تقارير دورية عن أثر أنشطتها البيئية والاجتماعية. كما انتشرت اتفاقيات استدامة طوعية جاءت استجابة لضغوط المجتمع المدني وحركات حقوق الإنسان، مطالبة الشركات باعتماد سياسات أكثر مسؤولية تجاه المجتمعات المحلية. غير أن هذه الأدوات، رغم ما تحمله من وعود، تعرضت لانتقادات حادة، إذ وُصفت في كثير من الأحيان بأنها مجرد آليات للعلاقات العامة تُستخدم لتلميع صورة الشركات بدلاً من محاسبتها بجدية.
من هنا، علت الأصوات في السنوات الأخيرة مطالبة بصياغة معاهدة دولية ملزمة تُقر بمسؤولية الشركات عن الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. يستند هذا التوجه إلى إدراك متزايد بأن غياب إلزامية القوانين الدولية يترك الباب مفتوحاً أمام الشركات لممارسة أشكال جديدة من الهيمنة الاقتصادية، قد تكون أقل وضوحاً من الاستعمار التقليدي لكنها لا تقل خطورة. وبالتالي، فإن المطالبة بمعاهدة ملزمة ليست مجرد نقاش أكاديمي أو قانوني، بل تعبير عن حاجة سياسية وإنسانية ملحة لضمان ألا تتحول الشركات إلى سلطات فوق الدول.
لكن الطريق إلى تفعيل مثل هذه الأطر ليس سهلاً، إذ تعترضه عقبات أساسية. أول هذه العقبات ضعف الإرادة السياسية لدى الدول الكبرى التي غالباً ما تنظر إلى هذه الشركات كامتداد طبيعي لقوتها الاقتصادية، وبالتالي لا تجد مصلحة في تقييدها. أما العقبة الثانية فتكمن في هشاشة الدول النامية واعتمادها الكبير على الاستثمارات الأجنبية، ما يجعلها مترددة في فرض قوانين محلية صارمة قد تدفع الشركات إلى الانسحاب. وتتمثل العقبة الثالثة في محدودية القضاء الدولي، حيث تظل آليات محاسبة الشركات العابرة للحدود ضعيفة للغاية وتعتمد في الغالب على تعاون الدول المضيفة.
في ضوء هذه التحديات، تبدو معركة بناء إطار قانوني عالمي لمساءلة الشركات متعددة الجنسيات طويلة ومعقدة. ومع ذلك، فإن تزايد الوعي المجتمعي والضغط المتصاعد من منظمات حقوق الإنسان يشيران إلى أن هذه القضية ستبقى مطروحة بقوة على جدول أعمال النظام الدولي. ببساطة، وضعت الإمبريالية الشركاتية الإنسانية أمام اختبار صعب: كيف يمكن ضبط قوة اقتصادية جبارة عابرة للحدود من دون أن تتحول إلى شكل جديد من الاستعمار؟
الخاتمة
يكشف تتبّع مسار الإمبريالية منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى بدايات القرن الحادي والعشرين عن تحول بنيوي عميق في طبيعة الهيمنة العالمية. فقد انتقلت الإمبريالية من نموذجها الكلاسيكي الذي ارتبط بسيطرة الدول القومية عبر الاحتلال العسكري المباشر، إلى نموذج أكثر تركيباً يتمثل في الإمبريالية الشركاتية، حيث أصبحت الشركات متعددة الجنسيات الفاعل المحوري في إعادة إنتاج التبعية الاقتصادية والسياسية.
هذا التحول لم يكن مجرد انتقال في الأدوات، بل كان انعكاساً لتطورات أوسع ارتبطت بالثورة الصناعية، وصعود الرأسمالية الاحتكارية، وبروز نظريات اقتصادية مثل أطروحات هوبسون ولينين التي فسّرت الإمبريالية باعتبارها مخرجاً حتمياً لفائض الإنتاج أو باعتبارها أعلى مراحل الرأسمالية. كما كان نتاجاً لصعود أيديولوجيات قومية ودينية–ثقافية أعادت تعريف التوسع الخارجي بوصفه “رسالة تمدين”، بينما كان يخفي في جوهره أهدافاً ربحية واضحة.
ومع تزايد اندماج الاقتصاد العالمي، غدت الشركات متعددة الجنسيات أدوات استعمار اقتصادي غير مباشر، استحوذت على موارد استراتيجية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وحوّلت بعض الدول إلى ما عُرف اصطلاحاً بـ”جمهوريات الموز”. وقد لعبت الدول الكبرى دور الحامي لهذا النمط الجديد من الهيمنة، مستخدمة قوتها العسكرية والدبلوماسية لصالح مصالح شركاتها. وهكذا، اندمجت مصالح الدولة والشركة في علاقة تبادلية عززت من نفوذ الإمبريالية في ثوبها الجديد.
غير أن هذا التحول أفرز إشكاليات خطيرة على مستوى السيادة الوطنية وحقوق الإنسان. فالإمبريالية الشركاتية اعتمدت على أدوات مثل الهيمنة المالية، والتبعية التكنولوجية، والاتفاقيات التجارية غير المتكافئة، وهي أدوات أقل صخباً من الاحتلال العسكري، لكنها أكثر رسوخاً في إدامة التبعية. وقد جعل ذلك من الشركات متعددة الجنسيات فاعلين دوليين ينافسون الدول ذاتها في التأثير، الأمر الذي أعاد رسم موازين القوى في النظام العالمي.
أمام هذه التحديات، برزت الحاجة إلى أطر تنظيمية وقانونية دولية. فجاءت المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة (2011) لتشكل خطوة مهمة في تحديد مسؤوليات الشركات، لكنها بقيت غير ملزمة، ما حدّ من فعاليتها. كما ظهرت مبادرات طوعية مثل تقارير الاستدامة، لكنها بدت في كثير من الأحيان مجرد أدوات للعلاقات العامة أكثر من كونها آليات مساءلة حقيقية. لهذا علت الأصوات المطالبة بمعاهدة دولية ملزمة تقر بمسؤولية الشركات، وهو نقاش لا يزال مفتوحاً ويعكس إدراكاً متنامياً بأن ضبط قوة هذه الكيانات ضرورة لحماية حقوق الشعوب وسيادة الدول.
في النهاية، يمكن القول إن الإمبريالية لم تنتهِ، بل أعادت تشكيل نفسها بما يتناسب مع تحولات الاقتصاد والسياسة العالمية. وإذا كانت الإمبريالية الكلاسيكية قد ارتبطت بجيوش وأساطيل، فإن الإمبريالية المعاصرة ترتبط بعقود تجارية، واستثمارات مالية، وشبكات نفوذ اقتصادي عابرة للحدود. وهنا تكمن المعضلة: كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يطور أدوات فعّالة لمساءلة هذه القوى الجديدة، دون أن يقع في فخ “استعمار اقتصادي” يعيد إنتاج أنماط الهيمنة القديمة بوسائل أكثر نعومة وخفاء؟