-دراسة في الجذور الطبقية والخطاب الأيديولوجي المعادي للبراكْسيس–
في العقود الأخيرة، ترسّخ في الخطاب السياسي والإعلامي، وأحياناً حتى في بعض الأوساط التقدمية، استخدام توصيف «المُنظِّر» كنوع من الانتقاص من قيمة المفكر أو المناضل. لا يُقصد به هنا الإشادة بقدرته على إنتاج الفكر النقدي، بل تصويره كمنعزل في «برج عاجي» بعيد عن هموم الواقع ومعاركه. هذا الاستخدام لا يفتح باب النقاش مع النظرية أو اختبار قوتها، بل يسعى ببساطة إلى إقصائها عبر ربطها بالعجز العملي أو الجدل العقيم. والمفارقة أن هذا الخطاب لم يعد حكراً على خصوم الفكر الماركسي أو اليسار، بل تسلّل أحياناً إلى قلب الحركة التقدمية نفسها، خاصة حين يشتد الصراع بين تيار يرى أن العمل الفكري شرط أساسي للممارسة الثورية، وآخر يرفع من شأن الفعل الميداني المباشر حتى لو كان منفصلاً عن التحليل العميق.
هذا التوتر بين النظرية والممارسة ليس أمراً طارئاً، بل امتداد لإشكالية قديمة ناقشها ماركس وإنجلز منذ القرن التاسع عشر. فقد عالجا العلاقة الجدلية بين البنية التحتية، أي الأساس المادي لعلاقات الإنتاج، وبين البنية الفوقية بما تشمل من مؤسسات سياسية وثقافية وأيديولوجية. في الرؤية الماركسية، البنية الفوقية ليست مجرد انعكاس آلي للبناء التحتي، بل هي ساحة مفتوحة للصراع الطبقي، حيث تُصاغ الأفكار وتُختبر، وقد تُعيد هذه الأفكار تشكيل الوعي الجمعي نفسه. من هنا، يصبح التقليل من قيمة النظرية أداة أيديولوجية في يد الطبقات المهيمنة، لأنها تحدّ من إمكانيات الوعي النقدي، وتُبقي النشاط السياسي محصوراً في مساحة آمنة لا تمس جوهر الهيمنة.
من الناحية اللغوية، يشير مصطلح «التنظير» إلى إنتاج معرفة منهجية وصياغة أطر تفسيرية لفهم الظواهر. وفي الفكر الماركسي، هو جزء لا يتجزأ من البراكسيس، أي وحدة النظرية والممارسة في مشروع التغيير الثوري. لكن هذا المعنى الإيجابي تآكل بمرور الزمن، خاصة مع صعود ثقافة براغماتية تُمجّد الحلول السريعة وتهمّش التحليل البنيوي العميق. هكذا، تحوّل «التنظير» في الخطاب السائد إلى مجرد ترف فكري منفصل عن الواقع، بدل أن يُنظر إليه كأداة لكشف القوانين الكامنة وراء الظواهر وتغيير بنيتها. والنتيجة أن كثيراً من الحركات السياسية فقدت القدرة على صياغة استراتيجيات متماسكة ترتبط بجذور الصراع الطبقي بدل الاكتفاء بردود فعل سطحية.
الاستخدام السلبي في التاريخ السياسي
خلال أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، شهدت الحركة العمالية الأوروبية انقسامات حادة بين تيارات تمسكت بالعمل السياسي المنظم والنظرية الثورية — كما مثّله الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني — وأخرى دفعت نحو النضال النقابي المباشر، معتبرة الانخراط في التحليل النظري شكلاً من «الإغراق في التنظير». في هذا السياق، أصبح وصف «المنظّر» يُطلق على القيادات المرتبطة بالمكاتب الحزبية والصحف المركزية، في مقابل صورة «المناضل العملي» الذي يقف في خطوط الإنتاج ويخوض معارك الميدان.
ومع توسع الحركات الشيوعية بعد ثورة أكتوبر 1917، تحول اتهام «التنظير» إلى أداة بارزة في النزاعات الداخلية. فبعض القيادات وُصِفت بأنها غارقة في الجدل الفكري على حساب «المهام الثورية العاجلة». ورغم أن لينين دافع بقوة عن مركزية النظرية في النضال الثوري، فإنه وجّه نقداً صارماً لأولئك الذين يحوّلون النقاش الفكري إلى غاية بحد ذاته، دون أن يربطوه بمهام سياسية محددة وملموسة تخدم مسار الثورة.
أما في النصف الثاني من القرن العشرين، وخصوصاً في العالم العربي وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، فقد أخذت هذه التهمة شكلاً جديداً. فقد برزت الخلافات بين قيادات مثقفة سعت لصياغة قراءة معمّقة للسياقين المحلي والدولي، وقيادات ميدانية انشغلت بالعمل العسكري أو بالتفاوض السياسي المباشر. في التجربة الجزائرية مثلاً، وُصِف بعض أعضاء جبهة التحرير الوطني بأنهم «منظّرون بعيدون عن المعركة»، رغم أن ما قدّموه من تحليلات كان يهدف إلى تأطير النضال برؤية استراتيجية طويلة المدى، لا إلى الانفصال عن واقع المعركة.
الاستخدام السلبي في السياق المعاصر
في ظل هيمنة النيوليبرالية، تشكّل خطاب إعلامي وسياسي يقدّم «المنظّر» كرمز للعزلة والانفصال عن الواقع، أسير قاعات الجامعات أو المراكز البحثية، وعاجز — كما يُروَّج — عن «تقديم حلول عملية». هذا التصوير لا يقترب من جوهر النقد الماركسي أو التحليل البنيوي، بل يستبعده عمداً لصالح خطاب «براغماتي» يكتفي بإصلاحات سطحية لا تمس بنية السلطة أو تفكك أسسها.
حتى في أوساط اليسار الجديد والحركات الاحتجاجية، يُستَخدم اتهام «التنظير» أحياناً كسلاح لإخماد النقاشات المعقدة حول الاستراتيجية والتنظيم. ففي موجات مثل «احتلوا وول ستريت» أو «الربيع العربي»، وُصفت المناقشات النظرية بأنها ترف يبطئ «الزخم الثوري»، ما أدى — في بعض الحالات — إلى قرارات متسرعة وغياب رؤية استراتيجية بعيدة المدى.
وفي الجامعات العربية، يتخذ هذا الاتهام بعداً مزدوجاً: فمن جهة، تُختزل البحوث النظرية إلى مجرد ملفات على «رفوف المكتبات»، ويُستهان بمحاولات الربط بين الفكر والممارسة. ومن جهة أخرى، يواجه الأكاديميون اليساريون انتقادات متناقضة؛ إذ يصوّرهم الإعلام الرسمي كـ«متطرفين» فكرياً، بينما يرى بعض النشطاء أنهم غير منخرطين ميدانياً بما يكفي، وكأن هناك معادلة مستحيلة للإيفاء بكلا المعيارين.
من منظور تحليل الخطاب، تعمل تهمة «التنظير» على ترسيخ ثنائية زائفة بين «النظرية» و«الممارسة»؛ ثنائية تُقدَّم باعتبارها تناقضاً لا تكاملاً. الهدف من هذا البناء الخطابي هو نزع الشرعية عن الفكر النقدي عبر تصويره كعائق أمام الفعل، مما يرسّخ ثقافة سياسية تميل إلى تفضيل الحلول السريعة والمحدودة على التحليل البنيوي العميق. الأيديولوجيا المهيمنة تغذّي هذه الصورة، فتصنع كاريكاتور «المثقف الكسول» أو «المنظّر المعزول» لتقويض إمكانية إدراك أن النظرية، في حقيقتها، ليست نشاطاً منفصلاً عن الميدان، بل أداة أساسية لصياغة الفعل نفسه وتوجيهه في أفق تغييري جذري.
ويتجاوز استخدام تهمة «التنظير» الإطار السياسي أو اليساري الضيق، ليجد امتداده في الحقل الثقافي والاجتماعي الأوسع عبر صيغ لغوية أخرى، أبرزها مصطلح «التفلسف» الذي يُستَخدم بلهجة تهكمية في الحياة اليومية لوصف أي محاولة للدخول في نقاش نظري أو تحليلي معمق. قد يبدو هذا التوظيف الشعبي مجرد مزحة أو تعليق عابر، لكنه يعكس في جوهره موقفاً ثقافياً مترسخاً ضد التفكير المنهجي والنقدي، ويغذي ميلاً عاماً لتفضيل التفسيرات السطحية الجاهزة على الاشتغال العقلي المركّب. وبهذا المعنى، تصبح الإدانة الضمنية لـ«التفلسف» الوجه الثقافي العام للإدانة السياسية لـ«التنظير»، وكلاهما يعمل على إقصاء التحليل العميق من المجال العام، وحصر النقاشات في حدود الانطباعات اللحظية والمعالجات السريعة للأحداث.
وعلى المستوى الداخلي للأحزاب اليسارية والشيوعية، لا يظل هذا الاتهام في إطار النقد الثقافي أو الإعلامي، بل يتحول أحياناً إلى أداة سياسية لحماية مواقع السلطة داخل التنظيم. فكثير من القيادات الحزبية ترى في العمل النظري الجاد تهديداً مباشراً لمكانتها، ليس لأنه يعطل العمل الميداني كما تدّعي، بل لأنه قادر على كشف الضبابية الفكرية، أو التناقضات غير المبدئية في المواقف السياسية والتنظيمية، أو حتى غياب رؤية استراتيجية متماسكة. في هذه الحالة، يصبح الهجوم على «التنظير» وسيلة لإغلاق النقاش الداخلي أمام القواعد، والتحكم في أجندة الحوار بحيث تُجنَّب الأسئلة الحرجة التي قد تدفع إلى مراجعة جذرية للخط السياسي أو إلى إعادة توزيع موازين القوى داخل الحزب. هذا الاستخدام الداخلي لا يقل خطورة عن توظيف التهمة في الخطاب الإعلامي المعادي، لأنه يضرب من الداخل القدرة على النقد الذاتي، ويعطل إمكانات تطوير النضال وتوسيع أفقه.
دلالات الاتهام في الصراع الطبقي
إن اتهام «التنظير» لا يمكن النظر إليه كمجرد نقد أسلوبي أو اختلاف حول ترتيب الأولويات التنظيمية، بل هو في جوهره ممارسة أيديولوجية تتحرك داخل قلب الصراع الطبقي. فهو يسهم في إعادة إنتاج علاقات الهيمنة عبر تشويه الرابط الجدلي بين الفكر والعمل. فالطبقات المسيطرة، بما تملكه من أدوات إنتاج الثروة وأدوات إنتاج الخطاب معاً، تدرك أن ما يهدد استقرارها ليس الفعل العفوي أو الاحتجاج اللحظي، بل تراكم وعي نقدي منظم قادر على قراءة البنية الاجتماعية بعمق، وتحويل هذه القراءة إلى استراتيجية نضالية ممتدة على المدى الطويل.
ومن هذا المنطلق، يصبح تحقير النظرية جزءاً من استراتيجية أشمل تهدف إلى احتواء الحركات الشعبية. فعندما يُختزل الفعل السياسي في مبادرات رمزية أو ردود فعل آنية، فإنه يصبح عرضة للتفريغ أو الاستيعاب ضمن النظام القائم. أما الدمج الواعي للنظرية والممارسة، فيمثل خطراً مضاعفاً، لأنه يمنح النضال القدرة على تحديد أهدافه بدقة، ورسم مراحله بوضوح، وكشف تناقضات الخصم الطبقي على نحو منهجي.
إن ترويج صورة «المنظّر المعزول» يخدم، في نهاية المطاف، هدفاً واضحاً: حرمان الحركات الاجتماعية والسياسية من امتلاك الأدوات التحليلية التي تتيح لها تجاوز السطحيات إلى الجذور، والتحرك على أساس فهم للتاريخ باعتباره عملية صراع مستمرة، لا مجرد سلسلة أحداث متفرقة. بهذا المعنى، يصبح الاتهام نفسه أحد أشكال الهيمنة الثقافية، إذ يفرض معايير «المشروعية» للعمل السياسي وفق منطق النظام القائم، ويقصي كل ما يتجاوزه نحو مشروع تحرري جذري.
الخلفية الفكرية والسياسية للاتهام.
في السياقات السياسية المعاصرة، سواء في الأنظمة الليبرالية أو في بعض الحركات الاحتجاجية ذات الطابع الراديكالي، يطغى تفضيل الفعل السريع على حساب بناء استراتيجيات متماسكة وطويلة المدى. هذا الميل نحو «النتائج الفورية» ليس قراراً تنظيمياً بحتاً، بل هو انعكاس مباشر لمنطق السوق الذي يقيس الفعالية بمردود قصير الأمد، ويحيل السياسة إلى إدارة أزمات آنية بدل أن تكون مشروعاً تحررياً ممتداً في الزمن. وفي ظل هذا الإيقاع المتسارع، يُتهم «التنظير» بعرقلة الزخم، بينما الواقع أن غياب الرؤية النظرية يحوّل الحركات إلى قوى رد فعل تتحرك ضمن الهامش الذي يتيحه الخصم الطبقي، بدل أن تخلق هي شروط الصراع وتحدد مواقعه.
الأيديولوجيا الليبرالية، بحكم تحالفها البنيوي مع الرأسمالية، تميل إلى تجريد الفكر النقدي من راديكاليته عبر تصويره كترف ذهني أو هواية نخبوية. وهي لا تكتفي بتهميش النظرية النقدية في الفضاءات الأكاديمية والإعلامية، بل تستبدلها بخطابات «إصلاحية» تُبقي على البنية الاقتصادية والاجتماعية دون مساس جوهري. وبهذه الآلية، يُفصل التحليل عن الممارسة عمداً، ليظل الحقل السياسي محصوراً في برامج جزئية محدودة لا تشكل خطراً حقيقياً على النظام القائم.
موجة معاداة المثقفين، في هذا السياق، ليست حالة عابرة أو انفعالاً ظرفياً، بل استراتيجية أيديولوجية متجذرة في بنية الصراع الطبقي. فالطبقات المسيطرة تدرك أن المثقف النقدي، حين يرتبط عضوياً بالحركة الشعبية، يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار النظام بقدرته على كشف التناقضات العميقة في البنية الاجتماعية والاقتصادية، وتحويل هذا الوعي إلى قوة مادية منظمة. لهذا، تُبنى في الوعي العام صورة مشوهة له باعتباره كائناً متعالياً ومنعزلاً عن حياة الناس اليومية، في محاولة لنزع شرعيته وتقويض مكانته كمرجعية فكرية داخل الصراع. وحتى في الحالات التي يُسمح له فيها بالظهور في المجال العام، يُحاصر داخل فضاءات أكاديمية أو إعلامية خاضعة للرقابة، بحيث ينتج معرفة مُفرغة من أي بعد تحريضي أو استراتيجي. وبهذا، تتكامل الهيمنة الثقافية مع التحييد السياسي لإبقاء المثقف النقدي إما مهمشاً على أطراف المشهد أو مروضاً ضمن حدود آمنة لا تمس البنية العميقة للسلطة.
الجذور الطبقية والخطاب المناهض للتنظير
الخطاب المعادي للنظرية لا يمثل ردّ فعل سياسياً عابراً، بل هو تعبير عن بنية طبقية تمتلك سلطة إنتاج المعنى وتوجيهه بما يخدم مصالحها. فالطبقات المهيمنة، من خلال سيطرتها على أدوات الإنتاج المادي (الاقتصاد) وأدوات الإنتاج الرمزي (الإعلام، التعليم، الثقافة)، تحدد الأطر التي يُسمح للوعي الجمعي بالتحرك ضمنها. هذه السيطرة لا تفرض فقط حدوداً مادية على الصراع الاجتماعي، بل ترسم أيضاً حدوداً فكرية غير مرئية، تمنع تبلور مشروع تغييري شامل. وفي هذا الإطار، يصبح التشكيك في جدوى التحليل النظري أداة لإعادة إنتاج الهيمنة، لأنه يفصل بين التجارب النضالية الجزئية وبين التصور الاستراتيجي الذي يمثل جوهر البراكْسيس الماركسي.
هذا النمط من الخطاب لا يبقى محصوراً في الفضاء الأيديولوجي العام، بل يتسرب تدريجياً إلى داخل الأحزاب اليسارية والشيوعية نفسها عبر مسارين متوازيين:
الأول، انغماس بعض هذه الأحزاب في عمل سياسي ومطلبي آني، يُختزل فيه النضال إلى تحسينات أو إصلاحات محدودة لا تمس جوهر السلطة.
الثاني، تحويل النظرية إلى نشاط فكري معزول عن الممارسة العملية، مما يعيد إنتاج الانقسام المصطنع بين الفكر والعمل. وفي الحالتين، تُفرغ النظرية من مضمونها الثوري، لتصبح إما غطاءً تبريرياً للفعل اليومي، أو جدلاً أكاديمياً بارداً منفصلاً عن الميدان.
تلعب البراغماتية السياسية — بصيغتها الليبرالية أو حتى داخل بعض الحركات الاحتجاجية — دور الوسيط الأيديولوجي في هذا المسار، إذ تروّج لـ«العملية» و«النتائج السريعة» كمقياس وحيد للمشروعية، بينما يُستبعد التفكير العميق باعتباره ترفاً أو عبئاً يبطئ «الزخم». هذا المنطق لا يلغي التفكير الاستراتيجي فحسب، بل يدفع الحركات الشعبية للتحرك ضمن جدول أعمال يضعه الخصم الطبقي سلفاً، بدل أن تحدد هي بنفسها ساحات الصراع وإيقاعه.
ويتكامل هذا الدور مع ما تقوم به المؤسسات الإعلامية والتعليمية الخاضعة لهيمنة رأس المال أو الدولة، حيث يُعاد إنتاج صورة «المنظّر» كفرد منفصل عن الواقع المعاش، ويُختزل النقاش السياسي في قوالب «الخبر العاجل» و«الرأي المختصر» التي تطيح بأي تحليل بنيوي. أما في التعليم، فتُهمَّش الدراسات النظرية النقدية لصالح مقررات تقنية أو مهارات قابلة للتسليع، تُهيئ الأجيال للتكيف مع متطلبات السوق بدلاً من فهم البنية التاريخية للصراعات الاجتماعية.
بهذه الطريقة، تتضافر البراغماتية السياسية مع الآلة الإعلامية والتعليمية لإنتاج بيئة فكرية مغلقة، تُختزل فيها الثقافة إلى معالجة سطحية للأزمات، ويُجرَّد الفكر النقدي من قدرته على طرح الأسئلة الجذرية التي تمس بنية السلطة والاقتصاد. وإذا لم تدرك الحركات اليسارية هذه الآليات وتواجهها بوعي تنظيمي ونظري متكامل، فإنها ستظل أسيرة خيارين زائفين: الانخراط في مطالب جزئية بلا أفق تغييري، أو الانعزال في تنظير منفصل عن النضال الحي، وكلاهما يضمن استقرار البنية الطبقية القائمة.
آليات اختراق الخطاب المناهض للتنظير داخل اليسار
يتسلل الخطاب المعادي للنظرية إلى داخل الأحزاب اليسارية والشيوعية عبر مسار معقّد، تتداخل فيه ضغوط الطبقات المهيمنة مع التناقضات البنيوية الداخلية لهذه الأحزاب. فمن الخارج، تمارس القوى المسيطرة ضغطاً منهجياً عبر الإعلام، والمؤسسات الثقافية، والأطر السياسية، لإعادة تعريف ماهية العمل السياسي بحيث يُختزل في أفق براغماتي ضيق يركز على إدارة الأزمات والمطالب الآنية، بدل معالجة الجذور البنيوية للصراع. ويواكب هذا الضغط حملات منظمة لتشويه صورة «المنظّر»، وربطه بالانفصال عن الشارع أو العجز عن تقديم حلول «عملية»، مما يمهّد الطريق لتسرب هذا الخطاب إلى بعض أوساط اليسار.
أما من الداخل، فإن ضعف البنية الفكرية والتنظيمية يفتح المجال أمام هذا الاختراق. إذ تميل بعض القيادات أو الكوادر إلى تبني أولويات تقتصر على الملفات السياسية والمطلبية المباشرة، متخلية عن أي أفق تغييري جذري. وفي المقابل، قد تنشأ تيارات أخرى تنغمس في التنظير المنعزل، وتستهلك جهدها في الجدل النصي وإعادة إنتاج التراث الماركسي الكلاسيكي دون إسقاطه على الشروط المحلية الملموسة. ورغم ما يبدو من تناقض بين الاتجاهين، فإن النتيجة واحدة: تعطيل الدور الثوري للنظرية الماركسية وتفريغها من مضمونها العملي.
التاريخ يقدم شواهد واضحة على هذا المسار. ففي بعض الأحزاب الشيوعية الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية، أدى الانخراط في التحالفات البرلمانية وسياسات «الجبهات الوطنية» إلى تراجع التحليل البنيوي للإمبريالية، وتحويل النظرية إلى أداة تبرير لخط إصلاحي بعيد عن مشروع التحول الاشتراكي. وفي السياق العربي، شهدت أحزاب يسارية خلال العقود الأخيرة انقساماً بين تيارات غارقة في التحالفات التكتيكية والمطالب الجزئية، وأخرى تحولت إلى دوائر فكرية مغلقة لا صلة لها بالنضال اليومي.
بهذا المعنى، فإن اختراق الخطاب المناهض للتنظير لا يقتصر على التأثير في اللغة أو المواقف، بل يمتد إلى إعادة تشكيل الأولويات التنظيمية والسياسية بما يخدم مصلحة الخصم الطبقي، حتى وإن جرى ذلك تحت شعارات يسارية أو ماركسية. لذلك، فإن مقاومته ليست مجرد نقاش داخلي حول أسلوب العمل، بل جزء لا ينفصل عن مسار الصراع الطبقي نفسه.
استعادة وظيفة النظرية في المشروع التغييري
مواجهة اختراق الخطاب المناهض للتنظير داخل اليسار لا يمكن أن تقتصر على مجرد ردود دفاعية أو شعارات عن «أهمية النظرية». ببساطة، المطلوب هو إعادة صياغة العلاقة الجدلية بين الفكر والعمل بطريقة تجعل النظرية جزءاً عضوياً من الفعل الثوري، لا مجرد ملحق اختياري أو عبء تنظيمي. في هذا السياق، تصبح النظرية أداة حية تُستمد من الواقع الملموس وتعود لتؤثر فيه، بحيث تظل مرتبطة بالحاجات الفورية للنضال الطبقي، وفي الوقت نفسه قادرة على رسم أفق استراتيجي يتجاوز اللحظة الراهنة.
تحقيق هذا التكامل يتطلب بناء فضاءات وهياكل داخل التنظيمات اليسارية، تسمح بمراكمة التحليل النقدي وتطويره جماعياً، ليصبح جزءاً لا يتجزأ من عملية اتخاذ القرار السياسي. هنا، يجب الانتباه إلى خطرين رئيسيين: الأول، تحويل النظرية إلى خطاب تبريري لقرارات اتُخذت مسبقاً، والثاني، حبسها في نقاشات نظرية مغلقة لا تصل إلى الميدان. وللتغلب على هاتين النزعتين، ينبغي أن تكون النظرية حاضرة في جميع مستويات العمل، من صياغة البرنامج العام إلى اختيار التكتيكات اليومية، مع تفاعل مستمر بين الكوادر الفكرية والميدانية.
إن استعادة وظيفة النظرية الماركسية بهذا المعنى ليست مجرد مهمة فكرية داخلية، بل هي جزء من معركة أوسع مع القوى الطبقية المسيطرة، التي تحاول دائماً تحييد الفكر النقدي أو احتوائه. لذا، دمج النظرية بالممارسة ليس ترفاً تنظيمياً، بل شرط تاريخي يجعل الحركة اليسارية تنتقل من موقع رد الفعل إلى موقع المبادرة، القادر على صياغة شروط الصراع وتحديد أفقه.
الخاتمة
يتضح أن اتهام «التنظير» ليس مجرد سوء فهم لغوي أو جدل حول الأولويات الداخلية، بل أداة خطابية وأيديولوجية تعمل في قلب الصراع الطبقي. فهي تهدف إلى فصل النظرية عن الممارسة وإبقاء النضال السياسي أسير حدود لا تمس البنية العميقة للهيمنة. فمنذ أن أوضح ماركس وإنجلز أن البنية الفوقية ليست انعكاساً سلبياً للبنية التحتية، بل ساحة صراع تتشكل فيها الأفكار والوعي الطبقي، صار واضحاً أن تحقير النظرية يخدم مصالح الطبقات المسيطرة، التي تسعى لنزع الطابع الاستراتيجي عن الحركة الشعبية وتحويل فعلها إلى ردود أفعال ظرفية قابلة للاحتواء.
هذا الاتهام يتغذى من منظومة أوسع تعتمد البراغماتية قصيرة المدى، وتشويه الفكر النقدي في الخطاب الليبرالي، وتعزيز ثقافة معاداة المثقفين. والنتيجة هي جماهير في حالة وعي مجزأ، وممارسة سياسية محاصرة ضمن أهداف جزئية وسطحية. وفي هذا المناخ، يصبح المثقف العضوي — بالمعنى الغرامشي — هدفاً رئيسياً، إذ تحاول السلطة عزله رمزياً عن قاعدته الاجتماعية أو تحييد دوره وتحويله إلى منتج معرفة بلا قوة مادية.
لكن التاريخ يعلّمنا شيئاً مهماً: الفعل السياسي الأكثر قدرة على إحداث تحول جذري هو الذي يدمج التحليل النظري العميق بالممارسة المنظمة. هذا الدمج يمنح النضال بعده التاريخي ويتيح له الانتقال من رد الفعل إلى المبادرة. لذلك، استعادة التكامل بين النظرية والعمل الميداني ليست ترفاً فكرياً أو خياراً ثانوياً، بل ضرورة استراتيجية لبناء حركة تحرر قادرة على إعادة صياغة الواقع بدل الاكتفاء بالتكيف معه.
المهمة الملحّة أمام الحركات اليسارية والاجتماعية اليوم هي خلق فضاءات للنقاش النقدي الحر، حيث يمكن تطوير رؤية بنيوية للصراع وتحديد مسارات عملية تنطلق من فهم دقيق للبنية الطبقية وآليات الهيمنة. فحين تتغذى النظرية من الميدان وتعود لتغذيه، تتحول إلى قوة مادية قادرة على تفكيك النظام القائم وفتح أفق تاريخي جديد. وهكذا، تسقط نهائياً الأسطورة الأيديولوجية التي جعلت من «التنظير» تهمة، ويستعيد معناه الأصلي كشرط أساسي للفعل الثوري الواعي.
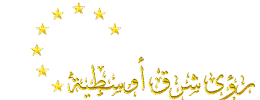


مقال ممتاز، استفدنا منه كثيرا في إشكالية النظرية والتطبيق