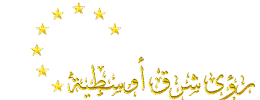في جوهر النظرية الماركسية، لا يُنظر إلى الفقر كعنصر مولِّد للثورة في ذاته، بل كشرط مادي لا يتحوّل إلى قوة سياسية إلا حين يُعاد تأويله عبر الوعي والتنظيم. فلا الأزمة الاقتصادية، مهما بلغت من العمق، تُنتج تحوّلاً تاريخياً بمجرد وقوعها؛ بل تتطلب ذاتاً طبقية قادرة على قراءة واقعها، تنظيم نفسها، والتدخل الواعي فيه. وهذا ما أكّده ماركس حين أشار إلى أن البؤس لا يتحوّل إلى فعل تاريخي إلا حين يُفهم كواقع قابل للتغيير، لا كقدر محتوم.
لا أهدف إلى إعادة تكرار الأطروحات الكلاسيكية، بل إلى مساءلتها من موقع ماركسي نقدي، يميّز بين الحتمية بوصفها تحليلاً لإمكانات التغيير، والميكانيكية التي تحوّل الجدلية إلى سلسلة مغلقة من الأسباب والنتائج.
في هذا المنظور، لا يُختزل الوعي إلى انعكاس سلبي للشروط، بل يُعاد موضعته بوصفه أداة للتدخل في التاريخ. فالناس يصنعون تاريخهم ضمن شروط لم يختاروها، لكنهم قادرون—عبر التنظيم والإرادة الجماعية—على إعادة تشكيل هذه الشروط. الثورة، بهذا الفهم، لا تأتي كنتيجة مباشرة لانهيار البنى الاقتصادية، بل كمشروع واعٍ ينبثق من داخل الأزمة، ويعيد تحويل الضرورة إلى إمكان سياسي.
وعليه، لا يُنظر إلى الفقر كقوة مولّدة للثورة في ذاته، بل كأرضية قابلة لإنتاج أشكال متعددة من الوعي، قد تكون نقدية وثورية، وقد تكون خاضعة وخانعة، بحسب السياق والتأطير. إن ما يُحوّل المعاناة إلى قوة تاريخية، ليس تراكم البؤس، بل نضج الشرط الذاتي، الذي يتجسد في الوعي والتنظيم معاً.
الحتمية التاريخية والجدل بين الضرورة والفاعلية
في المنهج الماركسي، لا يُنظر إلى الحتمية التاريخية كقانون صارم يُسقط من الأعلى مساراً واحداً محتوماً، بل تُفهم كتحليل جدلي للعلاقات الاجتماعية المتناقضة، يُظهر كيف يُنتج نمط الإنتاج شروط تحوّله. فهي ليست توقّعاً آلياً للمستقبل، وإنما مقاربة نقدية للواقع القائم، تستهدف الكشف عن التوترات البنيوية التي تجعل التغيير ممكناً، ولكنها لا تضمنه. من هذا المنطلق، يُصبح الصراع الطبقي جوهر الحتمية: لا بوصفه حركة ضرورية فحسب، بل كاحتمال يتوقف تحققه على دخول الذات التاريخية إلى ساحة الفعل.
ماركس، في رأس المال، لم يقدّم توصيفاً ميكانيكياً لانهيار الرأسمالية، بل كشف عن بنيتها التناقضية، حيث يؤدي تراكم رأس المال إلى تفاقم التفاوت الاجتماعي، وتعميم الاستغلال، وتوليد أزمات متكررة. لكنه في الوقت نفسه أشار—ضمنياً وصريحاً—إلى أن هذه الأزمات لا تقود إلى الثورة ما لم تواجه بوعي طبقي قادر على تنظيم الفعل السياسي. هذه الرؤية تميّز بوضوح بين الحتمية كمجال مفتوح لإمكانات التغيير، وبين الميكانيكية التي ترى التحول كنتيجة حتمية لانهيار الشروط.
في مقدمة نقد الاقتصاد السياسي (1859)، يقول ماركس: “ليس وعي الناس هو ما يحدد وجودهم، بل وجودهم الاجتماعي هو ما يحدد وعيهم.” وفي مقدمة نقد فلسفة الحق عند هيغل (1844) يقول “إن النظرية تصبح قوة مادية حالما تستولي على الجماهير:
فالوعي ليس تابع سلبي للشروط، بل أن الشروط تنتج إمكان الوعي، دون أن تختزله فيها. الوعي، هنا، ليس معطى جاهزاً، بل سيرورة تاريخية—يتشكل، يُعاد إنتاجه، وقد ينكفئ أو يُقاوم. وما يُحدث الفرق هو موقعه من الصراع الطبقي: هل يتماهى مع الأيديولوجيا السائدة، أم يتحول إلى أداة لتحليل العالم وتغييره؟ في الحتمية الجدلية، الوعي ليس لحظة انعكاس، بل لحظة تدخّل، شرط أن يُصاغ تنظيمياً ويتحول إلى استراتيجية سياسية.
هذا هو جوهر الجدل بين الضرورة والفاعلية: فالتاريخ لا يتحرك بفعل الضرورة وحدها، بل من خلال التوتر المستمر بين البنية والذات، بين الإمكان والشروط، بين ما هو كائن وما يمكن أن يكون. لا يمكن اختزال الفاعل إلى مجرّد نتاج لظروفه، بل يُعاد موضعه كقوة قادرة على تفكيك هذه الظروف، وتجاوزها، وإعادة إنتاجها في أفق جديد. لذلك لا يُنظر إلى الطبقة العاملة كضحية سلبية تنتظر “الانفجار الكبير”، بل كفاعل يُنتج ذاته داخل سيرورة الصراع.
الثورة، في هذا الأفق، لا تُفهم كتحصيل حاصل لانهيار بنية، بل كمشروع سياسي ينبثق من تفاعل جدلي بين الأزمة البنيوية والقرار الجماعي. فحتى في ذروة الأزمة، قد تسود الفوضى أو يرتدّ النظام إلى مزيد من القمع، إذا لم توجد قيادة ثورية تمتلك وعياً تنظيمياً وقدرة على بناء الأفق البديل. وهذا ما يجعل الحتمية التاريخية عند ماركس أكثر من مجرد قانون؛ إنها قراءة مفتوحة لإمكانات التغيير المشروطة دوماً بالفعل البشري.
الميكانيكية التاريخية: اختزال التغيير وسلب الفاعلية
إذا كان الفهم المادي للتاريخ، كما طوّره ماركس، قائماً على تحليل جدلي للصراع الطبقي داخل بنية اجتماعية متحولة، فإن ما يُعرف بالميكانيكية التاريخية يُعد انحرافاً عن هذا التصور؛ إذ تختزل هذه الأخيرة التاريخ إلى تتابع سببي مغلق، تتحرك فيه المراحل وكأنها نتائج آلية لتفاعلات اقتصادية لا تحتاج إلى تدخل بشري أو وعي سياسي. في هذا المنظور، تصبح الثورة ليست فعلاً واعياً يُبنى، بل نتيجة محتومة لانهيار الشروط الموضوعية، أشبه بثمرة ناضجة تسقط تلقائياً حين تبلغ الأزمة ذروتها. غير أن هذا التصور يُسقط الفعل الإنساني من معادلة التاريخ، ويفرغ الصراع الطبقي من مضمونه الجدلي، ويحوّل الذوات التاريخية إلى كائنات مفعول بها تنتظر حلول لحظة الخلاص.
“الاقتصادوية” التي يقوم عليها هذا التصور لا تنفي فقط أهمية الوعي والتنظيم، بل تُفرغ البنية الفوقية من مضمونها النظري والسياسي، وكأن الأيديولوجيا، والثقافة، والمؤسسات، مجرد مشتقات جانبية للبنية التحتية، لا تملك تأثيراً حقيقياً في مسار الصراع. وقد ساهمت بعض القراءات الأرثوذكسية للماركسية في ترسيخ هذا التصور، حيث رُسِم التاريخ كمجرى تقني، تتقدّم مراحله بحسب قانون داخلي لا يتطلب تدخلاً. ضمن هذا السياق، يتحوّل التنظيم السياسي إلى جهاز انتظار، يكتفي برصد المؤشرات الاقتصادية، دون قدرة على صناعة المبادرة أو تغيير موازين القوى.
هذا الفهم لا يعبّر عن الروح الجدلية للماركسية، بل يقتلها. إذ أنه يجرّد الفاعل الاجتماعي من موقعه في التاريخ، ويعيد إنتاج منطق لاهوتي بثوب مادي؛ فالتحوّل هنا لا يحدث بفعل الذات، بل بفعل حتمية خارجة عنها. وقد قدّم أنطونيو غرامشي نقداً صارماً لهذا النوع من التصور، حين أكد أن الأزمة الاقتصادية، مهما بلغت حدتها، لا تتحوّل إلى ثورة إلا بوجود ذات سياسية واعية تمتلك مشروعاً بديلاً وتستطيع توجيه لحظة التصدّع نحو التغيير. فالفراغ السياسي الناتج عن انهيار النظام القائم قد يُملأ بصعود قوى رجعية، إذا لم تكن هناك قيادة ثورية قادرة على ملء هذا الحيّز. هكذا تظهر أهمية “القيادة” و”المثقف العضوي” بوصفهما أداتين لتحويل العفوية إلى فعل منظم، وتحويل الأزمة إلى أفق جديد لا يُعاد فيه إنتاج الهيمنة القديمة.
في التصور الميكانيكي، يُعامل الإنسان ككائن مغترب بالكامل، مفعول به داخل بنية مغلقة لا يُنتظر منه سوى الاستجابة للظروف. أما في التصور الجدلي، فهو ذات واعية تُشكّل تاريخها داخل هذه الظروف، حتى وإن لم تخترها. يوضح ماركس هذه المسألة في الثامن عشر من برومير (1852) بقوله: “يصنع البشر تاريخهم، ولكنهم لا يصنعونه على هواهم، ولا في ظروف يختارونها هم أنفسهم، بل في ظروف يجدونها جاهزة، منقولة من الماضي.” هنا لا تُلغى الفاعلية البشرية، بل توضع ضمن شروطها الواقعية، حيث تُصبح الحرية لحظة تعيين الضرورة والعمل ضمنها لتجاوزها.
التاريخ، وفق هذا التصور الميكانيكي، يتحول إلى كيان مستقل عن الفعل البشري، يخضع لقوانين مغلقة، لا تتيح أي تدخل إلا بعد “نضج” خارجي مفترض. غير أن الوقائع التاريخية تناقض هذا الفهم، إذ شهدت البشرية أزمات اقتصادية خانقة—كما في الكساد العالمي عام 1929 أو أزمة 2008—لم تُنتج ثورات، بل شهدت صعود الفاشية أو تعزيز النظام القائم، بفعل غياب الشرط الذاتي المنظم. ولذلك أصر مفكرون ماركسيون كبار مثل لوكاش وغرامشي وماركوز على أن الأزمة تفتح باباً، لكنها لا تُنتج مساراً بذاتها. فالتحوّل لا يتم عبر التراكم العفوي للتناقضات، بل بفعل واعٍ يُحوّل الانهيار إلى مشروع تحرري، لا إلى فوضى أو قمع أو عودة رجعية.
من هذا المنظور، فإن الرد على الميكانيكية لا يكون بنفي الشروط الموضوعية، بل بإعادة تثبيت مكانة الذات الثورية داخلها، بوصفها اللحظة القادرة على التدخل، والتحويل، وقيادة التحوّل. فبدون هذه الذات، يبقى التناقض الاقتصادي مجرد أزمة أخرى في سجل الرأسمالية، لا أكثر.
العلاقة الجدلية بين الشروط الموضوعية والشرط الذاتي في صنع الثورة
من أكثر الصور اختزالاً في تلقي الماركسية على الصعيد الشعبي، ذلك التصوّر القائل بأن البؤس وحده يكفي لإشعال الثورة. هذا التفسير، الذي يربط التغيير بالمعاناة المجردة، يتعارض مع جوهر الفكر الماركسي الذي ينظر إلى التاريخ بوصفه حقلاً لصراع مركّب، لا تتحقّق فيه الإمكانيات إلا من خلال تفاعل جدلي بين الشروط الموضوعية والشرط الذاتي. فليس كل ظلم يولّد مقاومة، ولا كل أزمة تُفضي إلى انتفاضة، ما لم تتجسّد هذه المعاناة في وعي نقدي وتنظيم قادر على تحويل السخط إلى مشروع سياسي.
تُظهر التجربة التاريخية أن الشروط الموضوعية—كالتفاوت الطبقي، وانهيار الخدمات، وتفشي البطالة—قد تخلق مناخاً مواتياً للتغيير، لكنها لا تضمن حدوثه. ذلك أن هذه الشروط، بحد ذاتها، لا تنتج وعياً ثورياً، بل تُفتح على تأويلات متعددة قد تؤدي إلى الخضوع أو الانكفاء أو حتى إلى الانجراف خلف قوى رجعية، كما حدث في لحظات مفصلية من التاريخ. من هنا تأتي أهمية إدراك الطابع المركّب للوعي الشعبي، والذي لا يتكوّن بصورة تلقائية من التجربة المعيشية، بل يتأثر بالبنية الأيديولوجية والثقافية التي تصوغ تفسير الناس لأوضاعهم.
الوعي، في الماركسية، لا يُختزل إلى انعكاس آلي للواقع، بل يُفهم كنتاج تفاعلي بين التجربة الحية والنشاط الفكري، وهو ما يتطلب عملاً سياسياً منظَّماً يُعزز التفسير النقدي للواقع على حساب التفسير الخاضع أو التبريري. في هذا السياق، يبرز دور “المثقف العضوي” كما طرحه غرامشي، بوصفه الجسر الذي يصل بين المعرفة النظرية والتجربة الشعبية، ويعيد صياغة وعي الجماهير على قاعدة التحليل الطبقي.
ولا يكتمل هذا الوعي إلا إذا تُرجم إلى تنظيم سياسي. فبدون بنية تنظيمية قادرة على استقبال هذا الوعي وتأطيره وتوجيهه، يظل النقد الموجه للواقع عاجزاً عن التحقق، ويظل الغضب معلقاً بين التذمر والانفجار غير المنضبط. إن التنظيم ليس مجرّد أداة تقنية، بل هو الفضاء الذي تُعاد فيه صياغة العلاقة بين الذاتي والموضوعي، حيث يتحوّل الإدراك إلى قرار، والخطاب إلى استراتيجية.
في قلب هذا الجدل بين الشروط والفاعلية، يتموضع مفهوم الاغتراب كما نظّر له ماركس؛ فالإنسان في ظل الرأسمالية يعيش منقسماً عن نتاج عمله، عن مجتمعه، بل عن ذاته. ولا يُكسر هذا الاغتراب إلا من خلال وعي طبقي نقدي يُدرك جذور الاستغلال، وتنظيم ثوري يعيد للذات حضورها كقوة فاعلة في قلب الصراع. لذلك، لا يمكن فهم الثورة كاستجابة آلية للأزمات، بل كفعل واعٍ يَنتزع الإمكان التاريخي من فوضى الضرورة.
دور الصراع الطبقي والفاعلين التاريخيين في عملية التغيير
في بعض الخطابات اليسارية، تُفترض العلاقة بين البؤس الاقتصادي والوعي الثوري كعلاقة سببية مباشرة، وكأن المعاناة تُفضي تلقائياً إلى التمرّد، وأن الجماهير المسحوقة تحمل دائماً إمكان التغيير في ذاتها. غير أن الماركسية الجدلية تُحذّر من مثل هذه المقاربات الاختزالية، لأنها تُغفل الطبيعة المركّبة للوعي، وتُسطّح العلاقة بين الظرف الموضوعي والإدراك النقدي. فالفقر لا يُنتج ثورة بذاته، بل يفتح فضاءً لاحتمالات متعددة، تتراوح بين الخضوع، والامتثال، والتكيف، أو النقد والمقاومة، بحسب درجة الوعي، وشكل التنظيم، وعمق التجربة.
الهيمنة، كما فهمها غرامشي، لا تمارس بالقوة وحدها، بل تُعاد إنتاجها عبر الثقافة اليومية، اللغة، القيم، والمؤسسات التي تُرسّخ القبول الرمزي للنظام القائم. وهكذا، فإن الطبقات المقهورة لا تتمتع دوماً بوعي نقدي لموقعها، بل قد تستبطن منطق الهيمنة نفسه، وتعيد إنتاجه داخل حياتها اليومية. وهذا ما يجعل من الوعي حقلاً للصراع، لا معطًى جاهزاً، حيث يتداخل “الوعي العفوي”—المشحون بالتناقضات والأوهام الطبقية—with “الوعي السياسي المنظَّم” الذي يُشكّل ثمرة لنضال طويل، وتجربة، وتنظير، وتنظيم.
ومن هنا تنبع ضرورة العمل السياسي التربوي، لا بوصفه تلقيناً خارجياً، بل كحوار جدلي يُربط فيه بين التجربة الحياتية للمضطهَدين وبين البنية الطبقية التي تنتج هذه المعاناة. المطلوب ليس “زرع” الوعي في الجماهير، بل بلورته من داخل واقعها، عبر تنظيم يعيد ربط المحسوس بالمجرد، واليومي بالبُعد الطبقي الأعمق.
التنظيم السياسي، في هذا السياق، ليس جهازاً فوقيّاً يوجّه الجماهير، بل بُنية تُنتج داخل الوعي الجمعي ذاته، وتُخاض فيها معركة المعاني، وتُصاغ عبرها الإستراتيجيات. التنظيم لا يُكمّل الوعي، بل يُجسّده ويمنحه الشكل القادر على الفعل. كل ممارسة تنظيمية—من النقاش الداخلي إلى الخطاب التعبوي—تسهم في إما تعميق الفهم النقدي أو في تكريسه ضمن حدود الأيديولوجيا السائدة.
ومن خلال هذه الرؤية، يصبح وعي الفقراء ليس معطًى أصلياً أو متأصلاً، بل ساحة تنازُع، تُخاض فيها معركة طويلة بين التأويلات المختلفة للواقع. ولذلك فإن القوى الثورية مطالبة دائماً بإنتاج أدوات قادرة على احترام تعقيد التجربة الطبقية، والانخراط فيها دون اختزالها أو تنميطها. هنا لا يكفي الخطاب الراديكالي أو الرغبة في التغيير؛ ما يصنع الفارق هو القدرة على فهم البنية العميقة للوعي الاجتماعي، والعمل من داخلها لتفكيك التناقضات الكامنة، وبناء وعي بديل قادر على التنظيم والفعل.
التاريخ: مسار مفتوح من الإمكانات أو قدر محدد سلفاً؟
منذ أن ميّز ماركس في “أطروحات حول فيورباخ” بين تفسير العالم والعمل على تغييره، أصبحت الماركسية تنظر إلى التاريخ لا بوصفه مساراً حتمياً مغلقاً، بل كمجال مفتوح لصراع الإمكانات. هذا التصوّر هو ما يشكّل جوهر المادية الجدلية: التاريخ ليس سلسلة متتابعة من النتائج المنطقية لعلل سابقة، بل نتاج لصراعات اجتماعية، تتداخل فيها الشروط الموضوعية مع الوعي والقرار السياسي. التاريخ من هذا المنظور لا يتحرّك كقانون طبيعي أعمى، بل كمحصّلة جدلية لفعل البشر داخل بنى اجتماعية واقتصادية معيّنة.
تؤكّد الماركسية أن البنية الاقتصادية تخلق شروطاً مادية إمّا تُقيّد الفعل أو تفتحه، لكنها لا تحسم النتائج. فالتحول التاريخي لا يتحقق بمجرد نضج الشروط الموضوعية، بل يتوقف على تدخل الذات الواعية المنظّمة القادرة على تحويل تلك الشروط إلى أفق سياسي جديد. هذا ما يجعل الفقر، في منظور ماركسي نقدي، ليس دافعاً آلياً للثورة، بل شرطاً ناقصاً لا يكتمل إلا بالوعي والتنظيم. ومن هنا، فالرؤية الميكانيكية التي ترى أن كل نمط إنتاج يحمل نهايته في داخله تمثّل اختزالاً للتاريخ إلى منطق سببي مغلق، يُسقط الفاعلية الإنسانية ويحوّلها إلى هامش لا تأثير له.
لقد رفض مفكرون ماركسيون هذا التصوّر الحتمي المغلق، وفي مقدمتهم جورج لوكاش، الذي شدّد على أن التاريخ ليس علماً طبيعياً، بل علماً إنسانياً قائماً على صراع الذوات داخل شروط اجتماعية، وبالتالي لا يمكن التنبؤ به إلا في حدود القوى المتصارعة ودرجة تنظيمها ووعيها. فالانحراف الميكانيكي في فهم الحتمية يشبه في جوهره الفكر اللاهوتي، الذي ينسب كل حركة إلى مشيئة خارجية مطلقة، ما يفرغ الفعل السياسي من معناه، ويحوّل النظرية إلى سردية انتظار.
من خلال استقراء تاريخ الأزمات الكبرى—من ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الأولى إلى روسيا عام 1917—يتضح أن الشروط الموضوعية ليست كافية بذاتها لإنتاج الثورة. في الحالة الألمانية، فتحت الأزمة الاقتصادية الباب للتغيير، لكن غياب قيادة ثورية متماسكة سمح بصعود النازية. بينما في روسيا، وعلى الرغم من تخلّف البنية الاجتماعية، أفضى وجود قيادة ثورية وتنظيم محكم إلى استثمار الأزمة وتحويلها إلى مسار تحرري. هذان النموذجان يُظهران أن التاريخ لا يتبع خطّاً واحداً، بل يتحدد بموازين القوى، ونوع التدخّل السياسي، وقدرة الفاعلين على الإمساك باللحظة.
انطلاقاً من هذا الفهم، يُعاد تعريف الحتمية التاريخية بوصفها توصيفاً للشروط التي تجعل الفعل ممكناً، لا كقانون يفرض الفعل. فهي تُضيء التناقضات، لكنها لا تصنع القرار. والحرية، في الفكر الماركسي، لا تُفهم كمجرد إمكانية فلسفية، بل كممارسة سياسية داخل شروط محددة، تُسعى من خلالها إلى إعادة تشكيل الضرورة. ليس الإنسان صانعاً مطلقاً لتاريخه، لكنه أيضاً ليس مجرّد منتَج لشروطه. بل هو ذات تتفاعل مع الضرورة وتسعى لتجاوزها.
هكذا، تصبح الحتمية عند ماركس إطاراً تحليلياً يُعيد للذات مكانتها بوصفها قوة تدخل في الصراع وتُعيد توجيه ممكناته. التاريخ، بهذا المعنى، لا يحمل وعوداً مسبقة بالتحرر، لكنه يتيح إمكانياته لمن يملك الوعي، والتنظيم، والقدرة على الفعل. وإن كانت الأزمة لا تكفي لولادة الثورة، كما قال غرامشي، فإن غياب الذات السياسية يجعل من لحظات الانهيار فرصاً ضائعة، وربما منصّات لصعود أشكال أكثر قمعاً من الهيمنة.
الممارسة السياسية والاستراتيجية الثورية بين الحتمية والميكانيكية
يخطئ كثيرون في فهم الماركسية حين يتعاملون معها كمنظومة تنبؤية تُقدّم مساراً زمنياً حتمياً لسقوط الرأسمالية، بحيث يُختزل التحليل التاريخي إلى خريطة قدرية تُحاكم وفق مدى تطابق الواقع مع “الخطة المسبقة”. غير أن ماركس لم يُنشئ فلسفة مغلقة، بل وضع أداة نقدية لفهم العالم وتغييره. جوهر هذه الأداة هو المادية الجدلية، التي ترفض اختزال التاريخ إلى سلسلة من الحتميات، وتنظر إليه كفضاء صراعي مفتوح على احتمالات متعددة.
في هذا الإطار، تصبح الاستراتيجية الثورية ليست نتيجة حتمية للتناقضات البنيوية، بل ممارسة واعية تتشكّل عند نقطة التقاء بين الشروط الموضوعية والشرط الذاتي. إنها ليست فعلاً مؤجَّلاً إلى حين “نضوج الأزمة”، بل لحظة تدخّل تاريخي تتجسد فيها الحرية داخل الضرورة. فالثورة لا تُنتَج من التراكم الآلي للتناقضات، بل من قُدرة فاعلين سياسيين على اقتناص اللحظة، وابتكار أدوات الفعل فيها.
وهنا يجب التمييز بين القانون القائم والمسار الأحادي. الماركسية تفترض وجود قوانين تحكم البنية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها قانون التناقض، الذي يُعبّر عن الديناميكيات الداخلية لأي نمط إنتاج. غير أن هذا القانون، على الرغم من كونه حقيقيّاً وموضوعيّاً، لا يُنتج لوحده تحوّلاً اجتماعيّاً. بل إن فعاليته مشروطة بوعي الفاعلين، وقدرتهم على تنظيم أنفسهم سياسياً. فالتناقضات تفتح إمكانات متعددة: الثورة، الإصلاح، الفاشية، أو إعادة إنتاج الوضع القائم، حسب موازين القوى ونمط التدخل السياسي.
الخلط بين القانون الجدلي والمسار الأحادي هو ما وقعت فيه المقاربة الميكانيكية، التي حوّلت الماركسية إلى نموذج تنبؤي أشبه بالفكر اللاهوتي؛ حيث يُفترض أن التاريخ “يُحقق ذاته” دون حاجة إلى بشر فاعلين. وفي المقابل، تؤكد الماركسية الجدلية أن التاريخ لا يتحرك من تلقاء نفسه، بل من خلال نضال واعٍ ومؤطر. فالضرورة لا تُنتج التحرر، بل تفتح إمكانيته.
من هنا تبرز أهمية التنظيم السياسي، لا كهيكل فوقي منفصل عن الجماهير، بل كبنية تُنتج داخل الواقع وتعيد صياغته. التنظيم هو الوسيط الذي يربط النظرية بالممارسة، ويحوّل الوعي الطبقي من إدراك مجرد إلى قدرة عملية. وقد شدد كل من لينين وغرامشي على أن الطبقة العاملة لا ترتقي إلى الوعي الثوري بصورة تلقائية، بل تحتاج إلى إطار قيادي يُبلور مشروعها السياسي ويخوض معركة الهيمنة الفكرية والاجتماعية.
في لحظات الأزمات، حين تتكثف التناقضات البنيوية ويتفجّر الغضب الشعبي، لا يكفي الانفجار التلقائي. بل يتطلب الأمر قيادة قادرة على قراءة اللحظة، وإعادة توجيهها، وتأطير العفوية داخل أفق ثوري. فبغياب التنظيم، تتحول اللحظة التاريخية إلى فرصة ضائعة، وقد تُوظّف لصالح مشاريع رجعية أو تُعاد استيعابها داخل النظام نفسه.
الحرية، في الماركسية، ليست خروجاً من البنية بل إعادة تشكيل لها. كما قال ماركس: “لا معنى للحرية خارج فهم الضرورة“؛ الفعل الثوري لا ينطلق من الوهم، بل من وعي عميق بالبنية التي يريد تجاوزها. ومن هذا الوعي تنبثق الاستراتيجية الثورية بوصفها تخطيطاً واعياً لمواقع التدخل، وموازنة بين الإمكانيات وحدود الواقع، وليست خطة مسبقة محفوظة.
التعامل مع الفشل وأهمية النقد الذاتي في المنظور الجدلي
لم يكن الفشل في التجارب الثورية حدثاً هامشياً في مسار الحركات اليسارية، بل لحظة متكررة وضرورية في تطورها. فالخسارة لا تُعتبر، من منظور ماركسي جدلي، نهاية للمشروع التحرري، بل مرحلة كاشفة، تُمكّن من إعادة تأمل الواقع وبناء وعي أشد دقة بالتناقضات التي تتحكم فيه. الماركسية، في بعدها الجدلي، لا تنظر إلى التاريخ كمجرى خطّي للتقدّم، بل كحركة متعرجة يتناوب فيها التقدّم والانكفاء، الإنجاز والانكسار، دون أن تُلغى إمكانات التغيير.
في المقابل، تتعامل القراءة الميكانيكية مع الفشل بوصفه مفارقة لا يمكن تبريرها ضمن منظومة تدّعي الحتمية. فإذا كانت الثورة موعودة بـ”قانون التاريخ”، فإن غيابها يُفسَّر إما بالاتهام الجماهيري بعدم النضج، أو بتخوين القوى الخارجية، دون مساءلة الداخل، أو بنقد آليات التنظيم، أو حتى الخطاب السياسي. وهذا ما يُفرغ التجربة من بعدها النقدي، ويحوّلها إلى سردية مغلقة لا تتعلم من أخطائها. حينها، يصبح النقد الذاتي إما ترفاً تنظيرياً أو خطراً يُجرّم.
أما في المنظور الجدلي، فإن الفشل ذاته يصبح نقطة انطلاق جديدة، لا بوصفه عثرة ظرفية، بل كمؤشّر على قصور في القراءة أو في البناء الذاتي للتنظيم أو في علاقته بالبنية الاجتماعية. لقد مارس مفكرو الماركسية الكبار، من ماركس إلى غرامشي، النقد الذاتي بوصفه جزءاً بنيوياً من الممارسة الثورية. لم تكن مراجعاتهم تنكُّراً للمشروع، بل إعادة تأسيس له ضمن شروط جديدة أكثر تعقيداً. غرامشي، من داخل سجنه، لم يكتب مرثية للهزيمة، بل أعاد تحليلها كأزمة قيادة وفشل في بناء الهيمنة الثقافية والسياسية.
النقد الذاتي، في هذا السياق، ليس فعلاً شخصياً أو تنظيمياً محدوداً، بل هو ممارسة تحليلية مادية–تاريخية تُطال الظرف الموضوعي، الخيارات الاستراتيجية، طبيعة العلاقة مع الجماهير، بنية الخطاب السياسي، ودرجة التماسك التنظيمي. فالخسارة تفتح أسئلة جوهرية:
- لماذا لم تُترجم الأزمة إلى تحوّل؟
- ما الذي لم يُفهم أو لم يُفعّل؟
- كيف أُديرت العلاقة بين الوعي والتنظيم؟
- وما هي أشكال الهيمنة التي لم تُكسر بعد؟
هذا المستوى من المساءلة لا يهدف إلى التطهّر الرمزي أو جلد الذات، بل إلى تجذير مشروع تحرري أكثر دقة واتساقاً مع تعقيدات الواقع.
التنظيمات التي تخشى النقد، بحسب غرامشي، تميل إلى البيروقراطية والانفصال عن المجتمع، لأنها تفقد القدرة على التعلّم، وتحوّل التجربة إلى طقس مغلق، لا تُلامس الواقع ولا تسمح بإعادة بنائه. في المقابل، التنظيم الذي يُدرج النقد ضمن بنيته، يُراكم الوعي ويُحصِّن ذاته من التكلّس، لأنه يتعلّم من هزيمته كما يتعلّم من نضاله.
الثورة، في المنظور الجدلي، ليست نقيض الفشل، بل فن التعلّم منه. إنها القدرة على تحويل لحظات الانكسار إلى خبرة سياسية، وعلى استخراج ما لم يُفهم في المرة السابقة، من أجل العودة بزخم نظري وتنظيمي أوسع. فالفشل لا يُنهي المشروع، بل يدعو إلى إعادة بنائه على أسس أكثر رسوخاً.
خاتمة: الثورة بين الفقر والوعي – تأكيد الفاعلية السياسية والتاريخية
أن تراكم الأزمات الاقتصادية لا يكفي بذاته لإحداث تحوّل تاريخي. فالأزمة لا تتحوّل إلى فعل سياسي إلا حين تقترن بـوعي طبقي نقدي وتنظيم ثوري قادر على تأطير اللحظة التاريخية وتحويلها إلى مشروع تحرري. هذه العلاقة الجدلية بين الشروط الموضوعية والشرط الذاتي تمثل جوهر الفهم الماركسي للتاريخ؛ إذ لا التاريخ يتحقّق تلقائياً، ولا الإنسان يُنتج فعله بمعزل عن البنية. الفاعلية الثورية تقع تحديداً في نقطة التداخل بين الضرورة والحرية.
رفضت الماركسية الجدلية اختزال التاريخ إلى “قانون طبيعي”، كما رفضت ردّ الفعل السياسي إلى مجرد استجابة للبؤس. بدلاً من ذلك، رأت في التاريخ ساحة مفتوحة لاحتمالات متصارعة، تحددها القوى الاجتماعية ومدى قدرتها على التنظيم وإعادة إنتاج شروطها. وفي هذا السياق، لا تكون الثورة قدراً محتوماً، بل إمكاناً سياسياً يتطلّب وعياً يقظاً وتنظيماً قادراً على المواجهة.
والذي يتطلب كشفت حدود التصورات الميكانيكية، التي وإن بدت “علمية” في ظاهرها، فإنها تميل إلى نفي الإنسان وتجميد الفعل، وتحويل التناقضات إلى انتظارات. وعلى العكس من ذلك، فإن الاستراتيجية الثورية تُبنى على ممارسة نقدية ديناميكية، تُعيد باستمرار تأمل الواقع وإمكانات التدخل فيه.
وبالعودة إلى الأطروحة المركزية، يتضح أن التاريخ ليس مساراً أحادياً، بل مسرحاً لفاعلية الذات الإنسانية. القانون قائم، نعم، لكن فعاليته ليست آلية؛ بل تتوقف على الشرط الذاتي، على الوعي والتنظيم والقرار السياسي. الثورة، بهذا المعنى، ليست وليدة الأزمة وحدها، بل هي نتيجة لاصطدام الوعي بالضرورة، وتحويل تلك الضرورة إلى مسار للتحرر.