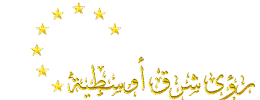يمكن القول إنّ فهم تحوّل العلم إلى سلعة داخل النظام الرأسمالي يقتضي العودة أولًا إلى الأساس النظري الذي وضعه كارل ماركس حول مفاهيم القيمة والعمل والإنتاج. فالماركسية، ببساطة، لا تنشغل بما يظهر على السطح من ظواهر، بل تحاول دائمًا النفاذ إلى ما تحتها، إلى البنية العميقة للعلاقات الاجتماعية التي تنتج تلك الظواهر. في هذا السياق، يصبح تسليع المعرفة ليس مجرد نتيجة لتطور تقني أو إعادة هيكلة مؤسساتية، بل هو قبل كل شيء تعبير عن بنية اقتصادية اجتماعية تعيد إنتاج نفسها باستمرار عبر السيطرة على العمل وتوجيهه نحو خدمة التراكم الرأسمالي.
ولكي نقرّب الفكرة، سأركز هنا على توضيح مفهوم “قيمة السلعة” كما صاغه ماركس، مع إبراز الكيفية التي تتشكل بها القيمة من خلال التفاعل بين ما يسميه “العمل الحي” و”العمل الميت”. هذه النقطة، وإن بدت نظرية للوهلة الأولى، ستكون بمثابة المدخل الضروري لفهم كيف يجري إنتاج القيمة داخل المجال المعرفي لاحقًا.
ولتسهيل استيعاب هذه المسألة، لنأخذ مثالًا مألوفًا: النجار في ورشته. النجار لا يعمل بيديه فقط، بل يعتمد أيضًا على أدوات سبق أن صنعها آخرون، أي أن عمله الحي يتداخل مع عمل ميت متجسد في الأدوات. هذه العلاقة بين الاثنين هي ما يمنح السلعة قيمتها. وإذا نقلنا هذا المثال لاحقًا إلى وضعية الباحث أو العالم في الاقتصاد القائم على المعرفة، سنجد أنّ ما يحدث داخل المختبر أو الجامعة ليس منفصلًا عن البنية الاجتماعية الأوسع للإنتاج الرأسمالي، بل يعيد إنتاجها بشكل مختلف.
من الخشبة إلى البراءة: كيف نفهم القيمة في النظام الرأسمالي؟
حين يفتتح ماركس كتابه رأس المال، يبدأ من أبسط نقطة يمكن الانطلاق منها: تحليل مفهوم السلعة. فالسلعة، في نظره، ليست مجرد شيء مادي نتداوله يوميًا، بل هي الوحدة الأساسية التي يقوم عليها النظام الرأسمالي بأكمله. وببساطة، يمكن القول إن ماركس لا ينظر إلى السلعة على أنها مجرد غرض مادي نستعمله، بل كعلاقة اجتماعية مشيّأة؛ أي علاقة اجتماعية تلبس شكل الشيء. فالسلع تبدو لنا في الظاهر كأشياء ملموسة وعادية، لكنها في حقيقتها تكثيف للعمل البشري، وتُنتَج ضمن علاقات اجتماعية واقتصادية غايتها النهائية تراكم رأس المال.
في هذا السياق، تبرز مسألة القيمة باعتبارها المدخل لفهم منطق الرأسمالية. ما الذي يعطي السلعة قيمتها؟ وكيف يمكن تحديد هذه القيمة؟ هنا يقدّم ماركس إجابة مختلفة تمامًا عن تلك التي طرحها الاقتصاديون الكلاسيكيون مثل آدم سميث وريكاردو. هؤلاء ربطوا القيمة بالمنفعة أو بالندرة، وكأن الشيء يكتسب قيمته من طبيعته أو من كونه نادرًا. أما ماركس فيؤكد أن القيمة التبادلية لا تأتي من خصائص السلعة ذاتها ولا من ندرتها، بل من كمية العمل الاجتماعي الضروري لإنجاز إنتاجها.
وللتقريب، يمكننا القول إن السلعة تحمل في داخلها مقدارًا معينًا من الزمن الاجتماعي المتجسّد في شكل مادي. فهي، إذن، ليست مجرد غرض قابل للتبادل في السوق، بل انعكاس لعلاقات اجتماعية محددة تُنظّم الإنتاج والتوزيع داخل المجتمع الرأسمالي. وهذا ما يجعل السلعة، في نهاية المطاف، أكثر تعقيدًا مما تبدو عليه في حياتنا اليومية.
حالة النجار: العمل المباشر والعمل الاجتماعي المتراكم
لفهم هذا المفهوم بصورة أوضح، دعونا نقترب من مثال بسيط في ظاهره، لكنه غني بالمعنى التحليلي. تخيّل نجّارين يقومان بالمهمة نفسها: قطع شجرة لتحويلها إلى خشبة قابلة للبيع. الأول يستخدم منشارًا يدويًا، بينما الثاني يعتمد على منشار كهربائي. في النتيجة، كلتا الخشبتين تُطرحان في السوق كسلع، لكن قيمتهما ليست متطابقة، رغم تشابه وظيفتهما. والسبب هنا أن عملية الإنتاج نفسها تختلف من حيث الأدوات والوقت المبذول.
في الحالة الأولى، يعتمد النجار على جهده العضلي وعلى وقت أطول، مستخدمًا منشارًا يدويًا غالبًا ما صُنع بوسائل بسيطة على يد حدّاد أو حرفي. أما في الحالة الثانية، فيستند النجار إلى آلة كهربائية أكثر تطورًا، صُنعت داخل مصنع حديث شارك في إنتاجه مهندسون وعمال وتقنيون. بمعنى آخر، ما نراه أمامنا ليس مجرد اختلاف في الأداة، بل اختلاف في كمّ العمل الاجتماعي المتراكم داخل تلك الأداة. ومن هنا، لا يمكن اختزال قيمة الخشبة في زمن العمل المباشر للنجار فقط، بل يجب النظر أيضًا إلى العمل الكامن في وسائل الإنتاج ذاتها.
ماركس يلفت النظر هنا إلى نقطة دقيقة: وسائل الإنتاج لا تُضيف قيمة جديدة بذاتها، بل تنقل فقط ما تحمله من قيمة إلى السلعة. أما القيمة الجديدة فهي دائمًا نتاج العمل الحي الذي يُبذل في لحظة الإنتاج الفعلية. وهكذا، تحتوي أي سلعة على مزيج مركّب من “العمل الميت” المتجسد في الأدوات، و”العمل الحي” المباشر. وهذه الثنائية هي المفتاح لفهم كيفية إنتاج القيمة الفائضة داخل النظام الرأسمالي.
ولأن هذا المثال سيكون حجر الأساس لاحقًا لفهم كيف تُسَلَّع المعرفة، نكتفي الآن بتوضيح منطقه الداخلي، على أن نعود إليه مجددًا حين نتناول وضعية الباحث وأدواته والمؤسسة العلمية بوصفها بدورها وسائل إنتاج تحمل في داخلها عملًا اجتماعيًا سابقًا.
القيمة الاجتماعية الضرورية والفرق بين الإنتاج الفردي والإنتاج الرأسمالي
ما يعمّق هذا المثال أكثر هو التمييز الذي يقدّمه ماركس بين ما يسميه “القيمة الفردية“ و**”القيمة الاجتماعية الضرورية”**. ببساطة، إذا كانت الغالبية العظمى من المنتجين يعتمدون على المناشير الكهربائية، فإن القيمة الاجتماعية لإنتاج خشبة واحدة ستُحسب على أساس الزمن المتوسط المطلوب للإنتاج بهذه الوسيلة السائدة. عندها يصبح النجار الذي لا يزال يعمل بالمنشار اليدوي في موقف صعب: فهو ينتج السلعة نفسها، لكن بزمن أطول وبقيمة فردية أعلى، ما يجعله غير قادر على المنافسة. هذا الفارق بالضبط هو ما يسميه ماركس “فائض القيمة النسبي“، والذي يمنح الأفضلية لمن يستخدم أدوات إنتاج أكثر كفاءة.
في هذا السياق، يتضح أن الجهد الفردي أو حتى المهارة العالية لا يكفيان وحدهما لإنتاج سلعة ذات قيمة في السوق. ما يحكم الأمر فعلًا هو خضوع العمل لمنطق الزمن الاجتماعي. وهذا المفهوم أساسي، لأنه يكشف أن قيمة السلعة لا تتحدد فقط داخل الورشة أو المصنع، بل ضمن شبكة اجتماعية أوسع، تتحكم فيها الأدوات والتقنيات وسرعة الإنتاج بما يتماشى مع حاجات التراكم الرأسمالي.
ومن هنا يمكن أن نمهّد الطريق لفهم تسليع المعرفة: الباحث الذي لا يملك أدوات معرفية متطورة ــ مثل البرمجيات الحديثة أو التمويل المؤسسي ــ يجد نفسه في وضع شبيه بالنجار الذي يستخدم منشارًا يدويًا. فهو قد يصل إلى النتيجة ذاتها، لكن بزمن أطول، ما يجعله أقل “إنتاجية” وفق المعايير الرأسمالية التي تحدد القيمة.
من النجار إلى الباحث: إنتاج القيمة في اقتصاد المعرفة
إذا كانت الخشبة في المثال السابق سلعة، فإن المعرفة في الاقتصاد المعاصر قد تحوّلت هي الأخرى إلى سلعة. يمكن القول ببساطة إن الباحث أصبح هو “النجّار الجديد”، غير أنّ أدواته لم تعد مناشير أو مطارق، بل مختبرات رقمية، منصات بحث، خوارزميات، وأنظمة تمويل معقّدة. وحين ينتج الباحث مقالًا علميًا أو يسجل براءة اختراع، فإن عمله لا يُقاس فقط بالزمن المباشر الذي بذله، بل يُضاف إليه أيضًا رصيد ضخم من العمل الاجتماعي المتراكم في أدوات إنتاج المعرفة التي يستخدمها.
فالمقال العلمي، على سبيل المثال، لا يتشكل حصريًا داخل ذهن الباحث، بل يمر عبر شبكة واسعة ومتشابكة من البنى المعرفية والاجتماعية: من سنوات التعليم الجامعي، إلى قنوات التمويل، إلى بيئة النشر، وصولًا إلى البنية التحتية الرقمية التي تدعم العملية كلها. كل هذه العناصر تتضمن جهدًا سابقًا ومتراكمًا، وتنتقل قيمته إلى المنتج النهائي. ومع ذلك، تظل القيمة الجديدة مرتبطة بالعمل الحي للباحث نفسه. غير أن المفارقة تكمن في أنّ الباحث، تمامًا كالعامل الصناعي، لا يحصل على القيمة الكاملة لمنتجه. فهو يتقاضى أجرًا أو تمويلًا محدودًا، بينما تُحتكر القيمة الفائضة من قبل المؤسسات الأكاديمية أو الشركات الخاصة، كما يحدث في النشر العلمي التجاري أو في الاحتكار القانوني لبراءات الاختراع.
بهذا الشكل، نجد أن علاقات الإنتاج الرأسمالية يُعاد إنتاجها داخل الحقل المعرفي نفسه. فالباحث يُختزل إلى مجرد “منتِج”، والمعرفة تتحول إلى وحدات قابلة للتبادل والخضوع لقوانين السوق. وبذلك، تُستبدل القيمة الاجتماعية للفكر بالقيمة التبادلية، وتتحول الحقول العلمية إلى ساحات منافسة ومراكمة، لا تختلف في جوهرها عن أي قطاع آخر من قطاعات الإنتاج الرأسمالي.
الخاتمة
يمكن القول إن منطق القيمة في الرأسمالية لا يقتصر على الصناعات المادية أو العمل اليدوي، بل يمتد ليشمل حتى أكثر أشكال النشاط الإنساني تركيبًا، وعلى رأسها إنتاج المعرفة. فالسلعة، في التصور الماركسي، ليست مجرد شيء مادي نتداوله، بل هي تجسيد لعلاقات إنتاج اجتماعية. والمعرفة، حين تُعامل كسلعة، تُنتج هي الأخرى من خلال تداخل العمل الحي (أي جهد الباحث المباشر) مع العمل الميت (المتجسد في البنى المؤسسية والتقنية المتراكمة)، وتحمل في داخلها أثرًا غير مرئي للبنية الاجتماعية التي تنظّم شروط إنتاجها.
في هذا السياق، لا نسعى إلى إقامة تماثل سطحي بين العمل اليدوي والعمل المعرفي. المقصود هو إظهار الكيفية التي يتغلغل بها منطق الرأسمالية في مختلف مجالات النشاط البشري، بحيث يحوّل حتى الفكر نفسه إلى وحدة قابلة للتسليع، تُباع وتُشترى وتُقيَّم على أساس مردودها السوقي. ومن هنا تأتي خطورة موضوع “تسليع العلم” في الرأسمالية المعاصرة، إذ يطاول المجال الذي يُفترض أن يكون أكثر استقلالًا وارتباطًا بالحقيقة والبحث الحر.
هذا الفهم يشكل مدخلًا أوسع لتفكيك التحوّل الرأسمالي في بنية المعرفة. فمن الضروري تحليل ديناميات التمويل العلمي، احتكار النشر الأكاديمي، نماذج الملكية الفكرية، علاقات السوق في الجامعات، وشروط إنتاج التكنولوجيا. كما يتطلب الأمر مساءلة الخطابات التي تروّج لفكرة “حيادية البحث العلمي”، والكشف عن ارتباطها الوثيق بالسلطة الاقتصادية والسياسية.
وبالمحصلة، تصبح إعادة وضع العلم في سياقه الطبقي وربطه بالتحوّلات البنيوية للرأسمالية النيوليبرالية شرطًا لتطوير أدوات نقدية قادرة على مساءلة المعرفة ذاتها: كيف تُنتج؟ ولمن؟ وبأي ثمن؟ وما الذي يُقصى أو يُستبعد من هذا الإنتاج بفعل علاقات الهيمنة؟
من هنا، يمكن القول إن مهمة النضال الفكري اليوم لا تقتصر على فضح آليات تسليع المعرفة، بل تتطلب أيضًا استعادة ممكناتها التحررية، وإعادة ربطها بحاجات المجتمعات لا بمصالح السوق.