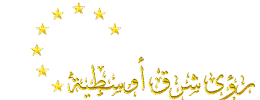في الفهم الماركسي الجدلي، لا يمكن اختزال العلاقة بين الحزب والمنظمات الجماهيرية إلى تنسيق إداري أو تحالف تكتيكي محكوم باللحظة. فالحزب الثوري ليس كيانًا منفصلًا عن الصراع الاجتماعي، بل أحد تمظهراته الواعية. والمنظمات الجماهيرية، على تنوعها، ليست مجرد أدوات مطالبية، بل ساحات إنتاج للوعي والهيمنة المضادة، حيث تتشكل البنية الحقيقية للقوة الاجتماعية.
إن هذه العلاقة تتجاوز حدود التشارك أو التلاقي المؤقت. إنها علاقة عضوية، تنبع من واقع أن الحزب – بوصفه تعبيرًا سياسيًا عن مصالح الطبقات المضطهدة – لا يملك وجودًا مستقلًا عن نضالات الجماهير، بل يُعاد تشكيله داخلها، ويتجذر من خلالها. إنه لا “يستخدم” هذه التنظيمات كوسائط نفوذ، بل ينخرط فيها بوصفها الحقل الحي الذي يُصاغ داخله الفعل الثوري.
في هذا السياق، لا يمكن أن تكون العلاقة بين الحزب وهذه الأطر علاقة تبعية أو ذوبان. فالحزب ليس قيادة فوقية تملي على الجماهير، كما أنه لا يفقد طابعه الطليعي بانخراطه في العمل الشعبي. بل يمارس حضوره السياسي من خلال علاقة جدلية مزدوجة: يعمّق وعي الجماهير من جهة، ويتطور هو ذاته من خلال التجربة الميدانية من جهة أخرى.
وعليه، فإن هذه العلاقة ليست فرعًا تنظيميًا تابعًا، بل تشكّل جزءًا من البنية التحتية لأي مشروع ثوري. كل فصل بين التنظيم الثوري والبنى الجماهيرية هو فصل بين النظرية والممارسة، بين الذات الثورية والحقل الاجتماعي. وكل محاولة لحصر العلاقة في البُعد الإداري أو التقريري تُنتج بالضرورة نخبًا مفصولة، تفتقر للشرعية الاجتماعية، وتعيد إنتاج أشكال فوقية من القيادة السياسية، تقف على هامش التحولات.
النواة الثورية: المحرك الداخلي للمنظمات الجماهيرية
حين يتحدث الفكر الثوري عن “الوجود الحيّ للحزب داخل الجماهير”، فإنه لا يُحيل إلى مجرد حضور رمزي أو تمثيل إداري في قيادة المنظمات الجماهيرية. بل إلى نواة تنظيمية ملموسة، تشكّل القلب النابض للفعل السياسي داخل هذه الأطر، وتُمثّل الجسر العضوي بين التجربة اليومية للطبقات الشعبية والمشروع السياسي للتحرر.
هذه النواة ليست جهازًا معزولًا يُدار من مركز حزبي مغلق، بل تشكّل نقطة تقاطع بين وعي الطليعة واحتياجات القاعدة. إنها تعمل داخل الجماهير لا من فوقها، وتبني شرعيتها من خلال المراكمة اليومية في ميادين التعليم، والعمل، والاحتجاج، لا من خلال قرارات فوقية أو صلات تنظيمية محضة.
وظيفتها تتجاوز التنسيق أو التعبئة. إنها المسؤولة عن تحويل العفوية الشعبية – بما تحمله من شتات وغضب – إلى طاقة منظّمة، واعية، وقادرة على الفعل السياسي. ومن خلال وجودها، لا تتحول التنظيمات الجماهيرية إلى أذرع إعلامية للحزب، بل إلى ساحات نضالية تستند إلى منطق التنظيم الذاتي، وتنتج وعيها السياسي من داخل التجربة.
النواة لا تولد جاهزة، ولا تستمر بنفس البنية. إنها بنية متحركة، تتجدد بانتظام عبر استيعاب الكوادر الجديدة من القواعد، وتُعيد صياغة أدواتها التنظيمية بحسب تحوّلات الحقل الاجتماعي. وبهذا المعنى، هي ليست أداة ضبط، بل أداة تفعيل – لا تتلقى تعليمات فحسب، بل تُعيد إنتاج المعنى السياسي ذاته من موقعها الجدلي بين الحزب والجماهير.
وحيثما وُجدت نواة ثورية متجذّرة، يمكن تحويل الأطر الجماهيرية من قنوات مطلبية محدودة إلى أدوات فعل سياسي مؤسِّس، تمتلك القدرة على قلب ميزان القوى الاجتماعي، لا مجرد التفاعل مع نتائجه.
العمق أم الانتشار؟ جدل التأثير الحزبي
لطالما شكّلت الثنائية بين “العمق” و”الانتشار” سؤالًا تنظيميًا مركزيًا في مسار الأحزاب الثورية: هل يُفضَّل ترسيخ وجود نوعي داخل إطار جماهيري صغير ومتماسك؟ أم التوسّع العددي في فضاء جماهيري واسع ولو بفعالية سياسية محدودة؟ هذا السؤال، في جوهره، يُعيد إنتاج الانقسام بين النخبوية المعزولة والحشد غير المؤطر، وهو ما يتجاوزه المنظور الماركسي من خلال إدراك العلاقة الجدلية بين العمق والاتساع كشرطين متكاملين لأي بناء ثوري فعّال.
فالترسخ داخل تنظيم صغير قد يسمح ببناء نواة متماسكة وواعية، لكنه يهدد بالتحول إلى طائفة مغلقة، تدور حول ذاتها وتفقد صلتها بالحقل الاجتماعي الواسع. أما الانتشار العددي بدون رؤية سياسية واضحة، فإنه يُنتج سطحية تنظيمية لا تُحدث تراكمًا نوعيًا، ويحول الحزب إلى كيان مائع، يستهلك طاقته في إدارة الحشود دون التأثير الفعلي في وعيها.
ما يطرحه الماركسي هو الدمج الجدلي بين الحضور العميق والتوسع الأفقي: نواة ثورية واعية داخل فضاء جماهيري حيّ. حضور يُعيد تعريف العلاقة بين التنظيم والجماهير بوصفها علاقة صراع وتعلم متبادل، لا قيادة فوقية أو تماهي عفوي. التنظيم الناجح لا يُقاس بعدد الحضور أو الشعارات المرفوعة، بل بقدرته على إنتاج تحول في الوعي السياسي، وعلى تحويل البنية التنظيمية من جهاز إداري إلى حقل تعبئة سياسي مستمر.
إن التأثير الحزبي لا يتحقق لا بالعدد ولا بالاصطفاف، بل بتجذّر الكادر في الصراع الاجتماعي، وبقدرته على نقل التنظيم من موقع المتفرّج إلى موقع الفاعل – من جهاز تعبئة إلى أداة اشتباك طبقي. فقط عند هذا الحدّ، يصبح الحزب قوة اجتماعية لا مجرد تشكيل سياسي.
من يقود يكشف من يبني: مقياس الفعل التنظيمي
ليست القيادة الحزبية مسألة تمثيل رمزي أو إعادة تدوير للنخب الداخلية، بل مقياسًا صريحًا للفعل التنظيمي في الميدان. فبنية القيادة، في أي لحظة تاريخية، تكشف بوضوح أين يزرع الحزب جذوره، ومن يُنتج حقيقته الاجتماعية. وعليه، فإن صعود الكوادر الشابة أو العمالية إلى مواقع متقدمة داخل الحزب لا يجب أن يُفهم كمجرد “تجديد” شكلي، بل كمؤشر مباشر على مدى نجاح الحزب في بناء قواعد جماهيرية حية وفاعلة.
القيادة التي لا تولد من قلب النضال اليومي، من الجامعات والمصانع والأحياء، هي قيادة مفصولة. تُعيد إنتاج التنظيم كجهاز مغلق، وتحوّله إلى هرم فوقي يفتقر إلى الامتداد الاجتماعي. فالشباب لا يظهرون في الصفوف الأولى لأن القيادة اختارتهم، بل لأنهم أثبتوا أنفسهم في ميادين المواجهة، في معارك التعليم والعمل والاحتجاج. والعامل الذي يتصدر الحزب لا يُمنح صوته، بل ينتزعه عبر نضال يومي متراكم، يعبّر فيه عن مصالح طبقته وينظّمها.
إن الكادر الحزبي الحقيقي لا يُقاس بولائه النظري ولا بحجم مشاركته في الاجتماعات، بل بقدرته على البناء والتنظيم والتجذّر داخل المجتمع. وكل قيادة تتشكّل خارج هذا المنطق، تكشف عن أزمة داخلية: عن جهاز حزبي لا يفرز قيادته من واقعه، بل يختارها من علٍ، وفق توازنات فوقية، أو علاقات شخصية، أو شبكات نفوذ حزبي.
هذه الأزمة لا تقتصر على ضعف الأداء أو محدودية التأثير، بل تمثل تهديدًا استراتيجيًا للحزب نفسه. إذ تُنتج طبقة تنظيمية مغلقة، تعيد إنتاج نفسها، وتفقد الاتصال بجذورها الجماهيرية. وإذا ما استمر هذا الفصل، فإن الحزب لن يُهزم من الخارج، بل سيتآكل من الداخل، بفعل الانفصال البنيوي بين القيادة والقاعدة.
القيادة لا تُصنَع في الغرف المغلقة، بل تُنتزع في ميادين الصراع. وكل بنية تنظيمية تفشل في ترجمة هذه الحقيقة، إنما تؤسس لأزمتها بيدها.
من التعبئة إلى التنظيم الثوري: قلب مفهوم العمل الجماهيري
غالبًا ما يُختزل العمل الجماهيري، حتى داخل الأحزاب التقدمية، في مجرّد تعبئة ظرفية أو حشد موسمي: مظاهرات، حملات انتخابية، استجابة لمطلب عاجل. هذا الفهم يُفرغ العمل الجماهيري من محتواه الثوري، ويحوّله إلى أداة تعبئة استهلاكية، تتكرر دون أن تنتج تراكمًا فعليًا في الوعي والتنظيم.
لكن في المنظور الماركسي، لا يُفهم العمل الجماهيري كوظيفة ثانوية أو كواجهة نضالية، بل كبنية عضوية ضمن مشروع التغيير الاجتماعي الشامل. هو امتداد للبرنامج السياسي، وساحة اختبار حقيقية لمدى قدرة الحزب على الترجمة العملية لأفكاره داخل نسيج الواقع الاجتماعي. وبهذا المعنى، لا يُفصل العمل الجماهيري عن الصراع الطبقي، بل يُعاد تأطيره كحقل من حقول المواجهة المباشرة، حيث تُبنى القيادة من القاعدة، وتُصاغ أشكال التنظيم الذاتي في قلب الحركة.
حين ينجح الحزب في تحويل النقابة من جهاز مطلبي إلى موقع اشتباك مع رأس المال، وحين تتحوّل اتحادات الطلبة من فضاءات خدماتية إلى أدوات نضال ضد سياسات الدولة التعليمية، عندها يصبح العمل الجماهيري أكثر من مجرد أداة احتجاج، ويُعاد إنتاجه كمحرك أساسي للوعي والتنظيم.
الحزب في هذا السياق لا “يستخدم” هذه الأطر، ولا يوجّهها من الخارج، بل يعيد تشكيلها من الداخل عبر كوادره المتجذّرة. ومن خلال هذا الانخراط، يتحوّل الحضور السياسي إلى فعل تأسيسي: يُعيد صياغة التوازنات، ويُنتج قيادته من رحم التجربة، ويحوّل الغضب العفوي إلى قوة سياسية منظمة.
العمل الجماهيري إذًا ليس وظيفة ثانوية، بل هو المجال الذي تُختبر فيه قدرة الحزب على التأثير، التنظيم، وإنتاج الوعي التحرري داخل الجماهير نفسها.
الخاتمة
ليست العلاقة بين الحزب والمنظمات الجماهيرية مسألة هيكلية أو خيارًا تنظيميًا من بين بدائل عدة، بل هي مقياس جوهري لمدى جدية أي مشروع ثوري. فالحزب الذي يعجز عن تنظيم الفئات الشعبية ضمن أطر جماهيرية حية، يعجز بالضرورة عن تحويل الصراع الاجتماعي إلى فعل سياسي مؤثر. ومن لا يزرع نواته التنظيمية داخل الحياة اليومية للطبقات المضطهَدة، لن يحصد إلا العزلة والتنظير المجرد.
الثورة، في معناها الجدلي، ليست لحظة انفجار، بل سيرورة بناء. وهذا البناء لا يتم من فوق، بل من داخل المجتمع نفسه، عبر أدواته الحية: النقابات، الجمعيات، الاتحادات، اللجان الشعبية، وكل شكل من أشكال التنظيم الذاتي. وكلما نجح الحزب في تحويل هذه الأطر إلى فضاءات للصراع والتعبئة السياسية، اقترب من تحويل الغضب الاجتماعي إلى وعي طبقي منظم، وإلى قوة مادية قادرة على الفعل.
إن حزبًا يختصر وجوده في المركز، أو يحصر نضاله في الخطاب، هو حزب ينفصل تدريجيًا عن قاعدته، ويعيد إنتاج نفسه كجهاز مغلق. أما الحزب القادر على غرس بنيته في عمق المجتمع، وعلى تحويل النضال اليومي إلى مدرسة للصراع الطبقي، فهو الوحيد الذي يمكنه تجاوز الهزيمة الرمزية، وتحقيق تراكم تاريخي فعلي.
فالثورة لا تُصنع بالنوايا ولا بالنصوص، بل تبنى على الأرض، داخل الجماهير، وبلغة التنظيم. ومن لا يحسن بناء هذه اللغة، لا يحسن ترجمة المشروع الثوري ذاته.