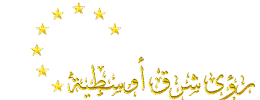شهد العالم خلال العقود الأخيرة انتقالاً نوعياً من الطور الصناعي إلى الطور الرقمي. في هذا السياق، لم تعد الخوارزميات والذكاء الاصطناعي مجرد أدوات تقنية تهدف إلى تحسين الكفاءة أو تسريع عملية اتخاذ القرار، بل أصبحت تمثل البنية التحتية الأعمق والأكثر جوهرية في المنظومة الرأسمالية المعاصرة. ببساطة، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي لم يعد أداة إضافية للإنتاج، بل غدا قلب العملية الإنتاجية وإعادة الإنتاج الرأسمالي.
فالذكاء الاصطناعي اليوم يشكّل عنصراً مركزياً ليس لأنه ينجز المهام بسرعة أكبر أو بدقة أعلى فحسب، بل لأنه يعمل كآلية لتكثيف الاستغلال وإعادة صياغة العلاقة بين رأس المال والعمل. على سبيل المثال، لم تعد الخوارزميات تقتصر على أتمتة الأعمال اليدوية الروتينية كما كان الحال في الثورة الصناعية، بل امتد أثرها ليشمل إعادة تشكيل أنماط التفكير، والوعي، والإنتاج الرمزي والمعرفي. وكأن كل نشاط إنساني – من الكتابة إلى التفاعل الاجتماعي – صار قابلاً للتحويل إلى قيمة تبادلية ضمن السوق.
هذا التحول العميق يجعل من الضروري، بل والملحّ، أن يُدرس الذكاء الاصطناعي من منظور النظرية الماركسية. فالتحليل الماركسي يسمح لنا بفهم طبيعة التناقضات التي يعيد الذكاء الاصطناعي إنتاجها في قلب النظام الرأسمالي: كيف يُضاعف آليات الاستغلال، وكيف يعيد تكريس التفاوتات الطبقية والاحتكارية، ولكن في صورة رقمية أكثر تعقيداً.
ومن هنا تنبثق إشكالية أساسية: فالخوارزميات ليست مجرد أدوات محايدة، بل هي وسائل لاستخراج فائض القيمة وتكثيف السيطرة، وفي الوقت ذاته قد تفتح الباب أمام إمكانيات جديدة للمقاومة أو لتحولات جذرية في بنية الصراع الاجتماعي. بعبارة أخرى، ما نشهده اليوم ليس مجرد تطور تقني، بل إعادة صياغة لعلاقات القوة في المجتمع على نحو يفرض علينا إعادة التفكير في مستقبل الصراع الطبقي في عصر الرأسمالية الرقمية.
السياق التاريخي للتراكم
كما يوضح ماركس في رأس المال، نشأت الرأسمالية على أساس عملية فصل عنيفة عُرفت باسم “التراكم البدائي”. فقد جرى انتزاع الفلاحين من أراضيهم وتحويلهم إلى قوة عمل “حرة”، لكنها في الحقيقة قوة محرومة من وسائل الإنتاج. ببساطة، يمكن القول إن هذا الفصل التاريخي بين العامل ووسائل عيشه كان الشرط الجوهري لتوسع رأس المال وبسط سيطرته.
ومع كل ثورة صناعية جديدة، أعيد إنتاج هذا الفصل ولكن في أشكال متجددة. فالثورة الصناعية الأولى ارتكزت على المكننة وقوة البخار، في حين قامت الثانية على الكهرباء والإنتاج الكثيف. أما الثالثة فقد عمّقت دور الأتمتة والحواسيب، وترافقت مع بروز العولمة النيوليبرالية. وإذا أخذنا هذا التسلسل كخط بياني، نجد أن كل مرحلة كانت بمثابة خطوة إضافية في إعادة تشكيل العلاقة بين رأس المال والعمل.
وفي طور الثورة الصناعية الرابعة، يتجسد هذا المسار في الذكاء الاصطناعي الذي يمثل اليوم المرحلة الأعلى والأكثر تعقيداً. فالرأسمال لم يعد يكتفي بالسيطرة على قوة العمل الجسدية كما في السابق، بل يسعى الآن إلى السيطرة على المعرفة والذاكرة وأدوات التواصل ذاتها. يمكن تشبيه الأمر بالانتقال من التحكم في آلة تعمل بالبخار إلى التحكم في عقول وأفكار الأفراد عبر الخوارزمية. إن هذا التحول يعكس انتقال التراكم من السيطرة على الطبيعة بالآلة إلى السيطرة على الإنسان نفسه بالبيانات والخوارزميات. وبذلك يُعاد إنتاج التناقض الأساسي بين رأس المال والعمل، لكن في مستوى جديد أكثر شمولية وتعقيداً، حيث يُختزل النشاط الإنساني كله إلى بيانات قابلة للقياس والتسليع والاستخدام التجاري.
ومنذ الثورة العلمية الحديثة، أخذت المعرفة موقعاً محورياً في تطور قوى الإنتاج. فالمعارف العلمية والتقنية لم تعد مجرد تراكم ثقافي عبر الأجيال، بل تحولت إلى قوة إنتاجية مباشرة. وفي ظل الرأسمالية الرقمية، نجد أن الخوارزميات هي التعبير الأقصى عن هذا التحول، إذ تجسد “العمل الميت” في صورة أنظمة ذكية قادرة على توجيه العمل الحي وإعادة تشكيله. وهنا تكمن المفارقة: فالمعرفة لم تعد مجرد سلعة تُباع وتُشترى، بل غدت وسيلة للسيطرة على إنتاج المعنى نفسه.
إن الذكاء الاصطناعي، في هذا السياق، يمثل علاقة جدلية دقيقة بين المعرفة كرأسمال والعمل كعنصر اجتماعي حي. فحتى أبسط التفاعلات اليومية – كالنقر على شاشة الهاتف أو كتابة تعليق قصير – تتحول إلى مواد أولية لإنتاج القيمة. وبذلك يصبح كل فعل إنساني، مهما بدا هامشياً، جزءاً من منظومة تراكم رأسمالي جديدة تُخضع الحياة اليومية ذاتها لمنطق السوق.
آليات التراكم عبر الذكاء الاصطناعي
تُستخدم الخوارزميات اليوم لاستبدال العمال في المهام الروتينية وتسريع وتيرة الإنتاج، وهو ما أدى إلى قفزة غير مسبوقة في معدلات الإنتاجية. غير أن هذا التحول لا يعني، ببساطة، القضاء على العمل البشري؛ بل على العكس، يكشف عن مضاعفة معدل استغلاله. فكما أوضح ماركس، يتحقق فائض القيمة إما من خلال إطالة وقت العمل غير المدفوع، أو عبر تكثيف إنتاجية العمل القائم. واللافت أن الذكاء الاصطناعي يحقق هذين البعدين معاً: فهو يقلص الحاجة إلى العمالة البشرية في جوانب معينة، لكنه يفرض على من يبقون في مواقعهم إيقاعاً أسرع وضغوطاً أعنف. وبذلك تتحول الأتمتة إلى أداة لاختصار “العمل الحي” وتوسيع نطاق “العمل الميت”، وهو ما يمنح رأس المال قدرة أكبر على تركيز فائض القيمة.
في ظل الرأسمالية الرقمية، أخذت البيانات موقع المورد الاستراتيجي الأهم، حتى بات يُشار إليها بـ”النفط الجديد”. لكن ثمة فرق جوهري هنا: فالنفط يُستخرج من الطبيعة، أما البيانات فتُستخرج من النشاط الاجتماعي ذاته. ببساطة، المستخدمون ينتجونها بأنفسهم يومياً عبر أبسط التفاعلات – من نقرة على الشاشة، إلى إعجاب عابر، إلى عملية بحث أو محادثة شخصية. كل هذه الأنشطة تُحوَّل إلى مادة خام قابلة للتسليع والاستغلال التجاري. وهكذا نشهد شكلاً جديداً من “العمل غير المرئي”، حيث يُستغل النشاط الإنساني المجاني ليُعاد تدويره في صورة قيمة سوقية. يمكن القول إننا أمام نوع مغاير من فائض القيمة: فائض لا يُنتزع من قوة العمل المباشرة وحدها، بل من تحويل تفاصيل الحياة اليومية ذاتها إلى مادة للتراكم الرأسمالي.
لكن الأمر لا يقف عند حدود استبدال العمال أو استخراج بياناتهم، بل يتجاوز ذلك إلى إعادة صياغة أدوارهم داخل عملية الإنتاج. فالعامل المعاصر لم يعد خاضعاً فقط لإيقاع المصنع كما كان في الماضي، بل أصبح مرهوناً برقابة خوارزمية دقيقة تُمارس في الزمن الحقيقي. فإنتاجيته تُرصد، وأداؤه يُقيَّم، بل ويجري التنبؤ بسلوكه المستقبلي استناداً إلى أنماط بياناته. هنا نواجه ما يمكن وصفه بـ”الفوردية الرقمية”؛ فهي استمرار لمنطق الفوردية القديمة في التحكم والإيقاع، لكنها تستند إلى بيانات وخوارزميات بدلاً من الآلات الميكانيكية. العامل، في هذا السياق، لا يحدد وتيرة عمله بنفسه، بل تُحددها المنصة الرقمية التي ترسم موقعه، وجدوله الزمني، ومكافأته، بل وقد تهيكل مستقبله المهني بأكمله.
ومن أبرز سمات الرأسمالية الرقمية أن أدوات الذكاء الاصطناعي تُحتكر من قبل شركات عملاقة مثل Google وAmazon وMeta وMicrosoft. هذه الشركات لا تسيطر على التكنولوجيا فحسب، بل تحتكر البيانات والبنى التحتية والقدرات البحثية. وهذا الاحتكار لا يعكس مجرد تفوق اقتصادي، بل يجسد منطق “رأس المال الاحتكاري” في صورته الأحدث، حيث تتحول المعرفة ذاتها إلى ميدان للهيمنة. وبذلك تتكرس سلطة اقتصادية وسياسية عابرة للحدود، تجعل من الوصول إلى البيانات شرطاً أساسياً للوجود الاقتصادي والسياسي داخل النظام العالمي الراهن.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي كأدوات تراكم
تشير دراسات حديثة إلى أن أنظمة الصيانة التنبؤية والرقابة الآلية المبنية على الذكاء الاصطناعي أسهمت بشكل ملحوظ في تقليص الأعطال وتخفيض تكاليف التشغيل. غير أن هذه الكفاءة، إذا نظرنا إليها من زاوية الاقتصاد السياسي، لا تعني سوى نقل القيمة من العمالة البشرية إلى رأس المال. فمع كل تقدم في الأتمتة، يُستبعد عدد متزايد من العمال من خطوط الإنتاج، بينما يُعاد توزيع فائض القيمة ليصب في مصلحة أصحاب رأس المال. ببساطة، الكلفة الاجتماعية لهذه الكفاءة هي تهميش العمل الحي لصالح توسّع العمل الميت.
وفي القطاع الصحي، يبدو الذكاء الاصطناعي وكأنه معجزة تكنولوجية: تسريع في التشخيص، إدارة أفضل للموارد الطبية والبشرية، وربما تحسين فرص النجاة للمرضى. لكن، في العمق، يعزز هذا التطور منطق الخصخصة، حيث تتحول الصحة إلى سلعة تُدار وفق معايير السوق بدلاً من أن تُعامل كحق اجتماعي شامل. وهنا يظهر تناقض صارخ: فبينما يُسوَّق الذكاء الاصطناعي كأداة لإنقاذ الأرواح، فإنه في الواقع يخضع الصحة لمنطق الربح، الأمر الذي يُفاقم من التفاوت في الوصول إلى الرعاية الصحية. إنه المثال الأوضح على كيفية انزلاق قيم إنسانية عليا – كالصحة والحياة – إلى مجال الحسابات الربحية.
أما في مجال الإعلام والتواصل، فقد حولت الخوارزميات الجمهور إلى منتجين غير مرئيين للبيانات. كل مشاهدة لفيديو، كل نقرة إعجاب أو مشاركة، تتحول إلى قيمة تبادلية. والنتيجة أن الوعي نفسه – الرغبات، العادات، والاهتمامات – أصبح موضوعاً للتراكم الرأسمالي. يمكن القول إن الاستغلال لم يعد يقتصر على قوة العمل الجسدية أو الذهنية المباشرة، بل امتد ليشمل الحياة اليومية بأدق تفاصيلها، حيث تتحول التجربة الإنسانية ذاتها إلى مادة خام تُباع وتُشترى.
في النظام المالي أيضاً، تبدو الخوارزميات أداة لا غنى عنها: فهي تُستخدم للتنبؤ بالمخاطر، تسريع المعاملات، وكشف الاحتيال. لكن الوجه الآخر لهذه التطورات يكشف مفارقة جديدة: فهذه الخوارزميات نفسها تُنتج أدوات مضاربة مالية تزيد من هشاشة النظام وتعمّق الفوارق الطبقية. وبدلاً من أن تشكل التكنولوجيا وسيلة لتحقيق الاستقرار المالي، تتحول إلى محرك لتوسيع الاحتكارات وتغذية الأزمات الاقتصادية. يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع يعمل كسيفٍ ذي حدين، لكنه في الغالب يُرجح كفة المخاطر.
وأخيراً، نجد مثالاً واضحاً في الخدمات الزبائنية. اعتماد المساعدين الافتراضيين وأنظمة الدردشة الآلية أدى إلى تقليص الحاجة إلى آلاف الموظفين في مراكز الاتصال. في المقابل، تولّد هذه الأنظمة بيانات ضخمة تُستغل بدورها لإنتاج فائض قيمة إضافي. وبذلك، لم يعد التفاعل البشري مع الزبون مجرد خدمة، بل تحول إلى عملية إنتاجية بحد ذاتها تُدر الأرباح لرأس المال. إنها إعادة صياغة لفكرة “العمل” بحيث يشمل حتى أبسط أشكال التواصل اليومي.
التداعيات الاقتصادية
من الواضح أن الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى زيادة فائض القيمة بشكل غير مسبوق، لكنه في الوقت ذاته يضعف القدرة الشرائية للجماهير نتيجة تفاقم البطالة وانخفاض الأجور. هذا يضعنا أمام تناقض جوهري: رأس المال يواصل التوسع في التراكم والإنتاج، بينما الطلب الاجتماعي ينكمش. يمكن ببساطة تشبيه الأمر بمصنع ينتج آلاف السيارات يومياً، لكن معظم المستهلكين لم يعودوا قادرين على شرائها. النتيجة الحتمية هي تفاقم الأزمات الاقتصادية، التي لا تصبح أكثر حدة فحسب، بل أيضاً أكثر دورية.
الرأسمالية الرقمية اليوم تواجه خطراً حقيقياً يتمثل في أزمات فرط الإنتاج. فعلى سبيل المثال، شركات التجارة الإلكترونية الكبرى تنتج وتوزع سلعاً بوتيرة متسارعة بفضل الأتمتة والذكاء الاصطناعي، بينما تظل القدرة الاستهلاكية محدودة بفعل الديون وضعف الأجور. الاعتماد على الائتمان أو تشجيع الاستهلاك بالدَّين ليس سوى حل مؤقت يؤجل الانفجار، لكنه لا يمنع حدوثه. وفي هذا المعنى، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي يعيد إنتاج الديناميكيات التقليدية للأزمات الرأسمالية، لكن في نطاق أوسع وأكثر خطورة. أزمة الرهن العقاري عام 2008 مثال بارز على كيف يمكن للائتمان أن يخفي هشاشة الطلب لفترة، قبل أن ينهار النظام فجأة.
من جهة أخرى، السيطرة على الذكاء الاصطناعي ليست متكافئة عالمياً. بل هي محتكرة من قبل قلة من الدول والشركات العملاقة مثل الولايات المتحدة (عبر شركات مثل Google وOpenAI وMicrosoft) أو الصين (عبر شركات مثل Alibaba وBaidu). أما بقية الدول، خصوصاً في الجنوب العالمي، فتبقى في موقع المستهلك للتقنيات دون أن تمتلك بنيتها التحتية أو بياناتها السيادية. هذا الوضع يعيد تشكيل التبعية الاقتصادية والسياسية في إطار ما يمكن تسميته بـ”الإمبريالية الرقمية”. على سبيل المثال، عندما تعتمد الحكومات في الشرق الأوسط أو إفريقيا على منصات غربية لإدارة خدماتها الرقمية أو تخزين بياناتها، فإنها تصبح عرضة لهيمنة غير مباشرة لا تختلف في جوهرها عن التبعية الكلاسيكية للموارد، لكنها أكثر تعقيداً وأشد خطورة.
الأبعاد الأخلاقية والسياسية
كما أوضحت شوشانا زوبوف (2019)، فإن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على كونه أداة تقنية، بل يتجاوز ذلك ليحوّل التجربة الإنسانية ذاتها إلى سلعة. فعملية جمع البيانات المستمرة لم تعد مجرد نشاط محايد، بل أضحت وسيلة لتوجيه السلوكيات البشرية وتحويلها إلى مصدر دائم للربح. ببساطة، يمكن القول إن الحرية الفردية أصبحت خاضعة لشكل جديد من الرقابة غير المرئية، وإن الاستقلال الذاتي يتعرض لتآكل مستمر بفعل هذه الآليات.
في هذا السياق، لم يعد العامل مجرد قوة عمل تُباع وتُشترى كما كان في الأنماط التقليدية للرأسمالية. بل تحوّل وعيه نفسه، أي تجربته الحياتية واليومية، إلى مادة أولية للاستغلال. هنا نصل إلى ما يمكن اعتباره أقصى مراحل التشييء، حيث لم تعد السلع تقتصر على المنتجات المادية أو حتى على العمل البشري المباشر، بل امتدت لتشمل تفاصيل الحياة اليومية ذاتها: من أنماط الاستهلاك إلى الانفعالات والمشاعر، التي تُحوَّل جميعها إلى عناصر في عملية التراكم الرأسمالي. يمكن تشبيه ذلك بآلة عملاقة لا تكتفي بابتلاع الوقت والجهد، بل تلتهم أيضاً ما هو شخصي وحميمي من حياة الإنسان.
إضافة إلى ذلك، تُدار الخوارزميات بوصفها “صناديق سوداء”. أي أن آليات اتخاذ القرار بداخلها تظل غامضة حتى بالنسبة إلى مطوريها أحياناً. هذا الغموض يمنح رأس المال حصانة شبه مطلقة من المساءلة، لأنه يصعّب على الأفراد والمجتمعات وحتى السلطات السياسية فهم كيف تُصنع القرارات أو تُوجَّه السلوكيات. وبذلك يصبح فرض الرقابة الاجتماعية والسياسية أمراً أقرب إلى المستحيل. إنها أشبه ما تكون بسلطة تعمل في الظل: لا تُرى ملامحها بوضوح، لكنها تؤثر بعمق في مسار الحياة اليومية وفي البنى الاجتماعية على حد سواء.
آفاق المستقبل
من الواضح أن الذكاء الاصطناعي، طالما ظل خاضعاً لسيطرة رأس المال، سيستمر في لعب دور أداة لتكثيف الاستغلال وتعميق التفاوت الاجتماعي. ببساطة، هذا يعني أننا سنشهد المزيد من البطالة، والمزيد من الأزمات الاقتصادية الدورية، فضلاً عن تفاقم الاحتكارات العابرة للحدود التي تحتكر المعرفة والبيانات والبنى التحتية. يمكن القول إن المستقبل، في هذا المسار، لن يكون سوى إعادة إنتاج لأشد تناقضات الرأسمالية، ولكن على نطاق رقمي أكثر اتساعاً.
ومع ذلك، ثمة وجه آخر محتمل. فالذكاء الاصطناعي يمكن أن يتحول إلى أداة تحرر إذا ما خضع لسيطرة اجتماعية وديمقراطية. في هذه الحالة، يصبح بالإمكان استخدامه لتقليص وقت العمل الضروري وتحرير البشر من قيود العمل المأجور. تخيّل على سبيل المثال مجتمعاً تُدار فيه التكنولوجيا ليس بهدف تعظيم الأرباح، بل من أجل تنظيم العمل بما يضمن تلبية الحاجات الإنسانية الفعلية. عندها، يمكن أن يفتح الذكاء الاصطناعي الطريق نحو ما يمكن وصفه بـ “مجتمع ما بعد القيمة التبادلية”، حيث لا يُنظر إلى الإنسان باعتباره وسيلة إنتاج، بل يُعاد تعريف العمل ذاته بوصفه نشاطاً اجتماعياً يهدف إلى تحقيق الرفاه الجماعي.
الخاتمة
يكشف تحليل الذكاء الاصطناعي من منظور ماركسي أنه لا يمكن النظر إليه بوصفه مجرد أداة تقنية محايدة، بل باعتباره آلية جوهرية في إعادة إنتاج التراكم الرأسمالي. فالذكاء الاصطناعي، ببساطة، يضاعف من فائض القيمة، ويوسّع من أشكال التشييء، ويعيد إنتاج الاحتكار بطرق أكثر تعقيداً. لكنه، في الوقت نفسه، يفضح تناقضات النظام ويُظهر نقاط ضعفه، بل ويكشف أيضاً عن إمكانيات المقاومة وتجاوز الوضع القائم.
في هذا السياق، يبرز سؤال مركزي لا يمكن تجاهله: من يسيطر على الذكاء الاصطناعي؟ ولصالح من يُستخدم؟ هذا السؤال ليس تفصيلاً تقنياً، بل هو جوهر الصراع حول شكل المستقبل. فالإجابة عنه ستحدد المسار: إما استمرار الرأسمالية الرقمية في إعادة إنتاج احتكاراتها وتعميق أزماتها، أو فتح أفق جديد لتحرر الإنسان من قيود العمل المأجور، حيث يصبح الذكاء الاصطناعي وسيلة لتوسيع الحرية الإنسانية بدلاً من تكبيلها.