عند محاولة فهم طبيعة السلطة في العراق بعد عام 2003، لا يكفي الاكتفاء بالمقاربات السياسية الضيقة التي ترى في التحول مجرد انتقال من حكم ديكتاتوري استبدادي إلى نظام ديمقراطي ليبرالي كما سوّق له الخطاب الرسمي. فالمسألة أكثر تعقيداً وتشابكاً، إذ أن ما جرى لم يكن ولادة دولة جديدة، بل إعادة إنتاج لنمط سلطوي تابع قائم على اقتصاد ريعي–كومبرادوري مشوّه، يشطر المجتمع ويقيده ضمن دائرة التبعية. إن النفط، الذي كان منذ منتصف القرن العشرين ركيزة الاقتصاد الوطني، تحوّل بعد الاحتلال الأميركي إلى الآلية المركزية لإعادة إنتاج السلطة نفسها، لا كأداة للتنمية أو بناء قاعدة إنتاجية، بل كسلاح سياسي لإدارة الولاءات وشراء الصمت الاجتماعي. هكذا انتقل العراق من وهم الدولة الوطنية الحديثة إلى واقع دولة محاصصة، تتقاسم فيها النخب الطائفية والإثنية العوائد والسلطة عبر قنوات زبائنية فاسدة.
لم يكن هذا النظام امتداداً طبيعياً للتاريخ العراقي، بل صناعة مقصودة فرضتها تركة الدكتاتورية ولحظة الاحتلال وما تلاها من إعادة تشكيل للسلطة عبر مجلس الحكم الانتقالي. هنا جرى إعلاء الانتماء الهوياتي على حساب المواطنة، وتحويل الطوائف والإثنيات إلى وحدات سياسية تتقاسم المواقع السيادية والبرلمانية. وبدلاً من أن تتبلور هوية طبقية قادرة على مواجهة بنية النهب والاستغلال، تم تفتيت المجتمع إلى جماعات متنازعة، كل منها يسعى وراء حصته من الريع، فيما ظلت الطبقة الطفيلية البيروقراطية–الزبائنية ممسكة بخيوط السلطة، متكئة على حماية مزدوجة من واشنطن وطهران.
بهذا الشكل، لم تكن السلطة العراقية بعد 2003 سلطة ذات سيادة فعلية، بل سلطة هجينة تعكس توازنات القوى الإقليمية والدولية أكثر مما تعبّر عن موازين الداخل. الانتخابات الدورية لم تفضِ إلى تداول حقيقي للسلطة أو إلى شرعية مستندة إلى قاعدة اجتماعية، بل بقيت أداة لتدوير النخب نفسها وتحصين نظام المحاصصة. وبينما يتحدث الخطاب الرسمي عن “العملية السياسية” كإنجاز.
هذه البنية المعطوبة لم تكن لتستمر بلا ثمن. ومع تراكم التناقضات اتسعت فجوة الشرعية، حتى بلغت ذروتها في تشرين 2019. فانتفاضة تشرين لم تكن مجرد احتجاج عابر على تردي الخدمات أو مطلباً جزئياً بالإصلاح، بل كانت تعبيراً عن سخط تاريخي على منظومة ريعية–طائفية–تابعة فقدت أي قدرة على التبرير أو الإقناع. الشباب الذين خرجوا إلى الشوارع لم يولدوا إلا في ظل هذا النظام، ولم يعرفوا الدولة إلا كأداة للنهب والقمع وتوزيع الغنائم. لذلك كانت صرختهم رفضاً جذرياً لبنية السلطة نفسها، ومحاولة لاستعادة المواطنة من أنياب الطائفية والمحاصصة.
من هنا، يمكن القول إن انتفاضة تشرين مثلت لحظة كاشفة: هي الانتفاضة التي جسّدت التناقضات البنيوية للنظام، لكنها في الوقت ذاته انتفاضة مؤجَّلة. مؤجَّلة بمعنى أنها عبّرت عن وعي احتجاجي متفجر لم يكتمل بعد في صورة مشروع بديل منظم وقادر على تجاوز الفوضوية السياسية التي ميّزت حراكها الأولي. غير أن هذا النقص لا يلغي حقيقتها، بل يؤكد ضرورتها التاريخية، ويجعل منها علامة فارقة في مسار الصراع الاجتماعي–السياسي في العراق. فالانتفاضة لم تكن حدثاً عارضاً، بل نتيجة حتمية لتراكم التناقضات بين وعود الديمقراطية الليبرالية الموعودة وواقع التبعية والنهب، وهي بهذا المعنى تفتح الباب نحو أفق جديد لتجاوز حدود العفوية، وتؤشر إلى الحاجة الملحة لبناء بديل ثوري قادر على تحويل الاحتجاج إلى مشروع تحرر اجتماعي منظم.
العوامل الذاتية والموضوعية المؤدية إلى انتفاضة تشرين 2019
من البديهي أن أي انتفاضة جماهيرية لا تنشأ من فراغ. فالحركات الاجتماعية الكبرى عادة ما تكون حصيلة تراكم طويل من الأزمات والتناقضات، إلى جانب تبلور وعي جمعي جديد قادر على تحويل هذه الأزمات إلى فعل احتجاجي منظم. انتفاضة تشرين كانت التعبير الأكثر جلاءً عن هذه الجدلية: اجتماع الشرط الموضوعي الذي وفّر الوقود المادي للحراك، مع الشرط الذاتي الذي عبّر عن وعي الفاعلين وقدرتهم على تحويل الغضب إلى قوة جماهيرية واسعة.
لا يمكن تفسير تشرين فقط بالأزمات الاقتصادية أو الاجتماعية، تماماً كما لا يمكن ردّها إلى مجرد حماسة شبابية عابرة. بل يجب النظر إليها بوصفها ثمرة تضافر العوامل الموضوعية والذاتية معاً: تناقضات النظام الريعي–الطائفي من جهة، وتطور أشكال الوعي والاحتجاج من جهة أخرى. بهذا المعنى، فإن تشرين لم تكن لحظة طارئة، بل ذروة مسار طويل من الاحتجاجات التي سبقتها في 2011 و2015، لكنها تجاوزتها من حيث الشمولية والحدة والرمزية.
العوامل الموضوعية
العوامل الموضوعية هي تلك الشروط المادية التي وفّرت الأرضية الصلبة لانفجار تشرين. إنها حصيلة عقود من السياسات الريعية–الطائفية، التي عمّقت التبعية الاقتصادية، وأنتجت فساداً ممنهجاً، وأفشلت قطاعات الخدمات الأساسية. هذه الشروط لا تخص لحظة تشرين وحدها، بل تمثل مساراً تاريخياً طويلاً من التراكمات التي جعلت من الانفجار الاجتماعي أمراً حتمياً.
الأزمة الاقتصادية والاعتماد شبه المطلق على النفط، الذي يشكل أكثر من 90% من موارد الدولة، خلق هشاشة بنيوية جعلت الاقتصاد رهينة لتقلبات السوق العالمية. ومع تفاقم البطالة، خصوصاً بين الشباب الذين يشكلون أكثر من نصف السكان، تحولت الأزمة الاقتصادية إلى قنبلة اجتماعية موقوتة. أضف إلى ذلك أن الفساد لم يعد مجرد حالات فردية، بل أصبح بنية ممنهجة لإدارة الدولة، حيث وُظّف الريع النفطي لإثراء النخب السياسية–الميليشياوية، فيما تُركت الجماهير دون أبسط الخدمات. هذا التناقض العنيف بين ثراء الأقلية الحاكمة وفقر الأغلبية الشعبية عزز الشعور بالظلم الطبقي، وكان بمثابة الوقود النفسي الذي غذى روح الانتفاض. فالناس لم يعودوا يرون في الدولة مؤسسة حيادية أو أداة لتوزيع الحقوق، بل شبكة فساد منظم تحكم قبضتها على مقدرات البلد.
كما أن الانهيار المستمر في قطاعات الكهرباء والماء والصحة والتعليم، رغم الإنفاق الهائل، كشف أن السلطة لم تكن معنية بتطوير بنية تحتية وطنية، بل كانت تسعى قبل كل شيء لتأبيد شبكاتها الزبائنية. كل هذه الأزمات تراكمت لتخلق إحساساً جماعياً بالعجز والإهانة، تعزّزه المفارقة المتمثلة في أن النظام الذي يرفع شعار “الديمقراطية” أعاد إنتاج الاستبداد بوسائل طائفية ومليشياوية. وهكذا وُضعت الطبقات الشعبية أمام خيارين: إما العيش في فقر وحرمان دائم، أو مواجهة سلطة لا يمكن إصلاحها من الداخل. في هذه اللحظة التاريخية، أصبح الانفجار الاجتماعي محتوماً.
اعتماد موارد العراق على النفط، وهو ما جعله أسير اقتصاد ريعي هشّ يقوم على التصدير الأحادي ولا يعرف الإنتاج الحقيقي أو التنويع. هذا الاعتماد المفرط لم يفتح أبواب التنمية، بل جعل البلاد رهينة لتقلبات أسعار السوق العالمية، أشبه بسفينة تتقاذفها أمواج لا سلطة لها عليها. وعندما انخفضت أسعار النفط في محطات مختلفة، كان أثرها مدمراً على الموازنة العامة وعلى معيشة الناس اليومية.
ومع تضاعف أعداد الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنوياً، تحولت الأزمة إلى قنبلة اجتماعية موقوتة. فمعدلات البطالة بين الشباب، الذين يشكلون أكثر من 60% من السكان، وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. الحكومة، بدلاً من أن تستثمر في قطاعات إنتاجية جديدة أو تبني مشاريع تنموية تخلق فرص عمل حقيقية، انكفأت إلى منطق الريع والتوزيع، معتمدة على التوظيف المؤقت أو العقود قصيرة الأمد كآلية لامتصاص السخط. هذه المعالجات لم تفعل سوى تأجيل الانفجار، إذ أبقت ملايين الشباب في حالة اغتراب اقتصادي واجتماعي، عاجزين عن المشاركة الفاعلة في إعادة بناء وطنهم. يمكن القول ببساطة إن الاقتصاد الريعي لم يُنتج سوى جيلٍ يشعر أنه بلا مستقبل.
يحتل العراق مراتب متقدمة بين دول العالم في مؤشرات الفساد، لكن المشكلة لم تعد محصورة في ممارسات فردية أو في بعض المسؤولين النافذين، بل تحولت إلى بنية كاملة لإدارة الدولة. فالفساد في العراق بعد 2003 أصبح منظومة حاكمة، تتغذى على الريع وتعيد إنتاج نفسها عبر المحاصصة. بمعنى آخر، لم يعد الفساد عَرَضاً، بل صار شرطاً بنيوياً لعمل السلطة.
قد تكون الكهرباء والماء والصحة والتعليم عناوين بسيطة للوهلة الأولى، لكنها في العراق تحولت إلى مؤشرات يومية لفشل الدولة. فمنذ 2003 وحتى اليوم، ورغم إنفاق ما يقارب مئات المليارات من الدولارات، لم تتحسن هذه القطاعات، بل تدهورت بصورة ممنهجة. الكهرباء مثال صارخ: ساعات الانقطاع الطويلة في بلد يطفو على بحر من النفط والغاز ليست مجرد صدفة أو تقصير إداري، بل انعكاس مباشر لبنية سلطة تضع النهب أولاً والخدمة أخيراً.
الأمر نفسه ينطبق على الصحة، حيث انهارت المستشفيات العامة وتراجع مستوى الرعاية، ما أجبر الفقراء على مواجهة المرض بلا حماية. التعليم أيضاً تراجع، فأصبح عبئاً على الأسر أكثر من كونه حقاً مضموناً. هذه الأزمات اليومية جعلت حياة الناس سلسلة لا تنتهي من المعاناة. إن المواطن الذي يبحث عن قطرة ماء نظيفة أو مقعد دراسي لابنه، ويُحرم منها رغم ثروة النفط الهائلة، لا بد أن يصل في النهاية إلى قناعة بأن النظام عاجز بنيوياً عن تلبية أبسط حقوقه. وهذا الوعي الملموس في تفاصيل الحياة اليومية كان أحد أهم محركات الغضب التشريني.
من الناحية الشكلية، يمتلك النظام العراقي دستوراً وانتخابات دورية ومؤسسات تشريعية، لكن الواقع الفعلي كان إعادة إنتاج للاستبداد عبر أدوات جديدة. فبدلاً من القمع المباشر الذي مارسته الديكتاتوريات السابقة، جاء الاستبداد هذه المرة مغلفاً بعباءة ديمقراطية شكلية. الممارسات اليومية للسلطة – من قمع الاحتجاجات، مروراً بتزوير الانتخابات، وصولاً إلى عسكرة المجتمع بالميليشيات – كشفت أن “العملية السياسية” ليست سوى واجهة لإدامة نفس البنية الريعية–الطائفية.
الجماهير العراقية جرّبت أكثر من مرة أن ترفع صوتها بالاحتجاج، كما في 2011 و2015، لكن الرد الرسمي كان دائماً القمع الوحشي. هذا التناقض بين خطاب الديمقراطية وواقع الاستبداد خلق شعوراً جماعياً بالإهانة: الناس يُطلب منهم المشاركة في الانتخابات، لكن أصواتهم لا تغيّر شيئاً؛ يُقال لهم إنهم يعيشون في نظام ديمقراطي، لكن الرصاص يستقبلهم في الشوارع إذا تظاهروا. هذا الوعي المزدوج، حيث الكذب الرسمي يتقاطع مع التجربة اليومية، كان بمثابة الشرارة النفسية التي مهّدت لانفجار تشرين 2019.
العوامل الذاتية
إلى جانب الشروط المادية التي راكمت أسباب الغضب، برزت العوامل الذاتية التي منحت الانتفاضة طابعها الخاص. فالأزمات وحدها لا تكفي لإشعال حركة اجتماعية بهذا الحجم، إذ تحتاج هذه الأزمات إلى وعي جمعي وأدوات تعبير وقدرة على التنظيم ولو بشكل أولي. هنا تكمن أهمية العوامل الذاتية التي سمحت بتحويل التناقضات البنيوية إلى حركة جماهيرية حقيقية.
انتفاضة تشرين لم تبدأ من العدم، بل استندت إلى رصيد احتجاجي تراكم عبر سنوات. الشباب الذين قادوا حراك 2019 كانوا قد خبروا محاولات سابقة في 2011 و2015، ورغم محدودية نتائجها، إلا أنها شكّلت مدرسة عملية للتنظيم والتجريب. تلك الخبرة السابقة هي التي جعلت تشرين أكثر نضجاً من حيث القدرة على الصمود وإنتاج أشكال احتجاج جديدة.
الحراك العراقي في 2011 تأثر بموجة “الربيع العربي”، ورفع شعارات تطالب بالإصلاح والخدمات. ثم جاء حراك 2015 ليضع شعار “محاربة الفساد” في قلب المشهد. هاتان المحطتان، رغم فشلهما في إحداث تغيير جذري، أفرزتا خبرة نضالية مهمة. تعلمت الجماهير أن السلطة لا تتردد في استخدام القمع، وأن الوعود الرسمية غالباً ما تكون فارغة. كما اكتشف المحتجون أهمية التنظيم الميداني للساحات، وأهمية الإعلام البديل في كسر الرواية الرسمية.
هذه الخبرات، وإن بدت متواضعة، تراكمت لتصبح جزءاً من ذاكرة جماعية. وعندما جاءت لحظة تشرين، لم يكن الشباب يبدؤون من الصفر، بل انطلقوا من تقاليد احتجاجية سبق أن اختبروها وطوروا عليها. يمكن القول إن تشرين كانت الابنة الشرعية لتجارب سابقة، لكنها الأكثر شمولاً وراديكالية.
الغالبية الساحقة من المشاركين في تشرين هم من جيل وُلد أو نشأ بعد الاحتلال الأميركي. هذا الجيل يختلف جذرياً عن الأجيال السابقة، فهو لا يحمل ذاكرة الحرب الطويلة مع إيران ولا تجربة الحصار القاسي في التسعينيات. تجربته الأساسية كانت مع “الديمقراطية الطائفية” نفسها. لذلك جاء وعيه أكثر تحرراً من إرث الخوف والإحباط، وأكثر جرأة في مواجهة السلطة.
بالنسبة لهذا الجيل، لم يعد النظام يُختزل في شخص أو حزب، بل في بنية كاملة من المحاصصة والفساد. رفضه كان شاملاً وجذرياً، يتجاوز المطالب الجزئية ليطال النظام برمته. بهذا المعنى، جيل ما بعد 2003 كان القوة النوعية التي منحت تشرين طابعها غير المسبوق: وعي جديد يرفض الخضوع للذاكرة المرهِقة ويطالب بفتح أفق مختلف كلياً.
لعبت التكنولوجيا الرقمية دوراً محورياً في التعبئة والتنسيق. عبر منصات مثل فيسبوك وتويتر وتلغرام، تمكن الشباب من نشر الدعوات للاحتجاج، تنظيم التظاهرات بشكل لامركزي، ونقل صور القمع والضحايا بسرعة فائقة. هذه الأدوات كسرت احتكار الدولة للإعلام الرسمي، وسمحت ببناء فضاء رمزي وطني بديل يتجاوز الانقسامات الطائفية.
الأهم من ذلك، أن هذه الوسائل لم تكن مجرد أدوات تقنية، بل فضاءً لولادة هوية جديدة. في ساحات التواصل ظهر خطاب يقول: “نحن عراقيون قبل كل شيء”، وهو خطاب يتجاوز الانقسام الطائفي ويفتح الطريق نحو وعي وطني جامع. بهذا المعنى، التكنولوجيا لم تُستخدم فقط كوسيلة، بل تحولت إلى جزء من البنية الثقافية والسياسية للانتفاضة.
انتفاضة تشرين لم تُعرّف نفسها فقط بالشعارات، بل أيضاً بالرموز الثقافية والفنية التي خلقتها. الأغاني الوطنية، الجداريات، المخيمات في ساحة التحرير ببغداد، كلها شكّلت فضاءً سياسياً–ثقافياً مختلفاً. هذه الثقافة الاحتجاجية جعلت السياسة تبدو كإبداع جماعي، لا كفعل حزبي تقليدي.
كان المشهد في الساحات مزيجاً من السياسة والفن، من الاحتجاج والاحتفال بالحياة. وهذا البعد الثقافي عزّز جاذبية الانتفاضة، وسمح لها باستقطاب فئات لم تكن منخرطة سابقاً في العمل السياسي. وهكذا، تحولت الساحات إلى مختبر حي لإعادة تعريف معنى السياسة في العراق: ليست مجرد صراع على السلطة، بل بحث عن معنى جديد للوطن.
التفاعل بين الموضوعي والذاتي
كل هذه العوامل الذاتية لم تكن لتنتج انتفاضة بحجم تشرين لولا التقاءها مع الشروط الموضوعية المتفاقمة. البطالة، الفساد، انهيار الخدمات، والقمع شكّلت الشرارة المادية. لكن لولا الوعي الجديد، والتجارب السابقة، والتكنولوجيا الحديثة، والثقافة الاحتجاجية، لبقيت هذه الشرارة مجرد غضب عابر.
التفاعل بين الشرطين هو ما جعل تشرين حدثاً نوعياً. فالحراك لم يكن مجرد رد فعل، بل كان انعكاساً لمسار طويل من التناقضات والوعي المتنامي. بهذا المعنى، تشرين لم تكن صدفة، بل لحظة تاريخية تكثفت فيها تناقضات النظام مع إمكانيات جيل جديد.
الأسباب الذاتية والموضوعية لانتكاس انتفاضة تشرين 2019
لا تُقاس أي انتفاضة جماهيرية بقدرتها على الانفجار وحده، بل أيضاً بمدى استمراريتها وقدرتها على تحقيق أهدافها. انتفاضة تشرين 2019، رغم عمقها الرمزي وتأثيرها السياسي والاجتماعي الكبير، انتهت إلى حالة من الانكفاء والانتكاس. هذا المسار لا يمكن تفسيره بعامل واحد، بل بجدلية معقدة جمعت بين أسباب موضوعية تتعلق ببنية السلطة والسياق الإقليمي–الدولي، وأسباب ذاتية تخص طبيعة الحراك نفسه، من حيث غياب القيادة وضعف الرؤية الثورية. بهذا المعنى، لم يكن إخفاق تشرين قدراً محتوماً، بل نتاجاً لتلاقي شروط تاريخية قاسية مع نواقص داخلية لم يُستطَع تجاوزها.
الأسباب الموضوعية
إذا كانت العوامل الموضوعية قد وفّرت الأرضية لانطلاق تشرين، فهي أيضاً وضعت حدوداً قاسية أمام استمرارها. فالسلطة في العراق، ببنيتها الريعية–الطائفية، تملك أدوات متينة لإعادة إنتاج السيطرة: العنف الدموي الممنهج، القدرة على شراء السلم الاجتماعي عبر توزيع الريع، والارتباطات الإقليمية والدولية التي تحمي النظام من الانهيار الجذري. هذه العناصر مجتمعة شكّلت جداراً صلباً واجهته الانتفاضة، وأعاق تحولها إلى بديل سياسي شامل.
أبرز أدوات السلطة كان العنف. فمنذ الأيام الأولى، واجهت الأجهزة الأمنية والميليشيات الحراك بالرصاص الحي، القنابل الغازية، الاغتيالات، والاختطاف. تشير تقارير حقوقية إلى مئات القتلى وآلاف الجرحى والمعتقلين في الأشهر الأولى فقط. لم يكن هذا القمع عفوياً أو رد فعل متسرع، بل استراتيجية مدروسة هدفها إجهاض أي احتمال لتطور الانتفاضة إلى قوة سياسية قادرة على تهديد النظام. العنف هنا كان بمثابة رسالة مزدوجة: إخافة الجماهير من جهة، وإثبات جدية السلطة في الدفاع عن نفسها من جهة أخرى.
ورغم الحضور الجماهيري الكبير، بقيت الانتفاضة محصورة في أوساط الشباب الحضري، خصوصاً في بغداد والبصرة والناصرية. الطبقات العاملة المنظمة، كعمال النفط مثلاً، لم تنخرط بشكل حاسم، والفلاحون ظلوا على هامش المشهد. هذا الغياب للقاعدة الطبقية المنظمة جعل الانتفاضة تفتقر إلى السلاح التاريخي الأكثر فعالية: الإضراب العام والعصيان الاقتصادي. فبدون مشاركة الطبقات المنتجة، بقي الحراك في حدود الضغط الاحتجاجي، دون أن يتحول إلى قوة قادرة على شل الدولة وإعادة صياغة التوازنات.
العراق، بطبيعته الجيوسياسية، ساحة تنافس بين الولايات المتحدة وإيران. كلا الطرفين لم يكن معنيّاً بانتفاضة شعبية تهدد النظام القائم. إيران رأت في تشرين خطراً مباشراً على نفوذها، فتدخلت بميليشياتها لقمع الحراك بدموية. أما الولايات المتحدة، فرأت أن بقاء النظام الحالي – مهما كان فاسداً – أفضل من انفلات الوضع نحو المجهول، فاكتفت بالمراقبة والتصريحات الفارغة. هذا التواطؤ الضمني بين القوى الإقليمية والدولية جعل من الصعب على الانتفاضة أن تجد سنداً خارجياً أو حتى حياداً يسمح لها بالتمدد.
الاقتصاد الريعي، رغم أنه سبب رئيسي للغضب، كان في الوقت نفسه أداة لامتصاصه. السلطة لجأت إلى توزيع بعض الوظائف المؤقتة، إطلاق وعود بالتعيينات، وتقديم منح مالية محدودة. هذه الإجراءات الترقيعية عملت كـ”مخدر” اجتماعي يخفف من زخم الاحتجاج دون أن يعالج أسبابه. الريع هنا لعب دور الصمام الذي يحول دون تحوّل الأزمة إلى انهيار شامل، ولو بشكل مؤقت. وهكذا، ظل النظام قادراً على شراء السلم الاجتماعي بما يكفي لإضعاف دينامية الانتفاضة.
الأسباب الذاتية
لكن الموضوعية وحدها لا تفسر الانتكاس. فقد كشفت تشرين عن نواقص ذاتية في بنيتها الداخلية. أبرزها غياب القيادة الثورية القادرة على توحيد الطاقات وتوجيهها، وغياب الرؤية السياسية والاقتصادية البديلة. العفوية، رغم نقاوتها، لم تستطع أن تعوض غياب التنظيم والبرنامج. وهذا ما جعل الحراك عرضة للفوضى، والاختراق، والاستنزاف.
الانتفاضة لم تنشأ في إطار حزبي أو تنظيمي، بل كحركة شبابية–مدنية عفوية. هذا ما منحها زخمها الأولي، لكنه أيضاً جعلها مفتقرة إلى جهاز قادر على صياغة أهداف واضحة أو اتخاذ قرارات استراتيجية. كل مجموعة محلية كانت تعمل بشكل مستقل، مما أدى إلى تشتت الجهود وغياب التماسك الوطني. وعندما جاء القمع الممنهج، لم يكن هناك إطار مركزي يضع خطط دفاعية أو بدائل استراتيجية. النتيجة كانت انكشاف الساحات وتراجع القدرة على الصمود.
أحزاب اليسار العراقي، التي كان من الممكن أن توفر إطاراً أيديولوجياً وتنظيمياً، لم تكن في موقع يؤهلها لقيادة الحراك. بعضها غرق في البيروقراطية أو التبعية للسلطة، وبعضها الآخر بقي ضعيف التأثير ومجزأ. هذا الغياب جعل الانتفاضة تتحرك بلا سند فكري–تنظيمي قادر على تحويلها إلى مشروع تاريخي.
العفوية كانت قوة لأنها سمحت للحراك بالانطلاق بحرية من دون قيود حزبية. لكنها كانت أيضاً حدوداً قاتلة، لأن غياب التنسيق جعل القرارات عشوائية والفعاليات غير متسقة. حتى الشعارات، رغم قوتها الرمزية، بقيت بلا برنامج عملي. ومع تصاعد القمع، ظهر أن العفوية وحدها لا تصنع ثورة.
أحد أبرز أوجه القصور كان غياب أفق سياسي واضح. الشعارات مثل “نريد وطن” أو “إسقاط النظام” كانت قوية ومؤثرة، لكنها لم تترجم إلى تصور ملموس حول طبيعة الوطن المنشود أو شكل النظام البديل. لم يكن هناك برنامج اقتصادي بديل للريع، ولا خطة لبناء دولة مواطنة حقيقية. هذا الغياب جعل الانتفاضة عرضة للاستنزاف والاختراق من قوى إصلاحية أو انتهازية.
يمكن القول إن انتكاس تشرين جاء من التقاء عاملين: سلطة ريعية–طائفية مسنودة بالعنف والتبعية، وحراك جماهيري فاقد للقيادة والبرنامج. الشرعية الشعبية كانت في صف الانتفاضة، لكن القوة السياسية–الطبقية بقيت في يد السلطة. ومع ذلك، لم يذهب الحراك سدى، إذ كشف عجز النظام وترك وراءه وعياً جديداً لن يُمحى بسهولة.
الفوضوية وعدم التنظيم في انتفاضة تشرين 2019
من أبرز السمات التي ميّزت انتفاضة تشرين كانت الفوضوية وغياب التنظيم المركزي. هذا العامل، على الرغم من أنه أضفى على الحراك شيئاً من الحيوية والحرية، كان في الوقت نفسه سبباً رئيسياً في محدودية أثره النهائي. فأي حركة احتجاجية تحتاج، حتى تستمر وتتحول إلى قوة تغيير حقيقية، إلى تنظيم داخلي وهيكلية واضحة تسمح بتوجيه الطاقات الجماهيرية. غياب هذا التنظيم جعل تشرين أقرب إلى موجة عاطفية ضخمة، قادرة على هز أركان النظام، لكنها عاجزة عن تثبيت نفسها كقوة تاريخية مستدامة.
الفوضوية في تشرين لم تكن مجرد غياب للتنظيم، بل كانت أحياناً خياراً واعياً من قبل المحتجين الذين رفضوا كل أشكال القيادة المركزية. الساحات امتلأت بمجموعات شبابية مستقلة، تتحرك من مكان إلى آخر، تبتكر شعارات وجداريات وأساليب تعبير جديدة. هذه العفوية أضفت على الانتفاضة طابعاً إبداعياً وجاذبية خاصة، إذ شعر المشاركون أنهم يصنعون تجربة حية خارج أطر السياسة التقليدية. لكن الوجه الآخر لهذه الفوضوية كان خطيراً: غياب خطة موحدة، تكرار الجهود، وتشتت المبادرات. النتيجة كانت أن السلطة وجدت في هذا التفتت فرصة لتفكيك الحراك عبر القمع أو عبر استنزافه تدريجياً.
حاولت بعض “التنسيقيات” المحلية في بغداد والبصرة والناصرية أن تؤدي دوراً تنظيمياً، لكنها بقيت محدودة التأثير، بلا سلطة مركزية أو آليات إلزامية. كل تنسيقية عملت كجزيرة منفصلة، ما جعل القرارات غير منسقة. فمرة تُعلن التظاهرة في توقيت محدد، ومرة أخرى في توقيت متضارب مع مدينة أخرى. النتيجة كانت ازدواجية الجهود وغياب التأثير المركّز. هذا الضعف البنيوي جعل من السهل على الدولة أن تتلاعب بالمشهد، سواء من خلال التشويه الإعلامي أو عبر تقديم تنازلات موضعية لامتصاص الغضب في مدينة ما، بينما تُبقي القبضة الحديدية في مدينة أخرى.
ارتبطت فوضوية تشرين بخيار اللاعنف الذي تبناه المحتجون. صحيح أن الطابع السلمي منح الانتفاضة شرعية أخلاقية وجعلها محط تعاطف واسع، لكنه مع الفوضوية كشف عن نقطة ضعف مزدوجة. فالنظام واجه الساحات بالعنف الممنهج، بينما لم تكن لدى المحتجين أدوات تصعيد ذكية مثل العصيان المدني المنظم، الإضرابات الشاملة، أو السيطرة الرمزية على البنى التحتية. غياب هذه الأدوات جعل الاحتجاج محصوراً في الساحات العامة، دون أن يتحول إلى ضغط اقتصادي أو سياسي عميق.
غياب التنظيم انعكس مباشرة على استدامة الحراك. فمع مرور الأشهر، بدأت المبادرات الفردية تتراجع، وتقلصت القدرة على تعبئة جماهيرية واسعة. لم يكن هناك جهاز تنظيمي يضمن استمرارية الزخم أو ينظم عملية التفاوض مع السلطة. وهكذا، أخذت الانتفاضة تفقد تدريجياً قوتها، حتى مع بقاء أسباب الغضب على حالها. يمكن القول إن الفوضوية حولت الحراك إلى نار كبيرة تشتعل بسرعة، لكنها تخبو بالسرعة نفسها.
الفوضوية لم تضعف فقط استدامة الانتفاضة، بل أثّرت أيضاً على غياب الرؤية الثورية. فالتنظيم المركزي هو ما يسمح ببلورة برنامج سياسي واقتصادي متكامل يربط بين المطالب اليومية والمشروع التاريخي للتغيير. غياب هذا الإطار جعل تشرين أكثر عرضة للاختراق، سواء من قبل قوى إصلاحية حاولت ركوب الموجة، أو من قبل الميليشيات التي سعت إلى تشويهها من الداخل. بهذا المعنى، الفوضوية لم تكن مجرد مشكلة تنظيمية، بل قيداً على إمكانية تطوير وعي استراتيجي متماسك.
أحد أبرز التعبيرات عن هذه الفوضوية كان رفع شعار “لا للأحزاب”. هذا الشعار جاء من عمق تجربة الشباب مع الطبقة السياسية التي تحولت إلى شبكة زبائنية فاسدة. بالنسبة للمحتجين، الأحزاب جميعها، سواء المشاركة في السلطة أو حتى تلك التي ادعت المعارضة، لم تعد تعبر عن مصالح الناس، بل عن مصالحها الضيقة. “لا للأحزاب” كان إذاً إعلان قطيعة مع السياسة التقليدية.
لكن هذه القطيعة، رغم رمزيتها، حملت معها مأزقاً. فرفض الأحزاب جميعاً دون تقديم بديل تنظيمي جعل الانتفاضة تفتقر إلى العمود الفقري الذي يمكن أن يحولها إلى مشروع سياسي مؤسسي. بهذا الشكل، تحول الشعار إلى قوة سلبية: فضح فساد الأحزاب، لكنه في الوقت نفسه أضعف قدرة الحراك على بناء أدوات بديلة للعمل الجماعي.
رغم كل سلبياتها، لا يمكن النظر إلى الفوضوية في تشرين بمنظار واحد. فقد منحت الانتفاضة مساحة واسعة للإبداع السياسي والثقافي، وأعطت للشباب فرصة لتجريب أشكال جديدة من التعبير الجماهيري. لكنها تظل، في النهاية، قوة مؤقتة لا يمكن أن تحل محل التنظيم والقيادة. إن التجربة التشرينية تُظهر أن العفوية قادرة على إشعال الشرارة، لكنها لا تكفي وحدها لإبقاء النار مشتعلة. الدرس هنا واضح: الغضب لا يصنع ثورة مستدامة ما لم يترافق مع أدوات تنظيمية ورؤية سياسية واضحة.
نتائج وعبر
إحدى الحقائق البارزة التي كشفتها انتخابات ما بعد تشرين، هي أن القوى أو الأفراد الذين ارتبطوا مباشرة بالانتفاضة – سواء من خلال شعاراتها أو عبر تمثيل رمزي لها – تمكنوا من حصد ما يقارب خمسين مقعداً في البرلمان. هذا الرقم لم يكن عادياً، إذ يفوق بأضعاف ما حصلت عليه القوى المدنية واليسارية التقليدية ذات الخبرات والامكانيات الفكرية والتنظيمية والسياسية كما تدعي، والتاريخ الطويل في العمل السياسي. النتيجة هنا بالغة الدلالة: فقاعدة تشرين الجماهيرية، رغم طابعها الجديد والعفوي، أثبتت أنها أوسع وأعمق من كل ما راكمته القوى المدنية واليسارية خلال عقود.
ببساطة، ما حصل يعني أن الجماهير التي خرجت إلى الشارع لم تكن تفتقر إلى الوعي أو الرغبة في التغيير، بل على العكس، كانت تبحث عن تمثيل جديد يعبّر عنها. في المقابل، كشفت النتائج أن القوى المدنية واليسارية، التي كان من المفترض أن تكون حاملة لهذا الوعي الشعبي، عانت من حالة تكلّس فكري وتنظيمي وسياسي جعلها عاجزة عن استثمار اللحظة التاريخية. هذه القوى بدت وكأنها تقف خارج الزمن، عاجزة عن التواصل مع الطاقة الجديدة التي ولّدتها الساحات.
بهذا المعنى، فإن انتفاضة تشرين لم تكشف فقط أزمة النظام الطائفي–الريعي الحاكم، بل كشفت أيضاً أزمة القوى المدنية واليسارية التقليدية التي ادعت معارضة هذا النظام. ظهر القصور بوضوح في قدرتها على الانفتاح على جيل جديد من الشباب، أو في تطوير أدوات تنظيمية عصرية تتناسب مع طبيعة الحراك. بدلاً من أن تكون جسراً بين الوعي الشعبي والمشروع السياسي، بقيت هذه القوى أسيرة خطابات تقليدية وهياكل مترهلة.
وهكذا، يمكن القول إن تشرين وضعت الجميع أمام امتحان: النظام الحاكم الذي أظهر وجهه الدموي والفاسد، والقوى المدنية واليسارية التي انكشفت حدودها التاريخية وحجمها الحقيقي. وبينهما برزت الجماهير كفاعل جديد يبحث عن لغة بديلة، وعن أطر تنظيمية لم تولد بعد.
في سبيل انتفاضة حقيقية: دروس مستفادة من تشرين 2019
تكشف تجربة تشرين أن الغضب الشعبي، مهما كان واسعاً وعميقاً، لا يكفي وحده لتغيير البنى الراسخة للسلطة. العفوية، رغم طاقتها الأخلاقية والرمزية الهائلة، تظل عاجزة عن تعويض غياب التنظيم والقيادة والرؤية. الانتفاضة، لكي تصبح قوة تاريخية، تحتاج إلى أعمدة أربعة: قيادة جماعية تعبّر عن إرادة الساحات، برنامج سياسي–اقتصادي واضح، تحالفات اجتماعية واسعة، ووعي ثوري قادر على مواجهة السلطة بما يتجاوز الاحتجاج الأخلاقي.
ضرورة التنظيم السياسي والقيادة الجماعية
أثبتت تشرين أن غياب القيادة لا يعني الحرية، بل الضعف. الانتفاضة الحقيقية تحتاج إلى تنظيم قادر على قيادتها في لحظتها التاريخية، ويعكس التنوع الداخلي للحراك. القيادة هنا لا تعني سلطة فوقية أو فرداً يقرّر باسم الجميع، بل إطاراً جماعياً ينسّق التحركات، يوحّد المطالب، ويحوّل الطاقات المتفرقة إلى قوة مركّزة.
القيادة الجماعية قادرة على صياغة أهداف استراتيجية، بناء تحالفات، وتطوير أدوات مقاومة كالعصيان المدني والإضرابات العامة. وبدونها، يبقى الحراك عرضة للتشتت والامتصاص. التجربة التشرينية كشفت أن السلطة نجحت في قمع الساحات جزئياً لأنها واجهت حركة بلا رأس، بلا جهاز قادر على اتخاذ قرارات حاسمة.
صياغة برنامج سياسي واقتصادي واضح
الشعارات القوية مثل “نريد وطن” أو “إسقاط النظام” وحّدت الجماهير، لكنها لم تقدّم بديلاً عملياً. أي انتفاضة تحتاج إلى برنامج يجيب عن أسئلة جوهرية: كيف يُدار النفط؟ كيف تُبنى دولة مواطنة خارج المحاصصة؟ كيف يتحوّل الريع إلى استثمار في التنمية؟
البرنامج ليس وثيقة نظرية فقط، بل أداة للتعبئة وبناء الثقة بين مختلف الفئات الاجتماعية. اقتصاد منتج يقلل من الاعتماد على النفط، دولة مؤسسات شفافة، وآليات واضحة لمحاسبة النخب الفاسدة، كلها عناصر يمكن أن تشكّل قاعدة لمشروع بديل. غياب هذا البرنامج جعل تشرين عرضة للتفكك أمام القمع والوعود الكاذبة.
بناء تحالفات اجتماعية استراتيجية
الحركات الشعبية الكبرى لا تنتصر إلا حين تمتد جذورها في أكثر من طبقة وفئة. انتفاضة تشرين، رغم قوتها، بقيت أسيرة الشباب الحضري. المطلوب هو ربط هؤلاء الشباب بالطبقات الكادحة الأخرى: العمال، الفلاحون، النقابات المهنية، والموظفون. هذه التحالفات يمكن أن تمنح الانتفاضة عمقاً طبقياً، وتحوّلها من حراك احتجاجي إلى مشروع تاريخي قادر على شل الدولة عبر الإضرابات والعصيان المدني.
التحالفات أيضاً يجب أن تراعي التنوع الاجتماعي والاقتصادي في العراق، بحيث تشمل الريف والمدينة، المرأة والشباب، العاطلين والطبقات الوسطى. بهذا الشكل، يصبح الحراك أكثر تجذراً وأصعب على السلطة في احتوائه أو قمعه.
تعزيز الوعي الثوري والإيديولوجي
الوعي الجماهيري بحاجة لأن يتجاوز حدود السخط الأخلاقي إلى فهم جذور الظلم. الانتفاضة تحتاج إلى خطاب يربط بين فساد النخب وبنية النظام الريعي–الطائفي، بين أزمة الخدمات والتبعية الاقتصادية، بين القمع المحلي والتدخلات الخارجية. هذا الوعي لا يتكوّن عفوياً، بل يحتاج إلى نقاشات مفتوحة، تعليم سياسي، وإعلام مستقل.
بدون وعي ثوري، يصبح الحراك عرضة للاختراق أو الانحراف. أما بوجوده، فإنه يتحول إلى مدرسة جماعية تربي أجيالاً على التفكير النقدي والعمل الجماعي.
دمج الثقافة الاحتجاجية مع الاستراتيجية
أحد أهم إنجازات تشرين كان خلق ثقافة احتجاجية ثرية: الأغاني، الجداريات، المخيمات، وحتى شعارات الشوارع. لكن هذه الثقافة، رغم قوتها الرمزية، بقيت منفصلة عن استراتيجية سياسية واضحة. الانتفاضة القادمة تحتاج إلى دمج الاثنين: تحويل الفضاء الفني والثقافي إلى أداة للتعبئة المستمرة، وإلى رمز يقترن بخطط عملية للتغيير. حينها تصبح الثقافة الاحتجاجية ليست مجرد زخرف، بل جزءاً عضوياً من النضال السياسي.
تشرين 2019 كانت مدرسة تاريخية. الدرس الأول: الغضب لا يكفي دون تنظيم. الدرس الثاني: العفوية تحتاج إلى قيادة جماعية. الدرس الثالث: أي انتفاضة تحتاج إلى برنامج بديل وتحالفات اجتماعية واسعة. الدرس الرابع: الثقافة الاحتجاجية تصبح قوة فعلية فقط حين تندمج في استراتيجية سياسية. إذا جرى استيعاب هذه الدروس، فإن أي انتفاضة قادمة لن تكون مجرد شرارة عابرة، بل قوة تاريخية قادرة على تغيير مسار العراق.
نتائج وعبر
إحدى الحقائق البارزة التي كشفتها انتخابات ما بعد تشرين، هي أن القوى أو الأفراد الذين ارتبطوا مباشرة بالانتفاضة – سواء من خلال شعاراتها أو عبر تمثيل رمزي لها – تمكنوا من حصد ما يقارب خمسين مقعداً في البرلمان. هذا الرقم لم يكن عادياً، إذ يفوق بأضعاف ما حصلت عليه القوى المدنية واليسارية التقليدية ذات الخبرات والامكانيات الفكرية والتنظيمية والسياسية كما تدعي، والتاريخ الطويل في العمل السياسي. النتيجة هنا بالغة الدلالة: فقاعدة تشرين الجماهيرية، رغم طابعها الجديد والعفوي، أثبتت أنها أوسع وأعمق من كل ما راكمته القوى المدنية واليسارية خلال عقود.
ببساطة، ما حصل يعني أن الجماهير التي خرجت إلى الشارع لم تكن تفتقر إلى الوعي أو الرغبة في التغيير، بل على العكس، كانت تبحث عن تمثيل جديد يعبّر عنها. في المقابل، كشفت النتائج أن القوى المدنية واليسارية، التي كان من المفترض أن تكون حاملة لهذا الوعي الشعبي، عانت من حالة تكلّس فكري وتنظيمي وسياسي جعلها عاجزة عن استثمار اللحظة التاريخية. هذه القوى بدت وكأنها تقف خارج الزمن، عاجزة عن التواصل مع الطاقة الجديدة التي ولّدتها الساحات.
بهذا المعنى، فإن انتفاضة تشرين لم تكشف فقط أزمة النظام الطائفي–الريعي الحاكم، بل كشفت أيضاً أزمة القوى المدنية واليسارية التقليدية التي ادعت معارضة هذا النظام. ظهر القصور بوضوح في قدرتها على الانفتاح على جيل جديد من الشباب، أو في تطوير أدوات تنظيمية عصرية تتناسب مع طبيعة الحراك. بدلاً من أن تكون جسراً بين الوعي الشعبي والمشروع السياسي، بقيت هذه القوى أسيرة خطابات تقليدية وهياكل مترهلة.
وهكذا، يمكن القول إن تشرين وضعت الجميع أمام امتحان: النظام الحاكم الذي أظهر وجهه الدموي والفاسد، والقوى المدنية واليسارية التي انكشفت حدودها التاريخية وحجمها الحقيقي. وبينهما برزت الجماهير كفاعل جديد يبحث عن لغة بديلة، وعن أطر تنظيمية لم تولد بعد.
في سبيل انتفاضة حقيقية: دروس مستفادة من تشرين 2019
تكشف تجربة تشرين أن الغضب الشعبي، مهما كان واسعاً وعميقاً، لا يكفي وحده لتغيير البنى الراسخة للسلطة. العفوية، رغم طاقتها الأخلاقية والرمزية الهائلة، تظل عاجزة عن تعويض غياب التنظيم والقيادة والرؤية. الانتفاضة، لكي تصبح قوة تاريخية، تحتاج إلى أعمدة أربعة: قيادة جماعية تعبّر عن إرادة الساحات، برنامج سياسي–اقتصادي واضح، تحالفات اجتماعية واسعة، ووعي ثوري قادر على مواجهة السلطة بما يتجاوز الاحتجاج الأخلاقي.
ضرورة التنظيم السياسي والقيادة الجماعية
أثبتت تشرين أن غياب القيادة لا يعني الحرية، بل الضعف. الانتفاضة الحقيقية تحتاج إلى تنظيم قادر على قيادتها في لحظتها التاريخية، ويعكس التنوع الداخلي للحراك. القيادة هنا لا تعني سلطة فوقية أو فرداً يقرّر باسم الجميع، بل إطاراً جماعياً ينسّق التحركات، يوحّد المطالب، ويحوّل الطاقات المتفرقة إلى قوة مركّزة.
القيادة الجماعية قادرة على صياغة أهداف استراتيجية، بناء تحالفات، وتطوير أدوات مقاومة كالعصيان المدني والإضرابات العامة. وبدونها، يبقى الحراك عرضة للتشتت والامتصاص. التجربة التشرينية كشفت أن السلطة نجحت في قمع الساحات جزئياً لأنها واجهت حركة بلا رأس، بلا جهاز قادر على اتخاذ قرارات حاسمة.
صياغة برنامج سياسي واقتصادي واضح
الشعارات القوية مثل “نريد وطن” أو “إسقاط النظام” وحّدت الجماهير، لكنها لم تقدّم بديلاً عملياً. أي انتفاضة تحتاج إلى برنامج يجيب عن أسئلة جوهرية: كيف يُدار النفط؟ كيف تُبنى دولة مواطنة خارج المحاصصة؟ كيف يتحوّل الريع إلى استثمار في التنمية؟
البرنامج ليس وثيقة نظرية فقط، بل أداة للتعبئة وبناء الثقة بين مختلف الفئات الاجتماعية. اقتصاد منتج يقلل من الاعتماد على النفط، دولة مؤسسات شفافة، وآليات واضحة لمحاسبة النخب الفاسدة، كلها عناصر يمكن أن تشكّل قاعدة لمشروع بديل. غياب هذا البرنامج جعل تشرين عرضة للتفكك أمام القمع والوعود الكاذبة.
بناء تحالفات اجتماعية استراتيجية
الحركات الشعبية الكبرى لا تنتصر إلا حين تمتد جذورها في أكثر من طبقة وفئة. انتفاضة تشرين، رغم قوتها، بقيت أسيرة الشباب الحضري. المطلوب هو ربط هؤلاء الشباب بالطبقات الكادحة الأخرى: العمال، الفلاحون، النقابات المهنية، والموظفون. هذه التحالفات يمكن أن تمنح الانتفاضة عمقاً طبقياً، وتحوّلها من حراك احتجاجي إلى مشروع تاريخي قادر على شل الدولة عبر الإضرابات والعصيان المدني.
التحالفات أيضاً يجب أن تراعي التنوع الاجتماعي والاقتصادي في العراق، بحيث تشمل الريف والمدينة، المرأة والشباب، العاطلين والطبقات الوسطى. بهذا الشكل، يصبح الحراك أكثر تجذراً وأصعب على السلطة في احتوائه أو قمعه.
تعزيز الوعي الثوري والإيديولوجي
الوعي الجماهيري بحاجة لأن يتجاوز حدود السخط الأخلاقي إلى فهم جذور الظلم. الانتفاضة تحتاج إلى خطاب يربط بين فساد النخب وبنية النظام الريعي–الطائفي، بين أزمة الخدمات والتبعية الاقتصادية، بين القمع المحلي والتدخلات الخارجية. هذا الوعي لا يتكوّن عفوياً، بل يحتاج إلى نقاشات مفتوحة، تعليم سياسي، وإعلام مستقل.
بدون وعي ثوري، يصبح الحراك عرضة للاختراق أو الانحراف. أما بوجوده، فإنه يتحول إلى مدرسة جماعية تربي أجيالاً على التفكير النقدي والعمل الجماعي.
دمج الثقافة الاحتجاجية مع الاستراتيجية
أحد أهم إنجازات تشرين كان خلق ثقافة احتجاجية ثرية: الأغاني، الجداريات، المخيمات، وحتى شعارات الشوارع. لكن هذه الثقافة، رغم قوتها الرمزية، بقيت منفصلة عن استراتيجية سياسية واضحة. الانتفاضة القادمة تحتاج إلى دمج الاثنين: تحويل الفضاء الفني والثقافي إلى أداة للتعبئة المستمرة، وإلى رمز يقترن بخطط عملية للتغيير. حينها تصبح الثقافة الاحتجاجية ليست مجرد زخرف، بل جزءاً عضوياً من النضال السياسي.
تشرين 2019 كانت مدرسة تاريخية. الدرس الأول: الغضب لا يكفي دون تنظيم. الدرس الثاني: العفوية تحتاج إلى قيادة جماعية. الدرس الثالث: أي انتفاضة تحتاج إلى برنامج بديل وتحالفات اجتماعية واسعة. الدرس الرابع: الثقافة الاحتجاجية تصبح قوة فعلية فقط حين تندمج في استراتيجية سياسية. إذا جرى استيعاب هذه الدروس، فإن أي انتفاضة قادمة لن تكون مجرد شرارة عابرة، بل قوة تاريخية قادرة على تغيير مسار العراق.
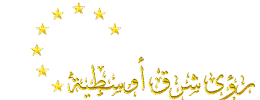


دراسة جيدة، ناقشت الأسباب الرئيسة لأزمة المجتمع العراقي، وعلى رأسها انحطاط الوعي الإجتماعي، والسياسي على الأخص الذي لا يمكنه تقديم رؤية ثقافية سياسية قادرة على صياغة برنامج سياسي يحدد مهمات واليت التغيير في المجتمع العرقي، وكذلك غياب القوة الحاملة لمهام التغيير، وعلى رأسها غياب الحزب السياسي أو القوى المجتمعية المدنية. شكراً
المقال يقدم قراءة معمّقة-لمفكر مشهود له- لبنية النظام السياسي العراقي بعد 2003، ويربط بين أزماته البنيوية وانتفاضة تشرين بوصفها نتيجة حتمية لهذه التراكمات. ورغم اتساع التحليل وتشعبه، تبقى خلاصته المركزية واضحة لنا كقُراء: لا يمكن لأي إصلاح جزئي أن ينجح ما دام الاقتصاد الريعي، والمحاصصة، وغياب السيادة، تشكل الإطار الحاكم للحياة السياسية. ولذلك تبدو تشرين، رغم انتكاستها، لحظة كاشفة لحدود النظام أكثر مما هي حدثاً عابراً.
دراسة رائعة بحجم الامل الذي اذكى قلوب الاحرار
دمت رائعا منصفا