لفهم ظاهرة الطائفية والمذهبية بدقة، علينا أولاً إزالة الالتباس الشائع بين مصطلحي “المذهب” و”الطائفة”. فالمسألة ليست مجرد اختلاف لغوي أو لاهوتي، بل قضية تحليلية أساسية، لأن الخلط بينهما لا يؤدي فقط إلى إرباك فكري، بل يعيق أيضاً فهم الكيفية التي تتشكل بها البنى الاجتماعية والسياسية، خاصة في المجتمعات التي لم تصل بعد إلى مرحلة الدولة الحديثة، أو ما زالت تمر بمرحلة انتقالية نحوها.
من منظور علم الاجتماع السياسي، يُنظر إلى المذهب باعتباره منظومة فكرية، عقائدية أو فلسفية، تنتمي إلى البنية الفوقية للمجتمع. هذه المنظومة تعبّر عن مصالح ورؤى طبقات أو فئات اجتماعية محددة في لحظة تاريخية معينة، حتى لو جاءت في صيغة خطاب ديني أو فلسفي.
أما الطائفة، فهي شكل من أشكال التنظيم الاجتماعي الملموس، ينتمي إلى البنية التحتية للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية، ويتفاعل مع مؤسسات الدولة، والسوق، وموازين القوى. وبذلك، فالطائفة ليست مجرد كيان فكري، بل جماعة اجتماعية لها مصالح وآليات عمل داخل الواقع المادي.
إن إدراك هذا التمييز، على بساطته، ضروري لتحليل الطائفية بوصفها ظاهرة اجتماعية وسياسية مشروطة بالظروف الاقتصادية والسياسية، لا مجرد تعبير عن انتماء مذهبي معزول عن سياقه الطبقي والتاريخي.
المذهب والمذهبية: من العقيدة إلى النسق التفسيري
في اللغة، المذهب مشتق من الفعل “ذهب”، ويعني الطريق أو المسار. واصطلاحاً، يشير إلى المنهج الذي يتبعه المفكر أو الفقيه أو الفيلسوف في تفسير العقيدة أو الدين أو الفلسفة.
من منظور علم الاجتماع السياسي، المذهب ليس مجرد آراء فكرية معزولة، بل هو منظومة فكرية متكاملة تنتمي إلى البنية الفوقية للمجتمع، وتعكس رؤية طبقية أو فئوية للعالم، حتى لو صيغت في قالب ديني أو فلسفي مجرد.
ومع مرور الزمن، قد تتحول هذه الآراء الفردية إلى مؤسسة فكرية لها قواعد وتقاليد وأدوات لإنتاج المعرفة، فتدخل ضمن منظومة الهيمنة الرمزية في المجتمع. وهنا، يمكن أن تصبح أداة في يد السلطة لترسيخ نفوذها، أو أداة بيد معارضيها لمواجهتها.
أما المذهبية، فهي الانتماء الواعي أو العاطفي إلى ذلك المذهب، والالتزام الإيديولوجي به. هي ليست مجرد قناعة فكرية، بل وعي جمعي يمكن أن يتحول إلى حركة اجتماعية منظمة، وفقاً لظروف الواقع المادي والسياسي. في هذه الحالة، يصبح الإيمان العقائدي موقفاً سياسياً وثقافياً، يتجاوز حدود التدين الفردي ليشكل طريقة محددة لفهم العالم وتحديد موقع الفرد أو الجماعة داخله.
الطائفة والطائفية: من الجماعة إلى الأيديولوجيا الاجتماعية
لغوياً، كلمة “طائفة“ تعني جزءاً من كل، أي جماعة بشرية فرعية تنتمي إلى جماعة أكبر. أما من الناحية الاجتماعية، فهي وحدة تضامن قائمة غالباً على أساس مذهبي أو ديني، لكن هذا التضامن لا يقتصر على العقيدة وحدها، بل يمتد ليشكل هوية جمعية متميزة. هذه الهوية تُبنى عبر مجموعة من العناصر المترابطة: الطقوس والشعائر التي تميزها، والذاكرة التاريخية التي تحفظ قصصها ورموزها، وشبكات الولاء والانتماء التي تنظم علاقات أفرادها ببعضهم وبالعالم الخارجي.
الطائفة كيان ذو طبيعة مزدوجة. فمن جهة، يمكن أن تكون ملاذاً يوفر الحماية والهوية والانتماء لأعضائها، خاصة في فترات الاضطراب أو انعدام الأمن. ومن جهة أخرى، قد تتحول إلى أداة لإعادة إنتاج أنماط الهيمنة الطبقية من خلال الولاءات ما قبل الوطنية، أي الولاءات التي تتشكل خارج إطار الدولة الحديثة ومفهوم المواطنة المتساوية.
هذه الطبيعة المزدوجة تجعل الطائفة كياناً قابلاً للتوظيف بطرق متناقضة: فهي قد تكون شبكة تضامن اجتماعي تمنح الأمان في أوقات الأزمات، لكنها أيضاً قد تصبح أداة في يد القوى السياسية والاقتصادية للتحكم في المجتمع عبر تقسيمه إلى جماعات متنافسة أو متناحرة.
أما الطائفية، فهي انتقال هذه الروابط والانتماءات من مستوى التضامن الاجتماعي البحت إلى مستوى الأيديولوجيا السياسية والاجتماعية. بمعنى آخر، تصبح الانتماءات الطائفية مورداً سياسياً أو اقتصادياً يُستثمر من أجل الحشد، أو الإقصاء، أو تحقيق مكاسب سلطوية.
ومن المهم التأكيد على أن الطائفية ليست نتيجة حتمية للإيمان الديني أو المذهبي، بل هي انعكاس لشروط مادية وسياسية واقتصادية محددة: ضعف الدولة الوطنية، انقسام السوق المحلي، عدم تكافؤ الفرص، وغياب العدالة في توزيع الموارد. هذه الشروط تخلق بيئة خصبة لتحويل الانتماء الطائفي من رابطة اجتماعية إلى أداة صراع.
بهذا المعنى، يمكن النظر إلى الطائفية كأحد أشكال الصراع الطبقي غير المباشر، حيث يتم توجيه التوترات الاجتماعية بعيداً عن جذورها الطبقية نحو ساحات الصراع الهوياتي. وهنا، تُستغل الهوية الطائفية لإعادة تشكيل الخريطة السياسية والاجتماعية بما يخدم مصالح فئات محددة، بدل أن تكون هذه الهوية مصدراً للتنوع الثقافي والتكامل المجتمعي.
الفرق بين المذهبية والطائفية
الفرق الجوهري بين المذهبية والطائفية يكمن في أن الأولى تمثل التزاماً عقلياً أو وجدانياً بفكرة أو تفسير معين، بينما الثانية تمثل انتماءً اجتماعياً إلى جماعة بشرية تحمل ذلك المذهب. المذهبية هي مسار تأويلي نحو الحقيقة، بينما الطائفية هي تموضع داخل هوية اجتماعية تستبطن ذلك المسار دون التفاعل النقدي معه.
المذهبية هي شعور بالإيمان بحقيقة ما، وبأن طريقاً محدداً في التفسير هو الطريق السليم للوصول إلى جوهر العقيدة داخل الدين الواحد. إنها التزام فكري ووجداني، يعبّر عن رغبة في التفاعل مع النصوص والتقاليد بوعي وإخلاص عقلي وروحي. بهذا المعنى، فإن المذهبية ليست مرتبطة بالضرورة بجماعة بشرية، بل قد تكون فردية في نزوعها، تقوم على قناعة عقلية أو وجدانية عميقة.
أما الطائفية، فليست انتماءً للفكرة ذاتها، بل للمجموعة البشرية التي تحمل تلك الفكرة. إنها انتماء إلى الحامل الاجتماعي للفكرة لا إلى مضمونها الفلسفي أو الروحي. وبذلك تكون الطائفية ضرباً من التضامن الاجتماعي مع الجماعة، قد لا يمر عبر بوابة القناعة العقائدية، بل يستند غالباً إلى روابط الدم أو الجغرافيا أو الحماية أو الخوف أو المصلحة، أو حتى التفاعل مع جماعة تمنح للفرد هوية وانتماءً ضمن واقع مأزوم أو مفكك.
الطائفية، إذاً، ليست حراكاً فكرياً، ولا هي بالضرورة نتيجة مشاعر وجدانية دينية، بل هي حراك اجتماعي، يشتغل داخل بنى الواقع، ويستمد فعاليته من موقعه ضمن شبكة العلاقات الاجتماعية والسياسية. لذا فإن الطائفية لا تسعى إلى الاجتهاد أو الحجاج أو التأمل في جوهر العقيدة، بل تُفعَّل غالباً في إطار التحشيد، بوصفها أداة لتوليد الولاء وخلق الاصطفافات والانقسامات داخل المجتمع.
فإذا كانت المذهبية خطاباً يتأسس في العقل والوجدان، فإن الطائفية خطاب يُنتَج في المجتمع ويُستثمر فيه. وإذا كانت الأولى تقوم على الاقتناع، فإن الثانية تنبني على الانتماء. ومن هنا يتضح أن الطائفي قد لا يكون مذهبياً، والمذهبي قد لا يكون طائفياً. والفرق هنا لا يتعلق بالمحتوى فقط، بل بنمط العلاقة مع ذلك المحتوى: علاقة تأمل ووعي في الحالة المذهبية، وعلاقة تضامن وتموضع اجتماعي في الحالة الطائفية.
جدلية العلاقة بين المذهب والطائفة
رغم التمايز الواضح بين المذهبية والطائفية، فإن العلاقة بينهما تاريخياً واجتماعياً ليست علاقة فصل حاد، بل علاقة مركبة تتسم بالتشابك وتبادل الأدوار وأحياناً التواطؤ غير المعلن. فالمذهبية، بصفتها نسقاً فكرياً وعقائدياً، لا تعيش في فراغ، بل تحتاج في كثير من الأحيان إلى حامل اجتماعي يحافظ على استمراريتها وينقلها عبر الأجيال. أما الطائفية، فهي تنظيم اجتماعي–سياسي يسعى دائماً إلى شرعنة وجوده واستدامة سلطته عبر استدعاء الرموز والمضامين المذهبية.
من جهة أخرى، توظف الطائفية المذهب لا من أجل تعميقه أو الدفاع عنه، بل كمظهر رمزي يضفي الشرعية على وجودها كجماعة اجتماعية. فهي تستخدم المذهب كوسيلة للتعبئة، دون الرجوع إلى جوهره أو الحرص على تمثيله تمثيلاً أميناً. وهكذا تصبح الطائفة واجهة اجتماعية للمذهب، لكنها لا تمثله فكرياً، بل تحتكره سياسياً.
العلاقة بين المذهب والطائفة تتغير تبعاً لموازين القوى. ففي فترات ازدهار الفكر المذهبي ووجود مساحة حرة للنقاش، تميل المذهبية إلى فرض استقلاليتها والحفاظ على بعدها المعرفي، محاولة توجيه الطائفية نحو الالتزام بالمبادئ الفكرية. أما في فترات الضعف أو الحصار، فقد تلجأ المذهبية إلى الاحتماء بالطائفية، حتى لو كان ذلك على حساب نقائها الفكري، لتأمين البقاء ومواجهة المخاطر. وفي الاتجاه المعاكس، حين تكون الطائفية في ذروة قوتها المادية والتنظيمية، قد تهمّش البعد المذهبي لصالح الاعتبارات السياسية والاقتصادية، وتحوّل المذهب إلى مجرد رمز تعبوي أو أداة لشرعنة سلطتها.
المذهبي، حين يعجز عن إقناع الآخر بحجته أو يُحاصر بفعل تطورات الواقع، قد يستدعي الطائفية كأداة للترهيب أو الترغيب، مستفيداً من قوة الجماعة في التحشيد أو فرض الهيمنة الثقافية، خاصة إذا وجد أن البعد الطائفي يمنحه تأثيراً جماهيرياً كان يفتقده. وهذا قد يكون نتيجة ضعف الموقف الفكري للمذهبي، أو نتيجة تعاظم الطائفية كقوة اجتماعية يصعب تجاوزها، وهي بدورها تسعى إلى توظيف المذهبية في خدمة مشروعها السياسي.
أما الطائفي، فإنه يوظف المذهب بطريقة معاكسة؛ إذ يجعل منه غطاءً رمزياً يخفي تحته أهدافاً سياسية واجتماعية تتعلق بالهوية والسلطة والموارد. الطائفي لا يسعى لتفسير العقيدة، بل لإعادة صياغة الواقع الاجتماعي بما يخدم مشروعه، مستخدماً الرموز المذهبية كأدوات سياسية. ولهذا، فإن أي مواجهة مع الطائفية قد تُفهم ضمنياً كتهديد للمذهب نفسه.
هذه الدينامية تجعل من الممكن الحديث عن شكل من التواطؤ التاريخي بين المذهب والطائفة، حتى في حالات التعارض. فكلاهما قد يجد في الآخر وسيلة لتحقيق أهدافه: المذهبية من أجل الحماية والانتشار، والطائفية من أجل الشرعية والتماسك. غير أن هذا التواطؤ ليس ثابتاً، بل يتبدل تبعاً للسياق التاريخي وطبيعة السلطة وشكل الصراعات التي يخوضها المجتمع.
الطائفية كظاهرة مشروطة بالواقع
الطائفية ليست نتيجة تطور طبيعي للمذهب أو لاحتياجات إيمانية ومعرفية، بل هي في جوهرها نتاج مباشر لشروط الواقع المادي والسياسي الذي تعيشه الجماعة. فهي تنشأ وتتغذى من اختلال البنية السياسية، وغياب الدولة الوطنية الجامعة، وضعف المؤسسات المدنية، وفشل المشروع الوطني في تحقيق العدالة والمساواة.
من منظور ماركسي، يمكن اعتبار الطائفية شكلاً من أشكال الوعي الزائف (False Consciousness)، إذ تُستبدل التناقضات الطبقية الحقيقية بصراعات تقوم على الهوية الأولية. وبهذا يتحول الصراع من مواجهة بين قوى اجتماعية حول الموارد والإنتاج، إلى مواجهة بين جماعات على أساس الانتماء الطائفي أو المذهبي. وهنا، تصبح الطائفة بديلاً عن الوطن، وإطاراً يوفر الحماية والهوية لأعضائها في مواجهة “الآخر” الذي يُقدَّم كتهديد وجودي.
لكن هذه الحماية ليست مجانية أو محايدة، فهي تؤسس لانقسامات عميقة داخل المجتمع. إذ تُبنى آليات ولاء وانتماء تتجاوز الدولة وتتنافس معها، مما يجعل الطائفية أداة مزدوجة: من جهة تمنح شعوراً بالأمان والتماسك لأعضائها، ومن جهة أخرى تعمّق الانغلاق والانقسام، وتعيد إنتاج الخوف من الآخر بشكل دائم.
ومن أخطر الآليات التي تكرّس الطائفية حتى في ظل أنظمة تدّعي الطابع الوطني، اعتماد تمثيل سياسي يقوم على الانتماءات الهوياتية، سواء كانت طائفية أو مذهبية أو إثنية. فعندما يُبنى التمثيل البرلماني أو الوزاري على أساس “تمثيل الطوائف” أو “حماية الأقليات”، يترسخ مفهوم أن الحقوق السياسية تُكتسب من خلال الانتماء الجماعي المغلق، لا من خلال المواطنة الفردية المتساوية.
ويزداد الأمر تعقيداً في حالة الأقليات، إذ يؤدي تخصيص حصص أو مقاعد لها على أساس هوياتي إلى تكريس عزلتها السياسية، بدل دمجها في الفضاء الوطني العام. كما يحولها ذلك إلى كتلة سياسية قائمة على منطق “الحماية” لا “المشاركة”، ويعزلها عن المساهمة في القوى الوطنية الجامعة، ويشرعن حصول ممثلي الطوائف على مكاسب سياسية استناداً إلى تمثيلهم الطائفي لا إلى برامج وطنية أو كفاءات شخصية.
الطائفية لا تُنتج خطابها من داخل الجماعة فقط، بل تستمد حيويتها من شبكة أوسع من العوامل: البنية الاقتصادية والسياسية، طبيعة النظام الحاكم، موقع الدولة في النظام العالمي، وأحياناً من تدخلات خارجية ترى في الانقسامات الطائفية وسيلة لإدارة الصراع أو السيطرة على الموارد. في هذه الحالات، تتحول الطائفية إلى أداة وظيفية لدى بعض الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، تُستخدم لضبط المجتمع عبر تقسيمه إلى كيانات متنافسة تمنع تشكل حركة جماعية موحدة.
وعليه، فالطائفية ليست مجرد شعور ديني أو روحي، بل هي بناء اجتماعي–سياسي يتجذر في غياب العدالة الاجتماعية، وانهيار العقد الوطني، وضعف الثقافة المدنية. إنها آلية لإدارة الصراع في مجتمعات مأزومة، لكنها في الوقت نفسه أداة لإدامة هذا الصراع وضمان استمراره.
نحو تجاوز الطائفية وبناء دولة المواطنة
التمييز بين المذهبية والطائفية ليس مجرد اجتهاد لغوي أو تمرين نظري، بل ضرورة سياسية لفهم طبيعة الانقسام الاجتماعي وطرق تجاوزه. فالطائفية، بصفتها بناءً اجتماعياً وسياسياً قائماً على الولاءات الأولية، لا يمكن معالجتها بالاكتفاء بخطاب أخلاقي أو دعوات إنسانية عامة، بل تحتاج إلى مشروع وطني متكامل يعيد صياغة أسس الدولة والمجتمع.
هذا المشروع يجب أن يبدأ بإعادة بناء مؤسسات وطنية شاملة، قادرة على فرض المساواة أمام القانون، وضمان توزيع عادل للموارد، وكسر احتكار الطوائف للتمثيل السياسي. الهدف هو أن يشعر المواطن بأن حقوقه مكفولة لكونه مواطناً، لا لأنه تابع لطائفة معينة.
كما يتطلب الأمر إعادة صياغة العقد الاجتماعي بحيث يكون الانتماء للوطن هو الرابط الأعلى الذي يعلو على الانتماءات الفرعية، ويتحول إلى مرجعية تحكم العلاقات بين الأفراد والجماعات. ولا يكفي أن يبقى هذا العقد في إطار الشعارات، بل يجب أن يُترجم إلى قوانين وممارسات مؤسسية ترسّخ مفهوم المواطنة المتساوية في الحياة اليومية.
في قلب هذا المشروع، ينبغي أن تنشأ قوى سياسية وطنية حقيقية، ليست شعاراتها فقط وطنية، بل بنيتها الداخلية وبرامجها السياسية والاجتماعية والاقتصادية تمثل جميع المواطنين، وتعبر عن مصالحهم المشتركة، بعيداً عن الاصطفافات الطائفية أو المذهبية. فوجود هذه القوى شرط أساسي لتوفير بديل فعلي للنظام الطائفي، ولخوض الصراع السياسي على أساس البرامج والخيارات الاقتصادية والاجتماعية، لا على أساس الهويات المغلقة.
إلى جانب ذلك، يجب تعزيز الثقافة المدنية في التعليم والإعلام والمجال العام، لخلق وعي جمعي يرفض الانغلاق والتعصب، ويستبدل الصور النمطية عن الآخر بثقافة الحوار والاعتراف المتبادل. كما ينبغي تحرير المجال السياسي من هيمنة المحاصصة الطائفية، دون المساس بالتعدد الفكري أو الثقافي، بحيث يبقى الدين والمذهب جزءاً من الهوية الثقافية لا أداة لتوزيع السلطة.
إن تجاوز الطائفية لا يعني إلغاء التنوع المذهبي، بل تحريره من أن يكون أداة للصراع، وتحويله إلى عنصر إثراء ثقافي للمجتمع. وهذا لن يتحقق إلا بوجود إرادة سياسية لبناء دولة المواطنة، التي توازن بين العدالة الاجتماعية والتعددية الثقافية، وتجعل الانتماء الوطني هو المعيار الأعلى الذي يعيد صياغة العلاقات الاجتماعية والسياسية على أسس جديدة.
.
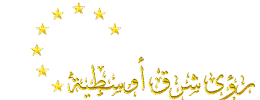


موضوع مهم وقد تم التطرق له بواقعية وكيف انا فهمته حيث يخاطب المنطق وموضح بشكل منطقي.ان التوازن بينهما فعلاً مهم ومهم جداً من اجل حياة هادئة ومجتمع مثقف ان فهم الناس والمجتمع باكمله هذه التركيبة . نامل ان يتغير واقعنا العراقي وسيتغير ان اصررنا على توعية الناس وإيقاظهم من غفوتهم طويلة باسم المذهب مثلاً او الطائفة ناسين ومتناسين انهم جميعاً مواطنون على ارض واحدة.