شهدت السنوات الأخيرة اتجاهاً متزايداً لاختزال الماركسية في كونها مجرد “نظرية اقتصادية”، تُعنى فقط بتحليل الأسواق والعمل ورأس المال. هذا التبسيط لا يعكس مجرد قراءة سطحية، بل يمثل توجهاً أيديولوجياً واعياً يسعى إلى تحييد الفكر الماركسي، وتدجينه داخل منظومة النظام القائم، بحيث يتحوّل من مشروع ثوري إلى مجرد أداة تحليلية محايدة.
باسم “تبسيط الماركسية”، يُجرَّد الفكر من طابعه السياسي الجدلي، ويُعاد إنتاجه كخطاب يمكن استيعابه ضمن المؤسسات القائمة، ليصبح أشبه بـ”ثورة مروّضة” تُقدَّم بعبارات سلسة خالية من التهديد.
في هذا السياق، تظهر الاقتصادوية كأداة لنزع البعد النقدي والتحليلي عن الماركسية، وتُحيلها إلى أدوات وصفية تُستعمل في الدراسات الاجتماعية دون مساءلة الجذور البنيوية للمجتمع. يُستشهد بماركس غالباً ضمن سياقات اقتصادية بحتة، خصوصاً في إطار كتابه “رأس المال”، الذي يُقدَّم على أنه عمل اقتصادي بحت، مع تجاهل الخلفية الفلسفية الجدلية العميقة التي يقوم عليها.
والحقيقة أن “رأس المال” ليس مجرد دراسة في قوانين السوق، بل يُمثّل نقداً شاملاً للاقتصاد السياسي البرجوازي، وهو جزء من مشروع فلسفي متكامل ينبع من المادية التاريخية، ويهدف إلى تحليل السلطة والعلاقات الاجتماعية والمعرفة نفسها.
اختزال الماركسية في بُعدها الاقتصادي فقط يُهمل عن عمد أو جهل قدرتها على تفكيك البنى الفوقية – من دين وقانون وثقافة وتعليم – والتي طالما كانت مركزية في فهم آليات السيطرة غير المباشرة. بهذا الشكل، تصبح الاقتصادوية إحدى آليات تفريغ الفكر من بعده الجدلي، فتصبح اللغة الثورية مجرد قشرة، لا تهدد جوهر النظام.
مؤسسات الليبرالية الجديدة وإعادة تشكيل الماركسية
لعبت المؤسسات الليبرالية، سواء كانت جامعات أو منظمات تنموية، دوراً حاسماً في إعادة تشكيل الماركسية بطريقة تُناسب الأطر النيوليبرالية وتُضعف بعدها الثوري. ففي السياق الأكاديمي، كثيراً ما يُقدَّم ماركس ضمن مناهج الاقتصاد السياسي كمفكر كلاسيكي، لا كثائر جدلي. وتُدرَّس أفكاره كمجرد أدوات لتحليل مؤشرات مثل الفقر أو توزيع الدخل، دون التطرّق إلى مشروعه السياسي الكامل.
في هذا التصور، تصبح الماركسية أشبه بمنهج تقني لفهم “عدم المساواة” بدل كونها موقفاً نقدياً جذرياً من النظام الرأسمالي ذاته. وهكذا، تُفرَّغ من محتواها الجدلي لتُقدَّم كعلم اجتماعي محايد.
أما على مستوى المؤسسات المالية الدولية – كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي – فالمقاربة أكثر وضوحاً. فهذه المؤسسات غالباً ما تستعير مفاهيم ماركسية جزئية، مثل الطبقات أو الفقر البنيوي، لكنها تُعيد تأطيرها داخل توصيات تقنية خالية من البعد الثوري. على سبيل المثال، يُصوّر الفقر هنا كمشكلة إدارية قابلة للحل عبر تحسين أدوات الدولة، وليس كنتيجة لعلاقات إنتاج ظالمة أو بنية طبقية غير متكافئة.
يتحول الصراع الطبقي في هذه السياقات إلى مسألة توزيع مالي لا إلى صراع جذري على ملكية وسائل الإنتاج أو شكل السلطة الاقتصادية. وهكذا، لا يُطرح النظام بوصفه محلاً للنقد أو المواجهة، بل يُفترض أنه قابل للتحسين من الداخل.
هذه المؤسسات تنزع الطابع البنيوي عن القضايا الجذرية، وتُحوّلها إلى مشاكل “تقنية” يمكن حلها ضمن النظام نفسه. إنها لا تُعالج جوهر الخلل، بل تُعيد رسم المشكلة بطريقة تجعلها قابلة للإصلاح دون المساس بالبنية الرأسمالية ذاتها.
إن ما يحدث ليس قمعاً مباشراً للماركسية، بل استيعاب ناعم لها. تُروّض المفاهيم الجذرية، وتُدمج في الخطاب الرسمي السائد دون تغيير جوهري فيه. فتصبح اللغة الماركسية مستخدمة – كلمات مثل “طبقة”، “استغلال”، “هيمنة” – لكنها تُستخدم دون تبنّي مشروع ماركس الذي يدعو إلى تغيير جذري في بنية السلطة والملكية.
تواطؤ بعض التيارات الماركسية في تكريس الاقتصادوية
من المفارقات اللافتة أن بعض التيارات التي ترفع شعار الماركسية، تساهم – عن وعي أو بدون وعي – في عملية تفريغها من مضمونها الثوري. فبعض الاتجاهات، مثل “الماركسية التحليلية” أو “الماركسية العلمية”، تعتمد مقاربات تركز بشكل شبه حصري على الجوانب الكمية والمفاهيم التقنية، متجاهلة الطبيعة الجدلية والسياسية للمشروع الماركسي.
في هذه القراءات، تتحول الماركسية إلى أداة بحثية لتقييم السياسات العامة أو دراسة مؤشرات اقتصادية، بدلاً من كونها مشروعاً نقدياً يسعى إلى تغيير جذري في علاقات الإنتاج. تُستخدم مفاهيم مثل فائض القيمة أو الاستلاب ضمن أوراق أكاديمية أو تقارير اقتصادية، لكنها تُفصل عن سياقها النضالي، وتُقدَّم بوصفها أدوات تحليلية لا مواقف سياسية.
يُركّز هذا الاتجاه على تحليل فجوات الأجور أو مستويات الإنتاجية أو مؤشرات السوق، من دون أن يُطرح السؤال الجوهري: من يملك وسائل الإنتاج؟ أو كيف تُنظّم علاقات القوة داخل الاقتصاد؟ وبهذا يتحول “الماركسي” من مناضل سياسي إلى محلل اقتصادي، ومن فاعل ثوري إلى موظف أكاديمي.
في هذه الصورة، يُعاد تقديم ماركس كمفكر اقتصادي محايد، يمكن الاقتباس منه والاستفادة من أدواته دون الارتباط بالمشروع الثوري الذي انطلق منه. وهذا ما يؤدي إلى تراجع الماركسية كقوة تغيير فعّالة، ويُفقدها قدرتها على التأثير السياسي والاجتماعي الحقيقي.
عندما تُسحب اللغة التحريضية من الماركسية، ويُعاد دمجها ضمن مؤسسات النظام الذي جاءت لتقويضه، يتحول الصراع الطبقي إلى مادة بحثية، ويُستبدل الفعل الثوري بالمؤتمرات والندوات الأكاديمية. وهذه النزعة التوفيقية تفصل النظرية عن جذورها الاجتماعية، وتُنتج نمطاً من التفكير النخبوي، المنفصل عن قضايا الجماهير.
وما يُعمّق هذا التفريغ، أن كثيراً من قيادات الأحزاب اليسارية نفسها تُثقف كوادرها على هذا الفهم السطحي والمختزل للماركسية، بوصفها مجرد نظرية اقتصادية، دون الإشارة إلى بعدها الفلسفي والاجتماعي والسياسي والنضالي. وقد يكون ذلك نتيجة للضعف النظري المتراكم، أو نتيجة للهيمنة الرمزية للثقافة الليبرالية، أو حتى تخلياً ضمنياً عن الماركسية كمشروع ثوري واستبدالها بمقاربات “أقل إحراجاً” داخل النظام القائم. بهذا تتحول الماركسية من أداة تغيير جذري إلى منتج رمزي يُستخدم لإضفاء “مسحة يسارية” على خطاب خالٍ من أي مضمون تحرري فعلي.
استعادة الماركسية كمنهج جدلي وثوري شامل
التصدي لاختزال الماركسية في بعدها الاقتصادي لا يكون بمحاولة بناء “اقتصاد ماركسي بديل”، بل باستعادة الماركسية بوصفها مشروعاً نقدياً شاملاً، وجدلياً في منهجه، وثورياً في غايته. فهي لا تبدأ من السوق أو الأسعار أو الإنتاج كمجرد معطيات تقنية، بل من تحليل علاقات الإنتاج التي تُشكّل البنية التحتية لكل ما هو سياسي وثقافي واجتماعي.
الماركسية لا تكتفي بشرح العالم، بل تهدف إلى تغييره. وهذا جوهر ما كتبه ماركس في نقده لبرنامج غوتا حين قال: “الحق البرجوازي يبقى ما دام هناك توزيع غير متكافئ لوسائل الإنتاج”. أي أن العدالة الشكلية لا تلغي جوهر الظلم، طالما بقيت السيطرة على الإنتاج محتكرة.
ولكي تستعيد الماركسية فاعليتها كقوة تحررية، لا بد من تحريرها من أسر التخصص الأكاديمي الضيق، وإعادة ربطها بالحياة اليومية، بصراعات الناس الحقيقية، وبالزمن الحيّ. ما نحتاجه ليس قراءة ماركس كمؤلف تاريخي، بل استعادة ماركس كمشروع متكامل: يربط الفكر بالفعل، والنظرية بالتنظيم، والتحليل السياسي بالممارسة الثورية.
ليست الماركسية نصوصاً تُقتبس، بل هي موقف تجاه العالم، وطريقة لفهمه بوصفه قابلاً للتغيير لا مجرد موضوع للشرح. في عالم تمزقه التناقضات الرأسمالية المتجددة، وتتصاعد فيه الأسئلة حول العدالة والعمل والملكية، لا تزال الماركسية توفر أدوات تحليل نقدية واضحة، لا لفهم العالم فحسب، بل لصياغة بديل عنه.
إن استعادة الماركسية اليوم لا تمر عبر المراكز البحثية أو المؤتمرات، بل من خلال ربطها مجدداً بالطبقات التي تعاني من الاستغلال، حيث يصبح الوعي بالتناقض بداية لفعل جماعي تحرري. هنا تستعيد الماركسية مشروعها الأصلي: لا كأرشيف فكري، بل كقوة قادرة على خوض الصراع من قلب الواقع.
خاتمة
أكبر التحديات التي تواجه الماركسية اليوم لا تقتصر على الضغوط الخارجية من القوى التي تسعى إلى تحييدها، بل تكمن أيضاً في الأشكال الداخلية من الترويض التي تسللت إليها عبر التأطير الأكاديمي أو التشويه المفاهيمي. من بين هذه الأشكال، تبرز الاقتصادوية بوصفها أخطرها، لأنها لا تهاجم الماركسية صراحة، بل تمنحها شرعية ظاهرية، في الوقت الذي تُفرّغ فيه مضمونها الثوري من الداخل.
التحدي الحقيقي لا يكمُن في إعادة طباعة كتب ماركس، بل في تحريره من السرديات التي جعلته مفكراً اقتصادياً محايداً، ومن الأنماط التعليمية التي اختزلت الماركسية في جداول ورسوم بيانية. فالماركسية ليست مجرد إرث نظري نُحافظ عليه، بل هي أداة كفاح يجب أن تُستعاد في سياقها الأصلي: كقوة تفسيرية موجّهة نحو التغيير الجذري.
من هنا، فإن كل محاولة لإعادة ربط الماركسية بجذورها النضالية تُعدّ خطوة نحو استعادة الأمل بتحقيق التحرر التاريخي. ومع تصاعد الأزمات العالمية وانهيار خطاب “الحياد العلمي”، تصبح الحاجة إلى ماركسية نقدية، متجذّرة، ونضالية، أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
هذه ليست دعوة حنين إلى الماضي أو تمسكاً بنموذج جامد، بل هي نداء لتجديد مشروع ماركسي حيّ، قادر على قراءة العالم لا كما هو فحسب، بل كما يجب أن يكون.
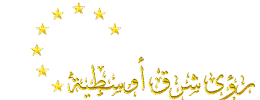


حقيقة هذالمقال يحب ان يقرأه طلبة العلوم السياسية الذي يطرح في مناهجهم الفكر الماركسي على انه انه نظرية اقتصادية كلاسيكية وليس ايدلوجية فكرية تربط بين الفكر والحياة والاقتصاد