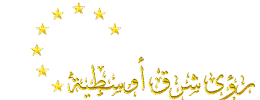ينطلق التحليل الماركسي للاقتصاد الرقمي من نقطة محورية وهي “السلعة”، لا باعتبارها كياناً مادياً فحسب، بل كبنية اجتماعية كثيفة تُجسد العلاقات الطبقية ضمن نمط الإنتاج الرأسمالي. في هذا الإطار، تُفهم القيمة التبادلية للسلعة على أنها لا تنبع من الندرة أو الحاجة الطبيعية، بل من العمل الاجتماعي الضروري المبذول لإنتاجها. هذا المفهوم، كما طرحه ماركس في “رأس المال” (1867)، يضع العمل البشري – لا المادة أو الأداة – في صلب إنتاج القيمة. ويتم التمييز الحاسم بين “العمل الحي”، الذي يولد فائض القيمة ويخضع للاستغلال، و”العمل الميت”، المتجسد في أدوات الإنتاج والبنية التحتية، والذي لا يولد قيمة جديدة بل ينقل قيمته إلى السلعة.
في هذا السياق، تُعد أدوات الإنتاج عنصراً مركزياً في عملية إعادة إنتاج علاقات السيطرة الطبقية. إذ إن تطورها لا يُنتج فقط كفاءة تقنية، بل يعيد تشكيل البنية الاجتماعية للعمل، ويؤدي إلى إعادة تنظيم القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج. وهذا ما يتجلى اليوم بوضوح في التحول من الأدوات المادية إلى الرقمية. ففي الرأسمالية الصناعية، كانت أدوات الإنتاج هي الآلات والمصانع، أما اليوم فهي الخوارزميات، البنى السحابية، الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة. هذه الأدوات الرقمية لا تخرق المنطق الرأسمالي الكلاسيكي، بل تعززه: فهي لا تخلق قيمة مباشرة، لكنها تسهل وتسارع عملية إنتاج القيمة، وتُعيد تنظيم الزمن الاجتماعي بما يخدم منطق التراكم الرأسمالي.
التفاوت الطبقي الذي أنتجته الثورة الصناعية، حيث تفوق العامل الآلي على العامل اليدوي، يُعاد اليوم إنتاجه بصيغة رقمية، حيث العامل المعرفي الذي لا يملك أدوات الإنتاج الرقمية (أو المهارات اللازمة للتفاعل معها) يُقصى أو يُخضع لوتيرة عمل تتجاوز قدرته. المستخدم، الباحث، أو منشئ المحتوى الرقمي يُنتج اليوم ضمن مناخ من التوتر الزمني والرقابة الرقمية الخفية.
أن الرأسمال الرمزي – كالاعتراف الأكاديمي والمكانة الاجتماعية – يُعاد تحويله إلى رأسمال اقتصادي داخل سوق المعرفة، ما يؤدي إلى إعادة إنتاج التراتب داخل الحقل الأكاديمي. وهذا التراتب لا يقوم فقط على الملكية المادية، بل على احتكار أدوات إنتاج المعرفة وتصنيفها. ويضاف بُعداً جديداً في تحليل الرأسمالية المراقبة، حيث تُنتج القيمة من خلال استخراج السلوك البشري وتحويله إلى بيانات قابلة للبيع. المعرفة هنا لم تعد نتيجة للعمل العقلي أو اليدوي، بل لتدفق سلوكي مستمر يُحوّل إلى مدخلات خوارزمية. في هذا النموذج، لم يعد العامل يُنتج السلعة، بل يُنتَج هو نفسه كبيانات وسلوك يمكن تحليلهم وتسليعهم.
فالمعرفة لم تعد “سلعة” بالمعنى الكلاسيكي فقط، بل أصبحت “أصلاً مالياً” يُقيَّم من خلال قابليته للبراءة، للترخيص، أو للتحويل التجاري. الأبحاث لم تعد تُقاس بمدى مساهمتها في تحرير الوعي أو مساءلة النظام، بل بما إذا كانت تولد تدفقات نقدية واستثمارات قابلة للتداول. بهذا المعنى، تتحول المعرفة من أداة تحرر إلى أداة تراكم، وتفقد قيمتها الاجتماعية لصالح وظيفتها السوقية.
ومع هذا التحول البنيوي، يمكن القول إننا أمام مستوى جديد من تطور القوى المنتجة، حيث لم تعد أدوات الإنتاج تُختزل في مكوناتها المادية – من مصانع وآلات – بل أصبحت تشمل أدوات إنتاج رقمية مثل البرمجيات، المنصات، الخوارزميات، وأنظمة الذكاء الاصطناعي. وبهذا المعنى، لم تعد السيطرة على أدوات الإنتاج المادية كافية لضمان التحكم في العملية الإنتاجية، إذ إن هذه الأدوات لا تُفعّل ولا تُوظّف إلا من خلال التحكم في البرمجيات والأنظمة الرقمية التي تُشغلها وتُوجهها.
ينتج عن ذلك تشظٍ في ملكية أدوات الإنتاج، حيث يمكن أن تمتلك طبقة ما المصانع والآلات، بينما تحتكر طبقة أخرى أدوات التحكم الرقمية، مما يُعيد تشكيل مفهوم السيطرة الطبقية. لقد أصبحت البرمجيات – بما فيها الأكواد المغلقة، أنظمة التشغيل، المنصات السحابية، وتكنولوجيا التنبؤ والتحليل – نقطة ارتكاز جديدة في علاقات الإنتاج. هذه الازدواجية تُنتج تعقيداً طبقياً جديداً: فمن لا يمتلك أدوات الإنتاج الرقمية أو المهارات اللازمة للسيطرة عليها، يبقى مهمشاً في سلسلة القيمة، حتى لو كان يمتلك الوسائل المادية التقليدية.
وهكذا، فإن الملكية لم تعد فقط مادية، بل أصبحت ثنائية البنية: مادية ورقمية، وهو ما يتطلب إعادة التفكير في مفهوم “الملكية” داخل الاقتصاد السياسي المعرفي، بوصفها بنية متعددة المستويات ترتبط ليس فقط بالموارد، بل بآليات التحكم والمعرفة التقنية كذلك.
بهذا الفهم، فإن الاقتصاد الرقمي لا يمثل قطيعة مع المنظومة الرأسمالية بل امتداداً لها، حيث تُعاد صياغة مفاهيم “السلعة”، “العمل”، “القيمة”، و”الاستغلال” في سياق جديد. البيانات والخوارزميات لم تعد أدوات تحليل فقط، بل وحدات إنتاج. السوق لم يعد مجرد ساحة للتبادل، بل نظام تنظيمي شامل يعيد تشكيل كل علاقة اجتماعية وفق منطق الربح. العمل لم يعد يُقاس بزمن مباشر، بل بتفاعل قابل للتوقّع والتسليع. رأس المال المعرفي لم يعد مرادفاً للعلم أو الفهم، بل للقدرة على احتكار أدوات إنتاج المعرفة الرقمية، بما فيها الذكاء الاصطناعي والمنصات.
تحليل التحوّل الرقمي لأدوات الإنتاج
في الطور المعاصر من الرأسمالية، نشهد تحوّلاً جوهرياً في بنية أدوات الإنتاج، لا يتمثل فقط في تشظٍ في ملكية أدوات الإنتاج من الأدوات المادية إلى الرقمية، بل في إعادة تشكيل البنية الاجتماعية للإنتاج ذاتها. أصبح مركز الثقل الإنتاجي يتموضع في أدوات رقمية لا مادية. هذه الأدوات لم تعد مجرّد أدوات مساعدة، بل تحوّلت إلى عناصر مركزية تتحكم في مسار الإنتاج، تنظيم العمل، وتوزيع القيمة. وهي، وإن بدت على السطح محايدة أو تقنية، فإنها تخضع خضوعاً كلياً لمنطق التراكم الرأسمالي والهيمنة الطبقية.
الخوارزميات، على سبيل المثال، ليست فقط تعليمات برمجية، بل أدوات تنظيم اجتماعي تُستعمل للتحكم في تدفقات العمل، توجيه السلوك، وإعادة إنتاج السلطة ضمن فضاءات العمل الرقمي. فالخوارزمية تُسند إليها مهام اتخاذ القرار – من تنظيم الجداول الزمنية للموظفين، إلى تصنيف المحتوى، إلى تحديد من يستحق التفاعل أو الظهور في نتائج البحث. بهذا المعنى، تقوم الخوارزمية مقام المدير، لكنها أكثر خفاءً، وأشد انضباطاً، وأقل قابلية للمساءلة. الذكاء الاصطناعي، بدوره، يعمل على تسريع إنتاج القيمة عبر تقليص الحاجة إلى العمل الحي، ما يُسهم في مضاعفة فائض القيمة من خلال أتمتة عمليات التحليل والإنتاج والتنبؤ.
المنصات الرقمية تمثل شكلاً جديداً من أدوات الإنتاج، لا تملك فقط الخدمة أو المنتج، بل تهيمن على العلاقة التي تربط بين المنتج والمستهلك. Uber لا تملك سيارات، بل تملك المنصة؛ Amazon لا تزرع أو تصنّع، لكنها تتحكم في البنية التحتية للتوزيع الرقمي. ما يُباع هنا ليس سلعة فحسب، بل الوصول، التفاعل، والبيانات المتولّدة عن السلوك البشري. هذا التموقع يمنح هذه المنصات وضعاً أشبه بـ”الرأسمالي الشامل”، الذي لا يشارك في الإنتاج المباشر، لكنه يحتكر البنية التي يتم عبرها الإنتاج نفسه، ويقتطع بذلك حصة مستمرة من فائض القيمة.
في ظل هذه المنظومة، لم يعد العامل يُمارس دوره التقليدي كمنفذ لعملية إنتاج مادية، بل أُعيد تشكيله كـ”فاعل رقمي”، يُشارك في الإنتاج من خلال وجوده، تفاعلاته، وسلوكياته اليومية على الإنترنت. لقد انمحى الفاصل بين العمل واللاعمل، وبين الإنتاج والاستهلاك، حيث أصبح المستخدم نفسه عنصراً إنتاجياً – ليس عبر الجهد الواعي، بل عبر المشاركة التلقائية، التي تُنتج بيانات قابلة للتحليل والتسويق. إن استغلال العمل لم يعد مقصوراً على الأجر المتدني، بل أصبح يتم من خلال اللامقابل: المستخدم يُنتج، دون أن يعترف به كنقطة في سلسلة القيمة، ودون أن يُعوّض مادياً على مشاركته.
يُظهر هذا التحول ملامح بنية رأسمالية جديدة، حيث لم يعد العامل وحده مستغلاً، بل أيضاً الفرد المستهلك، المتفاعل، الباحث، وحتى غير العامل. الزمن الاجتماعي يُعاد تنظيمه ليصبح قابلاً للتسليع، ويُعاد تعريفه وفق مبدأ “الحضور الدائم” (Always-On). لم يعد بالإمكان فصل العمل عن الراحة، أو الخاص عن العام، أو الإنتاج عن التفاعل. إن النظام الرأسمالي الرقمي يُخضع الزمن، الانتباه، والوجود البشري ذاته لمنطق السوق، في شكل جديد من رأسملة الحياة اليومية، يُعيد إنتاج الاستغلال خارج المصنع وداخل الشاشة، المنصة، والواجهة البصرية.
وتُعد شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل Google، Apple، Amazon، Meta، وMicrosoft، تجسيداً حياً لهذا التحول. هذه الشركات لا تملك أدوات إنتاج تقليدية فحسب، بل تهيمن على البنية التحتية الرقمية العالمية: مراكز البيانات، الخوارزميات، محركات البحث، والأنظمة التنبؤية. إنها طبقة مالكة جديدة، لا تحكم الإنتاج من خلال السيطرة على المواد الخام أو المصانع، بل من خلال احتكار المعلومات، التحكم في السلوك، وضبط الوصول إلى المعرفة. إنها تُنتج أكثر ما هو ندّيّ في الرأسمالية الرقمية: المعنى ذاته، إذ تُحدد ماذا يرى الفرد، متى يراه، وكيف يُقيّمه.
تتجلى الهيمنة هنا في قدرتها على إنتاج الواقع الرمزي نفسه، وتحويله إلى أصل يُستثمر ويُباع. هذه ليست فقط ملكية جديدة لأدوات إنتاج، بل أيضاً احتكار لمعنى الوجود، تُشكَّل عبر خوارزميات لا تفصح عن ذاتها، وتُدرّب عبر بيانات لا يملكها من يُنتجها، وتخدم مصالح لا يعيها المستخدم. وبهذا، يُعاد إنتاج علاقة الاستغلال بشكل أكثر خفاءً، لكن أكثر فاعلية.
إعادة تشكيل القوى المنتجة
إن التحوّل الرقمي الذي يشهده نمط الإنتاج الرأسمالي لا يمكن فهمه باعتباره مجرد تحديث تقني، بل هو إعادة تشكيل جذرية لما يسميه ماركس بـ”القوى المنتجة”، والتي لا تشمل الأدوات والمواد فحسب، بل أيضاً العنصر البشري – قدراته، وعيه، تنظيمه الاجتماعي. إن الرأسمالية الرقمية تعيد صياغة هذه القوى عبر تذويب الحدود بين الإنسان والتقنية، بين العمل والمعرفة، وبين الأداة والعامل. فبدلاً من الآلة الصناعية، التي كانت تمثل الشكل الأوضح لأداة الإنتاج، أصبح الذكاء الاصطناعي، الخوارزمية، البيانات، والمنصة هي القوى الجديدة التي تُنتِج وتُعيد تشكيل الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
هذا التحوّل ليس فقط في الشكل أو الوسيط، بل في البنية: لم يعد العمل يُعرّف من خلال الجهد البدني أو حتى العقلي المباشر، بل من خلال “القابلية للتحليل”. كل سلوك بشري – من تحريك المؤشر على الشاشة إلى النقر على إعلان – يتحول إلى بيانات قابلة للاستخراج والمعالجة والتسويق. وهكذا، يصبح الإنسان ذاته هو موقع الإنتاج، لا بما يُنتجه ويدركه، بل بما يُنتَج عنه دون وعيه. إن العلاقة بين العامل ووسيلة الإنتاج هنا لم تعد علاقة تحكم يدوي أو ذهني، بل علاقة إخضاع معرفي وسلوكي تُنظمها خوارزميات محجوبة، تعمل على تحليل الأفراد وإنتاج سلوكهم في الوقت ذاته.
في ظل هذه التغيرات، تولد طبقة جديدة يمكن توصيفها بدقة ماركسية على أنها “البروليتاريا الرقمية”. هذه ليست مجرد فئة من العاملين في القطاع التقني، بل تشمل طيفاً واسعاً من الفاعلين الذين يُستخرج منهم فائض القيمة من دون أن يُعترف بهم كعمّال: منشئو المحتوى، العاملون في المنصات، المشاركون في التصنيفات الرقمية، المتفاعلون في وسائل التواصل، بل وحتى المستخدم العادي الذي لا يدرك أنه يُنتج باستمرار بيانات قابلة للتسليع.
البروليتاريا الرقمية تُنتج دون أجر، وتخضع للمراقبة دون إدراك، وتُقيّم وفق معايير لا تصوغها بنفسها، بل تُفرض عليها عبر خوارزميات مملوكة لشركات كبرى. الاستغلال هنا لا يتم من خلال الجهد المباشر فقط، بل من خلال ما يمكن تسميته “الوجود المحسوب” – أي قدرة النظام الرأسمالي على تحويل كل وجود بشري متصل بالإنترنت إلى مادة خام تحليلية، يتم تصنيفها، بيعها، وتوظيفها في أنظمة التنبؤ والإعلانات والسيطرة السلوكية. كل تفاعل يُترجم إلى قيمة، وكل لحظة على الشبكة تُعد جزءاً من دورة إنتاج رأس المال الرقمي.
إن هذا النمط من الاستغلال هو الأخطر لأنه لا يكتفي بنقل فائض القيمة، بل يُغيب وعي العامل بوضعه الطبقي. البروليتاريا الرقمية لا تمتلك تصنيفاً قانونياً ولا تنظيمياً، ولا تعترف الدولة أو النقابات بها كفئة منتجة. بل إنها – في كثير من الأحيان – تستبطن منطق السوق وتعيد إنتاجه، من خلال السعي إلى تحسين الذات، رفع “الترتيب”، كسب “الإعجابات”، وزيادة التفاعل، في حين أن هذه النشاطات كلها تُعيد إنتاج منظومة استخراج القيمة لصالح الرأسمال المعلوماتي.
وبينما كانت الرأسمالية الصناعية تستغل الجهد والوقت، فإن الرأسمالية الرقمية تستغل ما هو أكثر خفاءً: الانتباه، التفاعل، والتاريخ السلوكي. إن كل نقرة، كل مشاهدة، كل تحريك على الشاشة يتحول إلى بيانات، وتلك البيانات تصبح سلعة، تُباع في أسواق تنبؤية يُعاد من خلالها إنتاج السوق ذاته كسلطة أيديولوجية. هنا، لم يعد الاستغلال قابلاً للقياس الزمني فقط، بل أصبح مستمراً، محيطاً، وغير مرئي. لم يعد هناك فاصل بين وقت العمل ووقت اللاعمل، فكل شيء بات صالحاً لأن يُستثمر.
بهذا المعنى، نحن أمام نمط جديد من استخراج فائض القيمة، لا يعتمد على بيع سلعة تقليدية، بل على تحليل أنماط السلوك الإنساني وتسليعها. لم تعد القيمة تأتي من العمل اليدوي أو الذهني، بل من مجرد القابلية للتوقع والتصنيف. وكل فرد متصل بالمنصات يتحول إلى منتج ومستهلك في آن، لا يُعوَّض مادياً على إنتاجه، ولا يُعفى من مسؤوليته كمستهلك. إنها علاقة استغلال ذات طابع دائري مستمر، يُنتج فيها النظام ذاته يومياً عبر الاستخدام، المشاركة، والتفاعل.
وفي نهاية المطاف، فإن الرأسمالية الرقمية، رغم اختلاف أدواتها، تعيد إنتاج منطق التراكم الرأسمالي ذاته، لكن بأساليب أكثر تعقيداً ومراوغة. والطبقة العاملة الجديدة، على الرغم من انتشارها وكثافتها، تظل خارج أطر التنظيم والاعتراف، ما يُصعّب من عملية وعيها الذاتي كطبقة مستغلة. هذا ما يجعل مهمة التحليل النقدي في هذا السياق ضرورية ليس فقط للفهم، بل أيضاً لتأطير المقاومة الممكنة، وتعريف الحقل الطبقي الجديد، حيث أصبح الإنسان يُستغل لا بما يفعله فقط، بل بمجرد أن يكون حاضراً رقمياً.
نقد ماركسي للرأسمالية الرقمية
إن من أبرز تجليات الرأسمالية الرقمية الحديثة هو بلوغها مستوى غير مسبوق من تسليع النشاط الإنساني، بما في ذلك المجال الأكثر ارتباطاً بالتحرر، وهو المعرفة. لقد فقدت المعرفة موقعها كمجال إنتاج رمزي مستقل، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من منطق السوق، تُقيَّم وتُنتج وتُموَّل على أساس الربحية. لم تعد المعرفة غاية بحد ذاتها، بل وسيلة إنتاج تابعة لمؤشرات الأداء والمردودية التجارية، ما يجعل الحقل العلمي والأكاديمي ساحةً جديدة لإعادة إنتاج الهيمنة الطبقية، بل أداة مباشرة لها.
في هذا السياق أن المعرفة العلمية، وخاصة في الجامعات والمؤسسات البحثية، لم تعد تُنتج بناءً على الحاجة الفهمية أو النقدية، بل بناءً على إمكاناتها في توليد براءات اختراع، منتجات قابلة للتسويق، ومشاريع قابلة للاستثمار التجاري. هذا التحول، لا يُعد مجرد انحراف مؤقت، بل يمثل إعادة صياغة شاملة لوظيفة العلم داخل النظام الرأسمالي المتأخر، حيث تتحول “الفكرة” ذاتها إلى “أصل”، وتُعامل وفق قواعد الملكية الخاصة والتسعير والمضاربة.
ومن هذا المنظور، لا يقتصر تسليع المعرفة على تحولها إلى منتج، بل يمتد إلى أدوات إنتاجها وتوزيعها. فمؤشرات النشر، التصنيفات الأكاديمية، مقاييس الاقتباس، والمجلات المحكمة لم تعد أدوات لتنظيم المعرفة بل آليات لتسليعها، تُستخدم كمعايير لتوزيع التمويل، الشرعية، والهيبة الرمزية داخل الحقل الأكاديمي.
إذاً، ما يحدث في الجامعات ليس مجرد بيروقراطية علمية، بل رأسمالية معرفية صريحة، حيث تخضع المشاريع البحثية لحسابات السوق، وتُقصى فيها الأسئلة النظرية، الوجودية، أو التحررية لصالح قضايا التكنولوجيا الحيوية، الذكاء الاصطناعي، و”الابتكار” بمعناه السوقي. وتتحول الجامعات إلى مؤسسات إنتاج معرفي مُخصخص، تدار كبُنى استثمارية تهدف إلى الربح، التموقع العالمي، وتحقيق أعلى معدل من “الأداء” القابل للقياس. بهذا المعنى، لم تعد الجامعة مؤسسة نقد، بل تحولت إلى شركة لإدارة المعرفة، يُديرها منطق الكفاءة السوقية لا الحرية الفكرية.
وفي قلب هذا التحول، يتربع الذكاء الاصطناعي بوصفه الأداة الأكثر تمثيلاً لهذه الرأسمالية الجديدة. إذ لا يعمل الذكاء الاصطناعي كوسيط تقني فحسب، بل يُمارس وظيفة أيديولوجية عميقة، تُعيد تشكيل السلوك البشري، المعرفة، واتخاذ القرار. فإن الذكاء الاصطناعي لا يهدف إلى الفهم أو التفسير، بل إلى التنبؤ والتحكم. فهو يُستعمل لاستخراج السلوك وتحويله إلى بيانات تُباع في أسواق الإعلانات، التسويق، والتأثير السياسي، ما يجعل منه أداة ضبط اجتماعي شاملة.
الذكاء الاصطناعي لا يُبرمج فقط ليحل مشاكل تقنية، بل يُبرمج ليخدم منطق الربح، وبالتالي يخضع لتصميم أيديولوجي يكرّس الطاعة، يُعزز الامتثال، ويُقمع الانحراف المعرفي. لا يطرح أسئلة، بل يُعيد إنتاج الإجابات المكررة التي تخدم أهداف السوق. إن المعرفة التي ينتجها الذكاء الاصطناعي ليست نتاجاً للحوار أو الصراع أو الشك، بل نتاج خوارزميات تقترح فقط ما هو قابل للبيع، وما يمكن استثماره، وما يحافظ على استمرارية النظام.
إن خطورة هذا التشكيل الجديد للرأسمالية لا تكمن فقط في استخدام التقنية كوسيلة، بل في تقديمها كقدر، كحتمية، كموضوعية محايدة. في حين أنها في جوهرها أداة للهيمنة الطبقية، تُعيد إنتاج العلاقات الاجتماعية من خلال معايير تقنية تخفي بنيتها السياسية والاقتصادية. المعرفة لم تُسلّع فقط، بل فُرّغت من بعدها التحرري. فعندما يُعاد تعريف “العلم الجيد” باعتباره ما يمكن تمويله وتسويقه، يتم تلقائياً طرد كل معرفة ناقدة، كل مشروع تحرري، وكل فكر راديكالي من الحقل المعرفي المشروع.
هذا ما أشرت إليه في دراستي السابقة “مقدمات في الاقتصاد السياسي للمعرفة: من العمل إلى التسليع”، حين اكدت أن الفكر ذاته أصبح وحدة قابلة للتسليع، تُنتج ضمن شروط السوق وتُقيّم وفق عائدها التجاري لا أثرها النقدي. حينها، لا يعود الفكر ساحة للصراع الطبقي أو مشروعاً للتجاوز، بل يصبح هو نفسه منتجاً محايداً، تُستخرج منه القيمة كما تُستخرج من أي سلعة أخرى، ويُوظف للحفاظ على الوضع القائم لا لتجاوزه.
وعليه، فإن التحول الذي نشهده لا يقتصر على الاقتصاد، بل يمسّ البنية التحتية للوعي نفسه. إننا نعيش لحظة تاريخية تُعاد فيها صياغة الإدراك، القرار، والمعنى داخل خوارزميات لا نراها، لكنها ترى كل شيء؛ لا نتحكم بها، لكنها تتحكم بما نراه ونفكر فيه. ومع اختفاء أي فصل بين المعرفة والتقنية والسوق، يصبح العقل ذاته موضعاً للصراع الطبقي، ويغدو إنتاج الوعي هو ساحة الهيمنة الكبرى.
الرأسمالية الرقمية: شكل جديد للاستغلال لا قطيعة مع النظام
إن التحولات التي يكشفها التحليل الماركسي للرأسمالية الرقمية لا تُشير إلى قطيعة مع المنظومة الرأسمالية الصناعية، بل إلى تعميق لمنطقها الجوهري، وتوسيع لبنيتها الهيكلية. فالرأسمالية الرقمية ليست مرحلة تقنية محايدة أو تطوراً طبيعياً في وسائل الإنتاج، بل هي إعادة تشكيل لجوهر الاستغلال على أسس أكثر كثافة ومرونة وخفاء. لقد استُبدلت الآلة الصناعية بالخوارزمية، والمصنع بالمنصة، والعامل اليدوي بالفاعل الرقمي، لكن جوهر العلاقة بين رأس المال والعمل ظل قائماً، بل أضحى أكثر تجذراً. إن الأداة تغيرت، لكن علاقات الإنتاج لم تتغير، بل تكثفت. الفارق الأساسي هو أن الرأسمالية الرقمية لا تستغل الجهد فحسب، بل تستغل الوجود ذاته، وتُعيد تشكيل الذات البشرية كطاقة إنتاجية غير مرئية، قابلة للتحليل والتوجيه والتسليع.
لم يعد العمل يُعرّف من خلال النشاط الإنتاجي المادي، بل من خلال قابلية الفرد لأن يُحلَّل، يُراقب، ويُتوقّع. القيمة لم تعد تستخرج من الزمن المباشر، بل من سلوكيات يتم تجميعها وتحويلها إلى بيانات، ومن ثم إلى سلعة، تُباع وتُعاد برمجتها ضمن أنظمة التوصية والإعلان والقرار. وبذلك، يصبح المستخدم، أو المتفاعل، أو الباحث، منتجاً للسلعة دون وعيه، وخاضعاً للعلاقات الرأسمالية دون أن يُعرّف كعامل. هذا ما يجعل من الاستغلال الرقمي أكثر تعقيداً من نظيره الصناعي، لأنه يستبطن ذاته في حياة الفرد اليومية، ويُقدَّم في صورة خدمات مجانية، ترفيه، أو خيارات مخصصة، بينما هو في حقيقته عملية استخراج فائض قيمة متواصلة.
وبهذا المعنى، فإن البروليتاريا الرقمية لا تعمل في المصانع، ولا تُنظَّم في نقابات، ولا تُحمى بقوانين عمل واضحة، لكنها تنتج القيمة يومياً، وتخضع لمنطق رأس المال في كل لحظة من تفاعلها. هذا الوضع لا يُفقدها موقعها في منظومة الإنتاج، بل يُخفيه، ما يجعل وعيها الطبقي هشاً أو مشوشاً. ولأن الرأسمالية الرقمية لا تظهر كسلطة قمعية مباشرة، بل كوسيط ناعم عبر الواجهات الرقمية، فإنها قادرة على إعادة إنتاج التبعية دون مقاومة واضحة، وعلى امتصاص الطاقة النقدية وتحويلها إلى بيانات تحليلية قابلة للتسويق.
إزاء هذا الواقع، تُطرح مسألة المقاومة بوصفها تحدياً مركباً يتجاوز مجرد الرفض الأخلاقي أو الانسحاب الرمزي. إن مقاومة الرأسمالية الرقمية تفترض أولاً تفكيك وهم الحياد التكنولوجي، والاعتراف بأن المعرفة، البيانات، والمنصة هي أدوات إنتاج متمركزة طبقياً، لا أدوات مشاركة بريئة. من هنا، يبدأ الشرط السياسي لأي فعل مقاوم، وهو إعادة توطين المعرفة في المجال العمومي، وفصلها عن شروط السوق، وتحريرها من مؤشرات الأداء، التمويل المشروط، والخوارزميات الاحتكارية. ولا يمكن تحقيق هذا إلا من خلال بناء فضاءات بديلة للإنتاج المعرفي، تستند إلى مبدأ المشاركة الديمقراطية، التمويل التشاركي، وحرية السؤال.
يتطلب هذا المشروع إعادة تصور المؤسسات العلمية والتعليمية باعتبارها بُنى جماعية لإنتاج المعنى والتحرر، لا شركات لإنتاج المحتوى الأكاديمي القابل للتسويق. وهذا يعني كسر احتكار أدوات الإنتاج الرقمية من خلال تطوير منصات مفتوحة المصدر، خالية من التتبع والضبط، تمكّن الجماعة من امتلاك بنيتها المعرفية، وتحرر المستخدم من موقع المستهلك إلى موقع المنتج الواعي.
إن ما هو على المحك في الرأسمالية الرقمية ليس فقط طبيعة العمل، بل طبيعة الإنسان نفسه: وعيه، قراره، معناه، وزمنه. لذلك، فإن المقاومة لا يمكن أن تكون تقنية فقط، بل لا بد أن تكون تحررية من الجذر، تعيد ربط المعرفة بالحاجة الجماعية، لا بالرغبة السوقية؛ وبالسؤال الوجودي، لا بالتنبؤ الإعلاني؛ وبالتحرر، لا بالتكيّف. وهذا يقتضي مساءلة أدوات الذكاء الاصطناعي نفسها، لا بوصفها تقنيات محايدة، بل بوصفها أجهزة أيديولوجية رأسمالية، صُممت لتنظيم السلوك لا لفهمه، ولإعادة إنتاج الطاعة لا للانفلات منها.
في الختام، يمكن القول إن الرأسمالية الرقمية قد خلقت شكلاً جديداً من الاستغلال، أكثر خفاءً، وأكثر رسوخاً، لكنه ليس أقل قابلية للنقد أو التغيير. وإذا كانت مقولة ماركس الشهيرة أن “الفلاسفة اكتفوا بتفسير العالم، بينما المهمة هي تغييره”، فإن المهمة اليوم تتجدد، ولكن على جبهة جديدة: نقد الخوارزمية والمنصة والبيانات، لا فقط المصنع والآلة. إننا نعيش لحظة تاريخية تتطلب إعادة ربط الوعي بجذوره المادية، والمعرفة بمشروعها التحرري، والإنسان بإمكانه التاريخي.