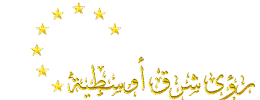أشارت تصريحات ترامب حول إبلاغ إيران مسبقًا بالضربات الأمريكية على قواعدها العسكرية، بما تحمله من دلالات وما لها من أبعاد، إلى جانب إخلاء إيران لمنشآتها النووية قبل الضربات، إلى تساؤلات حول وجود قواعد اشتباك أو اتفاقيات خفية بين الطرفين، الأمر الذي يعزز فرضية أن الحرب قد تكون، إلى حدٍّ ما، “مسرحية استراتيجية”. هذا الرأي يتبناه قسم كبير من المراقبين والمحللين المؤدلجين، مستندين في آرائهم إلى ارتجالية إعلامية ومواقف غير ودية ذات خلفيات متشعبة. لكن، وإعمالًا للعقل والمنطق في البحث العلمي، لا بد من تناول هذه النقطة بعمق من منظور نظريات العلاقات الدولية، وفقًا لقاعدة المعلومات المتاحة وسياق الأحداث وأدوات التحليل والربط المنطقي، مع فتح باب نسبية النتائج تبعًا للقسم المُغيّب من معلومات واتفاقيات الحرب، لأغراض استخباراتية وعسكرية لها مفرزاتها السياسية.
بالعودة إلى دلالات الإبلاغ المسبق لأمريكا وإخلاء إيران للمنشآت، تقول المحاكمة العقلية-التحليلية إنه: “إذا صحت تصريحات ترامب بأن إيران أُبلغت مسبقًا بالضربات، ثم قامت بإخلاء منشآتها النووية (مثل فوردو ونطنز وأصفهان)، فهذا ـ بديهيًا، والبديهيات لا تُناقش ـ يشير إلى وجود قنوات تواصل غير علنية بين الولايات المتحدة وإيران، ربما عبر وسطاء مثل دول الخليج أو قنوات دبلوماسية سرية”. والمهم أن هذا الإبلاغ المسبق قد يكون جزءًا من قواعد اشتباك ضمنية تهدف إلى:
أولًا: تقليل الخسائر البشرية عبر إخلاء المنشآت، بما يقلل من الضحايا ويمنع التصعيد إلى حرب شاملة قد تكون كارثية للطرفين.
ثانيًا: إدارة التصعيد؛ فالإبلاغ المسبق يعكس رغبة في الحفاظ على الصراع ضمن حدود محددة، مما يتماشى مع مفهوم “الحرب المحدودة” في نظرية الواقعية.
ثالثًا: إشارات سياسية؛ تُظهر إيران من خلال إخلاء منشآتها قدرتها على حماية “أصولها الاستراتيجية”، بينما تُظهر الولايات المتحدة قوتها العسكرية دون استفزاز رد فعل إيراني مدمر.
تشير أدلة من مصادر موثوقة، مثل تقارير الغارديان وNBC، إلى أن إيران أخلت منشآتها النووية قبل الضربات الأمريكية في 22 يونيو 2025، وأن الضرر كان محدودًا نسبيًا في بعض المواقع، حيث أشار مسؤولون إيرانيون إلى أن الأضرار كانت “سطحية” و”قابلة للإصلاح”. هذا يدعم فكرة أن الضربات كانت رمزية إلى حدٍّ كبير، تهدف إلى إظهار القوة أكثر من تحقيق تدمير شامل.
ولو حاولنا التحقق فيما إذا كانت هناك اتفاقيات خفية، فالحكم من منظور “نظرية اللعبة الاستراتيجية” قد يشير إلى أن هذه الضربات كانت جزءًا من اتفاق ضمني بين الولايات المتحدة وإيران، يهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية لكلا الطرفين:
أولًا: بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل، تُظهر الضربات التزام ترامب ونتنياهو بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مما يعزز صورتهما كقادة أقوياء أمام قواعدهم الشعبية. وتصريحات ترامب عن “تدمير كامل” للمنشآت النووية، رغم التقارير التي تشير إلى أضرار محدودة، تدعم هذا الهدف السياسي.
ثانيًا: بالنسبة لإيران، فإن إخلاء المنشآت والرد المحدود (مثل إطلاق صواريخ على إسرائيل، معظمها أُسقط)، يسمح لإيران بالحفاظ على صورتها كقوة إقليمية قادرة على الرد، دون الانجرار إلى حرب شاملة قد تهدد استقرار النظام. وتصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، التي أكدت على “حق الرد” دون تفاصيل واضحة، تعكس هذا النهج الحذر.
نشرت على منصة X (تويتر سابقًا) تحليلات تدعم هذا التفسير، حيث وصفت الحرب بأنها “مسرحية” أو “هجمة صورية” تهدف إلى تحقيق مكاسب دعائية لكلا الطرفين، مع الإشارة إلى أن التصعيد كان مضبوطًا بعناية. ومع ذلك، تبقى هذه المنشورات تعبيرًا عن رأي تحليلي شائع وليست دليلًا قاطعًا.
السؤال المطروح هو: لماذا يمكن اعتبارها مسرحية استراتيجية؟
الجواب، من منظور التحليل الدقيق، يتجسد في وجود عدة أسباب تدعم فكرة أن الحرب كانت تحمل طابعًا مسرحيًا:
أولًا: التوقيت والإخراج؛ الضربات الأمريكية جاءت بعد أسبوع من الضربات الإسرائيلية، مما يشير إلى تنسيق دقيق. إعلان ترامب عن مهلة “أسبوعين” لإيران للتفاوض، ثم تنفيذ الضربات خلال أيام، يبدو وكأنه تضليل إعلامي يوحي باتفاق مسبق.
ثانيًا: الحد من الأضرار؛ إخلاء المنشآت النووية واستخدام أسلحة دقيقة مثل قنابل GBU-57 “بانكر باستر” يشير إلى رغبة في تقليل الخسائر البشرية.
ثالثًا: الخطاب السياسي؛ تصريحات ترامب ونتنياهو التي وصفت الضربات بـ”النجاح الباهر”، بينما تشير تقارير استخباراتية إلى أن الأضرار لم تتجاوز تأخير البرنامج النووي لبضعة أشهر، تعزز فكرة أن الهدف كان سياسيًا أكثر منه عسكريًا.
رابعًا: وقف إطلاق النار السريع؛ الإعلان عن وقف إطلاق النار بعد أيام قليلة من الضربات يوحي بأن الطرفين كانا مستعدين مسبقًا لإنهاء التصعيد، مما يعزز فرضية التفاهمات الخلفية.
مع ذلك، هناك اعتراضات قوية على فكرة “المسرحية”:
أولًا: من المنظور الجيوسياسي، فإن الأهداف الأمريكية – الإسرائيلية تقوم على مشروع “إسرائيل الكبرى”، والذي يتطلب إزالة العقبات الجيوسياسية، ومن ضمنها الأنظمة المعادية كإيران. وبالتالي، لا يُحتمل وجود تنسيق مع عدو يُهدد المشروع الاستراتيجي نفسه.
ثانيًا: الوجود الإيراني في سوريا كان لأغراض استراتيجية مرتبطة بالثروات (كالفوسفات في تدمر) والممرات، وفقًا لنظرية السلعتين لمورغان كليفتن، مما يعكس دوافع مادية لا تتماشى مع توافق استراتيجي إسرائيلي-إيراني.
ثالثًا: القول بأن وجود نظام ثيوقراطي إسلامي يخدم مبرر وجود إسرائيل فيه شيء من التناقض؛ فبينما يُستغل هذا العداء داخليًا لتبرير التسلح والدعم الدولي، فإن بقاء إيران القوية قد يفرض على إسرائيل شريكًا إقليميًا منافسًا، مما يعقد استراتيجيتها.
رابعًا: الخسائر المادية الفعلية، سواء في إسرائيل أو إيران، تجعل من الصعب تصور أن كل شيء تم بتنسيق مُسبق، إلا إذا كانت هناك جهات ضامنة لإعادة الإعمار (مثل زيارة ترامب للخليج).
خامسًا: الانخراط الأمريكي المباشر في الصراع يزيد من مخاطر التصعيد، خاصة مع تهديد إيران بقصف قواعد أمريكية، مما يقلل من احتمالية وجود اتفاق مسبق.
سادسًا: الانقسامات داخل الإدارة الأمريكية، بين مؤيدي التدخل ومعارضيه، تشير إلى أن القرار لم يكن مجرد خطوة دعائية بل خطوة محفوفة بمخاطر داخلية.
النتيجة:
يمكن القول إن الحرب الإسرائيلية–الإيرانية كانت تحمل طابعًا مسرحيًا إلى حدٍّ كبير، حيث تم التحكم في التصعيد بعناية لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية محدودة، مما يدل على وجود قواعد اشتباك ضمنية أو تفاهمات خفية، ربما عبر وسطاء. ومع ذلك، فإن الخسائر الفعلية والتهديدات المتبادلة تُشير إلى أن الصراع كان مزيجًا من عمليات عسكرية حقيقية ومناورات سياسية. هذا التوازن يعكس استراتيجية “اللعب على حافة الهاوية”، حيث تسعى الأطراف إلى تعظيم مكاسبها دون تحمُّل تكاليف باهظة. في النهاية، عززت الحرب الموقف السياسي لترامب ونتنياهو، لكنها لم تغيّر النسق الإقليمي بشكل جذري، مع بقاء إيران لاعبًا مرنًا قادرًا على التكيّف.