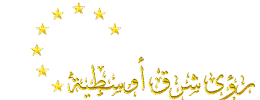يعلمنا التاريخ السياسي الحديث درساً أساسياً: الثورات الكبرى لا تخرج من العدم، بل هي نتيجة لتراكم معرفي نقدي يمتد لسنوات، يشكل ملامحها ويحدد جوهرها. في القرن الثامن عشر، على سبيل المثال، أرسى الفكر السياسي الأوروبي أسساً نقدية للتحولات الجذرية، من خلال استكشاف قضايا الدولة والحرية والعقد الاجتماعي وسيادة الشعب، وربطها بالحقوق الأساسية للإنسان والمواطنة. لم يقتصر المفكرون مثل جون لوك وروسو ومونتسكيو وفولتير على التأمل النظري المجرد. بل قدموا أدوات نقدية مكنت الجماهير من مساءلة السلطة، وتحويل المطالب الشعبية إلى برامج سياسية مدروسة. وهذا ما تجلى بوضوح في الثورة الأمريكية عام 1776 والثورة الفرنسية.
النظر إلى ذلك القرن كأنه فقير فلسفياً يقلل من دوره الحاسم في بناء الأرضية المعرفية للتحولات التاريخية. كانت الأعمال الفكرية موجهة أساساً نحو الإنسان والمجتمع والتاريخ، تربط التفكير السياسي بالعدالة وإعادة توزيع السلطة، بدلاً من أن تكون مجرد انعكاس للتقاليد أو أيديولوجيا تحافظ على الوضع القائم. لهذا، أشار كثير من المؤرخين، ومنهم إميل بريهية، إلى أن القرن الثامن عشر كان فقيراً فلسفياً، ويعود ذلك أساساً إلى اعتبار الفلسفة تأملاً ميتافيزيقياً محضاً. روسو، ببساطة، أسس لفهم السيادة الشعبية وشرعية السلطة. أما مونتسكيو فقد صاغ تصوراً لفصل السلطات يمكن من مساءلة المؤسسات. وفولتير أبرز أهمية النقد في تحرير الفكر من الهيمنة الدينية والاجتماعية (ماركس، نقد فلسفة الحق عند هيغل، 1843).
يؤكد هذا المسار التاريخي أن الفكر النقدي ليس ترفاً نخبوياً. إنه شرط حاسم لتحويل الغضب الجماهيري من انفعال عفوي إلى فعل تاريخي واعٍ. عندما يتراكم الوعي النقدي داخل المجتمع، يتحول من اعتراض مشتت إلى مشروع لتغيير البنية الاجتماعية والسياسية. أدرك ماركس هذه الحقيقة عندما كتب في نقد فلسفة الحق عند هيغل أن نقد الدين هو بداية كل نقد؛ أي أن تحرر الإنسان يبدأ بتحرر وعيه من الأوهام التي تبرر السلطة والاستغلال. وبهذا المعنى، لا تكتمل أي ثورة دون فكر نقدي يحول الرفض إلى رؤية، والغضب إلى برنامج، والاحتجاج إلى بناء مؤسسي جديد.
الفكر، إذن، هو الشرط الذي يمنح التاريخ منطقه الداخلي. الثورات التي تفتقر إلى هذا العمق الفكري تتحول سريعاً إلى فوضى، أو يعاد احتواؤها داخل النظام القديم بقناع جديد. لكن عندما تسبقها مرحلة نضج فكري، كما في عصر الأنوار الأوروبي، تصبح قادرة على تغيير البنية السياسية والاجتماعية بعمق. من هنا يمكن القول إن الفكر السياسي النقدي ليس ظلاً للحركة الثورية. هو محركها الباطني، روحها التاريخية التي تسبقها، تؤطرها، وتمنحها معنى يتجاوز اللحظة الانفعالية نحو أفق تحرري مستدام.
الفكر كشرط للثورة لا كنتيجة لها
التجربة التاريخية تؤكد أن الفكر النقدي يسبق الحدث الثوري ويحدد مضمونه واتجاهه؛ فلا يمكن لأي حركة اجتماعية أن تتحول إلى ثورة واعية دون أدوات تحليلية قادرة على فهم السلطة، البنية الاجتماعية، وربطها بالحقوق والسيادة الشعبية. الفكر السياسي هنا لا يعمل كرفاهية نظرية، بل كمرشد للوعي الجماعي، يحول الاحتجاج من مجرد رفض الظلم إلى مشروع تغيير شامل. فالثورة، كما رأى ماركس في الأيديولوجية الألمانية، ليست انفجاراً عفوياً للأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بل تتجسد كنتيجة لتراكم معرفي نقدي، حيث تُصاغ المبادئ النظرية أولاً ثم تتحقق على الأرض عبر ممارسة سياسية واعية.
تاريخ الثورات الكبرى يقدم نموذجاً حياً لهذه العلاقة. الثورة الفرنسية على سبيل المثال، لم تكن مجرد انفجار اجتماعي ضد الاستبداد والظلم الاقتصادي، بل كانت ثمرة تراكم فكر نقدي طويل الأمد تضمنه كتابات روسو، مونتسكيو، وفولتير، حيث أعادوا صياغة العلاقة بين المواطن والدولة، بين العقد الاجتماعي وسيادة الشعب، وبين الحرية الفردية والمسؤولية الجماعية. هذا الفكر لم يكتفِ بطرح نقد للسلطة، بل وضع أسساً لمفاهيم الديمقراطية والمساءلة السياسية، فحوّل الغضب الشعبي إلى برنامج سياسي واضح المعالم.
علاوة على ذلك، يوضح التاريخ أن المجتمعات التي تفتقر إلى العمق الفكري غالباً ما تتحرك وفق انفعالات ظرفية، مما يؤدي إلى تحولات سطحية أو تكرار أنماط تاريخية دون إنتاج بدائل حقيقية. الأمثلة كثيرة، من الانتفاضات التي شهدتها أوروبا قبل القرن التاسع عشر إلى الحركات الشعبية في القرن العشرين، حيث تبقى الطاقات الثورية حبيسة الاحتجاج العاطفي أو المطالب الجزئية، وتفشل في تحويلها إلى مشروع مؤسساتي قادر على إعادة تنظيم السلطة والهياكل الاجتماعية. هذه الملاحظة تؤكد أن الفكر السياسي النقدي يعمل كإطار لتأصيل العدالة، بحيث تصبح الثورة ليست مجرد طاقة غاضبة، بل عملية تراكمية لإعادة تنظيم المجتمع على أسس الحرية والمواطنة والمساءلة المستمرة.
الفكر النقدي أيضاً يمكّن من ربط الممارسة السياسية بالهيمنة الاقتصادية والاجتماعية. ففي الثورة الروسية 1917، كانت النظرية الماركسية تفسر ليس فقط الظلم الاجتماعي الناتج عن استغلال البروليتاريا، بل تحدد آليات إعادة بناء المجتمع على أساس طبقي، مع وضع السلطة في خدمة مصالح الأغلبية. هنا يظهر الدور التوجيهي للفكر، إذ يحول الحركة الجماهيرية من فوضى إلى مشروع متكامل. وبدون هذا العمق التحليلي، تبقى الحركة مجرد نشاط احتجاجي متقطع، بلا أفق تاريخي أو أفق تحرري مستدام.
يمكن القول إذن إن الثورة لا تنشأ من الفراغ، بل هي نتاج لوعي نقدي تراكم عبر الفكر والممارسة، حيث يُصاغ الإطار النظري أولاً، ثم يُختبر على أرض الواقع. الفكر السياسي يعمل كحلقة وصل بين الماضي والحاضر، بين الاحتياجات العاجلة والأفق الاستراتيجي، وبين نقد السلطة وإعادة إنتاج أطرها بطريقة أكثر عدالة. وهو بهذا المعنى، شرط للثورة لا نتيجة لها، إذ يحوّل الغضب الفردي والجماعي إلى طاقة تاريخية واعية، قادرة على تغيير الواقع وتحويله إلى مشروع اجتماعي مؤسسي.
الفقر الفلسفي في الواقع العربي
الواقع العربي المعاصر يعكس حالة من الفراغ الفلسفي والنقدي العميق، وهو فراغ يؤثر مباشرة على القدرة على إنتاج حراك سياسي واجتماعي مستدام. فالمشهد السياسي غالباً ما يقتصر على التنديد بالفساد، أو المطالبة بالحقوق دون تأسيس رؤية نقدية متكاملة حول الدولة، القانون، السلطة، الفرد والمجتمع. هذا النقص في البنية الفكرية يجعل التحولات السياسية والاجتماعية هشّة وغير متجانسة، إذ تتحرك القوى الاجتماعية ضمن نطاق محدود من المطالب المؤقتة أو الانفعالات اللحظية، بلا إطار نظري يوجّه الفعل ويمنحه أفقاً تاريخياً. في هذا السياق، يصبح الحراك الاجتماعي أشبه بسيل من المياه العارمة، سريع الزوال، يترك أثراً عابراً دون القدرة على صبّه في مشروع مؤسسي دائم.
يعود سبب هذا الفقر إلى تاريخ طويل من الانقطاع بين الفكر والنضال الاجتماعي. فالنخب العربية لم تنتج فلسفة سياسية نقدية متسقة تتعامل مع التناقضات الطبقية والبنية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والمجتمع، كما فعل الفكر الأوروبي في القرون السابقة. ومن ثم، فإن الحركات والمطالب الشعبية تتكرر ضمن نمط دائري، حيث يتكرر الاحتجاج، وتتكرر المطالب دون إعادة إنتاج أدوات نظرية قادرة على تحويلها إلى مشروع تاريخي واعٍ. هذا النقص لا يقتصر على السياسات العامة أو المؤسسات الرسمية، بل يمتد إلى وعي الطبقات والفئات الفاعلة، التي لا تستطيع قراءة التاريخ المحلي أو تحليل المؤسسات المعاصرة بعمق، مما يجعل أي احتجاج عرضة للتكرار أو الانحراف عن الهدف التحرري.
يمكن ملاحظة انعكاسات هذا الفقر في العديد من التجارب المعاصرة، من الانتفاضات في شمال أفريقيا إلى الحركات الشعبية في الخليج وبلاد الشام، حيث تظهر الاحتجاجات أحياناً كأحداث متقطعة، بدت وكأنها انفجارات عاطفية أكثر منها محركات تغيير مؤسساتي. فعلى سبيل المثال، الانتفاضات العربية في العقد الماضي أظهرت قدرة ضخمة على التعبئة الجماهيرية، لكنها سرعان ما اصطدمت بعجز في صياغة برامج سياسية شاملة، فضلاً عن محدودية البنية الفكرية التي يمكنها أن تخلق مسارات مستدامة للسلطة أو إعادة توزيعها. هذا المشهد يوضّح أن الفعل السياسي لا يكتمل إلا مع تراكم معرفي نقدي قادر على توجيه الغضب الجماعي نحو أهداف استراتيجية، لا مجرد مطالب آنية.
الفقر الفلسفي في العالم العربي أيضاً ينعكس على طبيعة الخطاب السياسي والفكر الاجتماعي، إذ يغلب عليه الطابع الجزئي والمطالبي، دون الالتفات إلى الأسباب البنية للتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية أو إلى تاريخ النضال الطبقي. وبهذا يصبح الخطاب النقدي ناقصاً، إذ يفتقد القدرة على إنتاج رؤى شاملة للتغيير، ويُترك المجال للنماذج السطحية أو المنهجيات المستوردة من الخارج التي لا تتفاعل مع خصوصيات الواقع العربي. وبالتالي، يظل الفكر العربي في مأزق: بين الانغلاق على الذات وبين التبعية للنماذج الغربية، دون القدرة على إنتاج نظرية نقدية محلية قادرة على الاشتباك مع السلطة والهياكل الاجتماعية بشكل واعٍ.
في هذا الإطار، يصبح واضحاً أن الحراك السياسي والاجتماعي في العالم العربي غالباً ما يتحرك وفق دورة مستمرة من الغضب المؤقت، بلا مشروع طويل الأمد، وبلا أفق تاريخي قادر على إعادة إنتاج البنية الاجتماعية والسياسية. وهذا يفرض ضرورة بناء مشروع نقدي يربط بين النظرية والممارسة، بين الفهم والتحليل، وبين المطالب اللحظية والأفق الاستراتيجي للتحرر. فغياب هذا العمق الفكري هو ما يفسر هشاشة الحراك الاجتماعي العربي، ويكشف عن التحدي المركزي الذي يواجه أي محاولة للتحول البنيوي في المجتمعات العربية المعاصرة.
انعكاس هذا الفقر على طبيعة الحراك السياسي
غياب العمق النظري والفلسفي في الواقع العربي لا يقتصر أثره على المجال الأكاديمي أو النقاشات الفكرية، بل يمتد مباشرة إلى طبيعة الحراك السياسي والاجتماعي، ويحدد أطره وإيقاعه ومردوديته. فالحركات في هذا السياق غالباً ما تتحرك وفق ظرفية الأحداث الاقتصادية والسياسية، حيث تصبح مطالبها محدودة بالاحتياجات الفورية أو ردود الفعل العاطفية تجاه الظلم أو الفساد، دون امتلاك رؤية استراتيجية قادرة على تحويل الطاقات الجماهيرية إلى مشروع مؤسساتي واعٍ ومستدام. هذا يجعل السياسة في كثير من الأحيان مجرد إدارة للأزمات، وليس بناء وعي جماعي قادر على إعادة إنتاج المجتمع وتنظيم السلطة بطريقة تراكمية ومنهجية.
يمكن ملاحظة هذا النقص في تكرار دورات الاحتجاج الشعبي في العديد من الدول العربية، حيث تتكرر الحركات الاجتماعية دون أن تحقق تغييراً جوهرياً في الهياكل الاجتماعية والسياسية. الاحتجاجات تصبح أدوات ضغط مؤقتة، وغالباً ما تتلاشى طاقتها بمجرد استجابة رمزية من الدولة أو تدخل خارجي لتطويق الأزمة. هذا النمط يوضح أن غياب الإطار النقدي والفلسفي يجعل الحراك السياسي محدود التأثير، إذ يفصل بين المطالب اللحظية والأفق الاستراتيجي، ويخلق فجوة بين الغضب الاجتماعي والقدرة على تحويله إلى عملية تغيير جذرية. فالممارسة الثورية، بلا أدوات نظرية نقدية، تظل حبيسة اللحظة، معرضة للتكرار والانحراف، أو حتى لتسخيرها في دعم النظام القائم دون أي تعديل بنيوي.
على سبيل المثال، تظهر التجربة العراقية بعد عام 2003 كيف أن الحركات الاحتجاجية رغم كثافتها، لم تتمكن من إنتاج مشروع متكامل للسلطة أو المجتمع، بسبب نقص الرؤية الفكرية والنقدية التي تفسر البنية الطبقية والمؤسسية وتوجه التحركات الجماهيرية نحو أهداف استراتيجية (انظر دراسة انتفاضة تشرين المؤجلة: نحو تجاوز الفوضوية السياسية) . كذلك، في مصر وسوريا، يمكن ملاحظة أن الانفجارات الجماهيرية كانت غالباً محكومة بالظرفية الاقتصادية والسياسية والضغط الاجتماعي المباشر، بينما لم تُترجم إلى إعادة تنظيم مستدام للسلطة أو إنتاج مؤسسات جديدة تتوافق مع مطالب العدالة والمساءلة.
هذا الواقع لا يقتصر على الحركات الشعبية وحدها، بل يشمل أيضاً النخب الفكرية والسياسية التي تقود النقاش العام، حيث تفتقد هذه النخب أحياناً القدرة على تقديم تحليل نقدي متكامل للعلاقات بين السلطة والاقتصاد والمجتمع، أو لربط الاحتجاج بالتحولات التاريخية الكبرى. ونتيجة لذلك، يبقى الوعي السياسي ناقصاً، لأنه يعزل اللحظة الاحتجاجية عن السياق التاريخي والاجتماعي الأوسع، ويجعل من كل حركة مجرد ظاهرة آنية، بلا مشروع طويل الأمد، ولا أدوات للتأثير البنيوي المستدام.
يمكن القول إن انعكاس الفقر الفلسفي على الحراك السياسي يُظهر بوضوح أن القدرة على التغيير ليست مجرد مسألة تعبئة شعبية، بل تحتاج إلى قاعدة معرفية نقدية تُؤسس لفهم التناقضات البنيوية في المجتمع والدولة، ولتوجيه العمل الجماعي نحو تغيير مستدام. فالسياسة بلا فلسفة تصبح إدارة للظرفية، والحركة الجماهيرية بلا نقد تصبح عرضة للاستغلال أو الانحراف، بينما الفكر النقدي يوفر الأفق، ويحوّل الغضب الاجتماعي إلى مشروع تاريخي واعٍ. ومن هنا يتضح أن الأزمة المركبة في العالم العربي ليست فقط سياسية، بل أيديولوجية وفكرية في الوقت نفسه، وهي أزمة تتطلب استعادة العلاقة الجدلية بين النظرية والممارسة، بين التحليل والتغيير، لتصبح الحركات الاجتماعية والسياسية أدوات للتحول البنيوي، لا مجرد انفجارات ظرفية تتلاشى مع أول أزمة جديدة.
امتداد الأزمة إلى الحركات الديمقراطية واليسارية
لا يقتصر الفقر الفلسفي والنقدي على الأنظمة القائمة في العالم العربي، بل يمتد ليشمل القوى المعارضة نفسها، بما فيها الحركات الديمقراطية واليسارية وحتى الماركسية. هذه الحركات، رغم شعاراتها التحررية، غالباً ما تظل ملتزمة بالمقولات التقليدية والتحليلات القديمة، دون تطوير معالجات نظرية وسياسية معاصرة تتعلق بالهيمنة الحديثة أو التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يفرضها الواقع المحلي والإقليمي. في كثير من الحالات، يمكن القول إن هذه القوى، بدل أن تكون أدوات لإنتاج وعي نقدي متجدد، تصبح مجرد ناقلة للتاريخ الفكري السابق، تعيد إنتاجه دون القدرة على الاشتباك الفعّال مع الواقع الملموس أو ابتكار حلول عملية تتناسب مع التحولات الجديدة.
على سبيل المثال، نجد أن كثيراً من الحركات اليسارية التقليدية في شمال أفريقيا وبلاد الشام تعتمد على تحليلات مستمدة من فترات تاريخية سابقة، حيث كان التركيز على الصراع الطبقي التقليدي بين البروليتاريا والبرجوازية، بينما اليوم يواجه العالم العربي نسقاً أكثر تعقيداً من الهيمنة الاقتصادية والسياسية، يتداخل فيه تأثير النظم المالية العالمية، الشركات متعددة الجنسيات، وأدوات السلطة الرقمية الحديثة، إلى جانب التحديات الاجتماعية والثقافية المحلية. غياب قراءة نقدية لهذه التحولات يجعل من الشعارات التحررية مجرد رموز شكلية، لا تُترجم إلى برامج استراتيجية قادرة على إنتاج تغيير ملموس ومستدام.
نتيجة هذا الفقر النقدي تظهر جلية في الأداء العملي لهذه الحركات، حيث نلحظ عدم قدرتها على تحويل الوعي الجماهيري إلى مشروع مؤسساتي، أو على الاشتباك مع المؤسسات القائمة بطريقة استراتيجية. فبدل أن تنتج هذه الحركات أفكاراً نقدية جديدة تواكب التحولات الحديثة، تبقى مقيدة بالخطاب التقليدي، مما يؤدي إلى استنساخ النموذج القديم من المعارضة، ويُضعف قدرتها على مواجهة أدوات الهيمنة الجديدة بفاعلية. هذا الأمر يخلق حلقة مفرغة، حيث تبقى الحركات عاجزة عن إنتاج بدائل حقيقية، بينما يظل الواقع العربي غارقاً في أزمات متكررة، دون امتلاك آليات للتحول البنيوي.
من منظور جدلي، يمكن اعتبار هذه الأزمة امتداداً للفقر الفكري، إذ ترتبط العلاقة بين النظرية والممارسة ارتباطاً جدلياً؛ فغياب التحديث النقدي للفكر يجعل الفكر مجرد أداة تأريخية، أو أيديولوجية جامدة، تُستخدم في دراسة الواقع بشكل جزئي، دون أن تُفضي إلى اشتباك فعال مع سلطات الهيمنة الاقتصادية والاجتماعية. وبهذا تصبح الحركات الديمقراطية واليسارية غير قادرة على التأثير في موازين القوة، ويظل دورها محصوراً في إعادة إنتاج التاريخ الفكري، بدل أن يُثمر في الواقع.
هذه الأزمة المركبة، إذاً، ليست محصورة في غياب مشروع سياسي وطني أو إقليمي، بل تتعداه إلى أزمة إنتاج فكري نقدي قادر على تفعيل الفعل الثوري أو الإصلاحي بطريقة واعية ومستدامة. فهي تظهر بوضوح أن الحركات نفسها، حتى لو كانت تحمل شعارات التحرر والعدالة، لا تستطيع الاشتباك مع الواقع بفاعلية ما لم تنتج أدوات تحليلية جديدة تستجيب للتحديات المعاصرة، وتعيد صوغ استراتيجيات مواجهة السلطة والهياكل القائمة. ومن هنا، يمكن القول إن أزمة الحراك السياسي في العالم العربي هي أزمة مزدوجة: أزمة تنظيم سياسي وأزمة إنتاج فكري نقدي، حيث يتقيد الفعل الاجتماعي والسياسي بعدم امتلاك أفق نظري كافٍ للتفاعل مع السلطة والهياكل الاجتماعية، ويظل قابلاً للاختزال في اللحظة العاطفية أو الانفعال الجماهيري.
الحاجة إلى مشروع نقدي عربي متكامل
إن تجاوز الأزمة الفكرية والسياسية في العالم العربي لا يمكن أن يتحقق عبر إصلاحات جزئية أو شعارات كبرى معزولة عن شروطها المادية، بل يتطلب بناء مشروع نقدي عربي متكامل، مشروع قادر على قراءة الواقع بوصفه بنية تاريخية مركّبة، لا مجرد سلسلة من الاختلالات الظرفية. فالأزمة، في جوهرها، ليست أزمة أفكار شحيحة، بل أزمة علاقة بين الفكر والواقع، بين النظرية والممارسة، بين ما يُقال وما يُنجز.
هذا المشروع النقدي لا ينطلق من فراغ، ولا يكتفي باستيراد مقولات جاهزة، سواء من الفكر الغربي أو من الماركسية الكلاسيكية بصيغتها المدرسية. بل يسعى، على العكس، إلى الاشتباك المباشر مع التجربة العربية نفسها، بوصفها مادة حية للتحليل والتفكير وإعادة البناء. هنا، لا تُفهم النظرية كقالب يُفرض على الواقع، ولا يُختزل الواقع إلى “خصوصية” معطِّلة للتحليل، بل يُبنى بينهما توازن جدلي: نظرية تمنح الفعل معناه التاريخي، وواقع يختبر هذه النظرية ويُجبرها على التطور.
غياب هذا التوازن هو ما يفسر هشاشة الحراك الاجتماعي والسياسي في العالم العربي. فغالباً ما تتحرك القوى الجماهيرية داخل أطر ضيقة من المطالب الآنية أو الشعارات العامة، دون أن تمتلك أفقاً تاريخياً واضحاً يحوّل هذه الطاقة إلى مشروع تغييري مستدام. تصبح الحركة، في هذه الحالة، رد فعل لا فعلاً واعياً، وانفعالاً لحظياً لا مساراً استراتيجياً. والمشكلة هنا ليست في الجماهير، بل في غياب الإطار الفكري النقدي القادر على تنظيم الوعي وربط المطالب اليومية بالبنية العميقة للأزمة.
المشروع النقدي العربي، في هذا المعنى، هو مشروع نقد متواصل للواقع، لا يهادن السلطة ولا يقدّس المجتمع، بل يفكك الدولة بوصفها بنية تاريخية، ويفحص المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية باعتبارها ساحات للصراع، لا معطيات محايدة. إنه نقد يرفض التعامل مع الواقع العربي كاستثناء خارج قوانين التحليل السياسي والاجتماعي، ويرفض في الوقت نفسه إسقاط نماذج جاهزة عليه دون مساءلة. فالتعامل مع الواقع بوصفه “حالة خاصة مطلقة” لا يقل خطورة عن التعامل معه بوصفه نسخة مشوهة من تجارب أخرى.
ومن هنا، فإن إحياء الفلسفة السياسية العربية لا يعني العودة إلى التراث بوصفه ملاذاً، ولا القطيعة معه بوصفه عبئاً، بل إدخاله في جدل حيّ مع الحاضر. الفلسفة، في هذا السياق، ليست ترفاً ذهنياً، بل أداة لفهم السلطة، وتحليل آليات الهيمنة، وإعادة تعريف مفاهيم الدولة، والحرية، والعدالة، والعلاقة بين الفرد والمجتمع ضمن شروط تاريخية محددة. إنها فلسفة لا تكتفي بالتفسير، بل تسعى إلى إعادة صياغة أدوات الاشتباك مع الواقع.
كما أن هذا المشروع النقدي لا يكتمل دون إنتاج أدوات فكرية وسياسية جديدة تمكّن الحركات الديمقراطية واليسارية من مراجعة استراتيجياتها. فالتشبث بالمقولات القديمة، أو الاكتفاء بتحليلات جزئية، يحوّل هذه الحركات إلى كيانات تكرر نفسها داخل عالم يتغير من حولها. المطلوب هنا هو خطاب نقدي قادر على فهم التحولات العميقة في بنية الاقتصاد، وفي أشكال الهيمنة الحديثة، وفي أنماط الوعي والثقافة، وربط كل ذلك بالفعل السياسي اليومي.
بهذا المعنى، يصبح الفكر النقدي أداة لبناء وعي طبقي وجماهيري، لا مجرد نشاط ذهني معزول. وعي يربط بين المطالب اللحظية والأفق الاستراتيجي للتحرر، بين النضال اليومي والتغيير البنيوي. فالمعرفة، حين تنفصل عن هذا الدور، تتحول إلى سلعة أخرى خاضعة لمنطق الهيمنة، بدل أن تكون قوة تحررية.
إن التحدي الحقيقي أمام المشروع النقدي العربي يكمن في استعادة العلاقة الجدلية بين النظرية والممارسة، بين الفلسفة والسياسة، بين التحليل والتنفيذ. عندها فقط يمكن تحويل الحراك الاجتماعي والسياسي من طاقة مشتتة إلى حركة واعية، قادرة على إحداث تغيير بنيوي مستدام. فالمستقبل العربي لن يُبنى بالارتجال ولا بالانفعال، بل على قاعدة فكر نقدي متجدد، ينطلق من الواقع، ويعود إليه، ويعيد تشكيله في مسار تحرري طويل النفس وواضح الأفق.