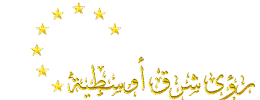تأتي هذه الدراسة ثمرةً لنقاشات مطوّلة جرت مع مجموعة من الأصدقاء والرفاق، وبطلب خاص من الصديق سلام العبلي، انطلاقاً من الأهمية النظرية والميدانية التي يكتسبها هذا الموضوع في فهم واقع اليسار المعاصر وإشكاليات فعله السياسي والتنظيمي. فمن خلال هذه النقاشات، تبلور الإحساس بأن سؤال دور الفرد في التاريخ لا يزال من أكثر الأسئلة إلحاحاً وتعقيداً داخل الفكر الماركسي، لتموضعه في قلب التوتر الجدلي بين الضرورة والحرية، بين البنية والفعل، وبين التاريخ بوصفه مساراً طويلاً ممتداً، والسياسة بوصفها لحظة تكثيف حاسمة.
هذا السؤال، في جوهره، لم يكن يوماً ترفاً نظرياً أو تأملاً فلسفياً مجرداً، بل ارتبط دائماً بإشكالات عملية واجهت الحركة العمالية والثورية عبر تاريخها، وفرضت نفسها مع كل منعطف سياسي وتنظيمي حاد: لماذا تنجح بعض المبادرات بينما تفشل أخرى؟ متى يصبح تدخل الأفراد عاملاً حاسماً في مسار الصراع؟ وأين تقف حدود الإرادة الإنسانية أمام ثقل الشروط الموضوعية التي تحكم الفعل التاريخي؟
في هذا السياق تحديداً، يبرز كل من غيورغي بليخانوف وفلاديمير لينين بوصفهما مرجعيتين مركزيتين في معالجة هذا الإشكال، لا لأنهما قدّما إجابات متطابقة، بل لأن كلّاً منهما تناول المسألة من زاوية تحليلية مختلفة، تعكس مستوى مميزاً داخل المادية التاريخية. إن فهم هذا الاختلاف، يُعد شرطاً أساسياً لتجاوز القراءات التبسيطية التي تنتهي، إما إلى تفريغ الماركسية من بعدها الفاعل، أو إلى تحويلها إلى إرادوية سياسية منفصلة عن التاريخ وشروطه المادية.
بليخانوف ودور الفرد ضمن قوانين التطور التاريخي
ينطلق بليخانوف من التزام صارم بالمادية التاريخية بوصفها نظرية لتفسير التطور الاجتماعي في أفقه البنيوي طويل المدى. فمن وجهة نظره، لا يمكن فهم أي حدث تاريخي أو أي دور فردي بمعزل عن البنية الاقتصادية–الاجتماعية التي تشكّل شروط إمكانه. الأفراد، ببساطة، لا يختارون الظروف التي يولدون فيها، ولا القوانين العامة التي تحكم تطور المجتمع، بل يجدون أنفسهم داخلها، ويتحركون ضمن حدودها الموضوعية.
غير أن بليخانوف لا ينفي دور الفرد، بقدر ما يرفض تضخيمه إلى الحد الذي يتحول فيه التاريخ إلى نتاج عبقرية فردية معزولة. الفرد، في تحليله، يمكنه أن يؤثر في شكل الحدث، وفي توقيته، وفي سرعته، لكنه لا يستطيع أن يخلق مساراً تاريخياً يناقض الشروط الموضوعية القائمة. وبهذا المعنى، فإن الأفراد “يصنعون التاريخ”، ولكنهم لا يصنعونه كما يشاؤون، بل كما تسمح به الظروف التي لم يختاروها.[1]
تكمن أهمية بليخانوف هنا في دفاعه الصارم عن البعد العلمي للماركسية، في مواجهة النزعات الرومانسية أو المثالية وحتى اليساروية التي تُرجع التحولات الاجتماعية الكبرى إلى إرادة قادة استثنائيين. لقد كان همه الأساسي حماية الماركسية من التحول إلى فلسفة بطولية، تُفرغ الصراع الطبقي من مضمونه البنيوي، وتستبدل التحليل التاريخي بسرديات البطولة الفردية.
كثيراً ما جرى اختزال موقف بليخانوف في صورة حتمية ميكانيكية، وكأن التاريخ يسير وفق قوانين صماء لا مكان فيها للفعل الواعي. غير أن هذا الفهم يتجاهل السياق الجدلي الذي كتب فيه بليخانوف، كما يتجاهل طبيعة الخصم النظري الذي كان يواجهه. فبليخانوف لم يكن بصدد نفي الفعل، بل نفي الوهم القائل بأن الإرادة الفردية تستطيع القفز فوق الشروط الموضوعية وتجاوزها بإرادة صافية.
في الواقع، ما كان يحذّر منه بليخانوف هو تحويل السياسة إلى مغامرة منفصلة عن الواقع الاجتماعي. وبهذا المعنى، يضع حداً نظرياً واضحاً بين الفعل الممكن والفعل الوهمي. غير أن هذا التحليل، حين يُنقل ميكانيكياً إلى مستوى الصراع السياسي المباشر، قد يتحول إلى مصدر شلل عملي، إذا لم يُستكمل بمستوى تحليلي آخر، وهو ما سيقوم به لينين لاحقاً.
لينين ونقل الإشكال إلى مستوى الصراع السياسي
في لحظات تاريخية معينة، لا يعود السؤال الجوهري: هل نضجت الظروف تاريخياً بصورة مكتملة؟ بل: كيف نتصرف داخل هذه الظروف القائمة، وبأي أدوات، وبأي تنظيم؟ هنا يبرز دور الفرد المنظَّم، لا بوصفه عبقرياً معزولاً أو قائداً كاريزمياً، بل بوصفه جزءاً من قيادة سياسية واعية، قادرة على قراءة ميزان القوى، وتحديد الأولويات، واتخاذ القرار المناسب في اللحظة المناسبة. لينين لا ينفي القوانين التاريخية، لكنه يرفض تحويلها إلى مبرر للانتظار السلبي أو إلى ذريعة لتعليق الفعل إلى أجل غير مسمى.
في هذا السياق، تتضح أهمية ما سيطوّره لينين لاحقاً في مفهوم الحزب الطليعي، لا باعتباره تنظيماً فوق المجتمع أو بديلاً عنه، بل بوصفه الأداة التاريخية التي يتجسّد من خلالها العامل الذاتي في أعلى أشكاله تنظيماً ووعياً. فالحزب الطليعي هو الإطار الذي تُكثَّف فيه الخبرة السياسية، ويُحوَّل فيه الوعي النظري إلى استراتيجية عملية، وتُربط فيه المبادرة الفردية بالفعل الجماعي المنظَّم. ومن دون هذا الإطار، يبقى دور الفرد عرضة للتشتت، وتظل السياسة أسيرة العفوية أو ردود الفعل الآنية، مهما بلغت حدّة التناقضات الموضوعية، والتي سأجد من المفيد التطرّق لها لاحقاً لأهميتها في فهم دور العامل الذاتي، والشروط التاريخية التي أفرزت هذه الصياغة اللينينية وحدودها.
بهذا المعنى، يكتسب الفعل السياسي وزناً نوعياً حاسماً. فالخطأ أو الصواب في التقدير والتحليل، والتوقيت الذي يُتَّخذ فيه القرار أو يُؤجَّل، وشكل التنظيم من حيث بنيته ومرونته وقدرته على الاستمرار، وبنية الكادر السياسي من حيث خبرته، وتجذّره الاجتماعي، ومستوى وعيه وانضباطه، وطبيعة التحالفات وحدودها الطبقية والسياسية، كلّها ليست تفاصيل ثانوية أو اعتبارات تقنية معزولة، بل عناصر حاسمة قد تغيّر مسار الصراع داخل حدود الشروط التاريخية القائمة.
فطريقة قراءة ميزان القوى، واختيار لحظة التدخل أو الانكفاء، وتحديد أشكال النضال الملائمة، وبناء جهاز تنظيمي قادر على التعلّم من التجربة لا إعادة إنتاج الأخطاء، وانتقاء تحالفات توسّع أفق الصراع ولا تفرغه من مضمونه الطبقي، جميعها عوامل تتداخل جدلياً في تحديد اتجاه الحركة السياسية. الفرد هنا لا يصنع التاريخ من العدم، ولا يقف فوق قوانينه الموضوعية، لكنه قد يكون عاملاً مقرِّراً في كيفية تجلّي التناقضات التاريخية، وفي المسار الذي تتخذه، تقدّماً أو انتكاساً، تبعاً لموقعه داخل تنظيم واعٍ وقدرته على تحويل الإمكان التاريخي إلى فعل سياسي منظَّم.
ما يميّز لينين هو إدراكه العميق لدور السياسة بوصفها وسيطاً جدلياً بين البنية والفعل. السياسة ليست خارج التاريخ، لكنها ليست ذوباناً سلبياً فيه أيضاً. إنها المجال الذي تُترجم فيه التناقضات البنيوية إلى قرارات عملية وخيارات تنظيمية. ولهذا، فإن دور الفرد عند لينين لا يُفهم إلا داخل التنظيم، وضمن رؤية استراتيجية واضحة، وهو ما يمنع السقوط في ثنائية زائفة: إما حتمية تاريخية تُلغي الفعل، أو إرادوية سياسية تتجاهل الواقع. السياسة، في هذا المعنى، هي ممارسة واعية داخل شروط محددة، لا استسلام لها ولا قفز فوقها.
القراءة الجدلية لبليخانوف ولينين تكشف أن الاختلاف بينهما ليس تناقضاً، بل بوصفه اختلاف مستويات تحليل لا تناقضات نظرية. بليخانوف يشتغل على مستوى التاريخ كشرط عام، ولينين يشتغل على مستوى السياسة كفعل داخل هذا الشرط. الأول يحدد الإطار، والثاني يحدد كيفية الحركة داخله. وهذا التكامل ضروري لفهم دور الفرد في التاريخ دون الوقوع في أيديولوجيا الهزيمة أو أوهام البطولة.
العامل الذاتي: المفهوم والحدود في المادية التاريخية
يُعدّ مفهوم العامل الذاتي من أكثر المفاهيم التباساً داخل الفكر الماركسي، لا بسبب غموضه النظري في ذاته، بل نتيجة الاستخدامات المتناقضة له في التحليل السياسي والتنظيمي. ففي كثير من الحالات، يُستدعى العامل الذاتي إمّا بوصفه إرادة فردية مطلقة يُفترض أنها قادرة على كسر كل القيود، أو يُهمَّش كلياً لصالح تفسير حتمي يُرجع كل شيء إلى البنية والظروف الموضوعية. كلا الاستخدامين، في الواقع، يعكسان قراءة مبتسرة للمادية التاريخية، ويقودان عملياً إلى أخطاء سياسية وتنظيمية ذات أثر عميق.
في المنظور الماركسي، لا يُفهم العامل الذاتي بوصفه معطى نفسياً أو أخلاقياً، بل كنتاج تاريخي مركّب، يتشكّل من تفاعل ثلاثة عناصر أساسية: الموقع الاجتماعي، مستوى الوعي، وشكل الممارسة. فلا يكفي، على سبيل المثال، أن يكون الفرد منتمياً إلى طبقة مضطهدة كي يصبح فاعلاً تاريخياً، كما لا يكفي امتلاك وعي نظري مجرد، ما لم يكن هذا الوعي مرتبطاً عضوياً بالممارسة الاجتماعية الفعلية.
يتكوّن العامل الذاتي عندما تتحول التجربة الاجتماعية إلى وعي، ويتحوّل هذا الوعي بدوره إلى ممارسة منظّمة. وهذه الحركة ليست تلقائية ولا تسير في خط مستقيم؛ إنها عملية معقدة تمر بتناقضات وانتكاسات وقفزات نوعية. ومن هنا، فإن العامل الذاتي ليس عنصراً ثابتاً أو مكتسباً نهائياً، بل متغير تاريخي يتقدّم ويتراجع تبعاً لشروط داخلية وخارجية. وبهذا المعنى، لا يُختزل العامل الذاتي في الفرد، ولا يُلغى لصالح البنية، بل يشكّل حلقة الوصل الجدلية بينهما، حيث تتجسّد الشروط الموضوعية في وعي وممارسة قوى اجتماعية محددة.
من الأخطاء الشائعة الخلط بين العامل الذاتي والإرادة الفردية. فالإرادة الفردية، مهما بلغت من الصدق أو التضحية، تظل محدودة التأثير إذا لم تُدمج في إطار اجتماعي منظَّم. التاريخ، ببساطة، لا يتقدم بفعل النوايا الحسنة، بل بفعل قوى اجتماعية جبارة قادرة على تحويل النوايا إلى أفعال ذات أثر مادي.
العامل الذاتي، في معناه الدقيق، هو القدرة الجماعية المنظَّمة على الفعل داخل شروط تاريخية معينة. وهو يتجسد في التنظيم، وفي الانضباط الواعي، وفي القدرة على اتخاذ القرار، وفي الاستعداد لتحمّل تبعات الفعل السياسي. الفرد هنا لا يختفي، بل يجد معناه داخل الكل الاجتماعي، حيث تتحول مبادرته من فعل معزول إلى طاقة تاريخية فاعلة. وهذا التمييز ضروري لتجنّب النزعة الإرادوية التي تُحمّل الأفراد ما يفوق طاقتهم التاريخية، كما هو ضروري لتجنّب النزعة الحتمية التي تنفي أي دور للفاعل الاجتماعي المنظَّم.
الاعتراف بدور العامل الذاتي لا يعني، بأي حال، تجاهل حدوده. فالفعل التاريخي ليس مطلق الحرية، بل محكوم بإطار من الشروط الموضوعية التي لا يمكن تجاوزها بالإرادة وحدها. ميزان القوى، مستوى تطور البنية الاقتصادية، شكل الدولة، ودرجة وعي الجماهير، كلها عوامل تضع حدوداً واقعية لما يمكن تحقيقه في لحظة تاريخية معينة.
غير أن هذه الحدود ليست جدراناً صماء أو قدراً نهائياً. إنها حدود متحركة، يمكن توسيعها أو تضييقها بفعل التنظيم، والقيادة، والرؤية السياسية. فالعامل الذاتي القوي لا يلغي القيود، لكنه يتعامل معها بوعي، ويبحث داخلها عن نقاط الاختراق الممكنة.
المشكلة تبدأ عندما تُحوَّل هذه الحدود إلى مبرر دائم للعجز، أو عندما يُطلب من العامل الذاتي ما يتجاوز قدرته الفعلية. في الحالتين، تكون النتيجة واحدة: إمّا إحباط يفضي إلى الانكفاء، أو مغامرة تنتهي إلى الهزيمة.
يمكن النظر إلى مستوى تطور العامل الذاتي بوصفه معياراً أساسياً لقياس النضج السياسي لأي حركة أو تنظيم. فالسؤال الحاسم ليس كم هو حجم القمع أو شراسة الخصم، بل كيف تُقرأ هذه الوقائع، وكيف يُبنى عليها فعل سياسي واقعي.
التنظيم الذي يمتلك عاملاً ذاتياً متطوراً لا يتفاجأ بالهزائم، ولا يحوّلها إلى قدر محتوم. بل يعيد تحليلها، ويستخلص دروسها، ويعيد تنظيم قواه على هذا الأساس. أما التنظيم الذي يفتقر إلى هذا العامل، فيميل إمّا إلى تبرير الفشل بالظروف الموضوعية، أو إلى تحميل الأفراد مسؤولية أخلاقية معزولة عنه. العامل الذاتي، بهذا المعنى، ليس مجرد أداة للفعل، بل أداة للفهم الذاتي والنقد الداخلي أيضاً، وهو ما يمنع تحوّل الهزيمة من تجربة تاريخية محددة إلى أيديولوجيا شاملة.
إن غياب الفهم الجدلي للعامل الذاتي يفتح الباب واسعاً أمام أيديولوجيا الهزيمة. فعندما يُلغى دور الفاعلية المنظمة، تصبح الظروف الموضوعية تفسيراً جاهزاً لكل إخفاق. وحين يُفصل العامل الذاتي عن شروطه الواقعية، تتحول السياسة إلى مغامرة معزولة عن المجتمع والتاريخ.
ومن هنا، فإن نقد أيديولوجيا الهزيمة يبدأ بإعادة الاعتبار للعامل الذاتي بوصفه إمكانية تاريخية، لا ضمانة مسبقة للانتصار، ولا ذريعة جاهزة للفشل. إنه مجال للصراع، وللتطور، وللتعلّم المستمر. ومن دون هذا الفهم، تبقى الماركسية إمّا نظرية تفسير بلا فعل، أو ممارسة بلا وعي.
التنظيم السياسي والقيادة الواعية – من الفعل العفوي إلى الفعل التاريخي المنظَّم
إذا كان العامل الذاتي يمثل الإمكانية التاريخية للفعل، فإن التنظيم السياسي والقيادة الواعية يشكّلان الإطار الذي تتحقق فيه هذه الإمكانية أو تُجهَض بالكامل. فلا وجود في التاريخ لفعل طبقي مؤثر دون تنظيم واضح، كما لا يمكن للقيادة الثورية أن تتجسد خارج وضوح الرؤية السياسية. فالعفوية، مهما بلغت شدتها، تظل طاقة مبعثرة، قابلة للاستنزاف أو الاحتواء، ما لم تُصغ ضمن مشروع سياسي منظَّم يمتلك أدواته التنظيمية وقدرته على التوجيه الاستراتيجي. وفي هذا السياق، لا يُنظر إلى التنظيم والقيادة بوصفهما مسألة تقنية أو إدارية فحسب، بل باعتبارهما قضية تاريخية–سياسية محورية، يتحدد على أساسها ما إذا كانت الحركة قادرة على تحويل التناقضات الموضوعية إلى فرص نضالية، أو ستبقى أسيرة ردود الفعل والتبريرات المتكررة للهزيمة، مع مراعاة العلاقة الجدلية بين القيادة والقاعدة، وبين وضوح الرؤية ومزاج الجماهير، وبين الانضباط والقدرة على التجديد والتكيّف.[2]
لا يتحول الوعي الطبقي إلى قوة مادية إلا عندما يتجسّد في تنظيم مستمر وفاعل. فالتنظيم ليس إطاراً خارجياً يُضاف إلى النضال من الخارج، بل هو شرط وجوده التاريخي المستدام؛ وبدونه يبقى الوعي مشتتاً، وتظل المبادرات فردية، وتتحول التضحيات إلى رموز فارغة لا يتراكم من خلالها أي رصيد فعلي للقوة. التنظيم هو الذي يربط بين التجربة والذاكرة، بين الفعل ونتائجه، وبين الهزيمة والتعلّم المستمر. ومن دونه، تتكرر الأخطاء نفسها تحت عناوين مختلفة، وتُعاد الهزائم وكأنها مفاجآت قدرية، في حين أن ضعف التنظيم لا يعني فقط ضعف القدرة على الفعل، بل يعني أيضاً ضعف القدرة على الفهم التاريخي لما يجري، وللشروط التي تشكّل الإمكانات المتاحة.
القيادة في الفكر الماركسي ليست نخبة تعلو فوق الجماهير، ولا مجرد انعكاس ميكانيكي لمزاجها الآني، بل هي موقع جدلي يتطلب قدرة مزدوجة على التمثيل والتوجيه. فالقيادة الثورية تلتقط التناقضات الكامنة في الواقع الاجتماعي، وتحوّلها إلى برنامج سياسي قابل للتنفيذ، يحافظ على توازن دقيق بين مصالح التنظيم واحتياجات الجماهير. وعندما تفقد القيادة هذه القدرة، تنزلق إما إلى الشعبوية، فتصبح أسيرة المزاج السائد، أو إلى الوصاية، فتنفصل عن القاعدة الاجتماعية. في الحالتين، يتعطل العامل الذاتي، ويتحوّل التنظيم إلى جهاز فارغ أو إلى عبء ثقيل. ووضوح الرؤية السياسية هنا ليس مسألة خطابية أو بلاغية، بل شرط أساسي لثقة التنظيم بنفسه وبجماهيره، وشرط لتحمّل المسؤولية عن القرارات، لا الهروب منها عند الفشل.[3]
كلما غابت الرؤية السياسية الواضحة، اتسع المجال أمام التفسيرات التبريرية للهزيمة. فالقيادة غير الواثقة من خطها تميل إلى ردّ الفشل إلى عوامل خارجية مطلقة: المال السياسي، السلاح المنفلت، وعي الجماهير، التدخلات الإقليمية، أو انتشار الطائفية والمصالح الفردية. وهذه العوامل موجودة بالفعل، لكنها تتحول في هذا السياق من أدوات تحليل ضرورية إلى أدوات إعفاء من المسؤولية. وهنا تتشكّل أيديولوجيا الهزيمة التي تقول، بشكل ضمني: «لا جدوى من الفعل، فالظروف تحسم النتائج مسبقاً». والخطورة لا تكمن في هذا الاستنتاج النظري وحده، بل في أثره التراكمي على التنظيم والجماهير، حيث يُزرع الإحباط بوصفه وعياً، والانكفاء بوصفه حكمة سياسية.
في هذا الإطار، يأخذ خطاب تبرير الهزيمة بعداً ساخراً ومأساوياً في آن واحد. يمكن، على سبيل المثال، تشبيه التعلّل المستمر بالعامل الموضوعي لتبرير الفشل بحال مفلس يلجأ إلى الخمر أو المخدرات كي يتجاهل أزمته المالية: هو يدرك أن ديونه لم تختفِ، وأن الأرقام تتضاعف، لكنه يفضّل نشوة قصيرة العمر على مواجهة الواقع. والسخرية السوداء هنا أن هذه النشوة نفسها تتطلب أموالاً إضافية، فتزيد أعباء الأزمة القائمة. وهكذا تفعل بعض القيادات والتيارات الانتهازية، حين توظّف أدواتها من مثقفين وكتّاب وصوليين لتحويل «الظروف الموضوعية» إلى مخدّر نظري، يُسكَّت به سؤال التنظيم، ويُنوَّم به غضب الجماهير، ويُمنح به مبرر أنيق للعجز. لكن الثمن يُدفع من رصيد الوعي والمبادرة والتنظيم، ومع كل هزيمة تُسكب جرعة جديدة من التبرير، حتى تتحول الهزيمة إلى أسلوب حياة، والعجز إلى حكمة، والانكماش إلى فضيلة سياسية.
في المقابل، يمثّل التنظيم الواعي الأداة الفاعلة الوحيدة لكسر هذه الحلقة المغلقة التي تعيد إنتاج العجز والهزيمة. فهو القادر على التمييز بين ما هو موضوعي لا يمكن تغييره فوراً، بوصفه معطى تاريخياً قائماً، وبين ما هو سياسي يمكن العمل عليه تدريجياً عبر التخطيط، وتراكم الخبرة، وتعديل أشكال النضال. ومن خلال هذا التمييز، يتحوّل الفشل من نهاية مغلقة تُفضي إلى الانسحاب، إلى لحظة تعليم سياسي تُستخلص منها الدروس وتُعاد صياغة الاستراتيجيات.
فبدل الانسحاب من العملية الانتخابية بذريعة هيمنة المال السياسي، يمكن تطوير أدوات مواجهة تنظيمية وجماهيرية أوسع، تفضح هذا النفوذ، وتحدّ من تأثيره، وتبني حضوراً تراكمياً ولو بحدوده الدنيا. وبدل انتظار وعي مثالي ومسبق لدى الجماهير، يمكن العمل على رفع هذا الوعي من خلال الممارسة اليومية، والانخراط في الصراع الفعلي، لا عبر الوعظ الأخلاقي أو الخطاب التجريدي. هذا الفهم لا يهوّن من صعوبة الشروط الموضوعية، ولا يتجاهل قسوتها، لكنه يرفض تحويلها إلى ذريعة دائمة للعجز، ويؤكد أن السياسة تبدأ تحديداً من العمل داخل هذه الشروط، لا من الاستسلام لها.
في جوهرها، القيادة الثورية مسؤولية تاريخية وليست وظيفة تبريرية. فعندما تتحول القيادة إلى جهاز لإنتاج خطاب يبرّر الفشل، فإنها لا تحمي التنظيم، بل تدمّره من الداخل، وتفصل بين القول والفعل، وبين التحليل والممارسة، وتفرغ السياسة من بعدها النضالي. أما القيادة الفعالة فتُقاس بقدرتها على قول الحقيقة للتنظيم والجماهير، حتى حين تكون هذه الحقيقة قاسية، وبقدرتها على إبقاء الأفق مفتوحاً، لا على إغلاقه تحت شعار الواقعية. فهي الوسيط التاريخي الذي يربط بين الإمكان والفعل، ويحوّل العامل الذاتي من طاقة مبعثرة إلى قوة جماعية منظَّمة، قادرة على مواجهة الظروف الموضوعية وتحويلها إلى فعل تاريخي ملموس.
القيادة ووضع الرؤية السياسية كشرط لتفعيل الفعل التاريخي
تتجلى أهمية القيادة في أي حركة سياسية أو ثورية ليس في صفات شخصية أو كاريزما فردية، بل في قدرتها على أن تكون وظيفة تاريخية تعكس مصالح الجماهيير وقدرتها على التوجيه في لحظة تاريخية محددة. فالقيادة الفعّالة هي التي تحول الإمكانات الموضوعية إلى فعل مؤثر، وتربط بين التحليل البنيوي للواقع الاجتماعي والمهام العملية للنشاط السياسي المنظّم، بحيث لا يتحول العامل الذاتي إلى طاقة مشتتة أو ردود فعل عفوية بلا أثر. الرؤية السياسية الواضحة هي الشرط الأساسي الذي يحدد قدرة القيادة على توجيه التنظيم وتحفيز الجماهير، فهي التي تمنع الانزلاق إلى العفوية أو الارتجال، وتتيح التوقيت الصحيح لاتخاذ القرارات، مع الحفاظ على مرونة كافية لمواجهة الظروف غير المتوقعة.
تأخذ القيادة في هذا السياق شكل وسيط بين الإمكانات والفعل، حيث تكون المسؤولية التاريخية للقيادة هي توجيه الجهود المتاحة وتحويل الفرص الموضوعية إلى استراتيجية عملية قابلة للتنفيذ. القيادة لا تتحقق إلا عبر تفاعل مستمر مع التنظيم، إذ لا معنى للقيادة المنفصلة عن قاعدتها، ولا جدوى للتنظيم بلا قيادة تمتلك وضوح الرؤية والقدرة على اتخاذ القرارات. هذا التفاعل الجدلي بين القيادة والتنظيم هو الذي يضمن أن الفعل السياسي ليس مجرد رد فعل، بل عملية متواصلة تتفاعل فيها القدرة الفردية والجماعية مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية، بما يحقق تراكماً تاريخياً حقيقياً للوعي والقوة.
وضوح الرؤية السياسية لا يعني مجرد تقديم خطابات تحليلية أو شعارات نظرية، بل يرتبط مباشرة بالقدرة على تحديد الأولويات، ووضع استراتيجيات قابلة للتطبيق، وتحويل الإمكانات الموضوعية إلى خطوات ملموسة. في غياب هذا الوضوح، يصبح الفعل السياسي هشاً، والعجز مُبرَّراً بسهولة، حيث تتحول الظروف الموضوعية إلى حجج مطلقة تمنع المبادرة، وتعمّق الإحباط لدى الجماهير. وهنا يظهر الدور الحاسم للقيادة في تحويل الهزائم المحتملة إلى فرص للتعلّم السياسي وتنمية قدرة التنظيم على المبادرة والتخطيط.
إن القيادة التي تفهم دورها بوصفه وظيفة تاريخية تعرف كيف تمنع الانزلاق إلى التبرير السلبي والفشل المعتمد على الظروف. فهي تميز بين ما هو قابل للتغيير وما هو ثابت نسبياً، وتعمل على استثمار الإمكانات المحدودة لتحقيق أكبر أثر ممكن. في هذا السياق، تصبح القيادة وسيلة لتحويل الفعل الفردي والعفوي إلى فعل تاريخي منظّم، قادر على مواجهة العقبات الموضوعية، سواء كانت مادية أو اجتماعية أو سياسية، مع الحفاظ على روح المبادرة والتجديد داخل التنظيم.
القيادة هنا ليست مجرد إدارة للأزمات، بل أداة لضمان استمرار حركة العامل الذاتي في التاريخ، وحماية التنظيم من الانكماش السياسي والثقافي. فهي تحفظ التنظيم من الانغماس في أيديولوجيا الهزيمة، التي تحوّل الفشل إلى منطق دائم، وتؤدي إلى الجمود، وتعطل الفعل الجماعي. القيادة الثورية الناجحة هي التي تحافظ على توازن بين الواقعية والتحفيز، بين تقدير الظروف الموضوعية والاستفادة من الإمكانات المتاحة، وبين الحفاظ على وحدة التنظيم وتحفيز الجماهير على المشاركة الفاعلة.
بهذه الطريقة، يصبح الفعل السياسي، عبر القيادة الواضحة والرؤية المستنيرة، عملية تاريخية متكاملة، تتفاعل فيها الإمكانات الموضوعية مع الفعل المنظّم، ويستعيد التنظيم دوره كفاعل تاريخي قادر على مواجهة الظروف، والتعلم من الهزائم، وتحويلها إلى فرص للنمو السياسي والاجتماعي. فالقيادة ليست مجرد شخصيات تقود التنظيم، بل وظيفة حيوية، تعكس جدلية البنية والفعل، وتمثل الجسر بين الإمكانات التاريخية للفرد والوعي الجماعي والتنظيمي.
أيديولوجيا الهزيمة – إعادة تفسير الفشل وتأثيرها على التنظيم والجماهير
في السياق التنظيمي والسياسي، لا تتوقف الهزيمة عند حدود الحدث العيني أو النتيجة الظرفية، بل غالباً ما تتحول إلى منطق داخلي دائم، يعيد تشكيل الثقافة التنظيمية وأنماط السلوك الجماهيري. عند هذه النقطة، لا تعود الهزيمة مجرد إخفاق قابل للتحليل والتجاوز، بل تتبلور كأيديولوجيا متكاملة يمكن تسميتها بـ«أيديولوجيا الهزيمة». هذه الأيديولوجيا تتجسد حين يُردّ كل فشل، بصورة آلية ومطلقة، إلى العوامل الموضوعية وحدها: الهيمنة المالية، السلاح المنفلت، تدني وعي الجماهير، أو تفشي المصالح الفردية والطائفية. في هذا المنظور، يصبح الفشل أداة لإعادة إنتاج العجز الداخلي، وآلية لتثبيت الجمود التاريخي داخل التنظيم، وإخماد كل مبادرة فردية أو جماعية قبل أن ترى النور.
تنتج أيديولوجيا الهزيمة هزيمة مزدوجة ومترابطة. الهزيمة الأولى تنظيمية، حيث يسود الشلل، وتغيب المبادرات، ويتراجع الإبداع الاستراتيجي، ويغدو اتخاذ القرار فعلاً متردداً أو مؤجلاً إلى ما لا نهاية. في هذا السياق، تفقد القيادة قدرتها على التوجيه، ويتحول الفعل السياسي من ممارسة واعية إلى ردود أفعال محدودة ومتأخرة. أما الهزيمة الثانية فهي جماهيرية، إذ يُنتج الإحباط شعوراً عاماً بالعجز، ويُضعف المشاركة النشطة، ويكرّس اعتماداً سلبياً على القيادة. تتحول الجماهير إلى كتلة في حالة انتظار دائم، تترقب القرار من الأعلى، بينما تُقمع الطاقة الثورية المحتملة تحت وطأة الخوف من المبادرة والإحساس بالعجز، وكأن التاريخ نفسه قد أُغلق في وجوههم.
الأثر النفسي لأيديولوجيا الهزيمة عميق وتراكمي. فهي تزرع في وعي الفرد قناعة راسخة بعدم جدوى الفعل، وبأن أي محاولة للتغيير ستصطدم بحتمية الفشل. يتحول الانسحاب النفسي إلى عادة، والإحباط المزمن إلى نمط سلوكي، بينما يغدو تبرير الهزائم المتكرر مخدّراً تنظيمياً وجماهيرياً يضاعف التردد ويشل القدرة على المبادرة. في هذا المناخ، لا تعود الهزيمة تجربة ظرفية، بل تتحول إلى ثقافة متكاملة، يصبح فيها الفشل معياراً مسبقاً لتقييم أي خطوة سياسية، وأي فعل نضالي، حتى قبل الشروع فيه.
تتفاقم هذه الظاهرة عندما تُستَخدم العوامل الموضوعية كذرائع جاهزة للتوقف عن الفعل. فالمال السياسي والسلاح المنفلت يتحولان إلى مبرر لإلغاء المشاركة السياسية، لا إلى معطيات تستدعي ابتكار أدوات مواجهة جزئية. وضعف وعي الجماهير يُطرح كحقيقة ثابتة تُعفي التنظيم من مسؤوليته في العمل على رفع هذا الوعي عبر الممارسة والتنظيم. النتيجة هي تضاعف الإحباط، وتجذّر الانسحاب السياسي، وتحول الثقافة التنظيمية من روح المبادرة والمخاطرة الواعية إلى خوف دائم من الخطأ، وانتظار سلبي لا ينتج سوى إعادة إنتاج الجمود.
هذا التراكم النفسي والاجتماعي لا يبقى في حدود السلوك الفردي، بل ينعكس جدلياً على بنية التنظيم نفسها. يتراجع الحافز على الابتكار، وتضعف الثقة المتبادلة بين القيادة والقاعدة، ويصبح كل فعل تنظيمي محكوماً بشبح الهزائم السابقة. تعمل أيديولوجيا الهزيمة هنا كحلقة مغلقة: تبرر نفسها بنفسها، وتعيد إنتاج التبريرات، وتكرّس الانكماش، فتستمر الهزيمة الرمزية حتى في لحظات تغيّر الشروط الموضوعية.
إن جوهر نقد أيديولوجيا الهزيمة يقوم على إعادة الاعتبار للعامل الذاتي، وتحديداً للأخطاء الذاتية داخل التنظيم والحركة السياسية بوصفها عاملاً حاسماً في مسار الفعل التاريخي. من هنا، يصبح النقد الذاتي، ومحاسبة القيادة، بل وإقصاؤها عند الضرورة، شرطاً لبقاء الفعل السياسي فاعلاً ومؤثراً. فأيديولوجيا الهزيمة لا تشكل مجرد خلل تحليلي، بل تمثل خطراً وجودياً على التنظيم، لأنها تفرغ التاريخ من معناه النضالي، وتحول الهزيمة من نتيجة قابلة للتجاوز إلى ثقافة مؤسِّسة للعجز الاجتماعي والسياسي.
كسر هذه الحلقة المغلقة ليس مهمة ظرفية، بل مسؤولية تاريخية مشتركة تقع على عاتق القيادة والتنظيم معاً. ويتحقق ذلك عبر توجيه الفعل لا تعطيله، وتحويل الفشل إلى لحظة تعليم سياسي، وإعادة بناء ثقة الجماهير بقدرتها على المبادرة. وحده هذا المسار قادر على تفكيك الهيمنة النفسية لأيديولوجيا الهزيمة، وإحياء الفعل التاريخي بوصفه ممارسة واعية، مفتوحة على الإمكان، وقادرة على تحويل الطاقة الكامنة إلى قوة جماعية منظمة.
[1] كارل ماركس، الثامن عشر من برومير لويس بونابرت
[2] فلاديمير لينين، ما العمل
[3] أنطونيو غرامشي، دفاتر السجن