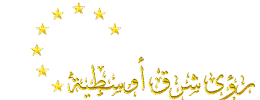تُعدّ المنظمات الجماهيرية في كل مجتمع مختبراً حياً لتفاعل البنية الطبقية مع البنية السياسية، وساحةً تتجسّد فيها التناقضات الاجتماعية في أكثر صورها وضوحاً. فهي لا تُفهم إلا في سياق الصراع بين قوى التغيير التي تسعى إلى إعادة بناء المجتمع على أسس مدنية ديمقراطية، وبين القوى المحافظة التي تعمل على إعادة إنتاج النظام الاجتماعي القائم. وبعبارة ماركس، ليست هذه المنظمات “قشرةً فوقيةً” للحياة الاجتماعية، بل تعبير مباشر عن حركة التناقضات داخل البنية التحتية ذاتها، أي بين الطبقات ومواقعها المتعارضة في عملية الإنتاج.
فالمنظمات الجماهيرية، على اختلاف أشكالها (نقابات، اتحادات طلابية، منظمات نسوية، جمعيات مهنية أو مدنية)، لا تنشأ في فراغ، بل تعكس ــ في بنيتها ووظيفتها ــ طبيعة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية السائدة. ولذلك، يمكن القول إنها مرآة الصراع الاجتماعي كما وصفه أنطونيو غرامشي في دفاتر السجن، حين أشار إلى أن المجتمع المدني هو “ميدان الهيمنة الطبقية عبر الثقافة والتنظيم”، أي أنه المجال الذي تُخاض فيه معركة الوعي، لا السلاح فقط.
في المجتمعات المنقسمة بين التقليد والحداثة، يظهر هذا الصراع بأشكال متباينة. فثمة نوع من المنظمات ينسجم مع منطق المجتمع الأهلي التقليدي، إذ يقوم على روابط الانتماء الأولي: العشيرة، الطائفة، المذهب، أو المرجعية الدينية. هذه المنظمات لا تُعيد إنتاج البنى التقليدية فحسب، بل تساهم في شرعنتها ضمن الفضاء السياسي، فتصبح الولاءات الخاصة بديلاً عن المواطنة، والمحسوبية بديلاً عن الكفاءة، والطاعة بديلاً عن المشاركة. هنا، يتحول الفضاء الجماهيري إلى امتداد لبنية الهيمنة التقليدية، لا إلى أداة لتفكيكها.
في المقابل، تظهر منظمات حديثة تسعى إلى إعادة تعريف الانتماء على أساس المواطنة والحق والمشاركة المتساوية. هذه المنظمات هي التعبير الاجتماعي للمجتمع المدني، أي كمجال مقاومة للهيمنة، وكقوة مضادة للبنى التقليدية والطبقية المسيطرة. فالمنظمة المدنية لا تكتفي بتمثيل الأفراد، بل تُعيد إنتاج الوعي الجماعي في شكل جديد يقوم على الإرادة الحرة لا على الطاعة العمياء، وعلى المصلحة العامة لا على الامتياز الطائفي.
ببساطة، يمكن القول إن المنظمات الجماهيرية تمثل ميداناً مفتوحاً للصراع بين نمطين من التنظيم الاجتماعي: نمط أهلي يُعيد إنتاج الولاء الشخصي، ونمط مدني يسعى إلى تأسيس علاقة سياسية عقلانية بين الفرد والمجتمع والدولة. وهي بهذا المعنى لا تنفصل عن جدلية التاريخ ذاته: فكل تقدم في بنية المنظمات المدنية يعكس تقدماً في مستوى الوعي الاجتماعي، وكل تراجعٍ نحو البنى الأهلية يعني انكماش الفضاء المدني لحساب سلطة الماضي.
يظهر هذا التناقض بوضوح في تجارب بلدان مثل لبنان والعراق واليمن، حيث تحولت الأحزاب الطائفية إلى واجهات سياسية للمجتمع الأهلي، بينما بقيت المنظمات المدنية الضعيفة تحاول شقّ طريقها وسط نظام من الولاءات المغلقة. فالأحزاب المحافظة هنا تتغذى من بنية المجتمع الأهلي نفسها، إذ تعيد إنتاجه في شكل مؤسسات حزبية تعتمد على الزعامة والقرابة والولاء. هذه الأحزاب لا تعادي الدولة الحديثة فقط، بل تفرغها من مضمونها عبر ربطها بشبكات الزعامة والمحاصصة.
أما القوى اليسارية والمدنية، فإنها تحاول باستمرار بناء منظمات جماهيرية تعبّر عن مشروع مغاير: مشروع تحرري يسعى إلى نقل الإنسان من موقع التبعية إلى موقع الفاعلية. إن مهمة هذه القوى لا تقتصر على التمثيل السياسي، بل تتعداه إلى إعادة بناء الوعي الجمعي ذاته. فهي تحاول أن تخلق إنساناً جديداًأي إنساناً تاريخياً واعياً بدوره في الصراع، لا مجرد تابع في شبكة الولاءات.
من هنا، فإن المنظمات الجماهيرية ليست حيادية كما يتوهم البعض، بل هي ساحة صراع على المعنى، على الوعي، وعلى تعريف السياسة نفسها. فالقوى المحافظة تحاول استخدامها لتثبيت النظام القائم، بينما تراها القوى اليسارية والمدنية أداة لتحطيم هذا النظام من الداخل. إنها تتجاوز كونها “هياكل تنظيمية” لتصبح جزءاً من البنية الأيديولوجية للصراع، حيث ينعكس فيها التناقض بين ما هو قائم وما يمكن أن يكون.
ومن المفيد هنا التذكير بأن ماركس نفسه رأى في النقابات العمالية نواة أولى لوعي طبقي جمعي، حين تتحول من أدوات لتحسين الأجور إلى أدوات لتنظيم النضال ضد رأس المال. فكما كانت النقابة في القرن التاسع عشر ميداناً لتشكل الوعي الاجتماعي، يمكن للمنظمات المدنية اليوم أن تكون ميداناً لتشكل وعي المواطنة والتحرر. إنها المساحة التي يمكن أن يتكوّن فيها، عبر الممارسة، وعي جديد بالعلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة.
إن فهم المنظمات الجماهيرية من هذا المنظور يتطلب ربطها بالبنية الاقتصادية والاجتماعية التي تنتجها. فهي انعكاسٌ لا للسياسة فقط، بل لتوازنات القوى الطبقية في المجتمع. ففي الدول الريعية، حيث تُوزَّع الثروة عبر الولاء السياسي، تضعف إمكانيات بناء منظمات مستقلة، لأن المجتمع نفسه قائم على التبعية الاقتصادية. بينما في المجتمعات التي شهدت نشوء طبقة وسطى متعلمة ومنتجة، تظهر منظمات قادرة على بلورة مطالب مدنية حديثة.
باختصار، يمكن القول إن المنظمات الجماهيرية تُجسد على نحو ملموس الصراع بين “هيمنة قديمة” و”مشروع تحرري جديد”. وهي بهذا المعنى، كما وصفها ألتوسير، جزء من “جهاز أيديولوجي” للصراع الطبقي، لكنه جهاز مفتوح يمكن تحويله من أداة للهيمنة إلى أداة للمقاومة. إنها مرآة للمجتمع، لكنها أيضاً أداة لتغييره، ومجالٌ تتصارع فيه سرديات الماضي والمستقبل على جسد الحاضر.
المجتمع الأهلي كحاضنة عضوية للمحاصصة والفساد
يُشكّل المجتمع الأهلي في البلدان ذات البنية التقليدية – سواء في المشرق العربي أو في مجتمعات ما بعد الاستعمار – قاعدةً عضوية للنظام السياسي المحافظ. فهو ليس مجرد بقايا تاريخية من زمن ما قبل الدولة الحديثة، بل جهاز فعّال داخل منظومة السيطرة الطبقية والزبائنية، يعمل على إعادة إنتاجها بأشكال رمزية ومادية معاصرة. في الظاهر يبدو المجتمع الأهلي شبكة تضامن اجتماعي تحافظ على قيم الانتماء والعائلة والعشيرة، لكنه في جوهره، ضمن التشكيلة الاجتماعية الرأسمالية التابعة، يتحول إلى بنية وظيفية للهيمنة، أي إلى شكل من أشكال السلطة الموازية التي تضمن استمرار النظام السياسي دون الحاجة إلى مؤسسات ديمقراطية حقيقية.
أن الهيمنة ليست فقط في يد الدولة كجهاز قمع، بل تُمارَس أيضاً من خلال المجتمع، أي من خلال البنى الثقافية والدينية والعائلية التي تُنتج الطاعة. غير أن ما يميز المجتمعات العربية – كما في العراق ولبنان واليمن – هو أن هذا المجتمع لم يتطور بعد إلى فضاء للمواطنة، بل بقي أسيراً لشكل من أشكال “المجتمع الأهلي” الذي يتماهى فيه الولاء الاجتماعي مع الولاء السياسي. وبذلك تصبح العشيرة والطائفة والحزب وجهاً واحداً لعملة السلطة.
في هذا السياق، يمكن القول إن المجتمع الأهلي يؤدي وظيفة البنية التحتية للمحاصصة. فهو يوفر القواعد الشعبية والولاءات التي تستند إليها الأحزاب الطائفية في توزيع الغنائم والمناصب. حين تتحول الدولة إلى غنيمة، يصبح الولاء هو العملة الوحيدة المتداولة، وتتحول مؤسسات الدولة إلى امتداد لشبكات القرابة والزعامة، فتذوب الحدود بين الخاص والعام. إن الفساد هنا ليس انحرافاً عرضياً عن القانون، بل هو القانون الفعلي الذي ينظم العلاقة بين السلطة والمجتمع.
هذه الظاهرة ليست محلية فحسب. فماركس، في الثامن عشر من برومير لويس بونابرت، حلّل كيف تتحول البنى التقليدية (كالفلاحين المتفرقين في الريف الفرنسي) إلى قاعدة لنظام سلطوي عندما تُستثمر سياسياً. النظام البونابرتي، كما يقول ماركس، لم يُنتج هؤلاء الفلاحين، لكنه استخدم تشتتهم وعزلتهم ليحوّلهم إلى قاعدة لسلطة فوقية تستمد شرعيتها من ضعف التنظيم الطبقي. والأمر نفسه يتكرر اليوم، حين تُستخدم العشيرة والطائفة لتفتيت الوعي الطبقي وتحويل الجماهير إلى كتلة طيّعة في يد السلطة.
في البلدان الريعية أو شبه الريعية، يتخذ هذا التحالف بين المجتمع الأهلي والدولة بعداً اقتصادياً مباشراً. فالموارد تُوزَّع على أساس الولاءات، لا على أساس الحاجة أو الكفاءة، مما يؤدي إلى ما يمكن تسميته بـ«اقتصاد الولاء». في العراق مثلاً، تحوّلت الوزارات إلى حصص للأحزاب الطائفية، وأصبحت المناصب تُمنح وفق نظام الزبائنية. أما في لبنان، فقد رسّخ اتفاق الطائف هذا المنطق حين جعل الطائفة هي الوحدة السياسية الفعلية، فبات المواطن مواطناً من خلال طائفته لا من خلال الدولة.
إن العشيرة والطائفة في هذا السياق ليست بُنى اجتماعية تقليدية فحسب، بل أدوات سياسية حديثة تُستخدم لإعادة إنتاج السيطرة الطبقية. فهي تحافظ على ولاء القاعدة الشعبية من خلال منطق “الحماية مقابل الطاعة”، كما وصف ماكس فيبر نموذج السلطة الأبوية، لكنها هنا تُستخدم بذكاء ضمن بنية رأسمالية هجينة. فالقائد السياسي – زعيم الطائفة أو العشيرة – يلعب دور الوسيط بين الدولة والقاعدة، يوزّع المنافع، ويحتكر التمثيل، ويعيد إنتاج علاقة تبعية عمودية تشبه علاقة ربّ العمل بالعامل، ولكن بلغة القرابة والهوية.
وهكذا، يتشكّل نظام مغلق من المصالح المتبادلة، تتحرك فيه الثروة والسلطة داخل الشبكات نفسها، فيما تُقصى الطبقات الشعبية عن أي إمكانية للتنظيم المستقل. يصبح الفساد، في هذا النظام، ليس مجرد ممارسة فردية بل آلية بنيوية لإعادة إنتاج المجتمع الأهلي نفسه. فإن الأيديولوجيا تعمل من خلال “أجهزة” قادرة على إنتاج الطاعة من الداخل، دون حاجة إلى القسر المباشر. والمجتمع الأهلي هو أحد أبرز هذه الأجهزة في المجتمعات التابعة، لأنه يُقدِّم الطاعة كقيمة، والولاء كفضيلة، والاعتراض كخيانة.
من هنا نفهم أن المجتمع الأهلي ليس مجرد “بنية دونية” تقليدية، بل شريك فعلي في منظومة السيطرة الطبقية الحديثة. فهو يقدّم للدولة وللنخب الحاكمة ما تحتاجه من شرعية “شعبية”، مقابل الحفاظ على امتيازاته الداخلية. هذه العلاقة التبادلية تنتج نوعاً من التواطؤ الاجتماعي العميق، يجعل الفساد متجذراً في نسيج الحياة اليومية، لا في رأس السلطة وحدها. ومن هنا تأتي خطورة الظاهرة: فكل إصلاح سياسي أو إداري يفشل لأن بنية المجتمع نفسها تنتج الفساد بوصفه شرطاً لوجودها.
يمكن القول إن المجتمع الأهلي يشكّل شكلاً من أشكال “الفوقية المتجسدة”، أي أنه لا يقتصر على الأفكار أو القيم، بل يتجسد في علاقات ومؤسسات تنظم إعادة توزيع الموارد والسلطة. وهذا ما يجعل تفكيكه مهمة معقدة، لأنه ليس مجرد وعي زائف يمكن تبديده بالتنوير، بل نظام مادي من العلاقات الاجتماعية. وكما أن الرأسمالية لا تسقط بالمواعظ الأخلاقية، كذلك المجتمع الأهلي لا يُستبدل بالمدنية عبر الوعظ أو الخطاب الإصلاحي، بل عبر صراع سياسي واجتماعي يعيد بناء البنية التحتية ذاتها.
إن تحالف المجتمع الأهلي مع الأحزاب المحافظة هو تحالف بين التقليد والفساد، بين الطاعة والمحسوبية، بين الماضي وبنية السلطة الراهنة. وهو ما يفسّر لماذا تبقى قوى التغيير محاصرة دائماً في هامش الفعل السياسي، لأنها تصطدم لا فقط بنظام سياسي فاسد، بل بمجتمع منتج للفساد ذاته. وفي هذا المعنى، يمكن أن نستعيد مقولة غرامشي الشهيرة: “الأزمة تكمن في أن القديم لم يمت بعد، والجديد لم يولد بعد”، فالمجتمع الأهلي يمثل هذا “القديم” الذي يرفض الموت، ويتقمص أشكالاً حديثة ليواصل وجوده في قلب الدولة الحديثة.
باختصار، المجتمع الأهلي في بنيته الراهنة ليس حنيناً إلى الماضي، بل هو وظيفة سياسية للراهن، تُستخدم لضمان استمرارية النظام القائم. إن تفكيكه لا يعني القضاء على التضامن الاجتماعي أو على الهويات الثقافية، بل يعني تحرير هذه الهويات من الاستخدام السياسي الطبقي الذي يجعل منها أدوات للهيمنة والفساد. من دون هذا التفكيك الجدلي، تبقى فكرة الدولة المدنية مجرد شعار، لأن الدولة التي لا تتحرر من المجتمع الأهلي لا يمكن أن تكون دولة مواطنة.
الأحزاب اليسارية والمدنية ومحاولة كسر البنية التقليدية
تجد الأحزاب اليسارية والمدنية نفسها، في معظم البلدان ذات البنية الاجتماعية التقليدية، في مواجهة منظومة معقّدة من التحالفات والعلاقات التي تربط المجتمع الأهلي بالدولة، وتُنتج بذلك نظاماً مغلقاً من السلطة والولاء. هذه الأحزاب لا تواجه خصماً سياسياً فحسب، بل تصطدم ببنية اجتماعية راسخة، تشكّل فيها الطائفة والعشيرة والزعامة منظومة متكاملة من الضبط الاجتماعي. ومن ثمّ، يصبح الصراع بالنسبة لليسار ليس فقط على السلطة السياسية، بل على الوعي ذاته، أي على الطريقة التي يدرك بها الإنسان علاقته بنفسه وبالآخرين وبالدولة.
تنطلق الرؤية التقدمية من مبدأ بسيط ولكنه جذري: الإنسان ليس تابعاً لانتمائه الأولي، بل فاعل اجتماعي حرّ داخل جماعة من المواطنين المتساوين. هذا المبدأ، الذي يبدو بديهياً في المجتمعات الحديثة، يتحول في مجتمعاتنا إلى هدف ثوري، لا بل حلم رومانسي، لأن بنية الولاءات الأولية ما تزال هي التي تحدد الموقع الاجتماعي والسياسي للفرد. ومن هنا فإن بناء المجتمع المدني الحديث ليس مسألة قانونية أو إدارية، بل معركة فكرية وتنظيمية وسياسية بامتياز ضد تاريخ طويل من الاستبداد الرمزي والمادي.
لذا أن أي مشروع للتحرر لا ينجح إلا إذا انتقل من مستوى «الهيمنة الثقافية للخصم» إلى بناء هيمنة مضادة، أي إنتاج وعي جديد داخل الطبقات الشعبية نفسها. هذا ما حاولت الحركات اليسارية والمدنية والديمقراطية أن تفعله عبر تاريخها، من النقابات العمالية في أوروبا القرن التاسع عشر، إلى حركات التحرر الوطني في الجنوب العالمي، إلى الأحزاب التقدمية في العالم العربي بعد الاستقلال. غير أن الفارق الجوهري في الحالة العربية هو أن هذه القوى نشأت في مجتمع لم يُستكمل فيه بناء الطبقات الحديثة، مما جعلها تعمل داخل فضاء تحكمه الولاءات الأهلية، لا المصالح الطبقية الواضحة.
في العراق ولبنان، على سبيل المثال، اصطدمت الحركات اليسارية بجدارٍ مزدوج: سلطة الدولة من جهة، وسلطة البنى الأهلية من جهة أخرى. فبينما كانت القوى المحافظة تمتلك نفوذاً عميقاً داخل المجتمع الأهلي، بقيت الأحزاب اليسارية في الغالب نخباً فكرية أو تنظيمات محدودة القاعدة. فالجماهير التي يُفترض أن تكون قاعدة اليسار كانت تُستوعَب ضمن شبكات الزعامة التقليدية، عبر منطق الرعاية والولاء. وبذلك تحوّل اليسار، في بعض المراحل، إلى “معارضة ثقافية” أكثر منه حركة جماهيرية.
إن جوهر التحدي هنا هو أن البنية الأهلية لا تواجه الديمقراطية واليسار بالقمع المباشر فحسب، بل أيضاً من خلال الأيديولوجيا. فهي تفرض على الناس تصوراً محدداً للعالم، يجعل الولاء الشخصي يبدو طبيعياً، والطاعة فضيلة، والمطالبة بالمساواة نوعاً من العصيان. هذا ما يمكن تسميته بـ” تشكيل هوية المكونات”، أي أن النظام يجعل الناس يعرّفون أنفسهم ضمن أدوار طائفية وعرقية وقبلية محددة مسبقاً تخدم استمراره، لذا فإن كسر البنية التقليدية يتطلب ما هو أكثر من تغيير القوانين؛ إنه يستدعي تحوّلاً في الوعي الاجتماعي ذاته.
في هذا السياق، يصبح عمل الأحزاب اليسارية والمدنية مشروعاً مزدوجاً: من جهة، بناء تنظيمات جماهيرية قادرة على التعبير عن المصالح الفعلية للطبقات الشعبية؛ ومن جهة أخرى، إنتاج خطاب ثقافي قادر على زعزعة البنية الرمزية التي تستند إليها السلطة. فالمجتمع الأهلي ليس فقط نظاماً للمحاصصة، بل نظاماً للمعنى أيضاً، أي أنه يحدد ما يُعتبر شرعياً، وما هو “خارج العرف”، وما هو “مخالف للدين” أو “للتقاليد”. لذلك، لا يمكن لأي قوة تغيير أن تكتفي بالمواجهة السياسية وحدها، بل عليها أن تخوض صراعاً طويلاً على معنى الحرية والعدالة والهوية.
من هنا، فإن تأسيس منظمات جماهيرية لا يعني فقط تعبئة الشارع، بل بناء فضاء اجتماعي جديد يتيح للناس أن يعيشوا تجربة المواطنة الفعلية. على سبيل المثال، لعبت النقابات العمالية في أوروبا خلال القرن العشرين دوراً مفصلياً في نقل الصراع من حدود المصنع إلى حدود المجتمع، محولةً المسألة الاقتصادية إلى مسألة سياسية عامة. في المقابل، فشلت النقابات في كثير من البلدان العربية في أداء هذا الدور، لأنها خضعت إما لسيطرة الدولة أو لاختراق المجتمع الأهلي، ففقدت استقلالها وقدرتها على أن تكون رافعة للوعي الطبقي.
لقد أظهر التاريخ الحديث أن الأحزاب الديمقراطية واليسارية التي لم تستطع بناء قاعدتها الاجتماعية ظلت أسيرة النخبة المثقفة، بينما تحولت الأحزاب الطائفية إلى ممثلين فعليين للجماهير. في لبنان مثلاً، كانت الأحزاب الشيوعية والقومية تحمل مشروعاً وطنياً تحررياً، لكن الطائفية نجحت في إعادة تعريف الهوية السياسية للناس بحيث أصبح “الانتماء” أهم من “المصلحة”. وهذا بالضبط ما يجعل الصراع اليوم ليس بين أحزاب، بل بين رؤيتين للعالم: رؤية ترى الإنسان مواطناً، وأخرى تراه تابعاً.
ومع ذلك، لا يمكن التقليل من إنجازات اليسار والقوى المدنية والديمقراطية. فعلى الرغم من التراجع السياسي، فقد ساهمت هذه القوى في نشر خطاب نقدي فكري، أعاد تعريف مفاهيم مثل العدالة والمواطنة والحرية من منظور اجتماعي لا ليبرالي. ففي حين ربطت النخب الليبرالية الحرية بحرية السوق، ربطها اليسار وقوى الديمقراطية الاجتماعية بحرية الإنسان من الاستغلال. وهذه المعركة المفهومية هي التي تفتح الطريق أمام التغيير المستقبلي، لأن كل ثورة تبدأ من إعادة تعريف الواقع.
إن تجاوز البنية التقليدية لا يعني رفض المجتمع الأهلي بوصفه مكوناً ثقافياً، بل يعني تحريره من طابعه الطبقي المحافظ. فالكثير من الفئات الشعبية التي تنتمي إلى هذه البنى ليست عدواً للمدنية، بل ضحيةً لها. إنها الطبقات التي تُستعمل كأدوات انتخابية، وتُشترى ولاءاتها بالمناصب والوعود، بينما تبقى خارج دائرة القرار الفعلي. لذلك، فإن المهمة ليست الصدام مع هذه الفئات، بل إعادة ربطها بمشروع تحرري شامل.
فعلى الصعيد الطبقي، فالطبقة العاملة لا تصبح طبقة لنفسها إلا عندما تمتلك وعيها الطبقي، أي عندما تدرك موقعها في النظام الاجتماعي وتتحرك لتغييره. والأمر ذاته ينطبق على المجتمع المدني: لا يصبح فعلياً إلا حين يعي ذاته نقيضاً للمجتمع الأهلي، لا امتداداً له. من هنا، فإن المهمة هي الانتقال من الوجود كأفكار إلى الوجود كقوة اجتماعية، أي تحويل النظرية إلى ممارسة، والممارسة إلى تنظيم، والتنظيم إلى وعي جمعي مستمر.
في المحصلة، يمكن القول إن معركة الأحزاب اليسارية والمدنية ليست معركة ظرفية من أجل مقاعد سياسية، بل معركة تاريخية من أجل إعادة بناء المجتمع ذاته. فهي تحاول أن تنشئ من قلب البنى التقليدية مجتمعاً جديداً، لا يقوم على الطاعة والوراثة، بل على المساواة والمشاركة. وبقدر ما تستطيع هذه القوى أن تربط مشروعها بالاحتياجات الفعلية للطبقات الشعبية – لا بالشعارات المجردة – بقدر ما تملك فرصة لتجاوز عزلتها وبناء هيمنة بديلة. إن المسألة هنا ليست فقط في تغيير من يحكم، بل في تغيير الطريقة التي يُفكَّر بها الحكم ذاته.
التحدي التنظيمي – بين الفكرة والقاعدة الاجتماعية
يمثل التحدي التنظيمي في التجارب اليسارية والمدنية أكثر حلقات الصراع تعقيداً، لأنه يجمع بين ما هو فكري وما هو مادي، بين الفكرة التي تسعى إلى التحرر والقاعدة الاجتماعية التي ما تزال مشدودة إلى قيودها التاريخية. لا يكفي أن تمتلك القوى التقدمية برنامجاً فكرياً متماسكاً أو خطاباً ثورياً جذّاباً؛ فالمسألة الحاسمة هي: كيف تتحول الفكرة إلى تنظيم، والتنظيم إلى قوة اجتماعية؟
في تاريخ الحركة الماركسية، كانت هذه المعضلة مركزية. ماركس نفسه، في البيان الشيوعي (1848)، لم يقدّم الشيوعية كمجرد نظرية فلسفية، بل كحركة تاريخية واقعية تعبّر عن مصالح طبقة محددة، هي الطبقة العاملة. ولينين في ما العمل؟ (1902) شدّد على أن الوعي الطبقي لا يتطور تلقائياً من داخل التجربة العمالية، بل يُنقل إليها عبر التنظيم الثوري، عبر حزب يمتلك الوعي العلمي بموقع الطبقة في النظام الاجتماعي. بهذا المعنى، يصبح التنظيم ليس مجرد أداة، بل هو الوسيط الجدلي الذي يحوّل الوعي إلى قوة مادية.
لكن في المجتمعات التابعة مثل مجتمعاتنا، حيث لم تتبلور الطبقات الحديثة بصورة مستقلة، تواجه الأحزاب الديمقراطية واليسارية إشكالية أكثر تعقيداً: فكيف يمكن بناء تنظيم جماهيري في غياب قاعدة طبقية واعية بذاتها؟ أي كيف يمكن إنتاج «الذات الثورية» في مجتمع لا تزال علاقاته الاجتماعية تُعاد إنتاجها من خلال العشيرة والطائفة والولاء الشخصي؟
الواقع أن ضعف التنظيم الجماهيري هو انعكاس مباشر لانقسام البنية الاجتماعية. فكلّما ازدادت سلطة المجتمع الأهلي، تراجعت قدرة الأحزاب الحديثة على إقامة علاقات أفقية مع الجماهير. فالفرد في المجتمع الأهلي لا يرى نفسه كمواطن بل كعضو في جماعة مغلقة، ما يجعل علاقته بالحزب السياسي علاقة خارجية، لا عضوية. هذه الفجوة بين الحزب والجماهير تجعل التنظيم هشاً، لأنه يفتقر إلى الجذر الاجتماعي العميق الذي يمنحه الاستمرارية.
في هذا السياق، يمكن القول إن كثيراً من الأحزاب اليسارية والمدنية تحوّلت – بمرور الزمن – إلى نخب مثقفة منعزلة، تمتلك أدوات التحليل ولكنها تفتقر إلى قاعدة الدفاع الاجتماعي. أصبح قادتها، كما يُقال، “جنرالات بلا عسكر”، يملكون الوعي ولا يملكون القوة. وهذا التوصيف لا يُعد مجازياً فقط؛ إنه يعكس واقعاً مادياً مؤلماً، حيث انقطعت الصلة بين الخطاب التقدمي والواقع الشعبي الذي يُفترض أن يخاطبه.
هذا الانفصال بين النظرية والممارسة لا يعود فقط إلى القمع السياسي أو ضعف التمويل، بل إلى غياب الرؤية التنظيمية التي تربط الفكر بالفعل. فالحزب ليس منبراً فكرياً، بل كائناً حيّاً يتغذى من التجربة الجماعية للناس. كلما فقد الحزب تواصله مع العمال والفلاحين والطلبة والنساء، تحوّل إلى مؤسسة بيروقراطية أو نادٍ فكري. لذلك، فإن النضال التنظيمي هو في جوهره نضال من أجل إعادة بناء العلاقة بين الفكر والواقع، بين المثقف والطبقة، بين الخطاب والممارسة اليومية.
هنا تبرز أهمية النقابات والاتحادات والمنظمات الشبابية والنسوية والطلابية، لا بوصفها مؤسسات ثانوية، بل كفضاءات لتشكيل الوعي العملي. فالنقابة التي تدافع عن حق العامل في الأجر العادل تخلق، من حيث لا تدري، وعياً طبقياً مضاداً، لأنها تكشف الطابع الاستغلالي للعلاقات الاقتصادية. والمنظمة النسوية التي تناضل ضد التمييز لا تدافع فقط عن المساواة بين الجنسين، بل تعيد تعريف معنى الحرية في المجتمع كله. بهذا المعنى، يصبح التنظيم الجماهيري وسيلة لإنتاج الذات التاريخية الجديدة، لا مجرد وسيلة ضغط على السلطة.
حين نقرأ تجربة حركات التحرر الوطني في أميركا اللاتينية، ندرك أن سرّ قوتها لم يكن في الشعارات، بل في قدرتها على بناء “شبكات حياة” داخل المجتمع، تمتد من المصنع إلى المدرسة، ومن الحيّ إلى الجامعة. لقد كانت هذه المنظمات، في لحظات تاريخية معينة، تعبيراً حياً عن وحدة الفكرة والقاعدة، عن التحام النظرية بالممارسة. في المقابل، حين تنقطع هذه الصلة تتحول الأحزاب إلى أجهزة جامدة فقدت روحها الثورية.
إن البناء التنظيمي في جوهره فعل أخلاقي أيضاً، لأنه يعبّر عن إيمان جماعي بإمكانية التغيير. الحزب الثوري الحقيقي لا يقوم على الطاعة العمياء، بل على الانضباط الواعي الذي يربط بين المسؤولية الفردية والمصلحة الجماعية. ولذلك، فإن الديمقراطية الداخلية ليست ترفاً تنظيمياً، بل شرطاً لتجديد الحيوية الثورية. الحزب الذي لا يسمح بالنقد الذاتي ولا بالمحاسبة يتحول تدريجياً إلى صورة مصغّرة عن النظام الذي يعارضه. وهنا تكمن المفارقة: أن تُصبح أداة التحرر أداة جديدة للهيمنة إن لم تُربط بالقيم التي تدافع عنها.
ومن هنا نفهم أن بناء تنظيم جماهيري ليس مجرد مهمة تقنية، بل معركة ضد منطق المجتمع الأهلي نفسه. فبينما يقوم المجتمع الأهلي على الولاء والقرابة والوساطة، يقوم التنظيم الجماهيري على الوعي والمشاركة والمساءلة. الشفافية داخل الحزب هي النقيض الجدلي للمحسوبية، والمساءلة هي نفي مباشر لمنطق الزعامة الأبوية. لذلك، فإن كل منظمة جماهيرية حديثة هي، بحد ذاتها، خلية مضادة للفساد، لأنها تخلق ثقافة جديدة للتعامل بين الناس، تُبنى على الكفاءة والمبادرة، لا على الولاء والقرابة.
في البلدان العربية اليوم، يمكن أن نلمس هذا الصراع داخل الجامعات، في النقابات المهنية، وفي الحركات النسوية الجديدة التي بدأت تُعيد تعريف السياسة من القاعدة إلى القمة. فحين تتجمع النساء في ورشة عمل لطرح قانونٍ يحمي العاملات من العنف، أو حين ينظم الطلبة اعتصاماً ضد خصخصة التعليم، فإنهم لا يعبّرون فقط عن مطالب جزئية، بل يفتحون ساحة اشتباك مع الهيمنة التقليدية. من هذه الساحة تولد السياسة من جديد كفعل جماهيري حرّ، لا كصفقة بين نخب متواطئة.
ولذلك، فإن التحدي الحقيقي أمام الأحزاب اليسارية والمدنية هو الانتقال من “الوعي النخبوي” إلى “الوعي العضوي”، أي من فهم الواقع إلى الانخراط في تغييره، فالمثقف الحقيقي هو من يجعل من فكرته علاقة اجتماعية حية، لا من يبقيها في الكتب أو الخطابات. الحزب الذي ينجح في خلق هذه العلاقة يتحول إلى أداة تاريخية، أما الذي يفشل فسيبقى مجرد فكرة جميلة في هواء الخطابات.
في نهاية المطاف، لا يمكن لأي مشروع تحرري أن يعيش من دون قاعدة اجتماعية. الفكرة التي لا تجد جسدها في الناس، تذبل وتموت. والتنظيم الذي لا يتحول إلى مدرسة في الممارسة الديمقراطية والالتزام الجمعي، يفقد روحه الثورية. ومن هنا، فإن الصراع التنظيمي ليس تفصيلاً في المعركة الكبرى، بل هو قلبها النابض. فإما أن تُبنى منظمات جماهيرية حيّة تخلق المواطن الفاعل، وإما أن يبقى الوعي أسيراً للنخبة، عاجزاً عن أن يصير تاريخاً.
الفعل الجماهيري كمدخل لتحرير السياسة من الفساد
لا يمكن فهم الفساد السياسي بوصفه مجرد انحراف أخلاقي أو سلوكاً شاذاً داخل جهاز الدولة؛ إنه انعكاس بنيوي لطبيعة السلطة في مجتمعات تفتقد لأسس المشاركة والرقابة الجماهيرية. إنّ الفساد في هذا المعنى ليس طارئاً على النظام، بل هو اللغة التي يتحدث بها النظام نفسه، هو الشكل اليومي الذي تتجسد من خلاله علاقات الهيمنة. لذلك، لا يمكن إصلاحه عبر الإجراءات الإدارية وحدها، بل فقط عبر إعادة تعريف السياسة ذاتها بوصفها فعلاً جماهيرياً لا امتيازاً نخبوياً.
الفساد، في جوهره، هو تجسيد مادي لانفصال السياسة عن المجتمع. فحين تتحول الدولة إلى غنيمة تتقاسمها النخب، يُقصى الشعب عن القرار، وتتحول السياسة إلى إدارة مصالح خاصة مغلّفة بخطابات عامة. بهذا المعنى، فإن الفساد هو الوجه الآخر للمحاصصة الأهلية، كلاهما يقوم على منطق الزبائنية وتبادل الولاءات. وما لم تُكسر هذه الحلقة، تبقى الدولة الحديثة مجرد قشرة فوق بنية اجتماعية قديمة.
من هنا، يمكن القول إن الفعل الجماهيري المنظم هو المدخل الحقيقي لتحرير السياسة من أسر الفساد والطائفية والعشيرة. لأن الجماهير، حين تنظَّم وتتحرك بوعي، تُعيد تعريف السياسة بوصفها مصلحة عامة، لا ساحةً للمنافع الخاصة. وهذا ما قصده ماركس حين قال إن تحرر الطبقة العاملة هو فعل الطبقة العاملة نفسها؛ فالتحرر لا يُمنح من الأعلى، بل يُنتزع من الأسفل، من فعلٍ جماعي يعيد صياغة المجتمع والدولة معاً.
في التجربة التاريخية، نجد أن اللحظات التي شهدت انهيار أنظمة الفساد لم تكن نتيجة إصلاحٍ بيروقراطي، بل نتيجة حركات جماهيرية كسرت احتكار السلطة. من ثورات أوروبا في القرن التاسع عشر إلى حركات التحرر في أميركا اللاتينية، ومن الانتفاضات الشعبية في أوروبا الشرقية إلى الحركات الاجتماعية المعاصرة في العالم العربي، كان القاسم المشترك دائماً هو تحرّك القاعدة الاجتماعية حين فقدت ثقتها بالنخب. ففي اللحظة التي تتحول فيها الجماهير من موضوعٍ للسياسة إلى فاعلٍ فيها، يبدأ الفساد بفقدان توازنه، لأن أدواته—الولاء، الرشوة، الزعامة—تفقد فعاليتها.
ومع ذلك، ليس كل فعل جماهيري بالضرورة فعلاً تحررياً. فالجماهير التي تتحرك دون وعي طبقي قد تُعيد إنتاج نفس منظومة السيطرة التي تثور ضدها. هذه هي المفارقة التي أشار إليها لينين حين حذّر من “العفوية” غير المؤطرة بالوعي السياسي. فالعفوية قد تفجّر النظام لكنها لا تبني بديلاً. لذلك، فإن الفعل الجماهيري لا يصبح تحررياً إلا حين يُدار عبر وعيٍ نقدي وتنظيمٍ مستقل قادر على ربط المطالب المباشرة بالبنية العميقة للنظام.
في هذا السياق، تلعب المنظمات الجماهيرية الحديثة – النقابات، الجمعيات المدنية، الاتحادات الطلابية، الحركات النسوية – دوراً لا غنى عنه. فهي ليست مجرد أدوات ضغط، بل مدارس سياسية تُعلّم الناس معنى المشاركة والمساءلة. إنها تدرّب المجتمع على الممارسة الديمقراطية من القاعدة، في مواجهة ثقافة الطاعة التي يفرضها النظام الأهلي والسلطة البيروقراطية. فعندما يتعلم العامل أن ينتخب ممثله في النقابة بناءً على الكفاءة، لا القرابة؛ وعندما تدرك المرأة أن نضالها من أجل المساواة ليس شأناً خاصاً بل سياسياً؛ وعندما يرى الطالب أن الدفاع عن التعليم العام جزء من معركة العدالة الاجتماعية، يصبح الفعل الجماهيري ذاته نقيضاً مادياً للفساد.
الفساد يحتاج إلى السرية ليعيش، بينما الفعل الجماهيري قائم على العلن؛ يحتاج إلى الزبائنية، بينما الجماهير تبني علاقاتها على المصلحة العامة؛ يحتاج إلى الخوف، بينما الحركة الجماهيرية تولّد الأمل. هذه هي الجدلية التي تجعل التنظيم الشعبي سلاحاً أخلاقياً قبل أن يكون سياسياً. فعندما تتحول المشاركة إلى ممارسة يومية، تفقد السلطة التقليدية قدرتها على احتكار الشرعية.
يمكننا أن نرى ملامح هذا التحول في الحركات الشبابية والنسوية في العالم العربي خلال العقدين الأخيرين. فهذه الحركات، رغم محدودية مواردها، نجحت في زعزعة الأشكال التقليدية للسلطة من خلال ممارسات بسيطة ولكنها جوهرية: الاعتصام في الشارع، تشكيل لجان طلابية، المطالبة بالشفافية في المؤسسات العامة، مقاومة التطبيع مع الفساد بوصفه “قدَراً اجتماعياً”. هذه الممارسات لا تغيّر النظام بين يوم وليلة، لكنها تفتح كُوًى في جدار الوعي، وتُعيد تعريف معنى السياسة بوصفها شأناً يومياً يخصّ الناس جميعاً.
ومن هذا المنظور، يمكن اعتبار الفعل الجماهيري نوعاً من “إعادة تسييس الحياة اليومية”. فالسياسة ليست في البرلمان فقط، بل في مكان العمل، في الجامعة، في الحيّ، وفي الفضاء الرقمي. كل فعلٍ جماعي يُسائل سلطة أو يكشف ظلماً هو، في جوهره، خطوة نحو استعادة السياسة من يد الفساد. كما كتب غرامشي، “كل إنسان هو فيلسوف، وكل عملٍ يومي يمكن أن يكون فعلاً سياسياً إذا وُجه بوعي نقدي.”
لكن يجب التنبيه إلى أن الفعل الجماهيري لا يتحقق في فراغ. فهو يحتاج إلى قيادة سياسية تمتلك مشروعاً واضحاً، وإلى تنظيمٍ قادر على الاستمرار بعد لحظة الانفجار. من دون ذلك، تتحول الثورات إلى دورات من الإحباط، كما شهدنا في تجارب الربيع العربي، حيث فشلت القوى المدنية في تحويل الزخم الشعبي إلى مؤسسات بديلة قادرة على إدارة الدولة. وهنا يتجلى الدرس الماركسي الأعمق: أن الثورة لا تنتصر بالشجاعة وحدها، بل بالوعي والتنظيم.
إذاً، فإن تحرير السياسة من الفساد ليس مهمة إدارية ولا معركة أخلاقية، بل عملية تاريخية تعيد بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع. الدولة الحديثة لا يمكن أن تكون شفافة إلا إذا كان المجتمع منظماً؛ ولا يمكن أن تكون ديمقراطية إلا إذا كان الناس فاعلين. إنّ الفعل الجماهيري، بهذا المعنى، هو الشرط المسبق لولادة السياسة الحديثة، لأن السياسة بلا جماهير تتحول إلى إدارة، والإدارة بلا رقابة تتحول إلى فساد.
في النهاية، يمكن القول ببساطة إن معركة اليسار والمدنية ضد الفساد هي معركة من أجل استعادة السياسة إلى أصحابها الشرعيين: الناس. فالتحالف بين المجتمع الأهلي والأحزاب المحافظة هو تحالف بين الماضي وبنية السلطة الراهنة، بينما الفعل الجماهيري يمثل وعد المستقبل، حيث تُعاد السياسة إلى معناها الأصيل: التعبير عن الصراع الطبقي، عن إرادة الإنسان في الكرامة والحرية والمساواة.
وحين يتحول هذا الفعل الجماهيري إلى وعيٍ منظمٍ يمتلك مشروعاً، يمكن عندها فقط الحديث عن ولادة سياسة جديدة – سياسة لا تقوم على التوريث والمحاصصة، بل على المشاركة والمساءلة، لا تُدار في الغرف المغلقة، بل تُمارَس في الفضاء العام، في الشارع، في المصنع، وفي الجامعة. عندها فقط يمكن القول إن المجتمع قد بدأ يتطهّر من الفساد، لا بقرارات فوقية، بل بفعلٍ جماعي يُعيد للإنسان دوره كمحركٍ للتاريخ، لا كموضوعٍ له.