تحتل العلاقة بين النقد ومسار الحركة السياسية موقعاً محورياً في التحليل الماركسي، كما في التجربة التاريخية لكل حركة ثورية سعت إلى تغيير بنيتها الاجتماعية والمادية. يمكن القول ببساطة إن النقد ليس أداة تحليل فحسب، بل هو الشرط الذي يسمح للحركة بإعادة إنتاج وعيها وبناء قدرتها على الفعل. فعبر النقد، تتكشف التناقضات الداخلية، وتظهر نقاط القصور في الممارسة، ويتحدد الطريق الممكن نحو فعل ثوري أكثر نضجاً وفاعلية. وعندما يغيب النقد، يتحول التنظيم تدريجياً إلى جهاز مغلق يستنزف طاقته الخاصة؛ جهاز تتوقف داخله ديناميات التجدد، وتترسخ فيه قيادة ثابتة لا تسمح بالسؤال ولا تقبل المراجعة. ومع الوقت، تصبح الأخطاء مبررة ومكررة، وتفقد الحركة قدرتها على قراءة الواقع وتعقيداته. ومن هذا المنحدر يبدأ الانزلاق نحو البيروقراطية أو الطائفية التنظيمية، حيث يُقدَّم الولاء للقيادة على ولاء الحقيقة، ويغدو الانغلاق على الذات عائقاً أمام أي إمكانية لإعادة بناء استراتيجية ثورية قادرة على الاستمرار.
النقد بوصفه آلية لإنتاج الوعي وإعادة بناء الفعل السياسي
يمكن القول إن النقد ليس فعلاً عدائياً ولا محاولة لانتقاص الحركة أو التشهير بها؛ هو في جوهره أداة معرفية تكشف البُنى العميقة التي يتكوّن منها خطاب الحركة وممارساتها، وتُظهر التناقضات التي تتسرّب إليها مع الزمن. وببساطة، لا يهدف النقد إلى إضعاف التنظيم، بل إلى حمايته من الدوران في الحلقة ذاتها ومن الوقوع تحت سطوة أوهام تُنتجها السرديات الداخلية حين تغيب المراجعة ويغيب الاختبار. فالحركة التي تتراجع عن ممارسة النقد تفقد تدريجياً قدرتها على رؤية الواقع كما هو، فتشرع في تشييد «واقع بديل» يتماهى مع رغبات القيادة أكثر مما يعكس الحقائق الفعلية للصراع.
في هذا السياق، يصبح النقد ضرورة لضبط العلاقة بين القيادة وقواعدها، وبين ما حققته الحركة فعلياً وما كان ينبغي أن تحققه. تنظيم يُفسح المجال للنقد كي يتحرك بحرية يقطع الطريق على تشكّل طبقة تنظيمية تتصرف كما لو كانت فوق المساءلة، وتُحوّل كل اعتراض إلى تهديد للوحدة بدل اعتباره خطوة طبيعية في مسار النضج السياسي. النقد المستمر يمنع الأخطاء من التراكم بصمت، ويحوّل الإخفاق من جرح مكتوم إلى مادة قابلة للتحليل تُغني التجربة التاريخية للحركة، بحيث يتحول الفشل إلى معرفة لا إلى عقدة تعيد إنتاج ذاتها.
ومن هذا المنظور، النقد ليس موقفاً فكرياً فحسب، بل آلية لإنتاج وعي اجتماعي وسياسي قادر على تحديد موقع الحركة داخل بنيتها المجتمعية. فتنظيم لا يُراجع ذاته ولا بيئته يتحول تدريجياً إلى كيان يتكيف مع القهر بدل أن يواجهه. احتضان النقد بوصفه عنصراً تأسيسياً يسمح للحركة بإعادة قراءة خياراتها الاستراتيجية، وببناء أدوات نضال تستجيب لتعقيدات اللحظة السياسية، بدل الارتهان لشعارات ثابتة تُثير الانفعال لكنها تعجز عن إنتاج فعل تاريخي فعّال.
النقد الذاتي بوصفه المسؤولية السياسية العليا
يمكن النظر إلى النقد الذاتي بوصفه اللحظة الأكثر حساسية في السلوك النقدي في مسار أي حركة تسعى إلى تجدد فعلي. أهميته لا تأتي من كونه غير موجّهاً للخارج، بل لأنه يعيد البوصلة إلى الداخل، إلى الذات التي تفكر وتخطط وتُخطئ وتتخذ القرارات. فإذا كان النقد العام ينصبّ عادة على الخطاب والسياسات والبنى التنظيمية، فإن النقد الذاتي يذهب أعمق من ذلك؛ يفتّش في موقع القيادة، في طرائق اتخاذ القرار، في طبيعة الكادر نفسه، وفي الفجوة التي قد تنشأ بين ما يُقال وما يُمارَس. هنا بالتحديد تصبح الأخطاء جزءاً من البنية الداخلية للحركة، لا مجرد حوادث عابرة يمكن تعليقها على الظروف. وتكمن أهميته في أن تحويل الخطأ إلى درس سياسي يتطلّب الاعتراف به أولاً، وقراءته كنتاج لعلاقات القوة ولآليات التفكير التي يعمل ضمنها التنظيم.
لا يعني النقد الذاتي اعتذاراً أو إعلان ضعف كما يتصور البعض؛ هو درجة أعلى من الوعي السياسي. إنه اعتراف بأن الممارسة الثورية ليست معصومة، وبأن الخط السياسي العادل قد ينحرف إذا لم يخضع للمراقبة المستمرة. وفي لحظة النقد الذاتي، تظهر الحركة كما لو أنها تنظر إلى نفسها في مرآة: فاعل سياسي يصنع الفعل، لكنه في الوقت ذاته يخطئ ضمن الشروط القاسية للصراع. والنتيجة ليست إضعافاً للحركة، بل تحريراً لها من يقينيات زائفة كانت تعيق نموّها، ومنحها قدرة دائمة على تعديل أدواتها وخياراتها بما يجعلها أكثر واقعية وأكثر حضوراً في اللحظة التاريخية.
وعندما تجرّم الحركة النقد الذاتي، فإنها تدفع الأخطاء إلى الداخل، حيث تتحول شيئاً فشيئاً إلى رواسب صلبة، تتراكم حتى تنتج شكلاً من القيادة لا ترى إلا نجاحاتها المتخيّلة ولا تسمع إلا صدى خطابها. في مناخ كهذا، يُغلق الباب أمام أي إمكانية للتجدد، ويتحول التنظيم إلى بنية تمضي بثقة عمياء نحو العزلة أو التآكل الداخلي أو الانقسامات التي يصعب احتواؤها. وتمتد النتيجة أبعد من شلل سياسي؛ إذ تنحدر الحركة تدريجياً نحو نوع من الاستبداد الداخلي المقنّع بشعارات “الهيبة” أو “وحدة الصف”.
وعلى امتداد التاريخ الثوري، يمكن أن نجد أمثلة توضح أن النقد الذاتي كان شرطاً للبقاء. فالبلاشفة، خلال انتفاضة يوليو 1917، لم يترددوا في مراجعة خياراتهم بعدما أدركوا أن قراءة خاطئة للواقع كانت كفيلة بإسقاط المشروع الثوري كله. كذلك، لم تُفهم ثورات 1848 في أوروبا إلا عندما عاد الفاعلون السياسيون إلى نقد الذات، لا نقد الظروف وحدها، وقرأوا تفاعل العامل الذاتي والموضوعي من خلال أخطائهم. وفي المقابل، فإن الحركات التي أنكرت على نفسها حقّ المراجعة سلكت طريقاً معروف المصير: العزلة، التكلس التنظيمي، أو الانقسام الذي أطاح بما تبقى من مشروعها.
بهذا المعنى، يبدو النقد الذاتي ليس طقساً تنظيمياً ولا وسيلة عقابية، بل ممارسة معرفية وسياسية تمنح الحركة فرصة دائمة لتجديد نفسها. ومن دون هذا التجدد، تتحول أي حركة، مهما كانت عظيمة بداياتها، إلى كيان يعيش على ذكرى أمجاد قديمة بدل أن يشارك في صنع واقعه الجديد.
صعود التزلف للقيادة وتبرير الأخطاء بوصفهما قوة مضادة للنقد
تظهر المعضلة الأكثر خطورة في مسار أي حركة سياسية عندما تنشأ داخلها فئة تُنصّب نفسها مدافعاً عن القيادة لا عن الحقيقة. هذه الفئة لا تنخرط في النقاش بهدف تطوير المشروع، بل تتخذ موقع “الحارس” عند بوابة التنظيم، معتبرة أن مهمتها الأساسية هي منع الأسئلة قبل السماح للأفكار أن تتدفق. ومع الزمن، يتحوّل التبرير لديها إلى منهج ثابت، وتغدو المغالطة يقيناً، ويُعامل أي نقد أو مساءلة كأنه طعن في قدسية لا يجوز المساس بها.
عندما تترسخ هذه الذهنية، تتحول القيادة من جهاز بشري يخطئ ويُصيب ضمن شروط الصراع، إلى مصدر للحقيقة ذاتها. وتبدأ الحركة بالتكوّن حول مركز ضيق تختنق فيه إمكانيات التفكير النقدي، ويعاد تعريف الولاء باعتباره خضوعاً بلا نقاش، لا التزاماً حراً بمشروع سياسي يسعى إلى التغيير. التزلف هنا يتجاوز مجرد سلوك أفراد يسعون للاقتراب من رأس الهرم؛ إنه ينتج نمطاً كاملاً من الوعي داخل الحركة، يُخفي الحدود الفاصلة بين الشخص والمشروع ويجعل نقد القيادة مرادفاً للطعن في الحركة نفسها.
في هذه البنية المغلقة، لا تُترك الأخطاء لتُفهم كما هي، بل يُعاد تشكيلها بلغة مضادة للواقع: الهزيمة تصبح “مرحلة ضرورية”، وفقدان البوصلة يُقدَّم كتكتيك لم يُفهم بعد، وسوء التقدير يُمنح صياغة سياسية مصطنعة تحجب نتائجه الكارثية. يتحول الخطاب إلى آلية لغسل الفشل وإلباسه ثوباً جديداً. النتيجة حركة تفقد حساسيتها تجاه الواقع وتتآكل قدرتها على التعلم، لأن كل نقد يصبح تهديداً، وكل مراجعة تُعامل كخيانة.
ويتفاقم الخطر حين يجري استدعاء “الظروف الموضوعية” بطريقة انتقائية تخدم مهمة التبرير بدل مهمة الفهم. تُستخدم الضغوط الاقتصادية، أو التدخلات الخارجية، أو اختلال موازين القوى كحائط صدّ يمنع الاقتراب من الأخطاء الذاتية داخل التنظيم؛ تلك الأخطاء التي تتمثل في المحسوبية، أو فساد الكادر، أو سوء تقدير اللحظة السياسية، أو اتخاذ قرارات مصيرية من دون تشاور، أو الانفصال المستمر عن القواعد الاجتماعية. يصبح العامل الموضوعي شماعة جاهزة، فيما يُفرض الصمت على ما هو ذاتي ويقع في صميم مسؤولية القيادة.
لكن النظرية الماركسية التي تُستدعى هنا اسمياً فقط، تقدّم فهماً مغايراً. فالقيادة، في هذا التصور، لا تُعفى من مسؤوليتها بحجة قسوة الواقع، بل تُقاس قيمتها بقدرتها على قراءة هذا الواقع، وتمييز الإمكانات الكامنة فيه، وتحويل المعطيات المتاحة إلى استراتيجية عملية. العلاقة بين الذاتي والموضوعي ليست ذريعة لرفع المسؤولية، بل مساحة تلتقي فيها إرادة الفاعلين مع الشروط التاريخية، لتشكّل معاً مسار الصعود أو الانكسار. التلاعب بهذه العلاقة يخدم من يريد حماية موقعه لا مشروعه، ويجعل الحركة أسيرة خطاب يبرّر عجزها بدل أن يدفعها نحو تطوير أدواتها.
وهذه الجدلية بين الشروط الذاتية والموضوعية ليست مسألة نظرية صرفه، بل محدِّد تاريخي لنجاح المشاريع السياسية أو تراجعها. وهي عملية متحرّكة تتشكل وتتغير مع تبدّل موازين القوى وتطور وعي الفاعلين السياسيين. تفكيك هذه العلاقة ومحاولة استعادتها إلى معناها الحقيقي يشكّل خطوة ضرورية لفهم كيف تُبنى الحركات وكيف تتصدع، وكيف يمكن تجديد مشروع سياسي بدل أن يتحوّل إلى بنية متصلّبة تعيش على تبرير إخفاقها بدل مواجهة أسبابه.
في هذا المسار تتضح الحاجة إلى مواصلة تحليل هذه الجدلية في محطات لاحقة، لأنها تشكّل حجر الأساس لأي قراءة نقدية تسعى إلى تجديد الحركة لا إلى جلدها، وإلى إعادة وصل المشروع بواقعه بدل تركه يتيبس داخل خطاب يصدّق ذاته أكثر مما يصغي إلى العالم.
صناعة الأكاذيب وتهويل الخصوم
تتحوّل بعض القيادات، برفقة الدوائر الضيقة المحيطة بها، من مجرد تبرير الأخطاء إلى ممارسة غير اخلاقية أكثر تعقيداً وخطورة، عبر الكذب وصناعة سرديات تضخّم صورة الخصوم وتعيد تشكيل الواقع السياسي بحيث يبدو كل إخفاق نتيجة حتمية لقوى غاشمة لا تُقهر. في هذه الروايات، يُقال للقواعد إن المال السياسي وحده هو الذي حسم النتائج، وإن السلاح هو ما رجّح الكفة، وإن الخسارة الانتخابية كانت قدَراً مفروضاً لا علاقة له بالكفاءة التنظيمية أو الأداء الداخلي. وأي نقد يوجَّه للقيادة يُصوَّر على أنه إساءة للحزب وتاريخه وخدمة مجانية للقوى المعادية، وأي محاولة لمراجعة الخيارات التنظيمية تُقدَّم بوصفها خطوة انتحارية قد تقود إلى انهيار كامل للحركة.
غير أن هذه السردية المحكمة تخفي جانباً جوهرياً، لا تُفصح عنه القيادة ولا حلفاؤها: هناك قوى سياسية أقل قدرة تنظيمية ومواردية واجهت الظروف نفسها وحققت نتائج أفضل، وتشير الحقائق إلى أن القوة الانتخابية الفعلية كانت أدنى بكثير من الحجم التنظيمي المعلن، ما يكشف عن عمق الترهل الداخلي وفساد البنى التنظيمية. وعندما لا يتناسب الوزن الانتخابي مع البنية التنظيمية وكتلتها الصلبة، فإن التنظيم يكون قد بنى على اكوام من الأكاذيب التي تملئ التقارير والمحاضر الحزبية يعيش على وهم القوة لا على حقيقتها، ويتآكل ليس فقط الحشد الجماهيري، بل القدرة على فهم الذات التنظيمية وتحليل موقعها في الواقع.
في هذا المناخ، تفقد القواعد جرأتها، ويتراجع العقل النقدي أمام خطاب يزرع الخوف بدل الوعي. تصبح الحركة أسيرة رواية تعيد إنتاج الفشل بطريقة دائرية: ما دام العدو مطلق القوة، يصبح الفشل نتيجة طبيعية، وحتى الأخطاء الفادحة يُعاد تفسيرها بوصفها «مفهومة» أو «حتمية»، وكأنها خارج إرادة القيادة وخياراتها. وهكذا تتحول الهزيمة من حدث قابل للتحليل إلى بنية ذهنية تبرّر نفسها بنفسها. بعض الأصوات تصل إلى حد تصوير الهزيمة وكأنها مسؤولية الجماهير نفسها، وليس نتيجة مباشرة لأداء سياسي عاجز. والأسوأ، أن هؤلاء يقلبون المعايير حتى يصبح عدم تحقيق أي مكسب سياسي دليلاً على «نجاح» غريب، وكأن المشاركة السياسية أشبه برحلة مدرسية يكفي فيها الحضور لاعتبار المهمة منجزة، بدل أن تكون فعلاً سياسياً هدفه انتزاع موقع في السلطة وتنفيذ برنامج قادر على تغيير الواقع. هذا المنطق لا يكتفي بتبرئة الأداء الفاشل، بل يفرغ السياسة من معناها، ويحوّل النضال إلى نشاط رمزي بلا أثر، وكأن الغاية ليست الفعل بل مجرد الوجود في المشهد.
هذه الصناعة ليست نتيجة سذاجة، بل هي فعل محسوب يهدف إلى حماية القيادة من المساءلة. حين يُضفى على العدو حجم أسطوري، تُجرد القيادة من أي مسؤولية تاريخية، ويُوضع التنظيم كله في حالة استنفار دائم يخدم استمرار الوضع القائم. تتحول الطاقة السياسية للأعضاء إلى الدفاع عن سردية مبنية على الخوف، بدل أن تُوظَّف في تطوير أدوات التحليل والعمل. بهذا الشكل، يصبح النقد فعلاً مشبوهاً، ويُعامل النقد الذاتي كجريمة تستهدف «الوحدة»، بينما يتحول الصمت إلى فضيلة تنظيمية يُكافَأ عليها. ومع كل دورة جديدة من الفشل، تُعاد صياغة الرواية نفسها، ويتكرس نوع من القدرية السياسية التي تُقصي الوعي، وتبقي الحركة في موقع العجز المنظّم. في ظل هذا التحكم الخطابي، تتعطل قدرة التنظيم على رؤية واقعه، وتضعف صلته بالتحليل العلمي، وتفقد الحركة إمكانها التاريخي في تجديد نفسها والتفاعل مع شروط الصراع الفعلية، لا المتخيلة.
قد تظن بعض الحركات أنها تمارس النقد حين تُطلق تصريحات عامة عن وجود أخطاء، لكنها تتجنب دائمًا تسمية الفاعل أو تحديد مصدر الخلل. في هذا النوع من الخطاب، يتحول النقد إلى غطاء لغوي يهدف إلى تهدئة القواعد دون كشف الحقيقة.
تحت الذريعة الانتهازية المتمثلة في تجنّب تحميل المسؤوليات أو الإدانات وتسميّة الأخطاء ضد مجهول، يظهر البعض متباكين على ما يُسمّى الهدف النبيل، في حين أن الغاية الحقيقية تكمن في إخلاء المسؤولية، لا في ممارسة النقد الثوري الذي يكشف عن المخطئين والمقصرين والانتهازيين. في هذه اللحظة، يصبح من الضروري التمييز بين النقد الماركسي والنقد الانتهازي. ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن أي نقد لا يحدد المسؤول عن الأخطاء، ولا يبيّن ما إذا كانت ناتجة عن إهمال أو غباء أم عن فعل تخريبي متعمّد، هو نقد انتهازي بامتياز.
هذه الآلية — التضخيم الممنهج للخصوم والتهويل المستمر من المخاطر وتزييف النقد — ليست مجرد تقنية خطابية، بل بنيان كامل من إنتاج الوهم، يحمي القيادة لكنه يدمّر الحركة. ومن دون تفكيك هذا البنيان، يستحيل على أي حركة سياسية العودة إلى ذاتها أو استعادة قدرتها على الفعل التاريخي الحر.
النقد والنقد الذاتي بوصفهما شرطاً لتجدد الحركة وقدرتها على الفعل التاريخي
في الختام، تتحوّل ممارسة النقد إلى فعل تحرري جوهري يعيد تشكيل العلاقة بين الوعي السياسي والحقيقة الواقعية. فحين تستعيد الحركة قدرتها على مساءلة ذاتها وممارساتها، تُعيد بناء مشروعها السياسي على أسس صلبة وواقعية، وتكتسب القدرة على مواجهة الأخطاء وتحويلها إلى دروس عملية تُعزز صلابتها التنظيمية والفكرية. أما إذا هيمنت ثقافة التبرير، وتوقفت آليات النقد عن العمل، فإن الحركة تنغلق على نفسها، وتفقد مرونتها في التعامل مع التناقضات الاجتماعية والسياسية، لتتحول إلى جهاز يحمي مصالح القيادة، بدل أن يكون قوة قادرة على الإنتاج والتغيير.
الحركة التي تسمح بالنقد وتحتضن النقد الذاتي تمتلك أدوات تجديد بنيتها، وتتمكن من قراءة الصراع الطبقي وفهم دينامياته المعقدة، وتقييم خياراتها الاستراتيجية بوعي ودقة. في المقابل، فإن الحركة التي تُشيّد حول قيادتها جداراً من القداسة، وتحوّل الأخطاء إلى محرمات، تصدر حكماً ضمنياً على مستقبلها بالموت التنظيمي والفكري، لأن الإغلاق على الخطأ يؤدي إلى تكرار الهزائم وفقدان القدرة على التعلم من التجربة التاريخية. فالصراع السياسي ليس مساراً خطياً مستمراً، بل هو عملية متقطعة من الصعود والانكسار، ومن هنا تصبح الهزائم جزءاً طبيعياً من التجربة الثورية، ويُمثّل النقد والنقد الذاتي شرطاً أساسياً لإعادة البناء والتجدد، لا مجرد ترف تنظيمي أو شعارات شكلية.
بهذا المعنى، يصبح النقد السلاح الفكري الذي يكسر حلقات الوهم، ويعيد ربط الحركة بالواقع الاجتماعي والسياسي كما هو، لا كما تُصوّره القيادة أو التفسيرات الأحادية. أما التبرير الأجوف لأخطاء القيادة، مهما كانت مبرراته، فهو مساهمة مباشرة في إعادة إنتاج الهزيمة وتثبيت الفشل التنظيمي والفكري. الحركة التي لا ترى نفسها بعيون مفتوحة تسير حتماً نحو العتمة والانغلاق على ذاتها، بينما الحركة التي تملك الشجاعة لقول الحقيقة، بدءاً من حقيقة ذاتها، تمتلك القدرة على إعادة كتابة مسارها السياسي وصنع التاريخ بمسؤولية ووعي.
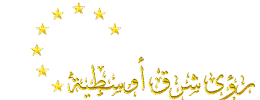


الدراسة تقدّم طرحاً واضحاً في أن غياب النقد والنقد الذاتي لا يضعف الحركة فحسب، بل يدفعها نحو العمى التنظيمي وتقديس القيادة وتبرير الأخطاء. أهميتها أنها تُعيد التذكير بأن أي مشروع سياسي يفقد قدرته على مساءلة ذاته يتحول تدريجياً إلى بنية مغلقة تعيش على الوهم بدل مواجهة الواقع. وباختصار، الرسالة الجوهرية هي أن النقد ليس تهديداً للحركة، بل ضمانة لنجاتها واستمرارها.