تعدّ البُنى الانتخابية والكتل السياسية التي تتفرع عنها مرآة عاكسة لتفاعلات المجتمع المعقدة، حيث تتشابك فيها العوامل الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، والسياسية. فهذه الكتل ليست مجرد أرقام أو نتائج آنية، بل هي بنى عميقة تعكس تراكم خبرات تاريخية وسلوكيات جماعية، تشكّل الأساس الذي يُبنى عليه الأداء الانتخابي والاستراتيجية السياسية. فهم طبيعة هذه الكتل، سواء كانت صلبة، معارضة أو صامتة، يمكّن من إدراك كيفية تفاعل القوى الاجتماعية مع الخطاب السياسي، وقياس مستوى الولاء أو الانحراف عن القاعدة، وكشف الفجوات التي قد يؤدي تجاهلها إلى نتائج غير متوقعة. كما أن تحليل هذه البنى يسمح بتمييز بين القوة الواقعية المبنية على الالتزام الفعلي، وبين القوة المعلنة أو المفترضة، التي قد تكون مشوّهة بسبب ممارسات تنظيمية خاطئة أو تضخم غير حقيقي للأرقام. ومن هنا، يصبح البحث في طبيعة الكتل السياسية ضرورة لفهم ديناميات السلطة، وحسابات الفوز والخسارة، والحدود الحقيقية للتأثير الشعبي.
الكتلة الصلبة — يقين الولاء وحدوده الجدلية
يمكن القول، ببساطة، إن الكتلة الصلبة تشكّل “القلب السياسي” لأي حملة انتخابية. لكنها ليست قلباً ثابتاً أو موحداً في كل الأزمنة والبيئات؛ فهي نتاج سيرورة اجتماعية وتاريخية طويلة، تتداخل فيها المصالح مع رمزية الهوية. في هذا السياق، تذكّرنا أفكار بيير بورديو حول رأس المال الرمزي بأن الولاء السياسي يتشكل عبر تراكم طويل للثقة والعلاقات والمصالح، مما يجعل الكتلة الصلبة نتاجاً لعلاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية متعاظمة عبر الزمن.
تتكون هذه الكتلة من فئات تتمتع بحس عالٍ بالانتماء الحزبي أو الأيديولوجي أو الشخصي، تشمل أعضاء الحزب وعوائلهم والمقربين منهم، بالإضافة إلى المنظمات الجماهيرية القريبة من الحزب. وغالباً، يكون هذا الانتماء متجذراً في تاريخ اجتماعي طويل؛ على سبيل المثال، في القوى المدنية والديمقراطية واليسارية، ينبع الولاء من الانتماء الفكري والطبقي والسياسي. لذلك، فإن التعامل مع هذه الكتلة لا يقتصر على الخطاب الانتخابي فحسب، بل يمتد إلى ما يسميه ريموند ويليامز بـ “البنى الشعورية” التي تحكم علاقة الناس، حيث يكون الولاء إحساساً مُعاشاً بالتاريخ والمعنى، وليس مجرد خيار عقلاني.
لكن، مع كل ذلك، لا ينبغي النظر إلى الكتلة الصلبة على أنها كتلة من “المطيعين” أو “المسلمات السياسية”. فهي قد تتآكل بمرور الزمن إذا ارتكب الحزب أخطاء تنظيمية أو سياسية متكررة، الأمر الذي يبرز طبيعة الولاء كعملية ديناميكية قابلة للتغير تحت تأثير الأداء السياسي.
الكتلة المعارضة — منطق الرفض وحدود التأثير
على النقيض، تمثل الكتلة المعارضة الوجه الآخر للمشهد الانتخابي، فهي كتلة تميل بوضوح إلى التصويت ضد الحزب أو المرشح، بغض النظر عن تغيّر الظروف أو الخطاب. ومع أن الحملات غالباً ما تعتبرها “خسارة محسومة”، فإن التحليل الأعمق يوضح أنها ليست كتلة صماء؛ ففهم دوافعها لا يهدف فقط إلى تغيير رأيها، بل إلى الحد من قدرتها على التأثير، تفكيك خطابها، ومنع تمددها نحو الفئات المترددة. يمكن القول إن كتلة المعارضة هي بمثابة الكتلة الصلبة للخصوم.
تُظهر الأدبيات الحديثة في علم السلوك السياسي، وبشكل خاص مدرسة ميشيغان بقيادة أنغوس كامبل، أن المعارضة غالباً ما تقوم على ما يسمى “الهوية الحزبية السلبية”، أي تعريف الذات عبر رفض الطرف الآخر. لذا، فإن تفكيك البيئة التي تعزز هذه الهوية قد يكون أكثر فعالية من مجرد الخطاب الانتخابي. وينطوي ذلك على ثلاثة مستويات: أولاً حماية الكتلة الصامتة من الانزلاق نحو المعارضة عبر خطاب هادئ وعقلاني يعيد بناء الثقة؛ ثانياً تفكيك خطاب المنافس مباشرة لكشف التناقضات ونزع قوة الإلهام منه؛ ثالثاً الحد من الحوافز التي تدفع الكتلة المعارضة للمشاركة بكثافة، لأن الانتخابات ليست صراعاً على الأصوات فقط، بل صراع نسب المشاركة أيضاً.
على العمق، تتطلب معالجة الكتلة المعارضة دراسة بنية مصالحها الاجتماعية والاقتصادية، وشبكاتها، لأنها كثيراً ما تعكس موقعاً اجتماعياً يرى في صعود خصمه تهديداً لبنيته. وهكذا يصبح التعامل مع هذه الكتلة جزءاً من الصراع الاجتماعي نفسه، وليس مجرد تكتيك انتخابي. كما يقول غرامشي، السياسة ليست فقط ما نمتلك، بل ما نمنع خصومنا من امتلاكه.
الكتلة الصامتة — الغائب الحاضر في المعادلة الانتخابية
الكتلة الصامتة هي الأكثر غموضاً، وتعقيداً، وقدرة على قلب الموازين الانتخابية إذا تحركت. هذه الفئة لا تتعامل مع السياسة بوصفها ضرورة يومية، بل كأمر ثقيل ومربك، وربما بعيد عن حياتها المباشرة. الدراسات السوسيولوجية تشير إلى أن هذه الكتلة غالباً تتكون من من لا يجدون لهم مصلحة مباشرة في الصراع السياسي.
السؤال الجوهري هنا: لماذا تصمت هذه الكتلة؟ الجواب لا يكمن في ضعف الاهتمام، بل في إحساس عميق بعدم جدوى السياسة. فالسياسة، بالنسبة لهم، لم تقدم حلولاً ملموسة للحياة اليومية. ولذلك، يتطلب خطاب هذه الكتلة مقاربة مختلفة: خطاب يضع “الخبز” قبل “الشعار”، ويبدأ من المشاكل الواقعية لا من القيم المجردة. التجارب الحديثة توضح أن هذه الكتلة تستجيب للغة بسيطة، واقعية، قائمة على أمثلة ملموسة: كيف سينخفض سعر النقل؟ كيف ستتحسن الرعاية الصحية؟ كيف يُخفف العبء الضريبي؟ هنا نعود إلى ماركس، الذي أكد أن الوعي الاجتماعي يتشكل عبر شروط الحياة الواقعية.
ومع ذلك، ليست الكتلة الصامتة فراغاً تنظيمياً؛ هي حقل للّامساواة البنيوية: لا تُشارك لأنها غير ممثلة، ولا تُمثّل لأنها لا تُشارك. ولذلك، فإن التواصل معها يتطلب بناء علاقات شخصية من خلال الحضور الميداني، خطاب مطمئن قريب من الحياة اليومية، واستماع حقيقي لمشاكلها.
كيف تقرأ النتائج الانتخابية
يمكن النظر إلى القوة التصويتية بوصفها الحصيلة النهائية لفاعلية الحزب التنظيمية والسياسية. هذه القوة لا تتشكل بصورة عشوائية، بل هي نتاج تفاعل عنصرين رئيسيين: الكتلة الصلبة، باعتبارها نواة الولاء الثابت، وأثر الدعاية الانتخابية وقدرتها على تحريك جزء من الكتلة الصامتة. ويمكن التعبير عن ذلك صياغةً على النحو الآتي:
القوة التصويتية = الكتلة الصلبة + أثر الدعاية الانتخابية في الكتلة الصامتة.
هذه المعادلة البسيطة تُظهر قانوناً سياسياً مهماً:
القوة التصويتية لا يمكن—من حيث المبدأ—أن تكون أقل من حجم الكتلة الصلبة، ما لم يكن هناك خلل تنظيمي أو أزمة عميقة في الشرعية المجتمعية للحزب. ولذلك، فإن قراءة النتائج الانتخابية لا تتم إلا عبر مقارنة الرقم الفعلي بما تمثّله الكتلة الصلبة.
عندما تكون القوة التصويتية أكبر من الكتلة الصلبة، فهذا يشير إلى أن الحزب نجح في إحداث اختراق بنسبة ما داخل الكتلة الصامتة، أي أن الدعاية الانتخابية، والخطاب، والبرامج، وطريقة إدارة الحملة، كانت قادرة على إقناع نسبة معتبرة من المترددين أو غير المهتمين. هنا تتجلى قدرة الحزب على توسيع قاعدة التأييد خارج دائرة تنظيماته، وهو ما تعكسه عادةً الحملات التي تخاطب الاحتياجات المباشرة للناس أو تعالج مشكلاتهم الواقعية بصدق ومهنية.
أما إذا كانت القوة التصويتية مساوية للكتلة الصلبة، فهذا يعني أنّ الحزب فقد أي قدرة على اختراق الكتلة الصامتة. في هذه الحالة يكون الخطاب الانتخابي، بأفكاره وأساليبه ومرشحيه، مرفوضاً اجتماعياً رفضاً واضحاً، أو على الأقل غير قابل للتحول إلى قناعة انتخابية. وهنا يصبح الصمت الانتخابي مؤشراً على انعدام الثقة بالحزب، أو على ضعف القدرة على إقناع فئات جديدة، أو على الفجوة القائمة بين الخطاب السياسي وواقع الناس.
لكن الإشارة الأخطر تظهر عندما تكون القوة التصويتية أقل من حجم الكتلة الصلبة نفسها. هذا الوضع غير الطبيعي لا يمكن تفسيره إلا بعاملين:
الأول: رفض شعبي عميق للخطاب أو للأداء السياسي، بحيث أن جزءاً من الكتلة الصلبة—التي يفترض أنها الأكثر ولاءً—يقرر الامتناع عن التصويت أو التصويت لصالح أطراف أخرى. وهذا يعكس أزمة ثقة، وفجوة بين الحزب واعضائه وعوائلهم ومنظماته الجماهيرية.
الثاني: وجود فساد تنظيمي داخل الحزب، يؤدي إلى تضخيم وهمي لأرقام الكتلة الصلبة عبر تقارير غير دقيقة أو مخادعة. فحين تُظهر النتائج أن القوة التصويتية الفعلية أقل من “الأرقام التنظيمية”، فهذا يعني أن البناء الداخلي للحزب مريض: الأرقام مصنوعة، الولاءات مبالغ فيها، والهيكل التنظيمي غير قادر على تحويل نواته الصلبة إلى قوة اقتراعية فعلية.
بهذا المعنى، تصبح المقارنة بين الكتلة الصلبة والقوة التصويتية أداة تشخيص دقيقة. هي ليست مجرد قراءة للنتائج، بل نافذة تكشف صحة التنظيم، وعمق الثقة، وصدق الخطاب، أو حجم الوهم المتراكم. وهي مدخل ضروري لفهم إن كان الحزب يعمل في مجتمع حيّ أم في مرآة تنظيمية تعكس ما يرغب بسماعه لا ما يواجهه على أرض الواقع.
تضخم حجم الكتلة الصلبة
الكتلة الصلبة ليست انعكاساً للمزاج الانتخابي العام، بل تمثل الخزان التنظيمي الأكثر قرباً للحزب: الأعضاء الملتزمون، المناصرون العضويين، والمقربون الذين يربطهم بالحزب شبكة التزام تاريخية وتنظيمية. ومن هذا المنطلق، أي نتائج انتخابية تأتي أقلّ من حجمها أو تزيد عنه قليلاً لا تعكس بالضرورة ضعف الخطاب أو سوء التحالفات، بل تكشف عن خلل تنظيمي عميق، وربما عن وهم بنيوي أُنتج داخل الأجهزة الحزبية نفسها.
هذا الوهم التنظيمي يتجاوز مجرد تضخيم الأرقام؛ فهو جزء من صراع داخلي بين “الشرعية الحقيقية” و”الشرعية الوهمية”، حيث تُبنى الأولى على القاعدة الشعبية الفعلية، بينما تُستمد الثانية من جهاز تنظيمي متخم بأفراد يسعون لمصالحهم الشخصية أكثر من مصالح الحزب. أي تقدير مبالغ فيه لحجم الكتلة الصلبة هو في جوهره “إيهام” وتضليل، يخلق شعوراً زائفاً بالقوة ويقود إلى استراتيجيات خاطئة عند الاقتراع.
غالباً ما يُستشهد بالمال السياسي وشراء الذمم كمبرر ساذج تستخدمه القيادة الحزبية لإقناع نفسها أو الرأي العام بأن هذه الوسائل هي التي أدت إلى نتائج غير متوقعة أو إلى تراجع التصويت لصالح مرشحي الحزب. ومع ذلك، يمكن القول ببساطة إن هذه الأدوات عاجزة عن تغيير حجم الكتلة الصلبة الفعلية، إلا إذا كانت هذه الكتلة نفسها وهمية منذ البداية. فالمال السياسي قد يحرك أصواتاً مؤقتة أو يوفر امتيازات ظرفية، انه قادر على زيادة استقطاب الكتلة الصامتة لكنه لا يستطيع التأثير بحجم الكتلة الصلبة. وهنا يظهر بوضوح أنّ لجوء بعض القيادات إلى تبرير تراجع النتائج بالحديث عن أدوات الخصوم—كالمال السياسي، والرشوة، وشراء الذمم—ليس سوى محاولة للهروب من مواجهة حقيقة الفساد التنظيمي المستشري في مفاصل الحزب، الفساد الذي يقوّض البنية الداخلية للالتزام ويحوّل القوة المفترضة إلى وهم انتخابي.
يتجلى الفساد التنظيمي بشكل واضح في تضخيم الأرقام من خلال تقارير مبالغ فيها تصدر عن القيادات التنظيمية ومسؤولي المناطق، الذين يسعون غالباً لتعزيز مواقعهم وترسيخ نفوذهم، لا لكشف الحقيقة. هذه “التقارير الوردية” تخلق خلطاً بين السلطة التنظيمية والواقع الشعبي، وتهيئ المجال لهيمنة مصالح فردية على بنية التنظيم، بدل الالتزام بالقواعد الحزبية. كما أن هذه الممارسات غالباً ما تحظى بمباركة وتقدير القيادات العليا، التي تدرك زيف هذه الأرقام لكنها سبق أن مارسوا سلوكاً مشابهاً عندما كانوا في مواقع تنظيمية أدنى. ويزداد تضخّم الأرقام كلما اقتربت من أعلى هرم القيادة، لتتحوّل إلى أداة لخلق وهم بالقوة التنظيمية أكثر منها انعكاساً للواقع الشعبي الفعلي.
عندما يحين يوم الاقتراع، تتكشف الحقيقة بلا تجميل: التوقعات المبالغ فيها تنهار، والكتلة الحقيقية تظهر أصغر بكثير مما رُوّج له. أي تفاوت بين الأرقام التنظيمية والنتائج الفعلية ليس مجرد فجوة طبيعية، بل برهان صارخ على وهم تنظيمي سبق أن أُشير إلى خطورته في تجارب الكادر التنظيمي. إن هذا الوضع يكشف عن الصراع الدائم بين “الشرعية الحقيقية” المبنية على القاعدة الشعبية، و”الشرعية الوهمية” الناتجة عن هيمنة جهاز تنظيمي متخم بالأفراد أصحاب المصالح الخاصة.
وبالتالي، فإن التراجع في الأصوات لا يعني بالضرورة قوة الخصوم، بل قد يعني ببساطة أن الحزب لم يكن يعرف حجمه الحقيقي. أي استراتيجية تُبنى على هذا الوهم تقود إلى صدمات عند الصناديق، لأنها تقوم على تمثيل ذاتي مبتكر من الجهاز التنظيمي، لا على التمثيل الواقعي المبني على التواجد الاجتماعي الفعلي والالتزام الملموس.
الخاتمة
أن القوة السياسية الفعلية لأي حزب لا تُقاس بالأرقام الورقية أو بالتقديرات التنظيمية، بل بالالتزام الواقعي للقاعدة، وبشبكات الولاء الطويلة الأمد، وبحضور مؤثر في المجتمع. فالكتلة الصلبة، كما أظهرت التجارب، هي نتاج تاريخي واجتماعي لا يمكن للمال السياسي أو وعود الانتخاب العابرة أن تخلقه أو تضاعفه، بينما يُبرز تضخم الأرقام والتقارير الوردية هشاشة النظام التنظيمي وسعي الأفراد خلف مصالحهم الخاصة على حساب مصداقية الحزب. وعليه، فإن أي استراتيجية سياسية أو انتخابية تقوم على وهم القوة التنظيمية لا بد أن تصطدم بالواقع عند الصناديق، لتكشف التباين بين الصورة المفترضة والقدرة الحقيقية على التأثير. ومن هذا المنطلق، تصبح مواجهة الفساد التنظيمي الداخلي، وتصحيح آليات القياس والمتابعة، شرطاً أساسياً للحفاظ على مصداقية الحزب، ولضمان أن ينعكس ولاء القاعدة في نتائج ملموسة، وليس في أوهام مؤقتة. إن دراسة هذه البنى، والتمييز بين القوة الواقعية والقوة الوهمية، تمنح الباحثين والقادة السياسيين أدوات لفهم التحولات المجتمعية وإدارة التحديات الانتخابية بوعي أكثر دقة وفاعلية.
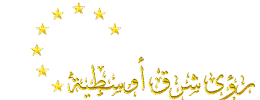


تحليل وتشخيص واقعي وصريح بدون نفاق نتمنى على القيادة ان تستفيد من هذا التشخيص الرائع المعبر عن كثير من الحريصين
تحليل استفدنا منه كثيراً، فهو لمفكر معروف