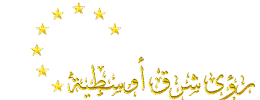تُعدّ ثنائية المجتمع الأهلي والمجتمع المدني من أكثر المفاهيم تعقيداً وإثارة للجدل في الفكر السياسي والاجتماعي الحديث، إذ تتقاطع فيها الأسئلة المتعلقة بطبيعة الدولة، والهوية، والسلطة، والتحوّل التاريخي للمجتمعات من البنى التقليدية إلى البنى الحديثة. وفي المجتمعات الطرفية على وجه الخصوص، تبرز هذه الثنائية بوصفها مرآة لصراعٍ تاريخي بين عالمين: عالم الولاءات الأولية والعصبيات الموروثة، وعالم المواطنة الحديثة والعلاقات التعاقدية التي تنشأ في ظل الدولة الحديثة.
فهذه الثنائية ليست تصنيفاً جامداً بل مرآةً تعكس الصراعات العميقة داخل البنية الاجتماعية والسياسية في مجتمعات الأطراف. في هذا السياق، لا يكفي النظر إلى الظاهِرَتَين باعتبارهما مرحلَتَين زمنيّتين فقط؛ بل يجب أن نفهمهما كعَقدٍ تاريخيٍّ يربط بين طريقة إنتاجٍ اقتصاديّةٍ محددةٍ وطرائق التنظيم الاجتماعي والسياسي التي تُخاطب الناس يوميّاً. على سبيل المثال، العلاقات القائمة على الدم والنسب أو الولاءات الطائفية ليست مجرد بقايا ثقافية؛ بل هي قدرة منظمة داخلياً تُستثمَر سياسياً واقتصادياً في سياقات الريع والشبه إقطاعيات. هذا الفهم لا يطعن في قيمة التضامن التقليدي بحد ذاته — بل يشخّص كيف يمكن لتحوّله أو استغلاله أن يُعطِّل منافذ المواطنة والمصلحة العامة.
المجتمع الأهلي كبنية ما قبل-دولتية
يُشكّل المجتمع الأهلي البنية الأولى في تدرّج التاريخ الاجتماعي، أي المرحلة التي تسبق قيام الدولة الحديثة والمجتمع المدني. فهو مجتمع يقوم على روابط أولية مثل القرابة والعشيرة والطائفة والقبيلة، وهي روابط تُستمد شرعيتها من الانتماء لا من العقد الاجتماعي. هذا الشكل من التنظيم الاجتماعي، الذي كان في فترات معينة ضرورةً لبقاء الجماعة وضمان أمنها، يتحول في زمن الدولة إلى عائقٍ بنيوي أمام تشكل المواطنة. فالمجتمع الأهلي، من حيث طبيعته، لا يعرف الفرد بوصفه مواطناً حرّاً، بل بوصفه عضواً في جماعة مغلقة تُحدّد موقعه وحقوقه سلفاً.
يمكن القول إنّ المجتمع الأهلي يمثل شكلاً من البنية الفوقية التقليدية التي تنشأ فوق قاعدة اقتصادية-اجتماعية ما قبل رأسمالية. ففي الاقتصاديات الزراعية أو شبه الإقطاعية، حيث وسائل الإنتاج محدودة وموزعة بين وحدات صغيرة معزولة، تظهر الحاجة إلى روابط حماية وتكافل تضمن البقاء في ظل غياب المؤسسات الحديثة. لكن هذه الروابط، رغم وظيفتها الاجتماعية الإيجابية في مرحلة تاريخية معينة، تُنتج وعياً زائفاً يقوم على الانتماء لا على المصلحة، وعلى الولاء الشخصي لا على الوعي الاجتماعي. وهكذا تتحول العصبية إلى بديل عن التنظيم، والقرابة إلى بديل عن المواطنة، والزعامة إلى بديل عن الدولة.
لنتخيّل مشهداً بسيطاً: قرية تعتمد تاريخياً على زراعة عائلية صغيرة؛ حين تدخل فيها الدولة ذات طابع ريعي — تنفق شركات نفط أو تمنح عقوداً إدارية — فإن رأس المال الريعي لا يبني روابط إنتاج جديدة، بل يوزّع الامتياز عبر قنوات الولاءات: شيوخ العشائر، قادة الطوائف، شيوخ العشيرة يصبحون كذلك وكلاء سلطة ومودعي امتياز. بهذا تتحول البنية الأهلية من وظيفة اجتماعية مساعدة إلى حلقة في سلسلة إعادة إنتاج الهيمنة. وهذا ما يفسر استمرار العصبيّات حتى مع وجود مؤسسات رسمية حديثة شكلاً: فالأجهزة الرسمية تُعوِّض نقص القاعدة الإنتاجية بسياسات التبعية والإدارة بالولاءات، فتصير الولاءات الأهلية جزءاً من بنية الدولة غير الرسمية.
من منظور تحليلي أعمق، المجتمع الأهلي يعمل كفوقية ثقافية تُخفي تحته اقتصاداً ما قبل-صناعياً أو اقتصاداً تابعاً غير قادر على إنتاج أساس صناعي مستقل. حين تختلُّ قاعدة الإنتاج الحقيقية، تزداد أهمية الروابط الشخصية كوسيلة للوصول إلى الموارد؛ وبذلك تُحوَّل الروابط إلى «سوق بديلة» لتوزيع الامتيازات. نتيجة هذا التحول أن الوعي الاجتماعي يبقى مفككاً: خطاب العدالة يتكسّر على حواف الولاءات، والاحتجاجات الاجتماعية تُستَقطَب بسهولة في قوالب طائفية أو قبلية. وهنا تكمن خطورة الفهم السطحي: المجتمع الأهلي لا يختفي بالتشريع؛ بل يتحول ويصوغ أشكالاً جديدة من الفعل السياسي يمكن أن تكون أداة تحكم أو منصة مقاومة إذا ما أُعيد تسيسها بوعي جديد.
من الناحة العملية، فإنّ تجاوز تأثير المجتمع الأهلي لا يعني محوه القسري أو نبذه الثقافي، بل إعادة توجيه طاقاته التضامنية نحو أطر تنظيمية تقوم على مصلحة عامة ومواطنة. على سبيل المثال، التحوّل من جمعيات عشائرية تقدم خدمات محدودة إلى تعاونيات عمل محلية أو لجان شعبية تدافع عن الحقوق الاقتصادية يمكن أن يحوّل التضامن التقليدي إلى قوة اجتماعية تشكّل أساساً للتحرر الشعبي، لا جهازاً لإدامة التقسيم. هنا يتبدّى كيف يمكن للبنى التقلّيدية نفسها أن تتحوّل إلى أدوات نضالية إن صيغت داخل مشروع يمزج الوعي بالمصلحة والتنظيم بالمساءلة.
المجتمع المدني: تركيبته، نشأته، وتطوّره — ودوره في التحول الديمقراطي
تاريخ مفهوم المجتمع المدني هو في جوهره تاريخ تطور الوعي السياسي والاجتماعي للإنسان الحديث. فالمفهوم لم يظهر دفعة واحدة، بل تشكّل عبر مسار طويل من التحولات الفكرية والاقتصادية التي رافقت الانتقال من البنى الأهلية المغلقة إلى المجتمع الرأسمالي الحديث. ويمكن القول إن المجتمع المدني والدولة المدنية يمثلان وجهين لعملية تاريخية واحدة: انتقال الإنسان من روابط الدم والعشيرة إلى روابط القانون والمواطنة.
في بداياته، عند أرسطو، كان المجتمع المدني مرادفاً لما نسميه اليوم بـ”الدولة السياسية”. فقد استخدم تعبيرKoinonia Politiké (مصطلح (κοινωνία πολιτική) يعني حرفياً المجتمع السياسي أو جماعة المدينة السياسية، وقد استخدمه أرسطو ليشير إلى مجتمع المواطنين الأحرار الذين يشاركون في الحياة السياسية للمدينة، هذا المفهوم يختلف عن المعنى الحديث لـ”المجتمع المدني”، إذ لم يكن هناك في الفكر اليوناني القديم فصلٌ بين الدولة (polis) والمجتمع المدني، بل كانت المدينة هي الإطار الأخلاقي والسياسي الكامل للحياة الإنسانية.
في كتابه السياسة ليشير إلى “مجتمع المواطنين الأحرار المنظَّم في إطار المدينة”، أي مجتمع يسوده القانون والعقل لا الغريزة أو القرابة (انظر: أرسطو، السياسة، ترجمة أحمد لطفي السيد، القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1947، الكتاب الثالث، 1280ب). هنا لم يكن ثمة فصل بين الدولة والمجتمع المدني، لأن المدينة الأرسطية كانت تمثل الوحدة الأخلاقية والسياسية التي تحتضن حياة الإنسان الكاملة.
فالمجتمع المدني هو فضاء متصدّع ومتحول: مساحة مؤسسية تقع بين الدولة والفرد، تضم جمعيات، نقابات، أحزاباً اجتماعية، مؤسسات ثقافية، ومؤسسات اقتصادية ونشطاء مدنيين. هذا الفضاء لا يولد دفعة واحدة؛ نشأ تدريجياً مع تشكّل الروابط القانونية والعقدية، ومع توسّع سوق مؤسساتي يسمح بوجود علاقات أفقية طوعية ومؤسسية. في الموروث النظري، نجد تراكيب مفاهيمية مختلفة: من تصور المدينة الأرسطية كوحدة أخلاقية-سياسية، إلى تفكيك المفهوم لدى هيغل الذي يميّز بين العائلة والمجتمع المدني والدولة، وصولاً إلى قراءة أكثر نقداً تُبيّن أن المجتمع المدني قد يكون ساحةً لإنتاج الأشكال الجديدة للسيطرة كما هو محلّل في كتابات نُخب نقدية معروفة.
لكن المجتمع المدني يحمل تناقضاً جوهرياً: هو مكان تتبلور فيه نزعة المشاركة والوعي بالمصلحة العامة، وفيه تنشأ مؤسسات للدفاع عن الحقوق، والحركات العمالية والنقابية. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يتحوّل إلى أداة احتواء عندما تفقد مؤسساته استقلاليتها؛ تتحول الجمعيات إلى مشاريع تمويلية، والنقابات إلى شراكات بيروقراطية مع الدولة، والمنظمات إلى أجهزة تدخل ضمن بروتوكولات «إدارة الفقر» بدل مواجهة أسبابه البنيوية. بعبارة أخرى: المجتمع المدني يمكن أن يكون جسراً نحو الدولة المدنية الديمقراطية، أو أن يتحوّل إلى آلة ترسّخ الوضع القائم.
تاريخياً، مسارات تشكّل المجتمع المدني في أوروبا اختلفت عن مجتمعات الأطراف. في أوروبا، تراكمت مؤسسات مدنية مع توسّع القاعدة الاقتصادية الغربية، فتمخض عن ذلك سلطة مدنية قادرة على الضغط على الدولة وصياغة مطالب واسعة. أما في مجتمعات الأطراف فـــ«استيراد» المجتمع المدني أو تأسيسه من الأعلى — عبر برامج تمويلية أو تشريعات شكلية — غالباً ما نتج عنه مجتمع مدني ضعيف ومشوه، محاصر ببقايا المجتمع الأهلي ومقوّض باستراتيجيات احتواء تمارسها الدولة أو الجهات الممولة. النتيجة أن المجتمع المدني لا يحقق بالضرورة تحولاً ديمقراطياً ما لم يُعاد توصيله بصراعٍ اجتماعيٍ قادرٍ على تحدّي بنية توزيع الثروة والسلطة.
من هنا ينبثق دور المجتمع المدني في التحول الديمقراطي: ليس كحقل تواصلي محايد بل كساحة لتشكيل موازين قوى جديدة. فالديمقراطية لا تُبنى بمجرد سنّ قوانين أو عقد انتخابات؛ بل باتزان القوى داخل المجتمع المدني الذي يعبر عن مصالح الطبقات المنتجة والمهمشة. عندما تكون مؤسسات المجتمع المدني مستقلة ومنظمة، وتعمل ضمن أجندة تمثيلية للمصالح الشعبية، فإنها قادرة على دفع الدولة نحو إصلاحات توزيعية حقيقية؛ أما إذا ظلت ذراعاً إدارياً مشروعاً من مشاريع التمكين التقني، فستصير مجرد واجهة تُدير نتائج التبعية بدل مواجهة أسبابها.
المجتمع المدني كساحة صراع طبقي: لماذا التوافق المدني دون توافق اجتماعي لا يكفي؟
من المؤكد أنّ أي تصور ديمقراطي حقيقي لا يمكن أن يُختزل في شكله المؤسسي أو الانتخابي، بل يجب أن يُقترن بفهمٍ عميقٍ للعلاقة الجدلية بين الصراع المدني والصراع الاجتماعي. فالمجتمع المدني ليس فضاءً محايداً أو فوقياً عن الطبقات، بل هو الامتداد الرمزي والمؤسسي لتوازنات القوة داخل البنية الاجتماعية. إنه الساحة التي تتجلى فيها تناقضات الطبقات، لا على نحوٍ مباشر دائماً، بل عبر مؤسسات ومنظمات ومشاريع ائتلافية تتخذ طابعاً “مدنياً” يخفي خلفه مصالح مادية محددة.
وحين يتحوّل المجتمع المدني إلى ميدان مؤسسي تهيمن عليه النخب المهنية وتُموَّل أنشطته من مؤسسات خارجية أو شبكات رأسمالية محلية، فإن أجندته تُختزل غالباً في إصلاحات شكلية تُعيد إنتاج النظام بدل تغييره، إذ تبقى محصورة في تحسين آليات التوزيع لا في تعديل قواعده. بهذا المعنى، يصبح توافق هذه النخب مع الشروط الطبقية السائدة شكلاً من أشكال الإضفاء الشرعي على الهيمنة، لا أفقاً لتحرّر جماهيري فعلي.
إن ظاهرة اصطفاف من يرفعون شعار “المدنية” إلى جانب القوى التقليدية – العشيرة والطائفة– ليست مفارقة عابرة، بل تعبير عن بنية وعي طبقي منقوص يرى في الديمقراطية مجرّد توازن بين القوى ضمن النظام القائم، لا مشروعاً لتقويضه. فمشاريع هؤلاء لا تصطدم بجوهر السلطة بل بقشرتها الشكلية، ولا تسعى إلى تفكيك منطق المجتمع الأهلي القائمة على روابط الانتماء التقليدية بل إلى إعادة تدويره بوسائل أكثر “تمدّناً”. وهنا تكمن المفارقة الكبرى: حين يُستَخدم خطاب المجتمع المدني لتجميل الانتماءات الفرعية بدل فضحها، تتحوّل المدنية إلى حجابٍ جديد للهيمنة، لا إلى جسرٍ نحو التحرّر.
يمكن النظر إلى هذه النتيجة بوصفها تعبيراً عن أزمة الوعي الديمقراطي في مجتمعات الأطراف، حيث يتقاطع المطلب المدني مع منطق التبعية الطبقية، فيتحوّل شعار الحرية إلى أداة لإعادة إنتاج السيطرة بوجهٍ أكثر نعومة.
في المقابل، إن استطاع المجتمع المدني استيعاب تعبئة العمال والفلاحين والطلبة والشباب، وتنظيم القوى الاجتماعية وتحويلها إلى تنظيمات دفاعية عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يصبح أداة محورية في إعادة صياغة الدولة. وهنا يتبدّى الشرط السياسي الضروري: توافق الصراع المدني مع الصراع الاجتماعي من أجل العدالة الاجتماعية ومواجهة التبعية والهيمنة. هذا لا يعني حتماً أن كل مبادرة مدنية يجب أن تتحول لحركة طبقية تقليدية، بل أن تكون قادرة على ربط مطالبها بتحولات في البُنى الاقتصادية — أي أن تطالب ليس فقط بإدارة أفضل للفقر، بل بتغيير قواعد توزيع الموارد والسلطة.
على سبيل المثال، عندما تسعى مؤسسات مجتمع مدني للعمل على قضايا الإسكان دون أن تتناول سلاسل الملكية العقارية أو علاقات رأس المال التي تُسيطر على الأرض، فإنها تظلّ ضمن منطق إدارة الأثر لا تقويض البنية. أما عندما تتحالف حركات الإسكان مع عمالٍ متفرغين ومع جمعيات محلية تُطالب بتقاسم الأرض والقرار، فذلك يقلب طاولة التمثيل ويطرح مشروعا واقعيا لإعادة توزيع السلطة. إذاً: التوافق المدني-الطبقي ليس رفاهية نظرية، بل شرط عملي لبناء دولةٍ مدنيةٍ ذات مضمونٍ اجتماعي.
جدلية الأهلي والمدني في سياق الدولة
لذلك لا يمكن اختزال هذا المشهد في قراءة واحدة أو تفسيرٍ خطّي للعلاقة بين المجتمع الأهلي والمجتمع المدني. فالمجتمع الأهلي لا يعمل دائماً كقوة محافظة بالمعنى التقليدي، بل يتبدّل دوره تبعاً لموقعه في منظومة السلطة والاقتصاد. في بعض السياقات، يتحول المجتمع الأهلي إلى حاجزٍ فعلي أمام التغيير الاجتماعي، إذ يُستخدم لتأبيد الولاءات الأولية وتثبيت الامتيازات القديمة، فيمنع تشكّل وعي جمعي عابر للطائفة أو العشيرة. غير أنّ خطورته الأكبر تظهر حين يُعاد تدويره داخل بنية الدولة الحديثة في هيئة مؤسساتٍ تحمل مظهر المجتمع المدني، لكنها تحتفظ بجوهرها الأهلي. عندها يُستنسخ الانقسام العمودي في شكلٍ أفقيٍّ مموّه، فتتحول الجمعيات والمنظمات إلى أدوات لضبط التناقضات بدل تحريرها.
بمعنى آخر، يمكن للمجتمع الأهلي أن يتقمّص شكل المجتمع المدني دون أن يشارك في وظيفته التحررية، فيتحول إلى ما يمكن تسميته “مدنية زائفة”؛ مؤسساتٌ تبدو حديثة في الشكل، لكنها تُدار بمنطق الولاء والزبائنية لا بالمواطنة والمساءلة. وهنا تكمن المفارقة: الدولة قد لا تحتاج إلى إعادة إنتاج البنى التقليدية بصورة صريحة، فهي قادرة على توظيفها داخل المجتمع المدني ذاته من خلال شبكات النفوذ السياسي والمالي والإيديولوجي. وبهذا، يُفرَّغ المجتمع المدني من محتواه الجدلي، ليغدو واجهة إصلاحٍ شكلي تُخفي استمرار العلاقات الطبقية ذاتها.
هذه البنية المزدوجة — حيث يتقاطع الأهلي مع المدني في فضاء واحد — تُنتج نوعاً من الاستقرار الزائف؛ فالتناقضات لا تُحلّ بل تُدار، والصراعات لا تُحسم بل تُحتوى. لذلك، لا يمكن للمجتمع المدني في هذه الحالة أن يؤدي دوره التاريخي في دفع المجتمع نحو التغيير ما لم يُعاد تحريره من هذا التشابك البنيوي. إن تجاوز هذا الوضع لا يتم عبر رفض البنية الأهلية أو البنية المدنية، بل عبر إعادة تحديد موقعهما في الصراع الطبقي: تحويل الأهلي من قاعدة للولاء إلى قاعدة للتنظيم الشعبي، وتحويل المدني من غطاء إداري إلى أداة نقدٍ ومساءلةٍ ومشاركةٍ حقيقية.
فما لم يتحقق هذا التحول، سيبقى المجتمع الأهلي، في صورته المتجددة، أداةً لإدامة التفاوت، وسيبقى المجتمع المدني في شكله الرسمي واجهة ديمقراطية بلا مضمونٍ اجتماعي. عندها تصبح الدولة الحديثة — وإن ارتدت ثوب المدنية — مجرّد جهازٍ يُعيد إنتاج الامتيازات نفسها بلغةٍ جديدة. ومن هنا، تتضح مركزية الصراع داخل الحقل الاجتماعي ذاته: فإما أن يتحول المدني إلى مشروع تحرر، أو أن يُعاد احتواؤه بوصفه الشكل العصري للهيمنة القديمة.
الدولة المدنية: هل تُمثل مقاربة للدولة الحديثة؟
الدولة المدنية ليست عبارة عن دستور أو مجموعة مؤسسات فارغة؛ هي عملية تاريخية تترجم وعياً اجتماعياً منظّماً إلى إطار سياسي مؤسساتي يُحكم بالشرعية الشعبية والمساواة والعدالة. هي ليست بالضرورة نقيضاً لكل ما هو تقليدي — فالعلاقة بين الدولة والمدنية قد تتضمّن عناصر من التراث تُعاد صوغها في سياق مواطني جديد. لكن الدولة المدنية تكون نقيضاً للبنية التي تستعين بالأهليات لتقسيم المجتمع أو لتقوية أغلال التبعية الاقتصادية.
يمكن القول إنّ الدولة المدنية تمثل الامتداد المؤسسي للمجتمع المدني حين يبلغ هذا الأخير مستوى من التمثيل الحقيقي يجعله قادراً على التعبير عن مصالح الطبقات المنتجة لا عن إرادات النخب وحدها. فالمقارنة بين نموذج الدولة المدنية الحديثة وبين أنماط الدولة الإقطاعية أو الريعية تكشف أن الفارق بينهما ليس شكلياً في البنية الإدارية أو القوانين، بل جوهرياً في طبيعة السلطة ذاتها. الدولة المدنية، في معناها التاريخي العميق، لا تقوم على احتكار القوة أو الثروة، بل على آليات لتوزيعهما؛ إنها مشروع لإعادة صياغة العلاقة بين المجتمع والدولة على أسس المشاركة والمساءلة، لا على مبدأ الوصاية أو الامتياز.
لكن هذه الدولة تبقى شعاراً أجوف إن لم يُمسّ جوهرها الاجتماعي: أي إن لم يُعاد النظر في منطق توزيع الموارد داخلها. إذ يمكن أن تُنشأ مؤسسات مدنية حديثة وتُسنّ قوانين متقدمة، بينما يظل الواقع السياسي والاقتصادي أسيراً لمنطق الريع وهيمنة الأنماط الإنتاجية المتخلفة. عندئذٍ، تصبح الدولة المدنية واجهة شكلية فوق بنية سلطوية قديمة، يجرى فيها تحديث الأدوات لا العلاقات.
من هنا، يتطلب بناء الدولة المدنية فعلاً تاريخياً مركباً يقوم على إعادة تشكيل العلاقة بين المجتمع المدني والدولة. فالمجتمع المدني مدعوّ لاستعادة استقلاليته التنظيمية والتمويلية، كي يتحول من واجهة رمزية إلى قوة اجتماعية تعبّر عن مصالح الطبقات المنتجة. وفي الوقت نفسه، يجب أن تتحول البنى الأهلية والتضامنية من روابط تقليدية إلى قوى ترافعية واعية، قادرة على الدفاع عن العدالة الاجتماعية والمصلحة العامة. أما النظام السياسي، فلا يمكن أن يكتسب طابعاً مدنياً حقيقياً ما لم يتخلَّ عن منطقه الريعي، ويستبدل به منطق الإنتاج والمشاركة الديمقراطية والمساءلة الشعبية.
هذه العملية ليست إصلاحاً إدارياً أو هندسة مؤسساتية فحسب؛ إنها مسار نضالي طويل يتضمن إعادة تأسيس للمجتمع على نفسه، وتحرير المجال العام من سيطرة السلطة والثروة. فقيام الدولة المدنية لا يعني فقط بناء مؤسسات جديدة، بل إعادة صياغة العلاقة بين الأفراد والجمع، بين الحقوق والواجبات، بحيث تغدو الدولة انعكاساً للبنية الاجتماعية المنتجة، لا سلطة مفروضة عليها.
خاتمة: نحو شكل ثالث — المدني الشعبي كأفق تحرري
حين انتقل مصطلح المجتمع المدني إلى العالم العربي في تسعينيات القرن الماضي، لم يكن انتقالاً بريئاً ولا استنباتاً طبيعياً داخل البنية الاجتماعية المحلية، بل جاء محمّلاً بطابعٍ مؤسسيٍّ خارجيٍّ مرتبطٍ بخطاب “الإصلاح” لا بخطاب التحرر. فبدل أن يكون المجتمع المدني مشروعاً لتفكيك علاقات التبعية والاستبداد، جرى تقديمه كأداة لإدارة الفقر والتكيّف مع الواقع، لا لتغييره. وهكذا، جرى فصل المفهوم عن جذوره الصراعية التي نشأ عليها في الفكر الغربي، وأُفرغ من مضمونه الجدلي، ليتحول إلى واجهة ناعمة تُستخدم لتسكين التناقضات الاجتماعية بدل كشفها.
ومع ذلك، يبقى المجتمع المدني في جوهره فضاءً مفتوحاً لإمكانية التغيير، شرط أن يُعاد وصلُه بالصراع الطبقي ومشروع العدالة الاجتماعية. ففي أوروبا، وُلد المجتمع المدني من رحم التحولات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي أفرزت الدولة الحديثة، وكان في بداياته يصطدم ببقايا البنى الأهلية التقليدية داخل المجتمعات المحلية، لكنه سرعان ما أصبح جزءاً من سيرورة التحديث نفسها، إذ كان يُعبّر عن لحظة نضج البرجوازية الصاعدة في مواجهة السلطة الإقطاعية والدينية.
أما في العالم العربي، فالمجتمع المدني لم يكن ثمرةً لتحوّلٍ تاريخيٍّ داخليّ، بل استُورد كمفهوم وممارسة في بيئة لم تستكمل شروط الحداثة الاجتماعية ولا التحول الاقتصادي. لذلك، لم يُنظر إليه كأداة لبناء الدولة الحديثة، بل كـ”منتج غربي” يُهدّد البنية القيمية والدينية للمجتمع، فتمت مقاومته ثقافياً وأيديولوجياً قبل أن يُختبر فعلياً سياسياً. هذه المقاومة جعلت المجتمع المدني يعيش مأزقاً مزدوجاً: فهو من جهة يُتَّهم بأنه جسد غريب على التقاليد، ومن جهة أخرى يُفرغ من محتواه الثوري حين يُدرج ضمن سياسات الإصلاح السطحي المموّل خارجياً.
من هنا، لا يمكن أن ينجح المجتمع المدني العربي في أداء دوره التاريخي إلا إذا ربط صراعه السياسي بالصراع الاجتماعي والاقتصادي، وجعل من قضايا الفئات الشعبية محور نشاطه ومصدر شرعيته. فالمجتمع المدني الذي لا ينحاز إلى مصالح العمال والفلاحين وصغار المنتجين يظلّ مجرد غطاء بيروقراطي للنيوليبرالية. أما إذا تحوّل إلى حركة تنظيمية شعبية تعبّر عن مصالح الطبقات المنتجة، فإنه يصبح القوة الدافعة نحو التحول الديمقراطي الحقيقي.
وعند هذه النقطة بالذات، تتكامل العلاقة بين المجتمع المدني والدولة المدنية. فالأخيرة ليست كياناً فوق المجتمع، بل هي المخرج الجدلي لتطوّره التاريخي، أي ثمرة تحوّل المجتمع من علاقات الانتماء الأهلي إلى علاقات المواطنة والمشاركة. فالدولة المدنية الحقيقية لا تُبنى بالخطابات الدستورية ولا بمجرد فصل الدين عن السياسة، بل حين يتحول المجتمع المدني ذاته إلى حاضنةٍ للوعي الاجتماعي، الذي يتجاوز الانتماءات التقليدية، وللممارسة الديمقراطية. إنها، في جوهرها، التجسيد السياسي للوعي الاجتماعي المتحرر من الانقسام الأهلي والهيمنة الطبقية.
لهذا، لا يكفي أن نرفع شعار “المجتمع المدني” أو نحلم بـ “الدولة المدنية” كنصوص مثالية؛ المطلوب هو ربط هذا الخطاب ببنية الواقع المادي، أي بالاقتصاد السياسي للمجتمع. إن تجاوز الثنائية بين الأهلي والمدني لا يعني القضاء على أحدهما، بل تحويلهما: تحويل الأهلي من شبكة ولاءات مغلقة إلى فضاء تضامنٍ نقديٍّ ومساءلةٍ مجتمعية، وتحويل المدني من جهاز إداري تقني إلى حركةٍ اجتماعيةٍ واعيةٍ قادرةٍ على تمثيل المصالح الجماعية.
بهذا فقط يتحقق الربط الجدلي بين المدنية والديمقراطية من جهة، والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى؛ بين بناء الدولة الحديثة ومصالح الجماهير الشعبية المشاركة في إنتاجها. فالمسألة ليست في رفع الشعارات بل في إعادة بناء القاعدة الاجتماعية التي تمنح هذه الشعارات مضمونها التاريخي.
وببساطة، ما تحتاجه مجتمعاتنا ليس خطاباً مدنياً استعراضياً، بل مشروعاً تاريخياً طويل النفس يبدأ من تنظيمٍ فعليٍّ من الأسفل، ويستهدف إعادة توزيع الثروة والسلطة. فهذا هو الشرط المادي لبناء دولة مدنية حقيقية تعبّر عن مصالح الأغلبية المنتجة لا عن امتيازات الأقلية المالكة، وتعيد للمدنية معناها الثوري الأصلي بوصفها فعل تحرر لا تسوية.