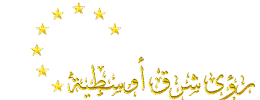لم يعد الإنفاق العسكري مجرد أداة للدفاع أو ردع خارجي، بل بات يشكّل ركيزة أساسية لإعادة إنتاج السيطرة الطبقية داخل الدولة القومية. لقد تحوّلت الجيوش من كونها آلية استثنائية إلى بنية دائمة، تعمل بوصفها جهازًا اقتصاديًا–أيديولوجيًا يعيد إنتاج الدولة في صورتها النيوليبرالية، كما يعيد توجيه الفائض العام نحو قطاعات غير منتجة من منظور اجتماعي، لكنها حيوية لحفظ النظام القائم.
فالاقتصاد الحربي لا يُمكن فصله عن منطق القيمة في الرأسمالية، وأن عسكرة الدولة لا تعبّر عن استجابة فنية لتهديدات، بل عن مشروع سياسي لإعادة ترتيب الموارد بما يخدم رأس المال. الجيوش، من هذا المنظور، ليست كيانات محايدة أو “وطنية” في الجوهر، بل أدوات لإخضاع الداخل بقدر ما يُروّج لها باعتبارها تحميه من “الخارج”.
ان مقاربة ماركسية ناقدة، تستعيد وظيفة “قانون القيمة” داخل الاقتصاد العسكري، وتفكّك الأبعاد الأيديولوجية والأخلاقية التي تُضفي على العسكرة طابعًا شرعيًا. كما سنستعرض كيف يُعاد تشكيل أولويات الإنفاق، وأثر ذلك على البنى الاجتماعية، من الصحة والتعليم إلى الغذاء والمسكن.
إن تحليل الاقتصاد الحربي ليس مسألة تقنية أو إحصائية، بل سؤال طبقي: من يدفع كلفة الحرب، ومن يربح منها؟ ومن دون الإجابة على هذا السؤال، لن يكون ممكنًا فهم الطابع العميق للعسكرة، ولا طرح بديل حقيقي يقوم على اقتصاد الحياة لا اقتصاد الموت.
الإنفاق العسكري العالمي: تحالف الطبقات والمجمع الصناعي الأمني
تشير التقارير السنوية لمعهد ستوكهولم إلى أن العالم ينفق اليوم أكثر من 2.7 تريليون دولار على التسلح والإنفاق العسكري. هذا الرقم لا يمثل مجرد مؤشر على مستوى التهديدات الجيوسياسية، بل يكشف عن تحوّل نوعي في بنية الاقتصاد العالمي: من اقتصاد منتج يُفترض أن يستجيب لحاجات البشر الأساسية، إلى اقتصاد مسيّر بأولويات العسكرة والردع والحرب الوقائية.
ويُلاحظ أن الولايات المتحدة تهيمن وحدها على نحو 37% من هذا الإنفاق، بما يناهز 997 مليار دولار، تليها الصين وروسيا والهند وألمانيا. أما في المنطقة العربية، ورغم هشاشة اقتصاداتها الإنتاجية، فقد شهدت دول الخليج ومصر والجزائر معدلات تسلح مرتفعة تُعبّر عن نزوع مزدوج: عسكرة السياسة وتهميش التنمية.
في هذا السياق، لا تُفهم الجيوش بوصفها أجهزة دفاع محايدة، بل كأطراف فاعلة في تحالف مركّب يجمع بين الدولة، ورأس المال العسكري، وشبكات التمويل والبنى السياسية. وهذا التحالف، الذي يُطلق عليه اسم “المجمع الصناعي–العسكري”، لا ينتظر الحروب بل يُنتجها، لأنه لا يراكم أرباحه من الاستقرار بل من إعادة إنتاج التهديد بوصفه أصلًا ثابتًا في معادلة السوق.
هنا تُصبح الحرب، لا السلام، هي الحالة الطبيعية، وتُستثمر الميزانيات العامة لا في الصحة أو الغذاء أو التعليم، بل في إنتاج أنظمة سلاح فائقة التكلفة، غالبًا دون جدوى عملية حقيقية، وإنما بوظيفة مزدوجة: أولًا، تدوير الفائض الرأسمالي غير القابل للتوظيف الإنتاجي؛ وثانيًا، فرض نظام قمع داخلي باسم “الأمن الوطني” يُبرر الإنفاق العسكري ويُعيد تشكيل وعي الجماهير.
إن ما يُدعى بـ”الردع” ليس سوى إعادة توزيع للموارد من الأكثرية إلى الأقلية، تحت غطاء أيديولوجي يقدّم الأمن كسلعة تحتاج إلى جيش دائم، وقواعد، وإنفاق تصاعدي. وهكذا، يتحوّل الإنفاق العسكري إلى وسيلة طبقية لإعادة ترتيب الأولويات، تُخضِع الحاجات الاجتماعية لمنطق السوق العسكري.
لكن الأهم من الأرقام هو الوظيفة الطبقية لهذا الإنفاق: فهو لا يهدف إلى حماية المواطن، بل إلى ضمان أمن السوق والملكية الرأسمالية، وتقييد مسارات التنمية البديلة في الجنوب العالمي. بعبارة ماركسية دقيقة: هذا الإنفاق يُعيد إنتاج السيطرة الطبقية عبر القوة المسلحة.
كلفة الفرصة الضائعة: حين يُموَّل السلاح بدل الحياة
في عام 2024، بلغ الإنفاق العسكري العالمي 2.718 تريليون دولار، بزيادة سنوية بلغت 9.4%، وهو أعلى نمو مسجّل منذ عام 1988، وفق تقرير SIPRI لعام 2025. وتُسجّل النفقات العسكرية نسبة 2.5% من الناتج العالمي الإجمالي، وارتفعت عند مستوى 7.1% من الإنفاق الحكومي [1]
من جانب اخر يفتقر حوالي ٢.٢ مليار إنسان إلى مياه شرب محسّنة وخدمات صرف صحي تُدار بشكل آمن [2]. لتغطية هذا النقص تتطلب مبلغًا حوالي 50 $ لأعلى جودة ممكنة فإن التكلفة الكلية تبلغ 110 مليار دولار سنويًا، استنادًا إلى UNDP (2016): Costing MDG Drinking Water Targets وWorld Bank: Infrastructure Outlook (2020).
كما ٧٥٠ مليون شخص دون كهرباء، وفق بيانات الوكالة الدولية للطاقة(IEA) [3] وتكلفة تزويد كل فرد بالطاقة المستدامة تُقدّر بـ100 $ سنويًا، ما يعني أن توفير الكهرباء للجميع سيكلف 75 مليار دولار سنويًا، وفق IEA & IRENA: Tracking SDG 7, 2023, p.7. ولتأمين طاقة مستدامة لهم يكفي إنفاق نحو ٧٥ مليار دولار سنويًا. [4]
بالإضافة ٢٥٠–٢٦٠ مليون طفل محرومون من المدرسة، بحسب اليونسكو. بتكلفة تقدّر بـ٢٠٠ دولار سنويًا لكل طفل، يمكن سد هذه الفجوة بـنحو ٥٢ مليار دولار. سنويًا، استنادًا إلى تقديرات Global Partnership for Education.
وتشير الاحصائيات الى ان حوالي ٢ مليار شخص خالية تغطيتهم الصحية الأساسية وتُكبدهم مصاريف مالية قاسية [5] حيث تُقدّر تكلفة توفير الحزمة الأساسية بـ150 $ سنويًا للفرد، ما يعني أن التكلفة الإجمالية تبلغ 300 مليار دولار سنويًا، وفق WHO: Global Health Expenditure Database وWorld Bank: Health Financing for Universal Coverage (2019).
يفتقر أكثر من مليار شخص لأي شكل من الحماية الاجتماعية [6] . ولتأمين دخل أساسي بقيمة ١٥٠٠ دولار للفرد سنويًا، نحتاج إلى نحو ١.٥ ترليون دولار
١.٦ مليار إنسان يعيشون في مساكن غير لائقة، وفق بيانات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وباحتساب 400 مليون أسرة وبمعدل 1200$ سنويًا لتكلفة إقامة منخفضة التكلفة، تبلغ الكلفة الإجمالية 480 مليار دولار سنويًا، وفق UN-Habitat: Global Housing Strategy (2021) وMcKinsey Global Institute: Tackling the World’s Affordable Housing Challenge (2014).
في المجمل، تكلفة سدّ كل هذه الاحتياجات الأساسية تقدر بـ2,517 تريليون دولار سنويًا، أي أقل من الإنفاق العسكري العالمي، مما يترك فائضًا بنحو 201 مليار دولار.، فالخلل ليس في الموارد أو الطلب، بل في تحوّل فائض القيمة مُنظّمًا نحو قمع الشعوب بدلًا من إشباع احتياجاتها الضرورية. وهو في جوهره اختلال بنيوي لصالح رأس المال.
الجيوش كأجهزة أيديولوجية للهيمنة الطبقية
في الخطاب الرسمي للدولة، غالبًا ما تُقدَّم الجيوش كقوى “وطنية” محايدة، خارجة عن الصراع الطبقي، وتقف على مسافة واحدة من الجميع. غير أن هذا التصور يتناقض جوهريًا مع التحليل الماركسي الذي يُدرج الدولة – بما فيها أجهزتها المسلحة – في صلب منظومة إعادة إنتاج الهيمنة الطبقية.
فالدولة ليست جهاز فوقي يقف فوق الطبقات، بل كأداة بيد الطبقة المسيطرة. والجيوش، بوصفها أحد أذرع الدولة الأساسية، لا تُستثنى من هذه الوظيفة. إنها ليست مجرّد أجهزة ردع خارجي، بل تُستخدم لتأمين الاستقرار الداخلي عبر القمع، وضبط الفضاءات التي قد تُنتج الوعي المناهض. هذا ما يجعل من الجيش، لا مجرد مؤسسة تنفيذية، بل جهازًا أيديولوجيًا–قمعيًا، يُساهم في فرض “القبول الطوعي” بالنظام القائم، كما أشار غرامشي لاحقًا.
من الناحية الرمزية، تُنتج المؤسسة العسكرية خطابًا وطنيًا يُجرَّد فيه الصراع من مضمونه الاجتماعي، ويُعاد تقديمه كمواجهة بين “الشعب” وأعداء خارجيين. لكن هذا الشعب – في تمثّلات الدولة – ليس طبقيًا ولا متنازعًا داخليًا، بل موحَّد تحت راية أمنية تقف فوق السياسة والمصالح. في لحظة الأزمة، لا يكون الجيش على الحياد؛ بل يتدخّل لحماية التراتبية القائمة، سواء عبر الانقلابات أو حالات الطوارئ، أو من خلال التحكم غير المباشر في مسارات الحكم.
في هذا السياق، تظهر العلاقة بين الجيش والطبقة الحاكمة كتحالف بنيوي، لا كولاء وظيفي فقط. وداخل هذا التحالف، تُصبح ميزانيات الدفاع أداةً لإعادة توزيع الموارد نحو الصناعات الحربية والمجمعات الأمنية، بعيدًا عن رقابة المجتمع، وبدعوى “الأمن القومي”.
من هنا، فإن نقد الحياد العسكري ليس موقفًا أخلاقيًا، بل تفكيك لوظيفة الدولة بوصفها تعبيرًا عن بنية القوة في المجتمع. والجيوش، في هذا المنظور، ليست أدوات حيادية تنتظر الأوامر، بل بنى عقائدية وتنظيمية تعيد إنتاج الأيديولوجيا السائدة، وتُشكّل جزءًا من ماكينة السيطرة الرمزية والمادية في النظام الرأسمالي.
من قانون القيمة إلى الاقتصاد الحربي: إعادة توجيه الفائض نحو العسكرة
في قلب التحليل الماركسي للاقتصاد السياسي، يشكّل “قانون القيمة” أداة مركزية لفهم كيفية تخصيص الموارد داخل النظام الرأسمالي، وتوزيع العمل الاجتماعي، وتحديد وجهة الفائض. هذا القانون لا يُحدَّد أخلاقيًا، بل تاريخيًا–طبقياً، حيث تُوجَّه الموارد وفق علاقات السيطرة، لا وفق منطق الحاجات. وفي هذا الإطار، يُعيد الاقتصاد الحربي إنتاج ذاته كقناة مركزية لإعادة توجيه الفائض نحو العسكرة، عبر آليات تبدو “تقنية” لكنها تخدم هدفًا طبقيًا واضحًا: حماية رأس المال، لا المجتمعات.
تُظهر هذه العملية كيف لا تُنتج الحروب في الهامش فقط، بل في المركز أيضًا، بوصفها حلًا “اقتصاديًا” لأزمة فائض الإنتاج أو الركود الصناعي. الصناعات العسكرية تُوفّر منفذًا ضخمًا لتصريف الإنتاج الرأسمالي الفائض، وتُسهم في تدوير عجلة التوظيف والإنتاج دون الحاجة إلى إعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية لصالح الفئات الشعبية. وهذا ما يجعل الاقتصاد الحربي أداة “مزدوجة”: من جهة يُقدَّم كخيار أمني، ومن جهة يُستخدم كآلية اقتصادية لتثبيت النظام.
لكن القيمة المُنتجة في هذا السياق لا تُترجم إلى منافع اجتماعية، بل إلى أجهزة قمع، بنى عسكرية، وبُنى تحتية معدّة للردع لا للرعاية. العمل هنا يُعاد تنظيمه لا لإنتاج الغذاء أو الرعاية الصحية، بل لإنتاج أدوات الموت والتحكّم. بل إن فئات واسعة من الطبقة العاملة تُدمج في هذه المنظومة من خلال توظيفها في الصناعات الدفاعية، ما يُعيد إنتاج “القبول الاجتماعي” بالعسكرة بوصفها مصدرًا للوظائف والاستقرار.
وعلى هذا الأساس، لا يُفهم الإنفاق العسكري كمجرد تحوّل في الميزانية، بل كمظهر من مظاهر إعادة تنظيم القيمة ذاتها. فحين يُنتج المجتمع فائضًا، تُقرّر السلطة إلى أين يتّجه: نحو بناء مستشفيات ومدارس، أو نحو إنتاج الصواريخ والطائرات. والاقتصاد الحربي لا يترك هذا الخيار مفتوحًا، بل يحوّل الحرب إلى منطق إنتاج، يُعيد بناء الدولة والبنية الطبقية في آنٍ واحد.
من عسكرة المجتمع إلى تسييل الأمن: كيف تتحول الحرب إلى ثقافة وسوق
ليست العسكرة مجرد ظاهرة متعلقة بجهاز الدولة أو الجيش النظامي؛ بل تتجاوز ذلك لتتحوّل إلى بنية ثقافية واقتصادية شاملة، تتغلغل في النسيج الاجتماعي وتُعيد تشكيل الوعي الجماعي، والذوق العام، وحتى أنماط الاستهلاك. فحين تتحوّل الحرب من استثناء إلى قاعدة ضمنية، تنتقل من كونها “حدثًا” إلى أن تُصبح بنية رمزية–اقتصادية تُعيد إنتاج ذاتها على شكل ثقافة وسوق.
في هذا السياق، يتحول الأمن إلى سلعة قابلة للتداول والاستهلاك، ويُعاد تعريف العلاقة بين الفرد والدولة من خلال “الخوف”. تُقدَّم المؤسسات الأمنية كحَكم ضروري في الحياة اليومية، وتتسع أدوات المراقبة والقمع لتشمل المدارس، الجامعات، شبكات التواصل، والإعلام. فالحرب لم تعد فقط على الحدود، بل باتت تتمدد إلى الداخل، وتُترجم إلى خطاب دائم حول “التهديد”، “الطوارئ”، و”الاستعداد الدائم”.
على المستوى الثقافي، تُروَّج العسكرة من خلال السينما، الألعاب الإلكترونية، والمناهج التعليمية، حيث يُعاد إنتاج العنف كأداة “مشروعة” و”لازمة”، ويُمنح الجندي/الشرطي مكانة رمزية بوصفه الحامي المقدّس، لا كأداة مادية داخل منظومة السيطرة. هذه الرمزية لا تُنتج الولاء فحسب، بل تُمأسس لما يسميه البعض “الروح العسكرية للمدني”، حيث يُعاد تشكيل الفرد ليكون مطواعًا، مراقَبًا، وقادرًا على تقبّل الطوارئ بوصفها طبيعية.
أما على المستوى الاقتصادي، فقد انفتح الفضاء الأمني على منطق السوق الكامل. الشركات الأمنية الخاصة، تكنولوجيا المراقبة، الذكاء الاصطناعي، تقنيات تتبع السلوك، جميعها أصبحت قطاعات ربحية ضخمة، تمثل ما يمكن تسميته “الرأسمالية الأمنية”. هذه القطاعات لا تسعى إلى إنهاء التهديدات، بل إلى تحويلها إلى تدفقات نقدية مستدامة. فكلما زاد الإحساس بالخطر، زادت أرباح صناعة الأمن، وتم تعزيز شرعية الإنفاق العسكري/الشرطي بوصفه “استثمارًا”.
وهكذا، تتلاقى الثقافة والسوق والأمن في آلية واحدة تُعيد إنتاج منطق الحرب بلا حرب، عبر خلق حالة دائمة من الاستعداد، وتوسيع أجهزة المراقبة، وتبرير توزيع الفائض نحو الأمن بدلًا من الحاجات العامة. والمجتمع، في هذا السياق، لا يعود موضوعًا للحماية بل موضوعًا للإدارة والسيطرة.
الخاتمة: نحو تفكيك الاقتصاد الحربي وبناء أفق بديل
ما يكشفه تحليل الاقتصاد الحربي من منظور ماركسي ليس مجرد خلل في توزيع الموارد أو مبالغة في الإنفاق العسكري، بل بنية مادية–أيديولوجية تُعيد إنتاج النظام الطبقي من خلال الحرب والعسكرة. فالجيوش، بوصفها مؤسسات ليست محايدة، تعمل على تأمين النظام القائم داخليًا بقدر ما تدّعي حمايته خارجيًا. والإنفاق العسكري، مهما بدا موجَّهًا لأهداف أمنية، يخدم في جوهره إعادة توجيه الفائض الاجتماعي بعيدًا عن الحاجات العامة، ويُرسّخ أولويات السوق على حساب الحياة.
في ظل تصاعد العسكرة عالميًا، وتحوّل الأمن إلى صناعة، والثقافة إلى وعاء تعبئة دائمة، يُصبح تفكيك منطق “الحرب كضرورة” مهمة سياسية وفكرية عاجلة. المطلوب ليس فقط تقليص النفقات العسكرية، بل إعادة بناء الاقتصاد على أساس حاجات البشر لا على أساس الخوف من العدو. وهذا يتطلب مساءلة جذرية لمكانة الجيوش، لدورها، لحيادها المزعوم، ولمشروعيتها داخل المجتمعات التي يُفترض أن تخدمها.
لقد حاولنا هذا ان نضع الاقتصاد الحربي في سياقه التاريخي والطبقي، باعتباره بنية منتجة، لا فقط مظهرًا سياسيًا. كما أبرز كيف أن الحرب – في زمن النيوليبرالية – لم تعد حدثًا استثنائيًا، بل أصبحت آلية مستدامة لتوجيه القيمة، وتنظيم العمل، والتحكم بالمجتمع. لذلك فإن الصراع ضد العسكرة ليس صراعًا ضد “الجيش” ككيان مجرد، بل ضد كل منظومة التراكم القائمة على الخوف، السيطرة، والتهميش المُمأسس.
في النهاية، لا يمكن لأي مشروع تحرري أن ينضج دون أن يطرح سؤالًا واضحًا: هل الفائض الاجتماعي يُستخدم للحياة أم للموت؟ للإبداع أم للقمع؟ للتعليم والرعاية أم للمراقبة والسلاح؟
إن الإجابة على هذا السؤال ليست تقنية، بل سياسية. ومن يملك شجاعة طرحه، يملك أيضًا مفاتيح نقد النظام الرأسمالي ذاته، وبناء أفق بديل يقوم على اقتصاد اجتماعي لا حربي، وعلى مجتمع تُبنى أمنه من العدالة، لا من فائض الرصاص.
[1] https://www.sipri.org/publications/2025/sipri-fact-sheets/trends-world-military-expenditure-2024
[2] https://www.who.int/news/item/18-06-2019-1-in-3-people-globally-do-not-have-access-to-safe-drinking-water-unicef-who
[3] https://www.iea.org/reports/sdg7-data-and-projections/access-to-electricity
[4] IEA & IRENA: Tracking SDG 7, 2023, p.7.
[5] https://www.who.int/news/item/18-09-2023-billions-left-behind-on-the-path-to-universal-health-coverage
[6] ILO: World Social Protection Report 2020–22, p.29.