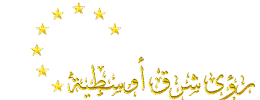تنطلق هذه المقاربة من فهم الدولة الريعية باعتبارها تشكيلة اقتصادية-اجتماعية يتأسس منطقها الداخلي على الاعتماد البنيوي على الريع بوصفه المصدر الرئيس للموارد، لا على عملية الإنتاج. ولا يظل هذا الاعتماد محصورًا في بعده المالي أو في كونه قناة للدخل، بل يتجاوز ذلك ليغدو إطارًا ناظمًا لعلاقة الدولة بكلٍّ من السوق والمجتمع والاقتصاد العالمي. فالدولة الريعية لا تضطلع بدور فاعل إنتاجي يحقق التراكم عبر استحصال فائض القيمة من العمل، وإنما تؤدي وظيفة مغايرة في جوهرها، أقرب إلى وسيط يتولى إعادة توزيع الريع المتأتي من الخارج داخل البنية الاقتصادية المحلية. وعلى هذا الأساس، فإن هشاشتها الاقتصادية والاجتماعية لا تعود إلى اختلالات ظرفية أو قصور إداري، بل تُستمد من طبيعة بنيتها ذاتها، حيث ينعدم الترابط العضوي بين الإنتاج والتراكم.
في هذا السياق، تظهر الدولة الريعية بوصفها سوقاً مزدوجاً للبضاعة. فهي، من جهة، تمتلك قدرة شرائية مرتفعة نسبياً ناتجة عن تدفقات الريع، ومن جهة أخرى، تفتقر إلى قاعدة إنتاجية قادرة على تلبية هذا الطلب داخلياً. النتيجة هي انفتاح واسع على السلع المستوردة، وتحول السوق المحلية إلى فضاء استهلاكي تابع، لا إلى مجال لتطور قوى الإنتاج. هذا الوضع لا يمكن فهمه بمعزل عن موقع الدولة الريعية داخل النظام الرأسمالي العالمي، حيث تُدرج بوصفها طرفاً يؤدي وظيفة محددة: توفير المواد الخام أو الموارد الأولية، واستيعاب فائض السلع المنتَجة في المراكز.
انطلاقاً من هذا الفهم، يصبح مفهوم التبعية مفتاحاً أساسياً لتفسير هذه البنية. غير أن التبعية لا تظهر هنا كحالة واحدة متجانسة، بل تتخذ أشكالاً متعددة تتباين في آلياتها ودرجاتها. لذلك، يمكن التمييز بين نمطين رئيسيين: التبعية الريعية والتبعية غير الريعية. هذا التمييز لا يهدف إلى الفصل القاطع بين حالتين منفصلتين، بل إلى إبراز الفروق البنيوية في كيفية اندماج الدول الطرفية في السوق الرأسمالية العالمية. ففي حين تقوم التبعية الريعية على الاعتماد شبه المطلق على إيرادات الموارد الطبيعية، تقوم التبعية غير الريعية على اندماج جزئي في سلاسل القيمة العالمية دون امتلاك السيطرة الفعلية عليها.
الأهم من ذلك أن هذين الشكلين من التبعية لا يعملان كحالات جامدة، بل كصيرورة تاريخية تُعاد إنتاجها باستمرار. فالعلاقة مع المراكز الرأسمالية لا تتحدد فقط عبر التجارة أو الاستثمار، بل عبر شبكة معقدة من العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وبهذا المعنى، لا تكون التبعية مجرد نتيجة، بل شرطاً لإعادة إنتاج النظام العالمي نفسه. فالمراكز لا تحافظ على تفوقها إلا بقدر ما تبقى الأطراف في موقع السوق والمورد، لا في موقع المنتج المتحكم. هذه الجدلية بين الريع والسوق، وبين التبعية وإعادة الإنتاج، تشكّل الأساس لفهم موقع الدولة الريعية، ليس كاستثناء في النظام الرأسمالي، بل كأحد أشكاله البنيوية المستقرة.
الإطار النظري الماركسي
يرى ماركس أن العلاقات الاجتماعية التي يقوم عليها النظام الرأسمالي لا تظهر في شكلها العاري والمباشر، بل تتخفّى خلف حركة تبادل السلع، بحيث يبدو العالم وكأنه محكوم بتفاعل أشياء مادية، في حين أن ما يجري في العمق هو تعبير عن علاقات اجتماعية محددة تاريخياً. في هذا الإطار، لا تكون السلعة مجرد شيء نافع، بل شكلاً اجتماعياً مكثفاً يحمل داخله علاقة بين العمل ورأس المال. ومن هنا تبرز أهمية قانون القيمة بوصفه الأداة النظرية التي تسمح بفهم منطق هذا النظام. فقيمة السلعة لا تُقاس برغبات المستهلكين أو بندرتها، بل بمقدار العمل الاجتماعي الضروري لإنتاجها ضمن شروط إنتاج سائدة تاريخياً. هذا الفهم يقود مباشرة إلى الصيغة التحليلية المعروفة:
c + v + s
حيث يشير C لرأس المال الثابت إلى وسائل الإنتاج[1]، ويمثل V لرأس المال المتغيّر[2]، بينما S يجسد فائض القيمة[3]
هذه الصيغة ليست مجرد معادلة تقنية، بل تلخيص مكثف لكيفية اشتغال الرأسمالية. فهي توضّح أن تراكم رأس المال لا يتحقق عبر التبادل وحده، بل عبر عملية إنتاج تُنتج فائض قيمة يُعاد استثماره باستمرار. وببساطة، يمكن القول إن قلب النظام الرأسمالي ينبض داخل المصنع، لا داخل السوق، حتى وإن بدا السوق هو الواجهة الأكثر وضوحاً. ومن هنا يظهر التمايز الجوهري بين اقتصاد يقوم على إنتاج فائض القيمة صناعياً، واقتصاد آخر يعتمد على تدفقات مالية لا تمر عبر دورة الإنتاج الكاملة. ففي الحالة الأولى، تكتمل الحركة في الصيغة الكلاسيكية:
M → C → M′
حيث يتحول المال M إلى سلعة C ، ثم يعود مالاً متضخماً ′ Mبفعل فائض القيمة. أما في الحالة الثانية، فنكون أمام حركة مختزلة أقرب إلى:
M → C أو حتى C → M، أي تبادل مباشر للمال بالسلعة دون توسّط إنتاجي فعلي.
هذا التمايز يكتسب أهمية حاسمة عند تحليل الاقتصادات الريعية. فهذه الاقتصادات لا تدخل في دورة التراكم الرأسمالي بوصفها منتِجة لفائض القيمة، بل بوصفها مالكة لإيرادات تُستخدم في شراء السلع المنتَجة في أماكن أخرى. وعلى هذا الأساس، تتحول السوق إلى الفضاء المركزي للاقتصاد، بينما يتراجع الإنتاج إلى هامش ضيق أو تابع. يشبه الأمر، على سبيل المثال، بيتاً واسع الأبواب والنوافذ، لكنه بلا أساسات صلبة؛ الحركة فيه نشطة، غير أنها لا تولّد ثقلاً بنيوياً.
من هنا، يصبح فهم سوق البضاعة أمراً أساسياً لفهم موقع هذه الاقتصادات داخل النظام العالمي. فالسوق، في الحالة الريعية، لا يكون امتداداً طبيعياً للإنتاج، بل بديلاً عنه. وهذا ما يفسر لماذا تتجلى الهشاشة البنيوية رغم وفرة الموارد المالية. فغياب إنتاج فائض القيمة يعني غياب القدرة على التحكم في شروط التراكم، وبالتالي الارتهان الدائم للخارج. بهذا المعنى، لا يكون الفرق بين الاقتصاد المنتج والاقتصاد الريعي فرقاً في الدرجة، بل فرقاً في الطبيعة، وهو فرق يحدد موقع كل منهما داخل خريطة الرأسمالية العالمية.
التبعية — تعريف ماركسي وتصنيفها
تُفهم التبعية، في المنظور الماركسي، بوصفها علاقة تاريخية–مادية تتشكّل داخل بنية النظام الرأسمالي العالمي، ولا يمكن اختزالها إلى حالة من التخلف التقني أو التأخر الزمني. فهي ليست وصفاً أخلاقياً لوضع غير مرغوب فيه، بل تعبير عن موقع محدد تحتله دول بعينها ضمن تقسيم دولي للعمل يخدم منطق تراكم رأس المال على مستوى عالمي. في هذا السياق، لا تكون التبعية نتيجة عرضية لمسار داخلي فاشل، بل مكوّناً بنيوياً في آلية اشتغال الرأسمالية نفسها. فكما يتطلب تراكم رأس المال في المركز شروطاً مواتية للإنتاج والسيطرة، يتطلب في المقابل إعادة إنتاج أوضاع طرفية تؤمّن المواد الأولية، والأسواق، وأشكال العمل الرخيص أو غير المحمي. وببساطة، يمكن القول إن التبعية هي الوجه المكمل لتراكم رأس المال في المراكز.
عند تفكيك هذا المفهوم، تتضح إمكانية التمييز بين شكلين رئيسيين من التبعية، يختلفان في آلياتهما المباشرة لكنهما يلتقيان في النتيجة النهائية. الشكل الأول هو التبعية الريعية، التي تقوم على اعتماد شبه مطلق على إيرادات مورد طبيعي واحد أو مجموعة محدودة من الموارد. في هذا النمط، لا تتطور قوى الإنتاج المحلية بوصفها أساساً للتراكم، بل يجري تجاوزها لصالح تدفق الريع من الخارج. الاقتصاد هنا يأخذ طابعاً إنكلافياً، حيث ينفصل قطاع الريع عن بقية البنية الاقتصادية، فلا يولّد روابط إنتاجية، ولا يدفع نحو تصنيع أو تنويع حقيقي. النتيجة هي اقتصاد استهلاكي يعتمد على الاستيراد، ويعيد إنتاج هشاشته مع كل دورة تقلب في أسعار الموارد أو في موازين القوى الدولية.
أما الشكل الثاني، وهو التبعية غير الريعية، فيبدو أقل حدّة على السطح، لكنه لا يقل بنيوية في الجوهر. في هذا النمط، تنخرط الدولة في سلاسل القيمة العالمية عبر أنشطة صناعية أو خدمية، وتشارك في عملية الإنتاج، لكنها تفعل ذلك من موقع تابع. فالتكنولوجيا، والمعرفة، والتحكم في الأسواق، وتحديد الأسعار، تبقى جميعها متمركزة في يد رأس المال العالمي. وعلى هذا الأساس، يُنتج جزء من فائض القيمة محلياً، لكنه لا يبقى داخل الاقتصاد الوطني، بل يُعاد تحويله إلى الخارج بآليات متعددة. يشبه هذا الوضع ورشة تعمل باستمرار، لكن مفاتيحها الأساسية ليست في يد من يديرها يومياً.
في كلا الشكلين، تظل البنية العامة واحدة: علاقة هيمنة تُقيّد إمكانات التطور المستقل، وتعيد إنتاج موقع الدول الطرفية كسوق ومورد، لا كفاعل متحكم. الفرق لا يكمن في وجود التبعية أو غيابها، بل في شكل تجلّيها وحدّة آثارها. فالتبعية الريعية تُنتج هشاشة فورية وعميقة، بينما تُنتج التبعية غير الريعية مساراً أكثر تعقيداً، يسمح بهوامش حركة محدودة، لكنه يظل محكوماً بسقف لا يمكن تجاوزه دون كسر الشروط البنيوية للعلاقة مع المركز. بهذه الطريقة، تظهر التبعية لا كحالة استثنائية، بل كمنطق منظم للعلاقة بين المركز والأطراف في الرأسمالية المعاصرة.
التبعية الريعية: كيف تُعيد إنتاج الهشاشة وتُرسّخ الدولة كسوق للبضاعة
تقوم التبعية الريعية على بنية اقتصادية يتمحور ثقلها حول استخراج مورد طبيعي واحد أو عدد محدود من الموارد وتصديرها إلى الخارج، بحيث يتحول هذا المورد إلى المصدر شبه الوحيد للعملة الصعبة، وإلى الأساس الذي يُبنى عليه الإنفاق العام للدولة. في مثل هذه البنية، لا يكون الريع مجرد عنصر من عناصر الدخل القومي، بل يصبح العمود الفقري للاقتصاد بأكمله. ونتيجة لذلك، يتخذ الاقتصاد طابعاً إنكلافياً واضحاً، أي أن قطاع الريع يعمل كجزيرة شبه معزولة عن بقية القطاعات الاقتصادية، فلا ينشئ روابط أمامية أو خلفية معها، ولا يدفع نحو تطوير صناعات تحويلية أو زراعية أو خدمية قادرة على خلق تراكم إنتاجي داخلي. وببساطة، يمكن القول إن الريع يحلّ محل الإنتاج بدل أن يكون محفزاً له.
ضمن هذا السياق، تتحول الإيرادات الريعية إلى طلب استهلاكي واسع على السلع المستوردة. فبدل أن يُعاد استثمار الفوائض في بناء قاعدة إنتاجية وطنية، يجري توجيهها نحو الاستهلاك، سواء عبر الإنفاق الحكومي أو عبر دخول الأفراد المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بتوزيع الريع. وهكذا، تتضخم السوق الداخلية بوصفها سوقاً للبضاعة الأجنبية، في حين يبقى الإنتاج المحلي ضعيفاً أو هامشياً. يشبه هذا الوضع خزان ماء يُملأ باستمرار من الخارج، لكنه مثقوب من الأسفل؛ التدفق لا يتوقف، لكن الامتلاء الحقيقي لا يتحقق.
إلى جانب ذلك، تظهر بوضوح آثار ما يُعرف بمرض الهولندي، حيث تؤدي تدفقات الريع الكبيرة إلى ارتفاع سعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية. هذا الارتفاع ينعكس مباشرة على تنافسية القطاعات الإنتاجية الأخرى، فيجعل السلع المحلية أغلى مقارنة بالمستوردة. النتيجة الطبيعية هي انكماش الصناعة والزراعة، وتراجع الحوافز للاستثمار فيهما. ببساطة، يصبح الاستيراد أرخص وأسهل من الإنتاج، ويتحول الاقتصاد تدريجياً إلى اقتصاد توزيع لا اقتصاد خلق قيمة. وإلى جانب هذا الخلل، يُعاد توجيه جزء معتبر من الفوائض الريعية نحو استثمارات مالية أو عقارية أو نحو الخارج، ما يعمّق القطيعة بين الريع وإعادة الإنتاج الموسّع.
سياسياً واجتماعياً، تفرز هذه البنية ما يُعرف بالعقد الاجتماعي الريعي، حيث تقوم الدولة، بوصفها المحتكر الرئيسي للريع، بإعادة توزيعه على المجتمع عبر وظائف عامة، وإعانات، وخدمات مدعومة. هذه العلاقة تُضعف تشكّل صراعات طبقية واضحة، وتؤجل المطالبة بتطوير قاعدة إنتاجية مستقلة. فالولاء السياسي، في كثير من الأحيان، يصبح مرتبطاً بإمكانية الوصول إلى الريع، لا بالمشاركة في عملية إنتاج اجتماعي. وعلى الصعيد الدولي، تسعى المراكز الرأسمالية إلى ضمان استقرار تدفقات هذا الريع، فتندمج الدولة الريعية في شبكة مصالح استراتيجية تُرسّخ تبعيتها بدل أن تفتح أفق تجاوزها. في النهاية، تتجسد الدولة الريعية كسوق للبضاعة الأجنبية: تمتلك القدرة على الشراء، لكنها تفتقد القدرة على الإنتاج، فتبدو غنية في الظاهر، هشّة في العمق.
التبعية غير الريعية
على النقيض من التبعية الريعية، تعكس التبعية غير الريعية شكلاً مختلفاً وأكثر تعقيداً من الارتباط بالمركز. في هذا النمط، لا يعتمد الاقتصاد الوطني على مورد طبيعي واحد، بل ينخرط في سلاسل القيمة العالمية من خلال أنشطة صناعية أو خدمية محدودة، قد تشمل مصانع للتجميع، مراكز خدمات منخفضة الكلفة، أو قطاعات سياحية تجلب العملة الصعبة. ورغم أن هذه الأنشطة تمنح الدولة قاعدة إنتاجية فعلية، فإن السيطرة على التكنولوجيا والمعرفة والأسواق، بما في ذلك القدرة على تحديد الأسعار، تظل بيد المراكز الرأسمالية. وهكذا، يظل الإنتاج المحلي تابعاً للدورة العالمية لتراكم رأس المال، لكنه يوفر هامشاً محدوداً للتنويع والتطوير، ولو تحت قيود صارمة.
هنا يظهر البُعد التكميلي بين التبعيات غير الريعية والريعية: فالدول الريعية، كما أشرنا، تغمرها السلع من المركز، لكنها في الوقت نفسه تتعرض لتدفق السلع المنتَجة في التبعيات غير الريعية التي استثمرت فيها المراكز نفسها. بالتالي، تُصبح السوق الريعية ساحة تنافس مزدوجة، حيث يتصارع سيل من السلع: تلك المنتَجة مباشرة في المركز، وتلك المنتَجة في التبعيات غير الريعية. هذا التنافس ليس مجرد تقاطع عرض وطلب، بل أداة استراتيجية لإبقاء الاقتصاد الريعي تحت هيمنة المركز، ولضمان أن جميع قنوات الاستهلاك تخدم إعادة إنتاج التبعية. بمعنى آخر، الاستثمارات الرأسمالية في التبعيات غير الريعية تعمل كامتداد للمركز، تعزز سلطته الاقتصادية عبر خلق منافسة داخل السوق الريعية نفسها، ما يزيد من اعتمادها على المراكز العالمية ويجعل من اقتصادها تابعاً مزدوجاً.
من الناحية البنيوية، يمنح هذا الوضع التبعيات غير الريعية فرصة محدودة لتطوير قاعدة إنتاجية، لكنه يظل ضمن سقف تفرضه سيطرة المركز. على سبيل المثال، يمكن للقطاع الصناعي في دولة غير ريعية أن يولد وظائف ويكتسب مهارات محلية، إلا أن الفائض الأساسي يتدفق إلى المركز عبر تحويل الأرباح، والتحكم في الأسعار، والتكنولوجيا المستوردة. هذا الوضع يكرّس التبعية بنمط أكثر تعقيداً من التبعية الريعية؛ فهو يخلق دورة مستمرة من السيطرة، حيث تصبح الدولة غير الريعية مصدراً للسلع والخدمات للسوق الريعية، بينما تظل الأخيرة مرتبطة بالسلع المنتَجة في المركز نفسه.
اجتماعياً، يُتيح هذا النمط فرص عمل ومهارات، لكنه لا يكسر منطق التبعية البنيوية؛ فالمركز يظل المستفيد الأكبر، والدول الطرفية تظل عاجزة عن تحقيق استقلالية اقتصادية حقيقية. وهكذا، يتضح أن التبعية غير الريعية لا تلغي هشاشة التبعية الريعية، بل تكمّلها من خلال خلق شبكة مترابطة من الأسواق الموجهة والسيطرة على التدفقات الاقتصادية، ما يجعل النظام العالمي متماسكاً في إعادة إنتاج علاقات المركز والأطراف على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
رأس المال العالمي والدول الطرفية — آليات تكريس التبعية (اقتصادياً، سياسياً، ثقافياً)
من منظور الاقتصاد السياسي العالمي، تُترجم التبعية إلى مجموعة من الآليات الاقتصادية والسياسية والثقافية التي تكفل استمراريتها وتعزز سيطرة المراكز على الأطراف. على المستوى الاقتصادي، تتجلى هذه السيطرة في التقسيم غير المتكافئ للقيمة، حيث تهيمن الشركات متعددة الجنسيات على التكنولوجيا والأسواق، وتوظف أدوات دقيقة مثل تسعير التحويل أو تحويل الأرباح إلى الخارج لضمان أن الجزء الأكبر من فائض القيمة يبقى في المركز. بهذه الطريقة، تُحافظ المراكز على تفوقها عبر آلية أوسع من مجرد الملكية، فهي تتحكم في ديناميات تراكم رأس المال عالمياً. ما وصفه مفكرو الاعتماد مثل سمير أمين وفرانك منذ عقود بأنه «تراكم على صعيد عالمي» يُبرز أن المركز يعيش على حساب الأطراف، ليس فقط عبر تبادل السلع، بل عبر كل دورة إنتاج وقيمة مضافة.
سياسياً، تتكامل هذه السيطرة الاقتصادية مع أدوات أخرى أكثر مباشرة: شروط القروض، إملاءات المؤسسات المالية الدولية، الحماية الأمنية للأنظمة الحليفة، أو حتى سياسات الاستثمار المباشر. الدولة الريعية، على سبيل المثال، تجد نفسها محكومة بشبكة من المصالح الدولية التي تهدف لضمان استمرارية تدفق الريع، بينما الدولة غير الريعية تتعرض لضغوط مرتبطة بالديون، أو باتفاقيات التجارة والاستثمار، أو قيود على إمكانية تطوير صناعات استراتيجية. كل هذه الضغوط تجعل الدول الطرفية عاجزة عن بناء استقلالية اقتصادية وسياسية حقيقية، حتى لو امتلكت بعض القدرات الإنتاجية.
من ناحية ثقافية، تتخذ عملية تكريس التبعية أشكالاً أكثر نعومة، لكنها لا تقل خطورة عن الأبعاد الاقتصادية والسياسية. فعادات الاستهلاك الغربية، والمناهج التعليمية المستوردة، ونماذج الإدارة والمؤسسات، تُرسّخ صورة الدول الطرفية كسوق للبضاعة بدل أن تكون منتجة لها. الثقافة والمعرفة تصبح أدوات للهيمنة، تعمل على إعادة إنتاج القيم والمؤسسات بما يخدم مصالح المركز، فتنتقل السيطرة من مجرد الاقتصاد والسياسة إلى المستوى المعرفي والاجتماعي. بهذا المعنى، الهيمنة الرأسمالية العالمية لا تتحقق بالقوة المادية وحدها، بل من خلال شبكة معقدة من السيطرة على المعرفة، والمهارات، وأساليب التنظيم الاجتماعي والاقتصادي.
النتيجة هي أن الدول الطرفية، سواء كانت ريعية أو غير ريعية، تظل في موقع التابع، يُعاد إنتاجه بشكل مستمر. في الحالة الريعية، يُحتكر الريع ويُعاد توزيعه داخلياً، فتظهر هشاشة بنيوية رغم القدرة الشرائية الظاهرية. أما في الحالة غير الريعية، فتظهر قاعدة إنتاجية محدودة، لكنها مرتبطة بالكامل بالشروط التي يفرضها المركز، ما يتيح فقط هامشاً ضيقاً للتنويع أو التطور. باختصار، التبعية ليست مجرد مرحلة يمكن تجاوزها بسهولة، بل هي جزء من منطق النظام العالمي نفسه، حيث تستمر المراكز في ترسيخ سيطرتها عبر اقتصاد الدول الطرفية، وسياساتها، وثقافتها، وعلاقاتها الاجتماعية، ما يجعل الهشاشة والارتباط بالمركز استمراراً طبيعياً لدورة تراكم رأس المال على المستوى العالمي.
[1] يمثل هذا الرمز كل ما يتم استثماره في وسائل الإنتاج الثابتة مثل الآلات، المصانع، المباني، المعدات، والأدوات
[2] يمثل رأس المال المستخدم لدفع الأجور للعمال. وهو “متغير” لأنه، بخلاف رأس المال الثابت، يمتلك القدرة على توليد فائض قيمة
[3] هذا هو الجزء الذي يولّده العمال فوق قيمة أجورهم، ويستولي عليه رأس المال. فائض القيمة هو أساس تراكم رأس المال ضمن النظام الرأسمالي