لم يكن الجدل حول قوى الإنتاج وليد اللحظة الراهنة، بل هو نقاش قديم متجذر في تاريخ الحركات العمالية، يعود إلى بدايات القرن التاسع عشر مع صعود المكننة الأولى في أوروبا وبزوغ الحركة العمالية الحديثة. في تلك المرحلة، سادت بين قطاعات واسعة من العمال والنقابات نزعة خوف من الآلة، إذ نظروا إليها كتهديد مباشر لوظائفهم ولأشكال عيشهم التقليدية، معتبرين أن إدخال الآلة إلى المصانع يعني البطالة الجماعية وانهيار أنماط الاستقرار الاجتماعي التي ارتبطت بعملهم اليدوي. هذا القلق، على الرغم من أنه استند إلى معاناة ملموسة وواقعية عاشها العمال، لم يلبث أن تعرّض لنقد حاد من الماركسية التي رأت فيه انعكاساً سطحياً لتناقض أعمق.
فماركس في كتابه رأس المال (1867) أوضح أن جوهر الأزمة لا يكمن في تطور قوى الإنتاج، أي في ظهور الآلات أو توسع المكننة، بل في علاقات الإنتاج التي تؤطر وتحدد استخدام هذه القوى. فالآلة ليست بذاتها قوة استغلالية، ولا تحمل في جوهرها ميلاً لإفقار العمال أو استلابهم، بل تتحول إلى أداة للاستغلال فقط حين تخضع لملكية خاصة تُسخّرها لخدمة تراكم رأس المال. بهذا المعنى، فإن الخوف من الآلة أو النظر إليها كعدو طبيعي للطبقة العاملة هو إسقاط خاطئ، لأنه يخلط بين المظهر السطحي والجوهر الطبقي. إن السبب الحقيقي في معاناة العمال لم يكن دخول الآلة، وإنما موقعهم التابع في علاقات الإنتاج الرأسمالية التي جعلت من التقنية أداة لزيادة فائض القيمة عبر التحكم بالعمل المأجور.
هذا التوضيح الماركسي يفتح الباب أمام قراءة جدلية للتاريخ الصناعي، إذ يظهر أن كل تطور في قوى الإنتاج لا يحمل بالضرورة نتيجة واحدة، بل ينطوي على إمكانين متناقضين: إمكان أن يتحول إلى أداة استغلال حين يُدمج في بنية رأسمالية، وإمكان أن يصبح قوة تحررية إذا أُعيد تنظيم العلاقات الاجتماعية على نحو يسمح باستثمار التقنية لصالح المجتمع بأسره. لذلك، لم يكن ماركس ناقداً للتكنولوجيا بذاتها، بل ناقداً للشروط الاجتماعية التي تجعل منها سلاحاً ضد الطبقة العاملة.
إن هذه الرؤية لم تكن مجرد مسألة نظرية، بل شكّلت أساساً في صراع الحركة العمالية الأوروبية مع ما عُرف بالتيارات اللوديتية التي هاجمت المصانع والآلات في بدايات القرن التاسع عشر. بالنسبة للماركسيين، كان ذلك الصراع مثالاً على إسقاط الغضب على السبب الظاهري بدل النفاذ إلى أصل التناقض. فالآلة، إذا ما أُخرجت من سياق الملكية الخاصة، قادرة على أن تكون أداة لتقصير ساعات العمل وتوسيع إمكانات البشر الإبداعية. ومن هنا، تشدد الماركسية على أن المعركة الحقيقية ليست مع الأداة بل مع من يحتكرها، أي مع الرأسمالي الذي يملك شروط إنتاجها وتوزيعها.
هكذا يتضح أن النقاش حول قوى الإنتاج ليس مجرد جدل تقني أو اقتصادي، بل هو سؤال جدلي يتصل بجوهر النظرية الماركسية: العلاقة بين القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج. فإذا كانت القوى المنتجة تمثل مستوى التطور المادي والتقني للمجتمع، فإن علاقات الإنتاج تحدد الكيفية التي تُستخدم بها هذه القوى، وما إذا كانت ستتحول إلى وسيلة لتحرر البشر أو إلى أداة لإعادة إنتاج استغلالهم. وفي هذا الإطار يصبح التاريخ الصناعي شاهداً على قانون عام في المادية التاريخية: كل قفزة في قوى الإنتاج تحمل بذور التناقض مع علاقات الإنتاج القائمة، وتفتح إمكاناً لأفق جديد يتجاوز شكل الملكية السائد.
وعليه، فإن النقاش الذي بدأ مع المكننة الأولى يظل راهناً حتى اليوم. فما كان يُقال عن الآلة في القرن التاسع عشر يمكن أن يُقال عن الرقمنة في القرن الحادي والعشرين: ليست المشكلة في الأداة، بل في علاقات الإنتاج التي تحدد مصيرها. بهذا المعنى، يقدم التاريخ الصناعي والجدل الماركسي معاً قاعدة لفهم التحديات الراهنة، إذ يضعاننا أمام السؤال نفسه: كيف يمكن تحويل قوى الإنتاج الجديدة من مصدر استلاب إلى قوة تحررية؟
الرقمنة وتحول التناقض الطبقي
مع دخول الرأسمالية طورها الرقمي في العقود الأخيرة، اتخذ التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج أبعاداً جديدة غير مسبوقة. إذا كانت الثورة الصناعية قد ارتبطت بالمكننة والآلة البخارية والكهرباء، فإن الثورة الرقمية أعادت تعريف مفهوم الإنتاج ذاته، حيث لم تعد المعرفة مجرد عنصر مساعد في العملية الإنتاجية، بل أصبحت هي القوة المنتجة الأولى. لم يعد الإنتاج مقصوراً على تحويل المادة الخام إلى سلع مادية، بل صار إنتاج القيمة مرتبطاً إلى حد كبير بالبيانات والمعلومات والتدفقات الرقمية التي تتحكم بها الشركات الكبرى. هذا التحول يعيد صياغة البنية الطبقية وسوق العمل ويكشف في الوقت ذاته عن عمق التناقض بين الإمكانات التحررية التي تتيحها الرقمنة وبين القيود التي تفرضها علاقات الإنتاج الرأسمالية.
لقد أدى هذا الانتقال إلى بروز نمط جديد من العامل، يمكن تسميته “العامل الرقمي”، الذي لم يعد يبيع قوة عمله الجسدية أو مهارته اليدوية كما في المراحل السابقة، بل يبيع انتباهه ومعرفته وخبرته المعلوماتية. فحتى النشاط اليومي البسيط على المنصات الرقمية يتحول إلى مادة خام تُختزل في خوارزميات تُباع وتُشترى في الأسواق. المستخدم لم يعد مجرد متلقٍّ للخدمة، بل صار في جوهره منتجاً للقيمة عبر حضوره الرقمي ذاته، لكن هذه القيمة لا تعود إليه، وإنما تُحتكر من قبل الشركات الاحتكارية التي تسيطر على البنية التحتية الرقمية. ومن هنا يظهر نمط جديد من البطالة البنيوية، إذ أن الرقمنة والذكاء الاصطناعي يؤديان إلى تسريح العمال من قطاعات واسعة، في حين يُستوعب جزء آخر في أعمال هشة وغير مستقرة تقوم على عقود قصيرة الأمد أو عمل على المنصات الرقمية دون ضمانات اجتماعية.
بهذا المعنى، فإن الرقمنة تعمّق التناقض الطبقي، لأنها من ناحية تتيح إنتاجية غير محدودة وفائضاً معرفياً هائلاً، ومن ناحية أخرى تحوّل هذه الإمكانات إلى وسيلة لاستغلال أكثر شمولية. العامل الرقمي يعيش اغتراباً مضاعفاً: فهو مغترب عن منتجه المادي الذي لم يعد ملموساً بقدر ما هو بيانات موزعة على خوادم، ومغترب عن ذاته المعرفية التي تتحول إلى سلعة تحتكرها الشركات الكبرى. بهذا يتجاوز الاستلاب الرقمي حدود المصنع أو المكتب التقليدي ليشمل تفاصيل الحياة اليومية، حيث تتحول كل نقرة، كل تفضيل، وكل لحظة من الحضور الرقمي إلى جزء من دورة تراكم رأس المال.
ولو أعدنا قراءة هذا الواقع بعين ماركس، لوجدنا أنه كان سيؤكد أن الرقمنة، رغم خطورتها في ظل الرأسمالية، ليست بذاتها عدواً للإنسان، بل تصبح كذلك حين تُدمج في بنية ملكية خاصة تجعلها وسيلة لتعميق الاستغلال. إن التهديد لا يكمن في الذكاء الاصطناعي كأداة تقنية، بل في انخراطه في شبكة علاقات إنتاج تُعيد إنتاج السيطرة الطبقية بوسائل أكثر خفاءً وفاعلية. هنا تكمن المفارقة: فبينما تتيح الرقمنة إمكانية تاريخية لتقليص ساعات العمل وتحرير البشر من أعباء كثيرة، تستخدمها الرأسمالية لتسريح العمال وتوسيع قاعدة البطالة وإعادة إنتاج هشاشة العمل.
إن ما يحدث اليوم يعيدنا إلى قلب المادية التاريخية: كل تطور في قوى الإنتاج يفتح أفقاً جديداً، لكنه يصبح مصدر أزمة ما لم تُعاد صياغة علاقات الإنتاج بما يتناسب مع مستواه. الرقمنة قادرة على أن تكون أداة للتحرر البشري، إذ تتيح أتمتة واسعة، وتقلل الحاجة إلى العمل الضروري، وتوسع إمكان الوصول إلى المعرفة، لكنها في ظل الرأسمالية تتحول إلى وسيلة للسيطرة على العقول والوعي والوقت نفسه. إننا أمام شكل جديد من السيطرة الطبقية لا يكتفي باحتكار المصنع والأرض ورأس المال المادي، بل يمتد إلى احتكار البيانات والمعرفة والذكاء الاصطناعي.
إن التناقض الطبقي في عصر الرقمنة يختلف في مظاهره لكنه يحافظ على جوهره الماركسي: سيطرة أقلية على وسائل الإنتاج، واستغلال أغلبية تحرم من ثمار عملها. الفرق أن وسائل الإنتاج لم تعد مجرد مصانع وآلات، بل شبكات رقمية وخوارزميات ومنصات عابرة للقارات. من هنا فإن الرقمنة ليست مجرد مرحلة تقنية، بل هي تحول نوعي في تاريخ التناقض الطبقي، لأنها تجعل من المعرفة نفسها موضوعاً للاستغلال، وتحوّل منطق السيطرة من استغلال الجسد إلى استغلال الوعي والزمن الحياتي.
الاغتراب الرقمي كأقصى أشكال الاستلاب
إذا كان ماركس قد رأى في الاغتراب الصناعي أن العامل يفقد السيطرة على منتجه المادي الذي يتحول إلى قوة غريبة عنه، فإن الاغتراب الرقمي يمثل طوراً جديداً وأعمق، حيث لم يعد الاستلاب يقتصر على انفصال العامل عن نتاج عمله اليدوي، بل تجاوز ذلك ليشمل ذاته المعرفية ووعيه الفردي والجماعي. في السياق الرقمي، لم يعد ما يُنتج هو مجرد سلعة مادية، بل تحوّل النشاط الإنساني برمته إلى مادة خام تدخل في دورة التراكم الرأسمالي. كل نقرة، وكل تفضيل، وكل حركة على المنصات الرقمية تتحول إلى بيانات يتم استخراجها وتخزينها ومعالجتها ثم بيعها، لتصبح حياة الإنسان اليومية وخبراته الشخصية وقناعاته الداخلية جزءاً من اقتصاد البيانات الذي يمثل أحد أهم مصادر القيمة في الرأسمالية الرقمية.
هذا الشكل الجديد من الاستلاب يتخذ بعدين متداخلين يصعب الفصل بينهما. الأول بعد اقتصادي يتمثل في أن النشاط الرقمي للمستخدمين، بما فيه من تفاعلات ومعطيات شخصية، يُستثمر ويوظف لإنتاج فائض قيمة لا يعود إليهم، بل يُحتكر من قبل شركات رقمية عملاقة مثل Google وMeta وAmazon. فالمستخدم هنا ليس مجرد مستهلك، بل هو منتج للقيمة من حيث لا يدري، لأن بياناته وانتباهه ووقته تُستثمر كسلع في السوق الرقمية. أما البعد الثاني فهو بعد وجودي–ثقافي، يتمثل في أن وعي الأفراد وأذواقهم وخياراتهم لا تتشكل بمعزل عن هذه الشركات، بل يُعاد صياغتها وتوجيهها عبر خوارزميات مصممة لخدمة منطق الربح. فالإنسان في هذا السياق لا يغترب عن عمله وحسب، بل يغترب عن ذاته ذاتها، إذ تُعاد صياغة شخصيته وفق مسارات استهلاكية مفروضة، ويغدو الوعي الفردي محاطاً بطبقة سميكة من “الوعي الزائف” الذي يخفي طبيعة الاستغلال الكامنة خلف واجهات الخدمات الرقمية.
الخطورة في هذا النمط من الاغتراب أنه يتغلغل في تفاصيل الحياة اليومية على نحو يجعله يبدو طبيعياً أو حتى مرغوباً. فالمنصات الرقمية تقدم نفسها باعتبارها خدمات مجانية، لكن هذه “المجانية” ليست سوى قناع يخفي أن المستخدم هو المنتج الحقيقي للقيمة. هكذا يُستدرج الفرد إلى المشاركة في عملية استلابه، إذ يمنح بياناته وحضوره الرقمي طوعاً، بينما تتحول هذه الموارد إلى مصدر لا ينضب لتراكم رأس المال. إن هذا الشكل من الاغتراب، بخلاف الاغتراب الصناعي الذي كان يتمركز في المصنع أو مكان العمل، يتوزع على فضاءات الحياة كافة، بحيث يصبح الإنسان مغترباً في لحظة استهلاكه كما في لحظة إنتاجه.
ما يميز الاغتراب الرقمي كذلك هو أنه يعيد إنتاج الهيمنة الأيديولوجية التي تحدث عنها ماركس وإنجلز في الأيديولوجيا الألمانية، ولكن بوسائل أكثر عمقاً وفاعلية. فالأيديولوجيا لم تعد تُبث عبر وسائل الإعلام التقليدية وحسب، بل باتت مضمّنة في البنية الرقمية ذاتها، في تصميم الخوارزميات، وفي ترتيب الأخبار، وفي أنماط الاستهلاك الثقافي. وهنا يتحقق شكل جديد من السيطرة، حيث يُمنح الفرد وهم الحرية المطلقة في الاختيار، بينما تكون اختياراته محددة سلفاً ضمن أفق ضيق يرسمه منطق السوق. فالإنسان يعتقد أنه يختار ما يشاء، بينما هو في الواقع يتحرك داخل بنية مغلقة تحدد له ما يراه وما يفضله وما يتخيله.
بهذا يصبح الاغتراب الرقمي أكثر خطورة من الاستلاب الصناعي التقليدي، لأنه لا يسلب العامل منتجه فحسب، بل يسلبه ذاته ووعيه، ويعيد صياغة شخصيته في اتجاه يخدم إعادة إنتاج رأس المال. إن ما نواجهه هنا ليس مجرد فقدان السيطرة على المنتج، بل فقدان السيطرة على الحياة اليومية نفسها، حيث يتحول الزمن الحياتي للفرد إلى مادة قابلة للقياس والاستثمار. الزمن لم يعد ملكاً للإنسان، بل صار مملوكاً للشركات التي تستثمر كل لحظة يقضيها أمام شاشة هاتفه أو حاسوبه.
ومع ذلك، فإن الطابع الجدلي للماركسية يفرض ألا نقف عند حدود الوصف أو التشخيص. فالتطور الرقمي الذي أدى إلى هذا الشكل العميق من الاستلاب يحمل في طياته أيضاً إمكانات لتجاوزه. فإذا كان الإنسان قادراً عبر التكنولوجيا على إنتاج فائض معرفي هائل وتوسيع أفق التواصل البشري إلى مستوى كوني، فإن التناقض يكمن في أن هذه الإمكانات مكبلة بعلاقات الإنتاج الرأسمالية التي تحوّلها إلى أدوات استلاب. وبمجرد أن تتحرر الرقمنة من منطق الربح والاحتكار، يمكن أن تتحول من أداة استغلال إلى أفق تحرري يعيد للإنسان السيطرة على بياناته ووعيه وزمنه.
إن الاغتراب الرقمي، بهذا المعنى، ليس قدراً محتوماً، بل هو شكل محدد من أشكال الاستلاب نتج عن اندماج الرقمنة في الرأسمالية. تجاوزه يتطلب إعادة بناء العلاقات الاجتماعية على نحو يسمح بتحويل المعرفة والبيانات من ملكية خاصة إلى مشاعات جماعية، حيث تُدار الموارد الرقمية بشكل ديمقراطي يحرر الفرد من التشييء ويمكّنه من استعادة ذاته. هنا فقط يمكن للرقمنة أن تصبح قوة إنتاجية تحرر الإنسان من عبودية العمل المأجور ومن أسر الوعي الزائف، وتفتح أمامه إمكانيات إبداعية ومعرفية لا حدود لها.
نقد النزعة التقنية–الفوبيا وصدمات التاريخ
ترافق كل قفزة تقنية كبرى في التاريخ مع موجات من الخوف والقلق، إذ يُنظر إلى الأدوات الجديدة وكأنها كيانات مستقلة تهدد الإنسان في وجوده ومصيره. هذه الظاهرة، التي يمكن تسميتها بالنزعة التقنية–الفوبيا، ليست جديدة؛ فقد ظهرت مع بدايات المكننة الأولى في القرن التاسع عشر حين هاجمت جماعات من العمال البريطانيين المصانع وحطمت الآلات البخارية اعتقاداً منهم أنها السبب المباشر في بطالتهم وفقرهم. كما تكررت في مراحل لاحقة عند إدخال الكهرباء والسكك الحديدية، حيث اعتبرها البعض خطراً يهدد النسيج الاجتماعي ويجلب الخراب إلى المجتمعات التقليدية. واليوم نجد صدى لهذه النزعة في النقاشات الراهنة حول الذكاء الاصطناعي والروبوتات والرقمنة، حيث يُثار القلق من أن تحل الآلة محل الإنسان وتجعله عاطلاً أو عديم القيمة.
غير أن الماركسية، بفضل منهجها الجدلي، تكشف زيف هذه الرؤية الفوبية، لأنها تسقط نتائج التناقض على السبب الظاهري. فالمشكلة لم تكن يوماً في الأداة ذاتها، بل في العلاقات الاجتماعية التي تحدد شروط استخدامها. الآلة البخارية لم تُنتج الاستغلال بذاتها، وإنما أُدمجت في نمط إنتاج رأسمالي قائم على الملكية الخاصة للعمل المأجور، فتحولت إلى وسيلة لتكثيف العمل وتعظيم فائض القيمة. وكذلك الأمر مع الرقمنة: ليست الخوارزميات أو الذكاء الاصطناعي قوة واعية تستعبد البشر، بل هي منظومات تقنية تُدار وفق مصالح رأس المال. إن اختزال الأزمة في الأداة يُحوّل الصراع إلى معركة خاطئة ضد “الآلة”، بدل أن يكون صراعاً ضد من يحتكرها ويوجهها لمراكمة الثروة.
هذا التشخيص يفتح أفقاً أوسع لفهم العلاقة بين التكنولوجيا والتاريخ. فالتطور التقني لم يكن يوماً مسيرة خطية نحو التحرر أو نحو الكارثة، بل كان دائماً مجالاً للتناقض. الثورة الصناعية مثلاً أدت في بداياتها إلى بطالة جماعية وفقر مديني، لكنها في الوقت ذاته مهّدت لظهور البروليتاريا الحديثة، تلك الطبقة التي صارت قادرة بفضل تمركزها في المصانع والمدن على تطوير وعي طبقي جديد، وجعلت من نفسها فاعلاً تاريخياً يطرح مشروع تجاوز الرأسمالية برمتها. من هنا، يمكن القول إن صدمات التكنولوجيا ليست نهاية المطاف، بل هي مقدمات لإعادة تشكيل التوازنات الطبقية وفتح إمكانات جديدة للصراع الاجتماعي.
إن نقد النزعة التقنية–الفوبيا لا يعني تبني موقف متفائل ساذج يرى في التكنولوجيا خلاصاً آلياً، بل يعني إعادة توجيه النظرية والممارسة نحو جوهر الصراع. المطلوب هو إدراك أن كل تطور في قوى الإنتاج يفتح إمكانين متناقضين: إمكان أن يتحول إلى وسيلة لاستلاب أشد حين يُحتكر من قبل رأس المال، وإمكان أن يصبح قوة تحررية إذا أُعيد تنظيم العلاقات الاجتماعية حوله. وبالتالي فإن النضال لا ينبغي أن يوجه ضد الأداة، بل ضد البنية الطبقية التي تحدد وجهتها. إن الخوف من التكنولوجيا، إذا تُرك دون تفكيك، يقود إلى نزعة رجعية تحلم بالعودة إلى الماضي، بينما المطلوب من الموقف الماركسي أن يكون هجومياً، يستثمر إمكانات التطور بدل أن يخشاها.
اليوم، مع الرقمنة والذكاء الاصطناعي، نواجه تكراراً لهذا المنطق. فالخوف من أن “تحكم الآلة” أو أن “تستولي الخوارزميات على العالم” لا يعكس إلا إسقاطاً مشوشاً للتناقضات الطبقية في صورة أسطورية. الحقيقة أن الشركات العملاقة هي التي تحتكر البيانات والخوارزميات وتعيد إنتاج السيطرة عبرها، وليس التقنية نفسها. ولذلك فإن نقد التقنية–الفوبيا شرط أساسي لتأسيس أفق اشتراكي جديد، لأنه يمنع الفكر الماركسي من الانزلاق إلى نزعات محافظة تعيق قدرته على قراءة الواقع.
التاريخ يوضح أن مواجهة صدمات التكنولوجيا لا تكون عبر تدمير الأداة أو إنكارها، بل عبر إعادة صياغة العلاقات الاجتماعية المحيطة بها. كما أن الرقمنة، على الرغم من أنها تُحدث بطالة وتخلق أشكالاً جديدة من السيطرة، فإنها تنتج في المقابل بروليتاريا رقمية عالمية ترتبط ببعضها عبر الفضاء الرقمي، وتراكم خبرات مشتركة يمكن أن تتطور إلى وعي طبقي عالمي جديد. وهنا يكمن الأفق التحرري: ليس في رفض الرقمنة، بل في تحويلها من وسيلة استلاب إلى أداة تضامن وتحرر، وهو ما يتطلب ثورة في علاقات الإنتاج، لا مجرد إصلاحات سطحية.
الإمكانيات التحررية للرقمنة وتناقضها مع منطق الربح
رغم أن الرقمنة في ظل الرأسمالية قد ارتبطت ببطالة بنيوية وبأشكال جديدة من الاغتراب والسيطرة، فإنها في جوهرها تحمل إمكانيات تحررية هائلة، يمكن أن تعيد صياغة علاقة الإنسان بالعمل والمعرفة إذا ما تحررت من منطق الربح والملكية الخاصة. فكما كانت المكننة الصناعية قادرة على تقليص الجهد البدني اللازم للإنتاج، فإن الرقمنة والذكاء الاصطناعي يمتلكان القدرة على تقليص زمن العمل الضروري نفسه، بحيث يمكن للبشر أن يتحرروا من عبودية ساعات العمل الطويلة التي أرّقت الطبقة العاملة منذ القرن التاسع عشر. هذه الإمكانية ليست مجرد وهم طوباوي، بل حقيقة مادية كامنة في قدرة الأنظمة الرقمية على أتمتة عمليات معقدة في الإنتاج والخدمات والإدارة.
إذا نظرنا إلى الجانب الإيجابي من الرقمنة، سنجد أنها تتيح أفقاً غير مسبوق لتوزيع المعرفة عالمياً، وتفتح المجال أمام بناء شبكات تضامن عابرة للحدود، وتعزز قدرة الأفراد على المشاركة في القرار العام. فالمعرفة التي كانت حبيسة الجامعات أو مراكز الأبحاث باتت متاحة بضغطة زر، والاتصال الذي كان يتطلب جهداً ووقتاً صار لحظياً، والتعاون بين جماعات متباعدة جغرافياً أصبح ممكناً عبر فضاءات رقمية مشتركة. كل هذا يمثل إمكانيات ثورية لإعادة صياغة العلاقات الاجتماعية على أسس أكثر مساواة وتعاوناً. غير أن هذه الإمكانيات تصطدم بحاجز صلب هو منطق السوق، الذي يحوّل المعرفة إلى سلعة ويحتكر البنية التحتية الرقمية في يد قلة من الشركات العملاقة.
التناقض هنا يتجلى بوضوح في أن ما يمكن أن يكون وسيلة لتحرير الإنسان من الضرورة يتحول إلى وسيلة لإخضاعه بشكل جديد. الذكاء الاصطناعي لا يُستخدم لتقصير يوم العمل بل لتسريح العمال وخفض تكاليف الإنتاج، والبيانات لا تُوظف لتعزيز المشاركة الديمقراطية بل لتوجيه الاستهلاك والسيطرة السياسية، والرقمنة لا تُستثمر لتوسيع حرية الفرد بل لتضييقها عبر الخوارزميات التي تصوغ وعيه وتحدد خياراته. إن ما يحدث هو إعادة إنتاج للتناقض الماركسي الكلاسيكي: قوى الإنتاج تصل إلى مستوى يسمح بالتحرر من عبء العمل الضروري، لكن علاقات الإنتاج الرأسمالية تكبح هذا الإمكان وتحوّله إلى مصدر جديد للاستغلال.
ومن منظور ماركسي، فإن هذا التناقض لا يمكن حله عبر إصلاحات سطحية أو تعديلات قانونية محدودة، بل يتطلب ثورة جذرية في علاقات الإنتاج. فالإمكانيات التحررية للرقمنة لن تتحقق إلا حين تتحول من ملكية خاصة إلى ملكية جماعية، أي حين تصبح البيانات والمعرفة والخوارزميات موارد مشاعية تُدار ديمقراطياً لصالح المجتمع بأسره. في مثل هذا السياق، يمكن للرقمنة أن تفتح أمام البشر أفقاً جديداً يتيح توزيع الثروة على نحو أكثر عدلاً، ويوفر وقتاً أطول للإبداع والثقافة والتواصل الإنساني. بذلك تتحقق مقولة ماركس حول تحويل الضرورة إلى حرية، إذ يصبح الإنسان حراً ليس لأنه تحرر من العمل كلياً، بل لأنه تحرر من العمل المأجور كعبء يستهلك حياته.
ما يميز الرقمنة في هذا السياق أنها لا تقتصر على تحسين مستوى المعيشة أو زيادة الإنتاجية، بل تحمل إمكانية إعادة تعريف معنى العمل ذاته. فإذا كانت الرأسمالية قد جعلت من العمل ضرورة وجودية وقسرية، فإن الرقمنة تفتح مجالاً لتحويل العمل إلى نشاط حر وإبداعي يمارسه الإنسان بصفته غاية في ذاته لا مجرد وسيلة للبقاء. وهنا يظهر الأفق التحرري للذكاء الاصطناعي والأتمتة: ليس في استبدال الإنسان بالآلة، بل في تحرير الإنسان من أشغال مرهقة تمنعه من التفرغ للإبداع والفكر والتضامن.
غير أن هذا الأفق سيظل معطّلاً ما دام محكوماً بعلاقات إنتاج برجوازية تعيد إنتاج السيطرة. ولذلك فإن إبراز الإمكانيات التحررية للرقمنة هو في الوقت ذاته إبراز لحدودها الراهنة تحت الرأسمالية. فكل ما يبدو اليوم كأداة استلاب يمكن أن ينقلب إلى أداة تحرر بمجرد أن تتحرر من قبضة الملكية الخاصة وتُعاد صياغة شروط استخدامها ضمن مشروع اجتماعي جماعي. إن الرقمنة ليست قدراً استغلالياً، بل قوة مزدوجة تحمل إمكانين متناقضين: إما أن تظل أداة لهيمنة رأس المال، أو أن تتحول إلى أفق لتحرر الإنسان. والمطلوب من الفكر الماركسي أن يفضح هذا التناقض وأن يفتح الباب أمام إعادة توجيه قوى الإنتاج نحو مشروع إنساني يتجاوز منطق الربح.
الثورة في علاقات الإنتاج وإعادة تعريف الملكية في العصر الرقمي
إن كل ما سبق من تحليل للتناقضات التي تثيرها الرقمنة والذكاء الاصطناعي يقودنا إلى النتيجة الجوهرية التي أكدتها الماركسية منذ بداياتها: لا يمكن تجاوز أزمة الاستغلال عبر إصلاحات سطحية، بل يتطلب الأمر ثورة جذرية في علاقات الإنتاج. فالمسألة لم تعد محصورة في ملكية المصانع والآلات كما في القرن التاسع عشر، بل اتسعت لتشمل ملكية أكثر تجريداً ورمزية: ملكية المعرفة والبيانات والخوارزميات والبنى التحتية الرقمية. هذه الموارد الجديدة باتت هي قوى الإنتاج الأساسية في الاقتصاد المعاصر، والسيطرة عليها هي ما يحدد شكل الهيمنة الطبقية في طور الرقمنة.
الرأسمالية الرقمية أعادت صياغة معنى الملكية نفسها. فإذا كان المصنع في الماضي يُعد رمزاً لسيطرة الرأسمالي على قوة العمل، فإن الشركات العملاقة مثل Google وMeta وAmazon تجسد اليوم السيطرة عبر احتكار البيانات والبنى التحتية التي تُبنى عليها الحياة الرقمية برمتها. بيانات المستخدمين، التي تبدو مجرد أنشطة يومية عابرة، تتحول إلى مادة خام أساسية في عملية التراكم الرأسمالي. إن رأس المال لم يعد يتجسد في الحديد والصلب وحدهما، بل في تدفقات غير مرئية من المعلومات يتم تحويلها إلى قيمة عبر الخوارزميات. بهذا المعنى، فإن علاقات الإنتاج في العصر الرقمي تتأسس على تملك غير مباشر لوعي البشر وذاكرتهم وخبراتهم الجماعية، أي على ما يمكن تسميته بـ”الملكية المعرفية الاحتكارية”.
من هنا تبرز الحاجة إلى ثورة في تعريف الملكية نفسها. فإذا كانت الماركسية الكلاسيكية قد طرحت شعار تحويل وسائل الإنتاج إلى ملكية جماعية، فإن الطور الرقمي يتطلب توسيع هذا الشعار ليشمل وسائل إنتاج المعرفة والبيانات. أي أن المسألة لم تعد فقط إعادة توزيع الثروة، بل إعادة صياغة الشروط التي يتم فيها إنتاج الثروة أصلاً. وهذا يقتضي بناء مؤسسات جديدة لإدارة هذه الموارد بشكل ديمقراطي ومشاعي، على غرار ما تحدث عنه ماركس في تحليله لـ”المشاعات”، ولكن بصيغة رقمية حديثة تتناسب مع طبيعة القوى الإنتاجية الراهنة.
إن المشاعات الرقمية لا تعني مجرد إتاحة الوصول إلى البيانات أو البرمجيات بشكل مجاني، بل تعني إعادة تنظيم الإنتاج الرقمي بحيث يخضع لإدارة جماعية ويُستخدم لتحقيق الحاجات الإنسانية لا لتكريس الربح. الجامعات، مراكز البحث، المنصات التكنولوجية، وحتى شبكات التواصل الاجتماعي، يجب أن تتحول إلى فضاءات مشاعية تُدار بشكل ديمقراطي يضمن للناس السيطرة على معارفهم وبياناتهم. وبدون هذا التحول، ستبقى الرقمنة أسيرة لرأس المال الذي يحولها إلى أداة استلاب.
الثورة في علاقات الإنتاج بهذا المعنى ليست مجرد خطوة اقتصادية، بل هي خطوة حضارية. فهي تعيد تعريف العمل نفسه، إذ لم يعد العمل مقصوراً على الجهد اليدوي أو حتى الذهني، بل أصبح يشمل إنتاج البيانات والمعرفة والإبداع. وبقدر ما تتحرر هذه الأبعاد من الملكية الخاصة، بقدر ما يتحرر الإنسان من عبودية العمل المأجور. وفي هذا السياق، يصبح الهدف الاشتراكي في الطور الرقمي ليس فقط القضاء على الاستغلال الاقتصادي، بل أيضاً تحرير الزمن الإنساني وإعادة توجيه طاقات البشر نحو الإبداع والتعاون والثقافة.
ومن الجدير بالذكر أن الثورة في علاقات الإنتاج لا يمكن أن تُختزل في عملية سياسية سريعة أو في قرارات تشريعية محدودة، بل تتطلب بناء بنية مؤسساتية بديلة، قادرة على إدارة المشاعات الرقمية بكفاءة وعدالة. وهذا يتطلب تطوير ديمقراطية أعمق من الشكل التمثيلي التقليدي، ديمقراطية تتناسب مع الطابع الشبكي للفضاء الرقمي وتتيح مشاركة واسعة للأفراد في صياغة القرارات. وهنا تظهر إمكانية الجمع بين الرقمنة والاشتراكية: الأولى توفر الأدوات التقنية لتجاوز مركزية القرار وبناء شبكات لامركزية، والثانية توفر الرؤية الطبقية والسياسية التي تضمن توجيه هذه الأدوات نحو المصلحة الجماعية.
بهذا المعنى، فإن الثورة في علاقات الإنتاج في العصر الرقمي ليست فقط ضرورة اقتصادية لمواجهة الاستغلال الجديد، بل هي ضرورة وجودية لإنقاذ الإنسانية من استلاب متصاعد يستهدف وعيها وزمنها وحياتها اليومية. هي ثورة تعيد للمعرفة طابعها الجمعي، وتعيد للإنسان مكانته بوصفه غاية الإنتاج لا مجرد وسيلة له.
نقد الاستلاب الرقمي وإمكانية بناء وعي طبقي جديد
يمثل مفهوم الاستلاب أحد أعمدة التحليل الماركسي الكلاسيكي، إذ اعتبر ماركس أن العامل في ظل الرأسمالية يفقد السيطرة على نتاج عمله، فيغدو المنتج غريباً عنه ويتحول إلى قوة مستقلة تهيمن عليه. غير أن ما نشهده اليوم في ظل الرقمنة يتجاوز هذا الاستلاب الصناعي التقليدي إلى ما يمكن وصفه بالاستلاب الرقمي. فالإنسان لم يعد مغترباً عن منتجه المادي فحسب، بل أصبح مغترباً عن ذاته المعرفية والرمزية. كل نقرة على الشاشة، كل تفضيل على منصة اجتماعية، كل تفاعل أو مشاركة، تتحول إلى بيانات تُستثمر وتُباع وتُعاد صياغتها في صورة خوارزميات تُستخدم لتوجيه السلوك. بذلك تصبح خبرة الفرد وحياته اليومية مادة خام لعملية تراكم رأسمالي، ويغدو وعيه ذاته مجالاً للاستغلال.
هذا الاستلاب الرقمي يتخذ شكلين متداخلين. الأول اقتصادي مباشر: إذ يُسلب العامل الرقمي أو المستخدم البسيط ثمرة نشاطه، سواء عبر العمل غير المدفوع في إنتاج المحتوى أو عبر القيمة التي تولدها بياناته الشخصية، والتي تحتكرها الشركات الرقمية الكبرى. أما الشكل الثاني فهو وجودي–ثقافي: حيث يتم تشكيل أذواق الأفراد وخياراتهم وحتى رؤيتهم للعالم عبر خوارزميات مصممة لخدمة منطق الربح. وبهذا لا يقتصر الاستلاب على فقدان السيطرة على المنتج، بل يمتد إلى فقدان السيطرة على الذات، ليغدو الفرد غريباً عن رغباته الحقيقية ومندمجاً في عالم من “الوعي الزائف” يبعده عن مصالحه الطبقية.
هذا الوضع يعيد إنتاج ما وصفه ماركس بالهيمنة الأيديولوجية، ولكن بأدوات جديدة أكثر فاعلية وخفاء. فإذا كانت وسائل الإعلام التقليدية في القرن العشرين قد لعبت دوراً في تشكيل الوعي الجمعي بما يخدم الطبقة الحاكمة، فإن المنصات الرقمية اليوم تتجاوز ذلك عبر قدرتها على التغلغل في تفاصيل الحياة اليومية والتأثير في الممارسات الفردية لحظة بلحظة. ما يجعل الاستلاب الرقمي أكثر خطورة هو أنه لا يظهر كقوة قسرية مفروضة من الخارج، بل يتجلى في صورة “حرية” يرحب بها المستخدمون. الفرد يشعر أنه يختار بحرية بينما في الحقيقة تُحدد خياراته مسبقاً عبر خوارزميات غير مرئية.
غير أن هذا التحليل الماركسي لا يقف عند حدود الوصف، بل يكشف أيضاً عن إمكانات تجاوزه. فالتناقض الكامن في الرقمنة يتمثل في أنها، رغم استخدامها لتعميق السيطرة، تتيح في الوقت ذاته إمكانيات لبناء وعي نقدي جديد. الفضاء الرقمي، بفضل طابعه الشبكي والعابر للحدود، يتيح للطبقات المستغلة أن تتواصل وتتبادل تجاربها، وأن تدرك أنها تواجه شكلاً جديداً من الهيمنة المشتركة. وبقدر ما تنكشف آليات الاستلاب الرقمي، بقدر ما تتبلور إمكانية تحويل هذا الفضاء إلى مجال لتشكيل وعي طبقي جديد يتجاوز حدود الدولة القومية ويأخذ طابعاً عالمياً.
إذن، ما يبدو في البداية أداة لتفتيت الوعي قد ينقلب إلى أداة لتشكيله على نحو أكثر جذرية. البروليتاريا الرقمية الناشئة – التي تضم العاملين في المنصات، والمنتجين المعرفيين، والمستخدمين المستلبين على حد سواء – تمتلك إمكانية تطوير وعي مشترك بمصالحها حين تدرك أن بياناتها وحياتها اليومية تتحول إلى مصدر لاستغلالها. وهنا يبرز الدور الحاسم للفكر الماركسي: ليس فقط في فضح آليات الاستلاب، بل في تحويل هذا الفضح إلى أداة لبناء وعي جمعي مقاوم.
إن نقد الاستلاب الرقمي يفتح أفقين متكاملين. الأفق الأول يتمثل في كشف آليات السيطرة التي تخفيها الشركات خلف واجهات “الخدمة المجانية” أو “الابتكار”، ما يتيح للمستغلين أن يدركوا طبيعة التناقض الحقيقي. أما الأفق الثاني فيتمثل في بناء بدائل قائمة على المشاعية الرقمية، حيث تُدار البيانات والبنى التحتية بشكل جماعي، وتُعاد للإنسان سيطرته على معارفه وخبراته. غير أن هذا الأفق لن يتحقق في غياب مشروع اشتراكي يطيح بالملكية الاحتكارية ويؤسس لبنية جديدة من العلاقات الاجتماعية.
بهذا المعنى، فإن الاستلاب الرقمي ليس نهاية المطاف، بل لحظة انتقالية في الصراع الطبقي. صحيح أنه يكشف عن مدى تغلغل الرأسمالية في تفاصيل الحياة، لكنه في الوقت ذاته يضع أسساً لوعي طبقي جديد أكثر شمولاً وعالمية. وما يميز هذا الوعي هو أنه لا يتأسس فقط على التجربة الاقتصادية المباشرة للعمل المأجور، بل أيضاً على تجربة الاستلاب اليومي للذات المعرفية والرمزية. وهذا ما يمنح الطبقات المستغلة أفقاً أوسع لتجاوز الرأسمالية في طورها الرقمي.
الخاتمة: نحو أفق اشتراكي جديد في عصر الرقمنة
بعد استعراض المسارات المختلفة التي تناولت العلاقة بين الماركسية والرقمنة، يتضح أن النقاش الراهن حول قوى الإنتاج في الطور الرقمي ليس مجرد امتداد ميكانيكي للنقاشات التي عرفها القرن التاسع عشر مع الثورة الصناعية، بل هو طور نوعي جديد يفرض إعادة تفكير عميقة في مفاهيم الاستلاب، والعمل، والملكية، والوعي. لقد بينت المحاور السابقة أن الرقمنة، بما تتضمنه من ذكاء اصطناعي وأتمتة وتحكم في البيانات، تمثل قفزة غير مسبوقة في تطور قوى الإنتاج، لكنها في الوقت نفسه تعمّق التناقض الأساسي بين الإمكانيات التحررية للتقنية وبين القيود التي تفرضها علاقات الإنتاج الرأسمالية.
في البداية، رأينا كيف تعاملت الماركسية مع الخوف الأولي من المكننة، إذ رفضت اختزال الأزمة في “الآلة” باعتبارها مصدر الاستغلال، وأكدت أن جوهر التناقض يكمن في علاقات الملكية الخاصة. هذا الدرس التاريخي يعاد إنتاجه اليوم في مواجهة الرقمنة، حيث يُسقط كثيرون نتائج الأزمة على الأداة نفسها – الخوارزميات أو الذكاء الاصطناعي – بدلاً من النفاذ إلى البنية الطبقية التي تجعل منها أدوات استلاب. بهذا المعنى، فإن “نقد نقد قوى الإنتاج” يصبح شرطاً لتجاوز النزعة التقنية–الفوبيا التي تحجب جوهر الصراع وتغرق الوعي في وهم الخطر التقني بدلاً من إدراك خطر الملكية الاحتكارية.
ثم رأينا كيف يكشف الاستلاب الرقمي عن أعمق أشكال السيطرة التي عرفتها البشرية حتى الآن. لم يعد العامل مغترباً فقط عن نتاج عمله المادي، بل صار مغترباً عن ذاته المعرفية ووعيه اليومي. البيانات، التفضيلات، الأنشطة، كلها تتحول إلى مادة خام لرأس المال، مما يجعل السيطرة أكثر خفاءً وفاعلية. ومع ذلك، فإن هذا الاستلاب ذاته يفتح إمكانية جديدة لبناء وعي طبقي عالمي، إذ يدرك الأفراد تدريجياً أن حياتهم اليومية ليست خارج علاقات الإنتاج، بل هي في صلبها.
في المقابل، أبرزنا أن الرقمنة ليست مجرد أداة للاستلاب، بل تحمل إمكانيات تحررية كبيرة. قدرتها على الأتمتة تتيح تقليص يوم العمل الضروري، ونشر المعرفة بشكل فوري، وبناء شبكات تضامن عابرة للحدود. غير أن هذه الإمكانيات تبقى مكبوتة ما دامت خاضعة لمنطق السوق، الذي يحوّل الرقمنة إلى وسيلة لتعميق البطالة والهشاشة بدلاً من تحرير البشر. وهنا يتجلى بوضوح الطابع الجدلي للتكنولوجيا: فهي في الوقت نفسه أداة استلاب وإمكان تحرر، ويتوقف مصيرها على طبيعة العلاقات الاجتماعية التي تحدد شروط استخدامها.
هذا يقود إلى المحور الأعمق: الثورة في علاقات الإنتاج. فالرأسمالية الرقمية لا تستند فقط إلى ملكية المصانع أو الأراضي، بل إلى احتكار المعرفة والبيانات والبنى التحتية الرقمية. ومن ثم، فإن أي مشروع تحرري لا يمكن أن يقتصر على إعادة توزيع الثروة، بل يجب أن يعيد تعريف الملكية ذاتها. المشاعات الرقمية تطرح هنا أفقاً جديداً، حيث تُدار الموارد المعرفية والتقنية بشكل جماعي وديمقراطي، وتتحول من أدوات تراكم رأسمالي إلى أدوات تعاون إنساني. وهذا التحول لا يقتصر على الجانب الاقتصادي، بل يفتح الطريق نحو إعادة تعريف معنى العمل نفسه، بحيث يتحرر من طابعه القسري ويغدو نشاطاً حراً وإبداعياً.
كما بينّا، فإن مواجهة النزعة التقنية–الفوبيا شرط أساسي لأي أفق اشتراكي جديد. فبدلاً من الخوف من التكنولوجيا أو الحنين إلى الماضي، يجب استثمار إمكانيات التطور التقني لتوسيع آفاق التحرر. والتاريخ يوضح أن كل قفزة تقنية كبرى ولّدت صدمات اجتماعية، لكنها في الوقت نفسه فتحت إمكانات جديدة للصراع والتحول. الثورة الصناعية أنتجت البروليتاريا الحديثة، والرقمنة اليوم تخلق بروليتاريا رقمية عالمية تمتلك أدوات جديدة للتواصل والتنظيم.
في النهاية، يتضح أن معركة الماركسية في عصر الرقمنة ليست معركة ضد التكنولوجيا، بل ضد النظام الطبقي الذي يحتكرها ويوجهها لمصالحه الخاصة. المطلوب هو تحرير الرقمنة من قبضة رأس المال وإعادتها إلى وظيفتها الإنسانية بوصفها قوة إنتاجية جماعية. ومن هنا، فإن “نقد نقد قوى الإنتاج” ليس مجرد تمرين نظري، بل هو ممارسة سياسية تستهدف إعادة توجيه مسار التاريخ. فإذا كانت الرقمنة اليوم مصدراً للاستلاب، فإنها تحمل في الوقت نفسه بذور التحرر، شرط أن تُنتزع من سياقها الرأسمالي وتُعاد صياغتها في إطار مشروع اشتراكي عالمي.
إن الأفق الذي يفتح أمامنا ليس أقل من ثورة حضارية، تنقل البشرية من مجتمع يقوم على الاستغلال والاغتراب إلى مجتمع يقوم على التعاون والمعرفة المشتركة. عندها فقط يمكن أن يتحقق الوعد الماركسي بتحويل الضرورة إلى حرية، وأن تتحول الرقمنة من قيد إلى أفق، ومن وسيلة هيمنة إلى أداة لتحرر الإنسان.
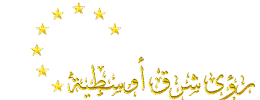


شكرا على هذا البحث القيم واثراء المجال