يبدأ ماركس نقده للرأسمالية من فرضية تبدو للوهلة الأولى بديهية، لكنها في الحقيقة تحمل عمقاً فلسفياً وإنسانياً لا يمكن تجاهله. فالعمل ليس مجرد وسيلة اقتصادية لتأمين الحاجات اليومية أو لإنتاج السلع المادية، بل هو التعبير الأسمى عن جوهر الوجود الإنساني نفسه. فالإنسان، بخلاف الكائنات الأخرى، لا يكتفي بما تمنحه الطبيعة بشكل مباشر، بل يسعى إلى إعادة تشكيلها وفق تصور ذهني وخطة مسبقة. إنه لا يعمل كي يعيش فقط، بل يعيش أيضاً كي يعمل ويبدع، لأن العمل بالنسبة له ليس فعلاً بيولوجياً آلياً، بل هو الفضاء الذي يتجسد فيه وعيه وتظهر فيه قدرته الخلّاقة على ابتكار الجديد وتجاوز حدود الغريزة.
لتقريب الفكرة، يمكن تخيّل العصفور الذي يبني عشه بدقة مدهشة، لكنه يفعل ذلك على نحو موروث لا يتبدل عبر الزمن، كأنه يكرر وصفةً قديمة أودعتها الطبيعة في غريزته. في المقابل، حين يبني الإنسان بيتاً، لا يكتفي بتقليد ما سبق، بل يتصور أولاً ما يريد، ثم يصمّم ويبتكر ويختار المواد والأشكال وفق ذوقه وحاجاته وأحلامه. البناء هنا لا يكون مجرّد فعلٍ نَفعي، بل تجلٍّ لقدرته على تحويل الفكرة إلى شكل، وعلى إدخال الوعي والإبداع في صميم الفعل العملي. هكذا يصبح العمل تعبيراً عن إنسانية الإنسان، لأنه يجسد حريته في أن يبدع لا أن يكرر.
غير أن هذه الإمكانية العميقة، التي تجعل من العمل أفقاً للتحرر، تنقلب في ظل الرأسمالية إلى نقيضها. فبدل أن يكون العمل ساحة للإبداع وتحقيق الذات، يتحول إلى سلعة تُعرض في السوق ويُقاس ثمنها بميزان الربح والخسارة. العامل لا يرى في منتوجه امتداداً لذاته، بل شيئاً غريباً عنه ينفصل عنه لحظة بيعه ويعود ليواجهه كقوة خارجية متسلطة. بل إن شروط العمل نفسها، من تقسيم المهام إلى ضبط الوقت الصارم والرقابة الدائمة، تتحول إلى وسائل لإخضاعه وإفقاده القدرة على ممارسة إنسانيته الكاملة.
وهنا يتجلى انفصال الإنسان عن منتوجه لأنه لا يملكه، وانفصاله عن عملية الإنتاج لأنها مفروضة عليه من الخارج، ثم انفصاله عن ذاته نفسها لأنه لم يعد يجد في عمله وسيلة لتأكيد إنسانيته، بل عبئاً يثقل كاهله ويقيد طاقاته. بهذا المعنى، يغدو العمل الذي كان ينبغي أن يكون طريقاً للتحقق الذاتي أداة للاستلاب والسيطرة، فتتحول الأزمة من مسألة اقتصادية بحتة إلى أزمة وجودية تمسّ تعريف الإنسان لنفسه وعلاقته بالعالم.
هذا التأسيس يفتح لنا الباب لفهم التحولات الراهنة في عصر الرقمنة. فإذا كان القرن التاسع عشر قد شهد اغتراب العامل الصناعي في المصنع، فإن القرن الحادي والعشرين يكشف لنا أشكالاً جديدة وأكثر تعقيداً من الاغتراب داخل فضاءات الخوارزميات والمنصات الرقمية. وهكذا ندرك أن نقد الاستغلال لم يفقد راهنيته، بل ما زال يشكّل مفتاحاً أساسياً لقراءة التناقضات الزمنية والمعرفية والوجودية التي يعيشها الإنسان في الحاضر.
التسارع المعرفي ومنطق التراكم الرأسمالي
شهد العالم في العقود الأخيرة تسارعاً غير مسبوق في إنتاج المعرفة، تسارعاً لا يقل في شدته عن الثورات الصناعية التي قلبت موازين الاقتصاد والمجتمع في القرون السابقة، غير أنّه هذه المرة لا يتمثل في الآلات وحدها، بل في حقل الأفكار والمعلومات والبيانات. فما كان يتطلب عقوداً من البحث والتجريب بات يُنجز اليوم في سنوات قليلة، بل في شهور وأحياناً في أسابيع معدودة، بفضل الخوارزميات المتطورة والحوسبة الفائقة والذكاء الاصطناعي القادر على معالجة ملايين المدخلات في لحظات. يكفي أن نتأمل حجم المعلومات التي تُنتج في يوم واحد، وهو حجم يفوق أحياناً تراكمات قرون كاملة من الجهد البشري، لندرك أننا أمام تحول عميق يمسّ طبيعة الزمن نفسه. إن صورة مكتبة ضخمة تُضاف إليها كل ساعة ملايين الكتب الجديدة، لكن معظمها لا يُقرأ أو يُستوعب، تعطي انطباعاً واضحاً عن هذا المشهد، حيث يغدو التراكم الكمي هو العلامة الأبرز، لا الاستيعاب ولا التوظيف النوعي.
غير أنّ هذا التسارع لا يحدث في فراغ محايد، بل يتم داخل منطق رأس المال الذي يسعى على الدوام إلى اختصار الزمن وتعظيم فائض القيمة. المعرفة لم تعد هدفها توسيع مدارك البشرية أو تعميق وعيها، بل تحولت إلى ما يمكن تسميته برأس مال معرفي، أي أصل اقتصادي يُحتكر ويُستثمر لتحقيق الأرباح. وبذلك يغدو الزمن ذاته سلعة قابلة للتسليع، وتختزل العملية المعرفية إلى سلسلة متواصلة من الإنتاج السريع الذي لا غاية له سوى خدمة التراكم الرأسمالي.
من هنا نفهم كيف تتحول براءات الاختراع والاكتشافات العلمية والابتكارات التقنية إلى ملكيات خاصة تحتكرها الشركات الكبرى، بينما يُحرم الجمهور الأوسع من الاستفادة منها أو الوصول إليها. المعرفة لم تعد تُنتج لتحرير الإنسان، بل لضمان السيطرة وتعزيز مواقع النفوذ في السوق العالمية. إن ضغط الزمن في هذا السياق لا يعني تحرير الإنسان من عناء العمل، بل يعني على العكس إخضاعه أكثر لإيقاع السوق المحموم. كل لحظة باتت محكومة بمعيار السرعة والاستجابة الفورية، حتى أصبح الإنسان يشعر بأن حياته كلها محصورة في سباق لا نهاية له.
وبهذا تتضح المفارقة الجوهرية: فالتسارع المعرفي الذي كان يمكن أن يكون مدخلاً لإطلاق طاقات البشر وتوسيع آفاقهم تحوّل إلى أداة لتعميق الاستغلال وتعزيز الاحتكار. المعرفة، بدل أن تكون ميراثاً مشتركاً للبشرية، غدت ثروة محتكرة لدى قلة قليلة. وفرتها المادية لم تعد تعني وفرة في المعنى أو في التحرر، بل على العكس صارت علامة على ندرة المشاركة وانكماش الأفق الإنساني. إننا أمام وفرة بلا تحرر، وتراكم بلا معنى، وزمن مسرّع لمصلحة الربح لا لمصلحة الإنسان.
بطء الاستيعاب والاستلاب الزمني
في مقابل هذا التسارع المحموم في إنتاج المعرفة، يظل الإنسان محكوماً بحدوده البيولوجية والمعرفية التي لا يمكن تجاوزها مهما بلغت قوة الأدوات التكنولوجية. فالتعلم البشري، بخلاف معالجة الآلة، يحتاج إلى زمن نوعي، زمن يتخلله التكرار والمراجعة والتأمل، ويقوم على التدرج البطيء لتكوين الفهم والوعي. العقل الإنساني لا يعمل بسرعة الخوارزميات التي تلتهم البيانات لحظة بلحظة، بل يحتاج إلى مسار يتراكم عبر التجربة والذاكرة والانفعال. يمكن القول إن الوعي يشبه شجرة صغيرة تحتاج إلى سنوات كي تمتد جذورها في الأرض وتتشابك فروعها في السماء، بينما تتعامل الرأسمالية مع الإنسان كما لو كان آلة يمكن برمجتها في لحظة لتبلغ اكتمالها.
هذا التفاوت يكشف عن تناقض بنيوي عميق: فمن جهة، هناك الإيقاع السريع الذي تفرضه مختبرات الشركات الكبرى ومراكز البحث التي تضخ آلاف الاكتشافات يومياً، ومن جهة أخرى، هناك الإيقاع البطيء لاستيعاب الفرد والمجتمع لهذه التدفقات. ليست القضية مجرد قصور في التعليم أو نقص في الأدوات، بل هي تعبير عن اصطدام منطقين مختلفين: منطق السوق الذي يضغط لاختصار الزمن وتسريع كل شيء، ومنطق الكينونة الإنسانية التي تتطلب زمناً نوعياً للتأمل والفهم وإعادة البناء الداخلي.
ومن هنا يبرز ما يمكن تسميته بالاستلاب الزمني. فالإنسان المعاصر لم يعد يغترب عن منتوجه فحسب، بل يغترب أيضاً عن زمنه. إن إيقاع السوق الرقمي يحاصره ويجعل حياته محكومة بساعة لا ترحم، كأنه عدّاء يجبر على الركض بلا توقف، لا لأنه يريد بلوغ هدف معين، بل لأن التوقف ذاته يعني الخروج من السباق. وهكذا تتحول اللحظات التي يفترض أن تكون مخصصة للراحة أو للتواصل الإنساني إلى امتداد للضغط نفسه، حيث تتدخل التطبيقات والتنبيهات المستمرة لتسرق الزمن الشخصي وتحوله إلى زمن السوق.
الأمر لا يقتصر على الأفراد وحدهم، بل يشمل المجتمعات والدول بأكملها. فالمجتمع الذي يعجز عن مجاراة إيقاع السوق الرقمي يجد نفسه في موقع التابع المتأخر، والدولة التي تفشل في التحكم في زمن المعرفة تُقصى من دوائر التأثير العالمية. الزمن لم يعد فضاءً للنمو أو للإبداع، بل أصبح معياراً للإنتاجية ومقياساً لمدى الانخراط في منطق السوق. ومع هذا التحول، يغدو الإنسان غريباً عن زمنه كما هو غريب عن عمله ومعرفته، فيفقد القدرة على أن يعيش إيقاعه الداخلي الخاص، ليجد نفسه أسيراً لإيقاع خارجي يفرضه السوق بلا رحمة.
بهذا المعنى، يصبح التناقض الزمني أكثر وضوحاً: فالمعرفة التي كان يفترض أن تكون طريقاً لتوسيع الحرية الإنسانية تتحول إلى مصدر ضغط وإكراه، لأنها تنتج بسرعة لا يوازيها الاستيعاب. الفجوة بين التسارع الخارجي والبطء الداخلي ليست مسألة تقنية يمكن حلها بتحسين التعليم أو تطوير الأدوات، بل هي فجوة بنيوية تكشف عن حدود الرأسمالية ذاتها. فالإنسان لا يمكن أن يتحول إلى آلة مهما بلغ التطور الرقمي، والوعي لا يمكن ابتلاعه كما تبتلع الخوارزمية ملايين البيانات. إن الكينونة الإنسانية تقاوم في صمت، وتفرض نفسها بوصفها حدوداً لا يستطيع منطق السوق أن يتجاوزها.
الاغتراب في صورته الجديدة – من المصنع إلى الخوارزمية
حين صاغ ماركس مفهوم الاغتراب في القرن التاسع عشر، كان يصف وضع العامل الصناعي في المصنع، ذلك الذي يرى نتاج عمله وقد انفصل عنه ليتحول إلى سلعة لا يملكها، ويشعر في الوقت نفسه أنه مجرد ترس صغير داخل آلة ضخمة تُدار من خارجه. كان الاغتراب إذن انفصالاً عن المنتوج، عن عملية العمل، وعن الذات التي لم تعد تجد في العمل سبيلاً للتحقق، بل عبئاً ثقيلاً يفرضه النظام الرأسمالي. غير أنّ ما نشهده اليوم في ظل الرأسمالية الرقمية لا يلغي هذا الاغتراب، بل يعيد إنتاجه في صورة أكثر تعقيداً وشمولاً. لم يعد الأمر مقصوراً على المصنع المادي، بل امتد ليغطي فضاءات جديدة: الخوارزميات، المنصات الرقمية، والبيانات التي تتحكم في الزمن والمعرفة والوعي الإنساني ذاته.
الفرد المعاصر يعيش نوعاً جديداً من الاغتراب، ليس فقط عن عمله المأجور بل عن زمنه نفسه. فالإيقاع المحموم الذي تفرضه السوق الرقمية يجعل الإنسان دائماً في سباق مع وقت يتسرب من بين يديه، حتى يصبح الزمن، الذي كان يوماً حليفاً طبيعياً للنمو والإبداع، خصماً دائماً يحاصر وجوده. ساعات اليوم تنقسم إلى وحدات صغيرة محكومة بمعيار الاستجابة الفورية والإنتاجية المتزايدة، فيجد الفرد نفسه غريباً عن زمنه كما لو كان يعيش داخل ساعة ضخمة لا تهدأ.
ويضاف إلى ذلك اغتراب آخر هو الاغتراب عن المعرفة ذاتها. فما ينتجه الأفراد من بيانات وأفكار وتفاعلات لا يبقى ملكاً لهم، بل يتحول إلى مادة خام تعيد الشركات الكبرى صياغتها وتحتكرها في شكل براءات اختراع وخوارزميات مغلقة. حتى المستخدم العادي الذي يتخيل نفسه مجرد مستهلك للمحتوى الرقمي يتحول في الحقيقة إلى عامل غير مرئي: كل نقرة وكل تعليق وكل حركة تُختزل في بيانات قابلة للتحليل والاستثمار. الذات الإنسانية نفسها تتحول إلى ملف رقمي، إلى معطيات قابلة للبيع والشراء، دون وعي كامل من صاحبها.
لكن الأخطر من كل ذلك هو اغتراب الإنسان عن ذاته الداخلية، إذ لم يعد الأمر يتعلق فقط بما ينتجه أو بما يستهلكه، بل بوعيه نفسه. فالمنصات الرقمية لا تكتفي بجمع البيانات بل تعيد تشكيل السلوكيات والخيارات وأنماط التفكير والمشاعر. الخوارزميات، عبر الاقتراحات الموجهة والمحتوى المصمم خصيصاً لكل فرد، تتحول إلى قوة تصوغ الوعي وتوجه الرغبات، حتى يغدو الإنسان محاصراً في مسارات لا يختارها بحرية كاملة. وهكذا يصبح الاغتراب مضاعفاً: اغتراب عن العمل وعن المعرفة وعن الزمن وعن الذات في آن واحد.
بهذا الانتقال من المصنع إلى الخوارزمية، يتضح أن الرأسمالية الرقمية لم تلغِ الاغتراب بل عمّمته وعمّقته، وجعلته سمة بنيوية للحياة المعاصرة. فالإنسان لم يعد يواجه اغتراباً في موقع محدد من عملية الإنتاج، بل يعيشه في تفاصيل يومه كلها، من لحظة استيقاظه تحت ضغط التنبيهات، إلى سلوكه في الفضاء الرقمي الذي يرسم له حدوده مسبقاً. إنه اغتراب شامل، يطاول العمل والمعرفة والزمن والوعي ذاته، ليعيد تشكيل الوجود الإنساني برمّته في صورة من الاستلاب المستمر.
المعرفة كسلعة محتكرة وفائض بلا معنى
من النتائج المباشرة للتسارع المعرفي وما يرافقه من استلاب زمني أن العالم يشهد فائضاً هائلاً من المعرفة غير المستوعبة، فائضاً يتراكم يومياً في شكل أبحاث علمية جديدة، وبراءات اختراع متزايدة، وخوارزميات لا تتوقف عن التدفق. غير أنّ هذه الوفرة لا تتحول بالضرورة إلى قوة إنتاجية اجتماعية متاحة للجميع، بل تبقى محجوزة داخل مستودعات رقمية مغلقة أو قواعد بيانات لا يملك مفاتيحها إلا قلة قليلة من الشركات والدول الكبرى. يمكن تخيّل المشهد عبر صورة مستودع ضخم تمتلئ رفوفه بالمواد الخام الثمينة يوماً بعد يوم، لكن أبوابه تبقى مغلقة بإحكام، فلا يستفيد منها سوى مالك المفاتيح، بينما يقف الآخرون في الخارج يراقبون من بعيد.
هكذا تتحول المعرفة، التي كان من المفترض أن تكون ميراثاً مشتركاً للبشرية، إلى أصل مالي واستراتيجي محتكر. إن الشركات العملاقة والمؤسسات المهيمنة تستحوذ على هذا التراكم الهائل وتعيد توظيفه في خدمة أهدافها الخاصة: تعظيم الأرباح، وتعزيز الهيمنة، وإحكام السيطرة على السوق العالمية. أما الأغلبية الساحقة من البشر فتُترك في موقع المتفرج أو المستهلك السلبي، عاجزة عن تحويل هذا التراكم إلى قوة لتحسين شروط الحياة أو توسيع آفاق الحرية.
تبدو المفارقة صارخة: كلما ازداد إنتاج المعرفة تقلّصت قدرتنا الجماعية على استيعابها وتوظيفها. إن الفائض، بدل أن يكون دليل قوة، يتحول إلى عبء يولّد الإحساس باللاجدوى. تتكدس المعلومات في فضاءات رقمية هائلة من دون أن تجد طريقها إلى الترجمة العملية في الواقع الاجتماعي. المعرفة ليست مجرد تراكم كمي، بل هي فعل تحويل للمعلومة إلى وعي وإلى ممارسة قادرة على تغيير الشروط القائمة. حين يُعطّل منطق السوق هذه العملية، يغدو التراكم نفسه بلا معنى، وكأن وفرة المعرفة لا تعني سوى ندرة المشاركة الإنسانية فيها.
الأخطر من ذلك أن هذا الاحتكار لا يقتصر على البعد الاقتصادي، بل يتخذ أيضاً أبعاداً ثقافية وأخلاقية. فحين تصبح المعرفة سلعة تباع وتشترى، يفقد البحث العلمي طابعه التحرري وينحصر في خدمة أهداف السوق. الجامعات والمراكز البحثية لا تضع الإنسان في قلب اهتماماتها، بل توجه طاقتها نحو إنتاج براءات تجارية أو برامج قابلة للاستثمار. وهكذا يتم تشويه معنى المعرفة نفسها، إذ تتحول من وسيلة للتنوير والتحرر إلى أداة للسيطرة والتربح.
إن فائض المعرفة غير المستوعب يكشف عن الأزمة العميقة التي تعيشها الرأسمالية الرقمية. فهي تنتج وفرة بلا معنى، وفرة لا يمكن للإنسان أن يحولها إلى قوة اجتماعية حيّة. هذه الوفرة، حين تُحتكر وتُعزل عن الأغلبية، تتحول إلى مرآة لعجز النظام الرأسمالي عن أن يجعل من المعرفة سبيلاً للتحرر. إننا أمام مشهد paradoxal: تراكم مذهل من المعلومات والبيانات يقابله جفاف إنساني متزايد، وفائض من الإمكانات يقابله عجز عن تحويلها إلى واقع أفضل. بهذا المعنى، لا تعكس الأزمة مجرد خلل تقني في توزيع الموارد، بل تكشف عن مأزق بنيوي: مأزق إخضاع المعرفة لمنطق السوق الرأسمالي، وتحويلها من حق مشترك إلى سلعة محتكرة تفقد معناها الإنساني كلما ازداد تراكمها.
الأخلاق الرأسمالية وتشويه وظيفة المعرفة والعمل
ليست أزمة التناقض الزمني وفائض المعرفة أزمة تقنية أو اقتصادية فحسب، بل لها بعد أخلاقي وثقافي عميق يعكس كيف تعيد الرأسمالية الرقمية تشكيل وعي الأفراد والمجتمعات. فبدل أن يكون العمل مجالاً للتعاون والإبداع المشترك، صار ساحة للاستغلال والتشييء، وبدل أن تكون المعرفة وسيلة لتوسيع آفاق الحرية الإنسانية، تحولت إلى سلعة تُباع وتُشترى وفق قوانين السوق. إن هذا التحول لا ينتج سلعاً وتقنيات فحسب، بل ينتج منظومة قيم جديدة، منظومة تُعيد صياغة معنى الفضيلة والحرية والمساواة بما يتلاءم مع مصالح رأس المال.
لنأخذ مثال الجامعة، تلك المؤسسة التي يفترض أن تكون فضاءً للبحث الحر وتنمية الوعي النقدي. في ظل هيمنة المنطق الرأسمالي، تتحول الجامعة إلى ما يشبه المصنع، مهمتها لم تعد إنتاج معرفة نقدية أو تنويرية، بل تخريج قوة عمل تلبي حاجات السوق. التعليم، الذي كان يُنظر إليه كتجربة إنسانية شاملة لتكوين شخصية قادرة على التفكير الحر، يغدو تدريباً تقنياً ضيق الأفق على مهارات آنية قابلة للتوظيف الفوري. بهذا المعنى يُفرغ التعليم من مضمونه التحرري، ليختزل إلى وظيفة اقتصادية تخدم التراكم الرأسمالي. وهكذا تنقلب الجامعة من فضاء للتنوير إلى مؤسسة إنتاجية تخضع لإيقاع السوق.
ويمتد هذا التشويه ليشمل القيم الكبرى التي صاغتها البشرية عبر تاريخها. الحرية تُختزل إلى حرية السوق، أي حرية رأس المال في التحرك بلا قيود، بينما تتحول المساواة إلى شعار زائف يخفي التفاوتات البنيوية. أما الفضيلة فتصبح مرتبطة بقدرة الفرد أو المؤسسة على تحقيق الربح، بغض النظر عن أثر ذلك على المجتمع أو على القيم الإنسانية. لقد انقلبت الموازين: التضامن والتعاون والمشاركة، التي مثّلت يوماً فضائل عليا، فقدت مكانتها لصالح قيم المنافسة الفردية والمنفعة السريعة.
إن هذه المنظومة الأخلاقية المشوّهة لا تبقى مجرد خلفية ثقافية، بل تترك آثاراً ملموسة على الحياة اليومية. فهي تكرّس عزلة الأفراد، وتفكك الروابط الاجتماعية، وتحوّل العلاقات الإنسانية إلى صفقات عابرة. كل فرد يصبح منشغلاً بمصلحته الخاصة في سباق لا ينتهي، بينما تُترك القيم الجمعية في الهامش. وبذلك تغدو الأزمة الأخلاقية وجهاً آخر للأزمة الاقتصادية والمعرفية، لا يمكن فصلها عنها.
الرأسمالية الرقمية إذن لا تغيّر شروط الإنتاج وحدها، بل تغيّر أيضاً البنية الأخلاقية للوجود الإنساني. فهي تعيد تعريف ما يعنيه أن نكون أحراراً، وما يعنيه أن نتساوى، وما يعنيه أن نسعى وراء الفضيلة. ومن خلال هذا التحول القيمي، تفرض هيمنتها ليس فقط على الاقتصاد والمعرفة، بل على الوجدان ذاته. إنها لا تسلب الإنسان زمنه ومعرفته فحسب، بل تعيد تشكيل معاييره الأخلاقية ليقبل بالاستلاب وكأنه قدر طبيعي.
المركز والهامش – استعمار رقمي واغتراب تاريخي
لا يتوقف أثر الرأسمالية الرقمية عند حدود التجربة الفردية في العمل أو المعرفة، بل يمتد ليعيد رسم الخريطة العالمية للعلاقات بين الشعوب والدول. فالمراكز الرأسمالية الكبرى، مثل الولايات المتحدة وأوروبا الغربية وبعض القوى الآسيوية الصاعدة، تحتكر اليوم أدوات إنتاج المعرفة الرقمية وتقنياتها المتقدمة، بينما يُترك العالم المتأخر في موقع التابع المستهلك. هذه الفجوة لا تعكس مجرد تفاوت في الدخل أو في نصيب الفرد من الثروة، بل تكشف عن تفاوت معرفي وأخلاقي أعمق، إذ تتحول المعرفة نفسها إلى سلاح جيوسياسي يكرّس سيطرة المركز ويعيد إنتاج تبعية الأطراف.
فإذا كان الاستعمار التقليدي قد صادر الموارد الطبيعية واليد العاملة، فإن الاستعمار الرقمي يصادر الموارد المعرفية والبيانات والخوارزميات التي تمثل المادة الخام للعصر الجديد. لم تعد السيطرة تُمارس بالدبابات والجيوش، بل بالبرمجيات والأنظمة الرقمية والبنى التحتية للشبكات العالمية. الأطراف تُترك في موقع المتلقي الدائم للتكنولوجيا التي ينتجها المركز، عاجزة عن إعادة توجيهها أو تكييفها وفق حاجاتها التاريخية. إن التبعية هنا ليست مجرد مسألة اقتصادية، بل هي تبعية معرفية تعمّق الشعور بالعجز وتؤسس لاغتراب تاريخي طويل الأمد.
هذا الوضع يولّد مفارقة وجودية حادة. شعوب الأطراف لا تشعر فقط بأنها متأخرة عن المركز، بل وكأنها تعيش خارج الزمن نفسه. فبينما ينطلق المركز بسرعة هائلة نحو المستقبل عبر الابتكار والإنتاج، تبقى الأطراف عالقة في موقع المتلقي السلبي، مكتفية بمراقبة المشهد من بعيد. يشبه الأمر قطاراً سريعاً يمضي إلى الأمام بقوة، بينما العربات الخلفية لا تملك التأثير في وجهته، بل تُسحب معها بلا إرادة حقيقية. إنه اغتراب عن اللحظة التاريخية نفسها، حيث تتحول الأطراف إلى كيانات على الهامش، خارج إيقاع الزمن الفعلي الذي يصنعه المركز.
ولا يقف الأمر عند حدود الاقتصاد والتكنولوجيا، بل يمتد إلى البعد الثقافي والأخلاقي. فالمعرفة الرقمية التي ينتجها المركز تُعيد تشكيل وعي الأطراف وصورتها عن ذاتها، بحيث يغدو وعيها الجماعي مشدوداً دوماً إلى مرآة الآخر، وكأنها غير قادرة على إنتاج أفق مستقل لمستقبلها. إنها صورة التابع الذي يعيش على هامش التاريخ، يستهلك ما يُنتج في مكان آخر، ويعيد صياغة قيمه ومعاييره وفق ما يفرضه المركز.
بهذا المعنى، يصبح الاغتراب في عصر الرأسمالية الرقمية اغتراباً تاريخياً أيضاً، لأنه لا يقتصر على الفرد أو على المجتمع المحلي، بل يشمل موقع أمم بأكملها داخل النظام العالمي. وهكذا تُعاد صياغة التبعية القديمة في صورة جديدة، حيث يحتكر المركز موارد المعرفة، بينما تظل الأطراف في موقع العجز، عاجزة عن كسر الفجوة التي تفصلها عن الزمن الفاعل.
الخاتمة – نحو مشروع تحرري بديل
ليس التناقض الزمني في اقتصاد المعرفة مجرد ظاهرة تقنية مرتبطة بسرعة الحواسيب أو حجم البيانات المتدفقة، بل هو تعبير عن أزمة أعمق تضرب جوهر الوجود الإنساني في ظل الرأسمالية الرقمية. فكما كشف ماركس عن اغتراب العامل في المصنع حين ينفصل عن منتوجه وعن عملية عمله، يكشف عصرنا الراهن عن اغتراب مضاعف يطاول الإنسان في زمنه ومعرفته وذاته معاً. الزمن يُستلب تحت ضغط السوق، والمعرفة تُحوّل إلى سلعة محتكرة، والوعي يُعاد تشكيله بواسطة الخوارزميات. إنها صورة جديدة من الاغتراب الكوني، حيث لم يعد الأمر مقصوراً على المصنع أو على لحظة العمل المأجور، بل امتد ليغطي فضاءات الحياة كلها.
هذا الوضع يذكّر بتحليلات ديفيد هارفي عن “ضغط الزمان–المكان”، حيث تتحول السرعة إلى أداة للهيمنة والسيطرة، كما يستدعي أيضاً أطروحات هابرماس حول “تشوّه الفعل التواصلي”، حيث يُستلب التواصل الحر لصالح أنماط عقلانية أداتية تخدم السوق. ما نعيشه اليوم هو الوجه الرقمي لهذا التشوّه، حيث يُعاد تعريف الزمن كأداة للربح، ويُفرغ من قيمته النوعية كفضاء للنمو والتجربة الإنسانية. إن الرأسمالية الرقمية لا تغيّر فقط شروط الإنتاج، بل تغيّر إدراكنا للعمل والمعرفة والزمن، أي تغيّر شكل الوجود ذاته.
ومع ذلك، فإن الأزمة ليست قدراً مغلقاً. فالفجوة بين سرعة الإنتاج وبطء الاستيعاب تكشف عن حدّ لا تستطيع الرأسمالية تجاوزه: الإنسان لا يمكن اختزاله إلى آلة أو خوارزمية. الوعي البشري، بما يحمله من تجربة وانفعال وذاكرة، يظل يطالب بزمنه الخاص، بفضائه للتأمل، وبمساره النوعي الذي لا يُقاس بمعايير السوق. إن هذه الهوة الزمنية، التي قد تبدو في ظاهرها مصدر ضعف، هي في حقيقتها إمكانية للمقاومة. فهي تؤكد أن الإنسان يظل مختلفاً عن الآلة، وأن كينونته لا يمكن أن تُسحق كلياً تحت منطق الربح.
من هنا يمكن أن ينبثق أفق بديل: اقتصاد معرفي يقوم على المشاركة لا على الاحتكار، عمل يستعاد كمساحة للإبداع لا كسلعة، وزمن يُعاش بوصفه حقاً إنسانياً أصيلاً لا مجرد وحدة إنتاجية. تحقيق هذا الأفق يتطلب مشروعاً تحررياً شاملاً، يتجاوز النقد النظري ليصوغ بدائل عملية. فالمعرفة ينبغي أن تُنشر كسلعة عامة متاحة للجميع، والتعليم يجب أن يُعاد بناؤه على أسس نقدية وتحررية، والتعاون الرقمي المفتوح يجب أن يُعزز ليحل محل أشكال الاحتكار. كذلك ينبغي أن تنشأ مؤسسات اجتماعية جديدة تضع الإنسان في مركز العملية التاريخية، بدل أن يكون تابعاً لإيقاع السوق.
إن نقد الرأسمالية الرقمية ليس مجرد موقف أكاديمي، بل هو دعوة سياسية وأخلاقية إلى إعادة بناء علاقتنا بالعمل والمعرفة والزمن. فالمقاومة لا تعني فقط الرفض، بل تعني أيضاً بناء بدائل جديدة قادرة على استعادة المعنى الإنساني. وبذلك تتحول الخاتمة إلى بداية: بداية وعي تاريخي يرفض الاستلاب، ويسعى إلى استعادة إنسانية الإنسان في زمن تهدد فيه الخوارزميات بتحويله إلى مجرد معطى رقمي. إنها دعوة إلى أن نعيد صياغة مستقبلنا بأيدينا، لا بأيدي السوق، وأن نحيا زمننا لا زمناً مفروضاً علينا من الخارج.
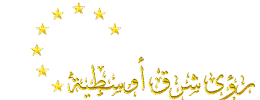


مقال يصوّر بدقّة العلاقات الاجتماعيّة في ظلّ تغوّل رأس المال، وكلّ ذلك أعزوه لنظام الملكيّة الخاصّة الّتي تحميه القوى الأمبرياليّة على الصعيد العالميّ لتضخيم جريمتها في الاستغلال وهو العمود الفقري للنّظام الرأسماليّ، وعندما تُستملك القوى المنتجة ومن ضمنها قوّة عمل الإنسان يصير الفرد جزءًا من الآلة الّتي يستخدمها قطاع الإنتاج ويفقد بذلك روحه الإبداعيّة، لا بل شعوره الإنسانيّ الإبداعيّ… تحياتي وتقديري أيها المفكر القدير والرائع