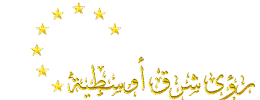لطالما مثّلت الماركسية مشروعاً نقدياً شاملاً يسعى إلى تجاوز الفهم التجريدي للواقع، نحو تفسيره وتغييره على أسس مادية وتاريخية. إلا أن ما يُثير الجدل في السياقين الأكاديمي والسياسي المعاصر، هو تصاعد النزعة نحو اختزال الماركسية إلى مجرد “منهج” لتحليل الظواهر، دون اعتبارها فلسفةً متكاملةً ذات بعد نضالي. هذا الاختزال لا يُعبّر فقط عن قراءة انتقائية للتراث الماركسي، بل يعكس أيضاً تحوّلاً بنيوياً في تموضع المعرفة داخل الحقل الأكاديمي، يسعى إلى نزع الطابع الثوري عن الماركسية وتحويلها إلى أداة تحليلية “مُروّضة”، تُستخدم ضمن خطاب أكاديمي “محايد”.
إن أهمية هذا النقاش تتجاوز البعد المفاهيمي، لتلامس قلب الصراع حول المعرفة والممارسة: فهل يمكن للماركسية أن تظل حية ومؤثّرة إذا جُرّدت من طابعها الفلسفي والطبقي؟ وهل يكفي استخدامها كـ”منهج” في البحث الاجتماعي دون تبنّي رؤيتها النقدية للتاريخ والبنية والسلطة؟ يهدف هذا البحث إلى تفكيك هذا النمط من القراءة التقنيّة للماركسية، عبر تتبع العلاقة الجدلية بين الفلسفة والمنهج في قلب المشروع الماركسي، بوصفها وحدة لا تنفصم، تُنتج وعياً وفعلاً، لا خطاباً حيادياً فقط.
الفلسفة في العلوم الإنسانية: بين التأمل والهيمنة
تُشكّل الفلسفة في العلوم الإنسانية الأداة الأولى التي من خلالها يُصاغ وعي الإنسان بعلاقته بالعالم والتاريخ والمجتمع. فهي لا تُعنى فقط بتقديم تصورات مجردة حول مفاهيم الوجود، المعرفة، والقيم، والزمن، بل تسهم أيضاً في بناء أُطر مرجعية كبرى تُوجّه الأنشطة المعرفية، وتُحدّد ما يُعدّ معقولاً أو مشروعاً في التفكير. بهذا المعنى، فإن الفلسفة لا تكون نشاطاً معزولاً عن الشروط الاجتماعية والسياسية، بل هي مرتبطة بعمق بالبُنى الثقافية والاجتماعية التي تُنتجها وتُعيد إنتاجها.
لقد أظهرت التجربة التاريخية أن الفلسفة، حين تنفصل عن جذورها المادية والاجتماعية التي تُنتجها، تتحوّل إلى أداة للهيمنة؛ أي إلى وسيلة لإعادة إنتاج النظام السائد وتبرير تسلسل القوى داخله. فعلى سبيل المثال، كثير من الفلسفات المثالية في الغرب الحديث (من ديكارت إلى هيغل) ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في ترسيخ مركزية الذات الأوروبية، وتبرير السيادة السياسية والثقافية والاستعمارية. كذلك، كانت الفلسفة الليبرالية الحديثة حاملةً لأيديولوجيا السوق الحر والفردانية، كما يتجلى في أطروحات منظّرين معاصرين مثل فوكوياما وراولز والفردانية، رغم ادّعاءاتها الكونية.
من هنا تبرز الحاجة إلى فلسفة نقدية بديلة، تسائل لا فقط أنماط التفكير السائدة، بل أيضاً الشروط التي أنتجت هذه الأنماط، وتكشف علاقتها بالبُنى الطبقية والاقتصادية. الفلسفة الماركسية لا تكتفي بالتموضع داخل إطار المعرفة بل تنخرط في لحظة تاريخية كاشفة، كما يظهر مثلاً في نقدها للأيديولوجيا البرجوازية بل تتدخل في التاريخ بوصفها أداة لكشف الزيف الأيديولوجي، وإعادة توجيه الوعي نحو أفق التحرر. في ضوء ذلك، لا يمكن التعامل مع الفلسفة داخل العلوم الإنسانية بوصفها مجرد نشاط تجريدي، بل يجب أن تُفهم باعتبارها فضاءً للصراع على المعنى، والهيمنة، والتاريخ.
. المنهج في العلوم الاجتماعية: من التقنية إلى الأيديولوجيا
يُقدَّم المنهج في العلوم الاجتماعية، غالباً، بوصفه أداة إجرائية وتقنية، محايدة في ظاهرها، تُستخدم لتنظيم ممارسات البحث وتحليل الظواهر الاجتماعية بطريقة “علمية”. يتمحور دور المنهج حول مجموعة من الخطوات: تحديد المشكلة، جمع البيانات، تحليلها، والوصول إلى استنتاجات. غير أن هذا التصور الشائع يُخفي بُعداً بالغ الأهمية: المنهج ليس مجرد أداة محايدة، بل دائماً يتكشّف عن أفق نظري وأيديولوجي يحدد اتجاه البحث، ويتداخل مع المفاهيم والبيانات التي تُختار لتحليل الظواهر. فالأسئلة التي نطرحها، وطريقة صياغتها، والبيانات التي نختارها، والمفاهيم التي نستعملها – كلها تحددها افتراضات نظرية مسبقة، غالباً ما تكون مندمجة ضمن النظام القائم.
في هذا السياق، يمكن القول إن المنهج هو مرآة للمنظومة التي يعمل ضمنها. فالمناهج الكمية، على سبيل المثال، تُجسّد في كثير من الأحيان نزعة وضعية، كما يتجلى في الاعتماد المفرط على استطلاعات الرأي أو المؤشرات الاقتصادية بوصفها معايير كافية لفهم الظواهر الاجتماعية تعتبر أن الظواهر الاجتماعية قابلة للقياس كما في العلوم الطبيعية، وتُقلل من شأن البُنى الرمزية والتاريخية التي تُشكّل تلك الظواهر. أما المناهج النوعية، رغم قدرتها على التقاط المعاني والتفاعلات، فإنها غالباً ما تبقى في مستوى التحليل “الجزئي”، دون أن تُعيد ربط الظواهر بالبنية الاجتماعية أو الأطر الاقتصادية التي تنظمها. المنهج التاريخي بدوره قد يجنح إلى الحكي أو التأريخ السطحي، متجاهلاً التناقضات الداخلية في عملية التطور الاجتماعي.
الأخطر من ذلك أن بعض التوجهات المنهجية الحديثة – خصوصاً بعد صعود ما بعد الحداثة – أصبحت تُشيح النظر كلياً عن أي محاولة لفهم البنية، أو السرديات الكبرى، أو الصراع الطبقي. وبدلاً من مساءلة منظومة الهيمنة، تكتفي هذه المناهج بتشظية الواقع إلى “رؤى” و”تجارب” و”خطابات”، على نحو ما نلمحه في طروحات بعض منظّري ما بعد الحداثة كجاك دريدا وجان فرانسوا ليوتار في نوع من التفكيك اللاهوتي للواقع الاجتماعي. هكذا يُفرّغ المنهج من أي إمكان تحليلي تحرري، ويتحوّل إلى تقنية أداتية تُعيد إنتاج الوضع القائم تحت شعار التعددية والانفتاح.
في المقابل، يُعيد المنهج الماركسي صياغة علاقة الباحث بالواقع، كما يظهر مثلاً في تحليله لبنية الفقر باعتبارها نتاجاً لعلاقات إنتاج واستغلال، لا مجرد اختلال في توزيع الموارد، ليس بوصفه مراقباً خارجياً، بل فاعلاً سياسياً من داخل البنية. فالمنهج، ضمن التصور الماركسي، ليس مجرد تقنية، بل أداة لفهم التناقضات الاجتماعية في أفق تغييرها. وسيتضح ذلك أكثر عند التطرق إلى البنية الفلسفية التي ينبثق منها هذا المنهج.
. الفلسفة الماركسية: المادية الجدلية كوعي نقدي للتاريخ
تقوم الفلسفة الماركسية على أساس مزدوج: المادية التاريخية من جهة، والمادية الجدلية من جهة أخرى. فهي لا تبدأ من تأملات ميتافيزيقية حول “جوهر الإنسان” أو “عقلانية التاريخ”، بل من الوجود المادي الملموس، من الشروط الاجتماعية والاقتصادية التي تحكم الحياة اليومية للناس، من عملية انتاج الحياة وإعادة انتاجها. ومن هنا، تختلف الماركسية جذرياً عن الفلسفات المثالية التي تعتبر أن الأفكار هي ما يصوغ العالم، فتقلب العلاقة لتُظهر أن الأفكار، في جوهرها، نتاجٌ لصيرورات مادية اجتماعية، وأن الوعي لا يوجد خارج الشروط الطبقية التي تنتجه.
في قلب الفلسفة الماركسية يكمن الديالكتيك – لا بوصفه أسلوباً منطقياً فحسب، بل كمفهوم جوهري لفهم الواقع في حركته. فالواقع الاجتماعي ليس ساكناً، بل يتحرك عبر تناقضات داخلية: بين القوى المنتِجة وعلاقات الإنتاج، بين الطبقات المسيطِرة والمسيطَر عليها، بين البنية التحتية الاقتصادية والبنية الفوقية الثقافية والسياسية. هذا الجدل لا يتوقف عند كشف التناقض، بل ينظر إليه كمحرّك للتاريخ، ومصدر للتحول الثوري. هكذا، لا يكون التغيير الاجتماعي في الماركسية نتاجاً لخطط نُخبوية أو رغبة أخلاقية، بل نتيجة حتمية لانفجار التناقضات الكامنة في النظام القائم.
أما وظيفة الفلسفة الماركسية فهي ليست تقديم تأويل مريح للعالم، بل تفكيكه على مستوى المفاهيم. من خلال نقد الأيديولوجيا، تسعى هذه الفلسفة إلى فضح البُنى الرمزية التي تُخفي علاقات السيطرة، وتُعيد إنتاجها في شكل “حقائق” و”قيم” و”عادات”. فالدين، والقانون، والتعليم، والثقافة – جميعها، وفق التحليل الماركسي، تشكّل أدوات “هيمنة ناعمة” تُعيد تشكيل الوعي وفق حاجات الطبقة السائدة. لهذا السبب، لا ترى الماركسية في الفلسفة تأمّلاً حرّاً، بل ساحة للصراع الطبقي داخل النظرية، كما عبّر ألتوسير.
تأخذ هذه الفلسفة على عاتقها مهمة مزدوجة: أولاً، إنتاج مفاهيم قادرة على تحليل الواقع المادي من داخله؛ وثانياً، بناء أفق تحرّري يسمح للوعي بأن يتحرّر من القيود المفروضة عليه من قبل النظام الرأسمالي. وهي، بذلك، فلسفة ليست للنُخبة أو الصفوة، بل للأغلبية المضطهدة، للطبقة العاملة، وللمهمّشين، بوصفهم فاعلين تاريخيين في قلب التغيير الاجتماعي.
المنهج الماركسي: البراكسيس وتحليل الواقع من موقع الصراع الطبقي
يمثل المنهج الماركسي أحد أبرز إنجازات الفلسفة الماركسية، لا بوصفه تقنية لتحليل الواقع، بل بوصفه صيغة عملية لفهم الواقع في أفق تغييره. هذا المنهج لا يفصل بين التحليل والنضال، ولا بين النظرية والممارسة، بل يؤسس على ما يُعرف بـ”البراكسيس”؛ أي وحدة النظر والعمل، الفهم والتغيير، الوعي والفعل. في هذا الإطار، لا يكون الباحث أو المثقف مجرد ملاحظ أو منظّر، بل جزءاً من البنية الاجتماعية التي يُحلّلها، ومسؤولاً عنها من موقع طبقي محدد.
يتأسس هذا المنهج على مجموعة من المبادئ الجوهرية، أبرزها التحليل الطبقي، الذي يُفهم من خلاله المجتمع بوصفه ميداناً لصراع دائم بين طبقات ذات مصالح متناقضة: البرجوازية، والبروليتاريا، والفئات المتحالفة أو التابعة. لا تُدرس الظواهر الاجتماعية على أنها معطيات معزولة، بل يتم ربطها بالأنساق الإنتاجية التي تشكّلها، مثل العلاقة بين ملكية وسائل الإنتاج والتقسيم الطبقي، أو العلاقة بين الأيديولوجيا والثقافة السياسية.
مبدأ آخر حاسم هو العلاقة بين البنية التحتية (الاقتصاد) والبنية الفوقية (الدولة، القانون، الدين، الإعلام، إلخ). فوفق المنهج الماركسي، تُشكّل البنية التحتية الأساس المادي الذي يُنتج البنية الفوقية، ويحدّد تطورها. غير أن العلاقة ليست آلية أو ميكانيكية، بل ديالكتيكية، بحيث تؤثر الفوقية بدورها في إعادة إنتاج التحتية. من خلال هذا التحليل، يستطيع المنهج الماركسي أن يُبيّن كيف تُنتج الثقافة أدوات للهيمنة، وكيف يمكن تحويلها إلى أدوات للمقاومة.
إضافة إلى ذلك، فإن التحليل الجدلي يُمكّن المنهج الماركسي من تتبع التحولات والتناقضات في البُنى الاجتماعية عبر الزمن. فبدلاً من التصور الساكن للتاريخ، ينظر هذا المنهج إلى الصراع الطبقي كقوة محركة للتاريخ، تنتج الأزمات، وتخلق إمكانيات جديدة للتحرر. لذلك، فالتحليل الماركسي ليس فقط تفسيرياً، بل أيضاً استشرافياً: يقرأ التناقضات لا فقط ليفهمها، بل ليستشرف اتجاه تطورها ويُعدّ أدوات التدخل فيها.
في ضوء كل هذا، لا يُمكن فهم المنهج الماركسي خارج مشروعه السياسي. فهو ليس مجرد وسيلة للمعرفة، بل أداة للتحرر، تُستخدم من أجل بناء وعي طبقي نقدي، وتحفيز العمل الثوري المنظم. هذا ما يميز المنهج الماركسي عن باقي المناهج في العلوم الاجتماعية، ويجعل منه تعبيراً عملياً عن رؤية فلسفية ثورية ترى أن العالم لا يُفهم إلا من أجل تغييره.
تفنيد أطروحات الليبرالية
منذ نهاية القرن العشرين، ومع تمدد النموذج النيوليبرالي في السياسة والاقتصاد والثقافة، شهدنا ما يمكن تسميته بـ”أكْدَمة” الماركسية، أي إدماجها داخل الأطر الأكاديمية والمؤسسية الليبرالية، لا بوصفها مشروعاً تحررياً، بل كمجرد أداة تحليلية قابلة للتوظيف السياقي. هذا الاختزال، الذي يفصل الماركسية عن رؤيتها الكلية وفلسفتها الجدلية، يُفرغها من وظيفتها الثورية، ويحوّلها إلى مجموعة من المفاهيم المتناثرة التي يمكن استخدامها في تحليل سوق العمل، أو السياسات العامة، أو حتى الموضة، دون أي التزام بالصراع الطبقي أو بالتغيير الاجتماعي الجذري.
تتجلى هذه الاستراتيجية بوضوح في الطريقة التي تُقدَّم بها الماركسية في الكثير من البرامج الأكاديمية الغربية، وامست صيعه حتى عند بعض “اشباه الماركسيين” العرب: فهي تُدرَّس غالباً بوصفها “مقاربة تحليلية من بين مقاربات أخرى”، تُوضَع جنباً إلى جنب مع البنيوية، والتفكيكية، وما بعد الاستعمار، وما بعد البنيوية، وغير ذلك. وبهذا الترتيب “الديمقراطي”، تفقد الماركسية تفوّقها النقدي بوصفها فلسفةً جدلية تاريخية شاملة، وتُختزل إلى “مجرد أداة” في صندوق أدوات الباحث الليبرالي وحتى الذي يدعي الماركسية.
هذا النوع من الاختزال لا يعبّر فقط عن سوء فهم للماركسية، بل يُعدّ موقفاً سياسياً مقصوداً، يسعى إلى تحييد الفكر الماركسي داخل فضاء “آمن”، يمكن السيطرة عليه ضمن المؤسسات الأكاديمية والبحثية. والمفارقة أن هذا التحوّل لا يُلغِي الماركسية تماماً، بل “يُهذّبها”، ويُعيد إنتاجها في صورة “صالحة للاستهلاك الأكاديمي”، خالية من أي قدرة على التحريض أو التنظيم أو التفكيك الجذري. وهكذا يتم نزع سلاحها النظري، وتجريدها من علاقتها بالممارسة، وتحويلها إلى خطاب ثقافي منزوع السياسة.
إضافة إلى ذلك، تظهر هذه النزعة بوضوح في بعض التوجهات الليبرالية التي تحتفي بـ”ماركس الاقتصادي”، وتتعامل معه بوصفه باحثاً كبيراً في الاقتصاد السياسي، لكنها تتجاهل تماماً “ماركس الثوري”، الذي دعا إلى تنظيم الطبقة العاملة، وإلى إسقاط البنية الرأسمالية من جذورها. وبهذا الشكل، يُفصل “المنهج” عن “الفلسفة”، ويُختزل مشروع ماركس إلى مساهمة جزئية في علم الاقتصاد، بدلاً من كونه مشروعاً تحررياً شاملاً يُعطي معنى جديداً للتاريخ والوعي والفعل.
من هنا، فإن الردّ على هذا الاختزال لا يكون فقط بالدفاع عن “صحة” المفاهيم الماركسية، بل بإعادة تأكيد وحدتها العضوية بين النظرية والمنهج والممارسة، وبالتمسك بدور الماركسية كأداة تحليل ونضال في آنٍ معاً. الماركسية ليست لغةً يمكن استعمالها خارج سياقها الطبقي، ولا مجرد أدوات تحليل مرنة؛ بل هي رؤية فلسفية ملتزمة ومشحونة بالصراع التاريخي، وكل محاولة لفصلها عن هذا السياق تُعد تفريغاً جذرياً لمحتواها.
دفاع عن الفلسفة كجذر تحرّري
إن الادعاء بأن الماركسية ليست سوى “منهج” لتحليل البُنى الاجتماعية أو العلاقات الاقتصادية هو تبسيط مخلّ، بل تشويه لأحد أعقد المشاريع الفكرية وأكثرها شمولاً في التاريخ الحديث. فالماركسية لم تُطرح منذ البداية كمجموعة أدوات بحث، بل كـفلسفة للتاريخ، ونظرية للثورة، وتحليل مادي للعلاقات الإنسانية، تُقوّض الأسس المعرفية والأخلاقية للعالم البرجوازي. لذلك، فإن التعامل معها بوصفها “منهجاً” فقط، يعني عزلها عن روحها الثورية، وتفريغها من علاقتها الجدلية بالتاريخ والمجتمع والطبقات.
جوهر الفلسفة الماركسية يكمن في مفاهيم لا يمكن فهمها أو استعمالها خارج بنيتها الفلسفية الكلية. على سبيل المثال، مفاهيم مثل “الاستلاب”، “التشييء”، “الهيمنة”، و”الوعي الزائف”، لا تُفهم بوصفها مصطلحات وصفية فقط، بل كمقولات تنتمي إلى نسق مادي جدلي يُفسّر كيف يُنتج النظام الرأسمالي ذاتاً مشوهة، مشروطة بشروط الإنتاج، ومقيّدة بعلاقات الاستغلال. إن نزع هذه المفاهيم من سياقها الفلسفي لا يؤدي فقط إلى تشويهها، بل إلى تحويلها إلى أدوات تحليلية سطحية، تُستخدم في وصف الظواهر دون أن تُحفّز على تغييرها.
والأخطر أن التعامل مع الماركسية كمنهج مستقل عن فلسفتها يجعلها قابلة للتوظيف في أنظمة فكرية معادية لها. فنرى، على سبيل المثال، كيف تُستخدم بعض أدوات التحليل الطبقي لفهم “سلوك المستهلك”، أو “الفجوة الرقمية”، أو حتى “سياسات الهوية”، دون ربط هذه الظواهر بالبنية الاقتصادية أو بالصراع الطبقي العالمي. هذا الشكل من التوظيف “الليّن” يُنتج ماركسية “مُعقمة”، منزوع منها أفق الثورة، ومتصالحة مع النظام الذي ادّعت في الأصل تقويضه.
إن الدفاع عن الماركسية كـفلسفة نضالية لا يعني فقط إعادة تأكيد بعدها الجدلي، بل يتطلّب أيضاً ربطها بواقع الجماهير الكادحة والمهمّشة، بوصفها أداة لفهم القهر والتنظيم ضده. الماركسية بهذا المعنى ليست حيادية ولا تقنية، بل هي موقف من العالم، ومن السلطة، ومن المعرفة. وهي بذلك تتعارض جذرياً مع الاتجاهات الليبرالية التي تفصل النظرية عن السياسة، وتحصر الفلسفة في حدود الصف الدراسي أو المختبر الأكاديمي.
فالماركسية ليست مجرد ترسانة من المفاهيم، ولا مجرد طريقة في التحليل، بل رؤية فلسفية للتاريخ والفعل، تمكّن الإنسان من أن يرى نفسه كفاعل في مجرى التاريخ، لا كمفعول به، وتفتح أفقاً لتحرّر جماعي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال وعي طبقي منظم ومسلّح بنظرية نقدية.
جدل التوليد والتحقق
في قلب المشروع الماركسي، لا تُفهم العلاقة بين الفلسفة والمنهج كعلاقة تراتبية، بحيث تُنتج الفلسفة المبادئ والمنهج يترجمها فقط، ولا كعلاقة انفصال تجعل من المنهج أداة تقنية مستقلة، بل كعلاقة جدلية قائمة على التوليد المتبادل. فالفلسفة الماركسية، بما هي رؤية للعالم وللتاريخ وللإنسان، لا توجد في الفراغ، وإنما تُعبَّر عنها وتُختبر من خلال المنهج الذي يُمارَس في الواقع، والعكس كذلك: المنهج لا يُمكن أن يُبنى أو يُفعّل خارج إطار فلسفي يُوجّهه ويوفّر له منطلقاته النظرية وحدوده النقدية.
الفلسفة هنا لا تُنتج فقط مفاهيم ومقولات مجردة، بل تُملي أيضاً نمطاً معيناً من التحليل ومن الموقف السياسي. حين نتحدث عن المادية الجدلية، لا نقصد فقط “قواعد للتفكير”، بل أيضاً تصوراً شاملاً للتاريخ قائم على الصراع والتناقض والحركة. هذا التصور لا يمكن نقله إلى الواقع إلا من خلال أدوات تحليلية – أي المنهج – تسمح بإدراك التناقضات الداخلية للبنية الاجتماعية، وتُحوّل الفلسفة من مجرّد نسق نظري إلى أداة تفسير وتحويل.
وبالمقابل، فإن المنهج – حين يُمارَس ضمن هذه الفلسفة – لا يظل ثابتاً أو نهائياً، بل يُعيد تشكيل الفلسفة نفسها من خلال اختبارها على أرض الواقع. أي أن التجربة التاريخية، والفعل السياسي، والممارسة النضالية، تغذّي التفكير الفلسفي وتُجبره على مراجعة ذاته. ولهذا فإن المشروع الماركسي لا يؤمن بنسق مغلق، بل بنمط تفكير مفتوح على الممارسة، قادر على النقد الذاتي والتطوّر في مواجهة الوقائع. كما أن التاريخ لا يُختبر فقط عبر النصوص، بل عبر نضال الطبقات، أي في المكان الذي تتفاعل فيه النظرية والمنهج في صيرورة واحدة.
هذه العلاقة الجدلية تضمن للماركسية حيويتها وقدرتها على التجدد. فهي لا تسقط في الدوغما (الجمود العقائدي)، ولا في النسبية الفكرية الليبرالية، بل تخلق توازناً حيوياً بين الفهم والتفسير، وبين الالتزام والتجريب. لا يُمكن، إذن، تخيّل مشروع ماركسي حي دون هذا التشابك بين الفلسفة والمنهج، لأن أي تفكيك لهذه العلاقة يؤدي إما إلى فكر تجريدي عاجز عن التغيير، أو إلى تقنية تحليلية بلا اتجاه أو هدف.
وهكذا، يُظهر الطابع الجدلي للعلاقة بين الفلسفة والمنهج كيف أن المعرفة في الماركسية ليست محايدة، بل هي دائماً معرفة موجّهة، تقف في خندق، وتُحدّد موقفاً من الواقع والتاريخ. وهي معرفة لا تُستكمل داخل الكتب فقط، بل في خضم الصراع، وفي لحظة تَحوّل النظرية إلى فعل.
محاولات تفريغ الماركسية من محتواها النضالي: دور الدوائر الليبرالية
في العقود الأخيرة، ظهرت موجة متزايدة من الجهود الفكرية والسياسية التي تسعى إلى تحييد الماركسية وتفريغها من مضمونها النضالي الجذري. هذه الجهود لا تُمارس العداء المباشر للماركسية كما حدث في سياقات الحرب الباردة، بل تتخذ شكلاً أكثر نعومة وتطبيعاً: إعادة صياغتها كمجرد خطاب نقدي أو “منهج اجتماعي” يُستخدم في دراسة بعض الظواهر المعاصرة. لكن هذا الشكل من الاحتواء لا يقل خطورة عن العداء المباشر؛ بل ربما يُعتبر أكثر فاعلية، لأنه يحوّل الماركسية إلى جزء من النظام الذي كانت تسعى إلى إسقاطه.
الدوائر الليبرالية – الأكاديمية منها والسياسية – تلعب دوراً أساسياً في هذا التفريغ. فمن خلال إعادة تقديم الماركسية ضمن مقررات الدراسات الثقافية، أو الاقتصاد السياسي “الناقد”، أو الفلسفة الاجتماعية، يتم نزع بعدها الثوري، وطمس مركزيتها في نقد البنية الرأسمالية ككل. على سبيل المثال، يُمكن أن تُدرَّس مفاهيم مثل “الطبقة”، “الاستلاب”، أو “التشييء”، في إطار بحث جامعي حول “عدم المساواة” أو “التفاوت الاجتماعي”، لكن دون أن تُربط هذه المفاهيم بمشروع تحرري جذري، أو بفعل جماهيري منظم.
تُستَخدم هذه المداخل “التوفيقية” كجزء من استراتيجية ليبرالية واسعة النطاق، تقوم على إدماج الخصوم الفكريين ضمن النظام، بدلاً من مواجهتهم أو السماح لهم بتحديه. وبهذا المعنى، تُقدَّم الماركسية في كثير من الأحيان كتراث “قيّم” لكنه “قديم”، أو كأداة تحليلية “مفيدة” لكنها “غير قابلة للتطبيق عملياً”، مما يُفقدها طابعها الثوري. وتُستَبدل بذلك الماركسية النضالية بـ”ماركسية أكاديمية”، تُكرّس القراءة الرمزية والتأملية، وتستبعد التنظيم، والمواجهة، والصراع.
الأخطر من هذا كلّه، أن هذه المقاربات تُسهِم في فصل النظرية عن الطبقات التي أنتجتها ومن أجلها. إذ لم تعد الماركسية تُطرح بوصفها أداة فكرية بيد العمال والمقهورين، بل أصبحت حكراً على نُخبة أكاديمية، تُناقشها بلغات معقدة، وفي سياقات بعيدة عن المعركة الطبقية الحقيقية. وهكذا، تُفقد الماركسية شرطها التاريخي – أي ارتباطها بالواقع المتحرك للصراع الاجتماعي – وتُختزل إلى نصوص مغلقة ضمن مجال بحثي ضيق.
الرد على هذه المحاولة لا يكمن في رفض كل أشكال الدراسة الأكاديمية للماركسية، بل في رفض نزعها من جذورها الثورية. فالماركسية لا يُمكن أن تكون خطاباً “محايداً”، ولا تحليلاً ثقافياً جزئياً، بل هي مشروع شمولي لتفكيك النظام الرأسمالي، وإعادة بناء العالم على أساس من العدالة والتحرر. وكل مقاربة تفصل الماركسية عن بعدها النضالي، هي بالضرورة مقاربة تُعيد إنتاج الهيمنة بشكل ناعم ومقنّع.
خاتمة: وحدة النظرية والممارسة شرط لاستعادة الماركسية الحية
بعد هذا المسار التحليلي، يتبيّن بوضوح أن الماركسية لا يمكن اختزالها إلى مجرد “منهج”، ولا يمكن التعامل معها كأداة تحليلية محايدة، تُستخدم في توصيف بعض الظواهر الاجتماعية بمعزل عن سياقها الطبقي والتاريخي. الماركسية هي مشروع فلسفي جذري، نابع من الأرض، ومن الصراع الطبقي، ومن التجربة الحية للجماهير العاملة والمضطهدة. إنها رؤية شاملة للعالم، لا تنفصل فيها النظرية عن الفعل، ولا التحليل عن الالتزام، ولا المفهوم عن التنظيم. اختزالها إلى منهج فقط، هو تمويه للواقع، ومحاولة لتجريدها من قدرتها على زعزعة النظام القائم.
لقد كشف البحث أن العلاقة بين الفلسفة والمنهج داخل الماركسية ليست علاقة شكلية أو تنسيقية، بل هي علاقة جدلية عضوية؛ الفلسفة تُنتج المنهج، والمنهج يُمارس الفلسفة، ويُعيد اختبارها وصقلها في الواقع. هذه العلاقة هي ما يسمح للماركسية بأن تكون نظرية حية، لا تتحنّط في النصوص، ولا تذوب في البيروقراطيات الأكاديمية. فالمعرفة في الماركسية ليست لحظة تأمّل فقط، بل لحظة اشتباك مع العالم، ومع القوى الاجتماعية التي تُعيد إنتاج السيطرة فيه.
في مواجهة محاولات التحييد الليبرالية، يصبح من الضروري إعادة تأكيد البُعد الثوري للماركسية، بوصفها سلاحاً نظرياً في يد المضطهدين، وليس نموذجاً منهجياً يُدرّس ببرود في القاعات الجامعية. وهذا يتطلّب استعادة الوظيفة الأصلية للفكر الماركسي: أن يكون أداة لبناء الوعي الطبقي، وتحفيز التنظيم، ومواكبة نضالات العمال والمهمّشين والمستَعمَرين.
الخلاصة أن الماركسية، إن أُفرغت من فلسفتها المادية الجدلية، ومن بعدها التاريخي والتحرري، تتحوّل إلى مجرد قشرة تحليلية. لكنها حين تُستعاد في وحدتها الفكرية والنضالية، تصبح أكثر من نظرية، تصبح أفقاً للتغيير، وخريطة طريق نحو تحوّل اجتماعي جذري. ومن هنا، فإن وحدة النظرية والمنهج، الفلسفة والتحليل، الفهم والفعل، ليست ترفاً مفاهيمياً، بل شرط وجود الماركسية ذاتها كفكرٍ للتاريخ والتغيير.