الماركسية لم تُولد كفلسفة نظرية معزولة عن الواقع، بل نشأت منذ بداياتها كمشروع ثوري، تندمج فيه الفكرة بالممارسة بشكل لا ينفصل. فكما بيّن ماركس، الوعي الطبقي لا يُمنح من خارج الواقع، بل يتشكّل من داخل الصراع الاجتماعي، عبر التفاعل اليومي مع البنية المجتمعية، ويتجسد من خلال التنظيم السياسي الذي يعبّر عن هذا الوعي، نظريًا وعمليًا.
بالتالي، الفكر الماركسي ليس تمرينًا ذهنيًا أو نشاطًا ثقافيًا منعزلًا، بل هو أداة عملية لفهم التناقضات التي يعيشها المجتمع، ولمعرفة كيف تعمل آليات السيطرة الطبقية، ولتحديد إمكانيات تجاوزها. الوعي لا ينبثق من الفراغ، بل من واقع مادي متحوّل. لكن هذا الوعي لا يصبح قوة تاريخية فعالة إلا إذا تحوّل إلى طاقة مادية داخل تنظيم سياسي واعٍ.
والحزب الثوري هو الشكل الأرقى لهذا التنظيم. مصيره مرتبط بمدى قدرته على الحفاظ على هذه الوحدة الحيوية بين الفكر والممارسة. فالحزب لا يُفترض أن يكون جهازًا بيروقراطيًا ينفذ التعليمات ويعيد إنتاج الانضباط، بل يجب أن يعمل كـ”عقل جماعي”، يحلل الواقع باستمرار ويسعى لتغييره.
ماركس وإنجلز أكدا منذ كتاباتهما الأولى على أن مهمة الفلاسفة ليست فقط تفسير العالم، بل تغييره. هذا يعني ضرورة تجاوز الفصل التقليدي بين النظرية والتطبيق. لاحقًا، قام لينين بتوسيع هذا المفهوم ليشمل التنظيم العملي، مؤكدًا أن الثورة لا تحدث تلقائيًا، بل تتطلب قيادة مثقفة، تجمع بين مهارات التحليل والتنظيم. ثم جاء غرامشي ليعطي بعدًا أعمق للمسألة، حين طرح فكرة “المثقف العضوي”؛ وهو ذلك المثقف الذي لا يعيش في برجٍ عاجي، بل يعمل داخل النسيج الاجتماعي، يشارك في إنتاج الوعي ويعيد تشكيل العلاقات الطبقية.
لكن هذه الرؤية الجدلية المتكاملة — التي تمزج بين الفكر والتنظيم والسياسة — تعرّضت للتشويه في الكثير من التجارب الحزبية، خاصة في العالم العربي. ففي هذا السياق، غالبًا ما تُفكك العلاقة الثلاثية: يُستبعد الفكر من التنظيم، ويفقد التنظيم عمقه النظري، وتُختزل السياسة إلى تكتيكات مؤقتة تفتقر لأي أفق تاريخي. نتيجة لذلك، يتحوّل الحزب من أداة للتغيير إلى جهاز بيروقراطي يُدير الواقع كما هو، دون أي قدرة على تغييره، مما يعمّق الانفصال بين النظرية والممارسة بدل أن يجمعهما في وحدة عضوية.
كيف يقصي التنظيم النشاط الفكري؟ – نقد لهيمنة السطحية التنظيمية
رغم أن التنظيم، بحسب التصور الماركسي، يُفترض أن يكون تجسيدًا ماديًا للفكر الثوري، أي أداته التاريخية لتحويل النظرية إلى قوة اجتماعية فاعلة، إلا أن التجربة الحزبية الراهنة، وخصوصًا في السياقات العربية، تكشف عن مفارقة موجعة. إذ أصبح التنظيم، بدل أن يحتضن الفكر، كثيرًا ما يُقصيه أو يُخنقه أو يُفرغه من محتواه، ليعيد إنتاجه على شكل بيروقراطية خاوية.
هذا التحول يرتبط بنمط تنظيمي ترسّخ تدريجيًا، يُعلي من قيمة الانضباط الشكلي ويهمّش التفكير النقدي. في هذا النمط، تُفرَز نخبة حزبية تمارس الإدارة لا الفهم، وتعيد إنتاج الهيكل التنظيمي لا كوسيلة لتغيير الواقع، بل كغاية بحد ذاتها. وعندما يتحوّل التنظيم إلى هدف مستقل، يفقد طابعه الثوري ويبتعد عن الفكر كشرط أساسي لفهم الواقع وتفكيك تناقضاته.
في هذه الحالة، يُهمَّش التحليل، وتُمنح مواقع القرار لمن يتقنون التنفيذ والانضباط، لا لمن يملكون وعيًا تاريخيًا أو قدرة تحليلية. معايير الترقية التنظيمية تُصبح خاضعة لدرجة الولاء الشكلي أو النفوذ داخل الأجهزة، بدل أن تقوم على الكفاءة النظرية أو النضال العميق. وهنا يُقصى “المثقف العضوي” الذي يُنتج الوعي من داخل التجربة، ويُستبدل بكوادر إدارية مطيعة تتقن إدارة الاجتماعات وترد على التعليمات، لكنها عاجزة عن إنتاج فهم مستقل للصراع الطبقي أو أدوات تحليل جدلية.
هذا الإقصاء لا يعني فقط تراجع المستوى الفكري، بل يعكس نزعة بنيوية لعزل الفكر عن التنظيم. فيصبح الفكر مجرد تقارير موسمية أو وثائق جامدة، بينما يتحوّل التنظيم إلى جهاز تنفيذي ينتج السكون لا التغيير. وتُصبح اللجان الفكرية أجهزة ملحقة لا دور لها سوى تبرير التوجهات، أو شرح قرارات اتُّخذت مسبقًا، بدل أن تكون فضاءات حرة لإنتاج التحليل، ومساءلة السياسات، وتجديد الرؤية.
هكذا تُفرّغ الماركسية من مضمونها النقدي، ويُعاد تقديمها كإيديولوجيا تبريرية تُكرّس الواقع بدل تفكيكه. ويتحوّل التثقيف إلى إعادة تكرار خطاب جاهز، لا إلى عملية جدلية تُكوّن الذات الثورية. ومع تهميش الفكر، يُصاب الحزب بالجمود؛ فبدون أدوات تحليل متقدمة وكوادر قادرة على فهم التحولات، يفقد الحزب قدرته على المبادرة، ويصبح تابعًا للأحداث، لا فاعلًا فيها.
الهزائم السياسية هنا لا تكون فقط نتيجة ضغوط خارجية، بل تعبير عن فشل داخلي في إنتاج وعي يعكس تعقيد المرحلة. ما لم يُستعد الفكر النقدي كمكون أساسي داخل البنية الحزبية، فإن الحزب يُستبدل بجهاز إداري يُدير التآكل بدل أن يبني أفقًا ثوريًا جديدًا.
من النخبوية إلى التلقين – أزمة المكاتب الفكرية
واحدة من أبرز تجليات الأزمة في العلاقة بين الفكر والتنظيم داخل الأحزاب الشيوعية، تكمن في الطريقة التي يُمارَس بها النشاط الفكري نفسه. فبدل أن يكون جزءًا حيًا من الممارسة اليومية، يُفصل هذا النشاط عن الحياة التنظيمية، ويُحصر داخل دوائر ضيقة من النخب النظرية. هؤلاء يُكلفون بإعداد كراسات أو كتابة بيانات، لكن دون أن يكون لهذا الجهد الفكري أي امتداد عضوي أو ارتباط فعلي بالقواعد الحزبية أو بالصراع اليومي.
بهذا الفصل، يتحوّل الفكر من أداة تحليل ونقد إلى وظيفة إدارية تؤدى بتكليف، فتفقد طابعها الجدلي. ويصبح دورها تفسير الأحداث وتبرير الخط السياسي بدل مساءلته أو تطويره. هذا الوضع يعكس نمطًا نخبويًا متجذرًا في التقاليد الحزبية، حيث يُحتكر الفكر من قِبل قلة تملك أدواته النظرية، فتنتج خطابًا مغلقًا ومنعزلًا عن الممارسة، ويُقدَّم للكوادر كمنتج نهائي يجب استهلاكه، لا المشاركة في إنتاجه.
ومن بين أخطر نتائج هذا المسار هو انتشار ما يمكن تسميته بـ”الثقافة الببغائية”، حيث يتحوّل بعض “المثقفين الحزبيين” إلى مروّجين للخط السياسي السائد، لا إلى محللين نقديين. فيُكتب المقال أو تُنتج الدراسة بهدف تبرير القرار، وليس لفهم الواقع أو تطوير الموقف. والأسوأ أن نفس المثقف قد يُغيّر خطابه رأسًا على عقب، حين تتبدّل توجّهات القيادة، مما يُفقده المصداقية أمام القواعد وحتى داخل الحزب ذاته.
في ظل هذا السياق، يتآكل احترام المثقف الحزبي، لا بسبب قلة معرفته، بل بسبب غياب الاستقلالية الفكرية. ويتحوّل الخطاب النظري إلى ملحق تبريري، يفتقر إلى الجدية أو القدرة على التجديد. ويعمق هذه الأزمة أن التكوين النظري لم يعد يُطرح كعملية مستمرة لتطوير أدوات الفهم، بل كواجب إجرائي أو إثبات ولاء للقيادة.
بهذا المعنى، يُختزل الفكر في دور أيديولوجي محدود، يُربط بالدعاية لا بالتحليل، ويُفصل عن الاستراتيجية. فيفقد الفكر طبيعته التحويلية، ويتحوّل إلى “قناع لغوي” يُغطي غياب الرؤية النقدية داخل الحزب. وتُصبح الوثيقة النظرية مجرد تعليق تنظيري، لا فعلًا تأسيسيًا مندمجًا في الصراع الطبقي.
تجاوز هذه الأزمة يتطلب تفكيك العلاقة السلطوية بين الحزب والمثقف، وبناء علاقة جدلية تقوم على الشراكة النقدية. المثقف في الماركسية ليس حاملًا للمعرفة فحسب، بل شريكًا في التغيير. والمعرفة نفسها ليست حكرًا على فئة، بل تُنتج جماعيًا من التفاعل مع الواقع.
لذا يجب التعامل مع كل كادر حزبي باعتباره عقلًا قادرًا على التفكير، لا مجرد منفّذ أو متلقٍ للتوجيهات. ويجب أن يُفهم الإنتاج النظري على أنه جزء من الاستراتيجية، لا وظيفة دعائية. ولا تُحل هذه الإشكالات بتوسيع المكاتب الفكرية أو زيادة عدد المنشورات، بل بكسر منطق النخبوية، ودمج التكوين النظري في المسار النضالي اليومي، بحيث يُصبح الفكر نفسه أداة تغيير، لا سلطة فوقية.
فعندما ينفصل الفكر عن الحقيقة، والتحليل عن الموقف، والسياسة عن المفهوم، تتفكك مصداقية التنظيم كله، وتُفرغ الماركسية من مضمونها، وتتحوّل إلى لغة فارغة. وحدها إعادة بناء الحزب كعقل جماعي — يُعيد للمثقف دوره كرافعة وعي ومسؤولية تحليل ومساءلة — يمكن أن تُنقذ وحدة الفكر والتنظيم والسياسة من هذا الانهيار.
الفكر كترف؟ – تفكيك وهم “الواقعية” السياسية
من أكثر الأوهام انتشارًا داخل الممارسة الحزبية المعاصرة هو النظر إلى الفكر بوصفه ترفًا تنظيريًا، أو فائضًا ثقافيًا يمكن الاستغناء عنه في لحظات التوتر السياسي أو “الاستعجال الثوري”. وتحت هذا التصور الزائف، يُقصى الفكر النقدي من موقع القرار، وتُعامل الماركسية لا كأداة تحليل وتغيير، بل كمجموعة من المصطلحات والشعارات تُضاف إلى البيان السياسي لتضفي عليه طابعًا تراثيًا أو لغويًا.
هذا النهج يعكس نزعة “واقعية” تتغلغل في عقل كثير من القيادات الحزبية، لكنها واقعية تُوظف كقناع لغياب التحليل، لا كمنهج لقراءة الواقع. فبدل أن تُفهم الواقعية كقدرة على الانفتاح على المتغيرات الاجتماعية، يجري استخدامها كتبرير للتخلي عن الفكر، واستبدال التحليل الجدلي بردود أفعال ظرفية. وتُختزل السياسة في مناورة آنية بلا أفق، تُنتج مواقف تُواكب اللحظة لكنها لا تملك عمقًا أو استراتيجية.
النتيجة أن الحزب يتحوّل إلى كيان يُعيد إنتاج نفسه داخل منطق اللحظة، ويتخلى عن وظيفته التاريخية بوصفه قوة فكرية – تنظيمية تُقارب الصراع من جذوره. في هذا السياق، تُستبدل الوثائق النظرية بمواقف إعلامية سريعة، ويجري تدوير الشعارات دون مراجعة أدوات التحليل، في وقت تتعقد فيه التناقضات الاجتماعية وتتطلب تفكيكًا عميقًا.
ومع غياب الفكر كمصدر للتحليل، تُفقد القيادة قدرتها على المبادرة. فهي لا تتحرك وفق تصور جدلي يُنتج موقفًا نقديًا، بل تكتفي برد الفعل على ما يفرضه الواقع. السياسة، في هذه الحالة، تتحوّل من فنّ استباق الصراع إلى فنّ التكيّف معه، ومن مشروع تحوّلي إلى سلسلة إجراءات ظرفية تُقدّم لاحقًا في صيغة خطاب تبريري.
لذلك، لا عجب أن يتسم خطاب كثير من الأحزاب اليسارية اليوم بطابع صحفي سطحي، أشبه بتعليقات على الأحداث أكثر من كونه تفسيرًا لبُناها أو لعمقها الطبقي. تغيب المفاهيم، يغيب الأفق النظري، وتذوب المواقف في لحظة التفاعل مع الحدث، دون استراتيجية تُنظّم العلاقة بين التكتيك والاستراتيجية، أو بين الحدث والواقع البنيوي.
الأسوأ أن بعض القيادات لا ترى في هذا الغياب أزمة، بل تعتبره شكلًا من “المرونة السياسية”، فتُعيد تأطير العجز النظري على أنه براغماتية أو فعالية. وهكذا يُستبدل النقد بالتبرير، ويُصبح الفكر أداة تسويغ، وتُفرغ الماركسية من جوهرها بوصفها منهجًا للتحليل التاريخي.
ما يُخفيه هذا الخطاب هو أن الحزب، في هذه الوضعية، يتخلّى عن دوره الطليعي، ويكتفي بلعب أدوار إعلامية أو تمثيلية. الواقعية السياسية هنا ليست انفتاحًا على الممكن، بل استسلام ضمني للهزيمة، وخلط مريب بين التكتيك والركود، بين المرونة والتنازل النظري.
الخطر في هذا الانفصال بين الفكر والسياسة لا يقتصر على ضعف النظرية، بل يصيب الفعل السياسي ذاته بالعمى. فحين تُدار السياسة بلا تحليل، وبلا رؤية نقدية، تغيب القدرة على التراكم، وتضيع البوصلة، ويتحوّل العمل السياسي إلى دوران داخل المنظومة بدل مواجهتها أو السعي لتجاوزها.
جدلية الفكر والتنظيم والسياسة في زمن الانحسار
عند تتبّع التداخل بين النشاط الفكري والنشاطين التنظيمي والسياسي داخل الأحزاب الشيوعية، لا نكتشف فقط خللًا وظيفيًا عابرًا، بل نواجه أزمة عميقة تطال البنية الحزبية ككل. ليست المشكلة في الفصل بين هذه الأنشطة الثلاثة فحسب، بل في غياب الجدلية التي يجب أن توحدها ضمن حركة واحدة، تُجسّد الماركسية كمنهج للفهم والتغيير، لا كمجرد مرجعية نظرية.
فعندما ينفصل الفكر عن التنظيم، ويتحول التنظيم إلى مجرد جهاز بيروقراطي هدفه الحفاظ على الانضباط، وتُختزل السياسة في إدارة لحظية بلا مشروع طويل المدى، يفقد الحزب ليس فقط توازنه الداخلي، بل أيضًا مبرر وجوده التاريخي. يتحوّل من أداة ثورية إلى كيان يُدير العجز، ويتكيّف مع ظروف الانحسار بدل مواجهتها.
الكثير من الأحزاب الشيوعية في السياقات المعاصرة أصبحت تكرر نموذجًا تنظيميًا مفرغًا، يُقصي التفكير النقدي، ويُهمّش المعرفة، ويُعيد إنتاج الانضباط كقيمة عليا. بهذا يتحول الحزب من عقل جماعي إلى جهاز جامد يُرتّب الأفراد داخل تراتبية صلبة، ويستبدل المثقف العضوي بالكادر التنفيذي، والنظرية بالشعارات، والسياسة بالبقاء.
أما الفكر، حين يُحاصر في لجان معزولة أو يُحوّل إلى نشرة داخلية، يفقد طاقته على كشف التناقضات أو صياغة بدائل. ويتحوّل إلى وظيفة تفسيرية تُكرّس الوضع القائم، بدل أن تحاول تجاوزه. وفي هذه الحالة، لا يعود الفكر قوة كشف وتغيير، بل رمزًا تاريخيًا يُستدعى للزينة، ويُجرّد من قدرته التحويلية.
مع ذلك، هذه الأزمة ليست قدرًا محتوّمًا، بل نتيجة مسار تاريخي يمكن فهمه وتفكيكه. فهي لا تنفصل عن التحولات العالمية التي ضربت المشروع الاشتراكي: تراجع الحركة العمالية، انقسام اليسار بين تيارات إصلاحية استوعبتها المنظومة، وأخرى راديكالية فقدت أدوات التنظيم، فضلًا عن صعود سياسات الهوية، وتفتت الروابط الاجتماعية، وهيمنة السردية النيوليبرالية. لكن رغم كل ذلك، لا يُعفى الحزب من مسؤوليته عن هذا المسار التراجعي، حين استبدل الفعل الثوري بإدارة الرماد التنظيمي.
العودة إلى جوهر الماركسية لا تتحقق بالحنين أو إعادة إنتاج الصيغ القديمة، بل بإعادة بناء العلاقة الجدلية بين الفكر والتنظيم والسياسة على ضوء الشروط الجديدة. وهذا يقتضي إعادة تعريف التنظيم، لا بوصفه جهازًا فوقيًا يُدير الأفراد، بل كحلقة وصل حية بين التحليل والممارسة، بين النظرية والواقع، بين الأفراد والتاريخ.
كما يتطلب إعادة الاعتبار للفكر بوصفه أداة تفكيك وبناء، لا سلطة معرفية، بل طاقة قادرة على تجديد البرنامج وإعادة وصل السياسة بتحليل مادي للتاريخ. إذ لا يمكن لحزب أن يكون ثوريًا حقًا إذا لم يوحّد هذا المثلث المفكك: فكر بلا سياسة يبقى معلقًا، وتنظيم بلا فكر يتحول إلى بيروقراطية، وسياسة بلا تحليل تغرق في العجز.
الحزب الثوري هو الذي يعي ذاته كعقل جماعي، لا كجهاز تنفيذي. هو الذي يفهم ذاته كأداة تنظيم للتناقضات، وكوعي تاريخي للصراع، وكحركة تُنتج التاريخ أو تسعى لتغييره. لا تُقاس ثورية الحزب بعدد فروعه أو بياناته، بل بقدرته على أن يكون مشروعًا لفهم الواقع وتغييره، على أن يكون وحدة حيّة بين الفكر والتنظيم والسياسة.
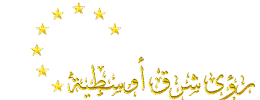


اتفق مع المقال والتحليل واشير ان هذا التشخيص هو لب الخلل الذي نعيشه في التنظيميات اليسارية