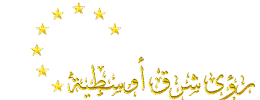حين تُذكر دولة الرفاه، يتجه الخيال عادة إلى قائمة خدمات، تعليم مجاني، رعاية صحية، ضمان اجتماعي، ومعاشات تقاعد. لكن التجربة السويدية تعلمنا شيئا أعمق، الرفاه لا يولد من برنامج حكومي معزول، بل من عقد اجتماعي طويل النفس، ومن مؤسسات تضبط الصراع وتحوّله إلى تفاوض. وفي قلب هذه الحكاية يقف الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي بوصفه الفاعل الأكثر اتصالا بصناعة ذلك العقد، لا باعتباره حزبا “خيريا”، بل باعتباره مهندس تسوية بين العمل ورأس المال، ومترجما للقيم إلى سياسات قابلة للاستمرار.
تأسس الحزب عام 1889، في لحظة كانت فيها الحركة العمالية الأوروبية تعيد تعريف السياسة بوصفها صراعا على الحقوق لا مجرد تداول نخبة على السلطة. ومنذ بداياته ارتبط بنشوء التنظيم النقابي، ثم نما تدريجيا من حركة احتجاج إلى حزب حكم، ومن خطاب مطالب إلى هندسة مؤسسات. هذه النقلة ليست تفصيلا تاريخيا؛ إنها ما يفسر كيف تحوّل الحزب إلى “حزب دولة” قادر على إدارة تناقضات المجتمع بدل الاكتفاء بتأجيجها.
غير أن اختزال التجربة السويدية في حزب واحد يظل تبسيطاً مغرياً وخاطئاً في آن. فنجاح الرفاه السويدي لم يكن نتاج نوايا سياسية وحدها، بل حصيلة توازنات اجتماعية وثقافة امتثال ضريبي، ومؤسسات تفاوض راسخة، وقوة نقابية وتنظيمات أرباب عمل قادرة على الجلوس إلى طاولة واحدة. هنا تظهر قيمة مقاربة “الاقتصاد السياسي المؤسسي”، الأفكار تمنح الشرعية، والمؤسسات تمنح الاستقرار، والسياسات تأتي غالبا ثمرة لهذا التزاوج.
أول مفاتيح الشرعية كان مفهوم “البيت الشعبي” Folkhemmet . ليست الكلمة مجرد استعارة جميلة، بل جهاز سياسي لصياغة معنى جديد للمجتمع، وطن كبيت، لا كسوق فقط؛ بيت لا يتسع لامتياز ثابت ولا لتهميش مقنن، وتدار فيه الخلافات ضمن قواعد مشتركة. عندما تبنى بير ألبين هانسون المفهوم في أواخر العشرينيات، لم يكن يكتب شعاراً عاطفيا؛ كان يعيد تدوير الصراع الطبقي إلى لغة جامعة تجعل إعادة التوزيع مقبولة أخلاقياً بوصفها “ترتيباً لشؤون البيت” لا “غلبة طبقة على أخرى”. بهذه اللغة، توسع الائتلاف الاجتماعي الداعم للرفاه، وتحوّلت الدولة من حكم فوق المجتمع إلى وسيط داخله.
لكن الشرعية وحدها لا تبني نظاماً قابلاً للحياة. لذلك جاء المفتاح الثاني،، اتفاق سالتشيوبادن عام 1938، الذي رسخ قواعد العلاقات الصناعية عبر تفاوض جماعي بين اتحاد النقابات LO ورابطة أرباب العمل. أهميته أنه خفض “كلفة الصراع” كلما كانت قواعد اللعبة واضحة ومركزية، ارتفعت قابلية التنبؤ، وانخفضت احتمالات الإضرابات الشاملة، وتحول النزاع من مواجهة وجودية إلى مساومة منظمة. وهنا يظهر جوهر “النموذج السويدي” دولة قوية لا تتغول على الأطراف، وسوق عمل لا يترك الأقوى يلتهم الأضعف، بل يفرض على الطرفين الاعتراف المتبادل.
ثم يأتي المفتاح الثالث… العقل الاقتصادي داخل الرفاه، أي نموذج رين–مايدنر. كثيرون يتحدثون عن المساواة كما لو كانت ترفا أخلاقياً ضد الكفاءة. هذا النموذج قلب المعادلة، جعل المساواة جزءا من هندسة الاستقرار. صاغه اقتصاديان مرتبطان بحركة النقابات (غوستا رين ورودولف مايدنر) ليجمع بين أربعة أهداف صعبة التعايش، تشغيل كامل، نمو مرتفع، تضخم منخفض، وتفاوت محدود في الدخول. عبر أجور تضامنية تضغط على الشركات منخفضة الإنتاجية كي تطور نفسها أو تخرج من السوق، ومع سياسات سوق عمل نشطة تعيد تأهيل العامل بدل تركه خارج اللعبة، وبسياسة كلية منضبطة تكبح دوامة الأجور والأسعار. هكذا بدأ الرفاه ليس توزيعاً بعد الإنتاج فقط، بل تنظيما للإنتاج نفسه.
وفي ترجمة القيم إلى سياسة ملموسة، يظل الإسكان المثال الأكثر كاشفية، لأنه يربط العدالة بالمدينة وبالفرز الاجتماعي “برنامج المليون” (1965–1974) لم يكن مشروعاً عمرانياً فحسب، بل تدخلاً بنيوياً يعلن أن السكن ليس سلعة خالصة، وأن الدولة حين تملك الإرادة والمؤسسات تستطيع أن تخلق عرضاً واسع النطاق. وبحسب هيئة الإسكان والتخطيط السويدية، بُني خلال تلك السنوات نحو 1.005.578 وحدة سكنية في عموم البلاد. غير أن أثره التاريخي مزدوج، حل أزمة، ثم ترك لاحقاً أسئلة عن التجديد الحضري، وتفاوت الخدمات، وتمايز الضواحي عن المراكز.
إلى هنا تبدو القصة كأنها نموذج مكتمل. لكن القرن الحادي والعشرين لا يرحم الحنين. التحدي اليوم لم يعد مجرد حسابات تمويل، بل اختبار ثقة وتمثيل وعدالة مكانية. السوقنة والخصخصة في بعض الخدمات فتحت سجالاً حول المساواة والمساءلة، هل يتحول المواطن إلى زبون؟ وهل تصبح جودة الخدمة وظيفة للحي الذي تقطنه؟ وفي الوقت نفسه، يضغط التحول الديموغرافي وتقدم العمر على كلفة الرعاية، بينما تعيد الهجرة وتبدلات سوق العمل رسم خريطة جديدة للمخاوف والفرص، وظائف أكثر مرونة وأقل استقراراً، مدينة أكثر تنوعاً وأشد فرزاً، وقلق اجتماعي يترجم سياسياً بصعود الاستقطاب.
هنا يُطرح سؤال الحزب الاشتراكي الديمقراطي بصيغة عملية لا خطابية، هل يستطيع أن يعيد إنتاج “البيت الشعبي” بمعناه الجديد؟ والأدق، هل يمتلك أدواته المؤسسة في سياق مختلف؟ من جهة، يظل الحزب قوة كبرى انتخابياً في انتخابات الريكسداغ 2022 حصل على نحو 30.3% ونال 107 مقاعد، وفي انتخابات البرلمان الأوروبي 2024 نال نحو 24.77% وحافظ على 5 مقاعد من أصل 21 مقعدا مخصصة للسويد. لكن الوزن لا يعني الهيمنة، ولا يضمن وحده القدرة على تجديد العقد.
ولكي لا نقع في رومانسية معكوسة، لا يجوز أيضاً الادعاء بأن “النموذج انتهى” لمجرد أنه يواجه اختباراً. الأصح أن نقول، النموذج يتغير، ومن لا يبتكر أدواته يخسر شرعيته بالتدريج. إذا كان سالتشيوبادن قد روض الصراع داخل سوق العمل، فالسؤال اليوم، كيف نروض صراعاً جديداً يتغذى من تفاوت مكاني وثقافي، ومن خدمات تتفاوت جودتها، ومن شعور بعض الفئات بأن العقد لا يعاملها بالإنصاف؟ وإذا كان رين–مايدنر قد نجح في اقتصاد صناعي قوي التنظيم، فكيف تُصاغ سياسات سوق عمل نشطة لاقتصاد خدمات ومنصات وعقود مؤقتة؟
الخلاصة أن “البيت الشعبي” لا يصلح بوصفه تميمة تاريخية، بل بوصفه مشروع تجديد دائم. بيت تدار فيه الاختلافات بعدالة، وتوزع فيه الأعباء بوضوح، وتصان فيه الثقة بوصفها رأسمالاً سياسياً لا يقل قيمة عن الاستثمار والنمو. التحدي أمام الحزب الاشتراكي الديمقراطي ليس أن يستعيد الماضي، بل أن يستعيد منطقه، بناء ائتلافات واسعة، وتقوية أدوات التفاوض، وربط الاندماج بالعمل والسكن والتعليم في حزمة واحدة، ووضع السوق تحت معيار المساءلة لا تحت شعار الكفاءة المجردة. عندها فقط يصبح الرفاه ممارسة سياسية حية، لا ذكرى جميلة تروى في المناسبات.