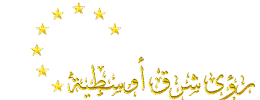يرتبط التنوع الثقافي بالبحث في اختلافات الخطاب الثقافي القادر على تحديد انسانية الانسان وهويته الثقافية من منظور ابستيمولوجي قادر على إيجاد وسائط معرفية تخلق حركية ثقافية دائمة بالرجوع إلى التحليل الثقافي للاختلافات العرقية حيث أن “مشكل الاختلاف لا يقتصر على أن يطرح نفسه بصدد الثقافات التي ينظر إليها في علاقاتها المتبادلة، إنه موجود أيضا داخل كل مجتمع وفي جميع الفئات التي تكونه” (ستراوس، 1983، صفحة 466)، فالتنوع الثقافي كمصطلح حديث يعني أن لكل ثقافة من الثقافات الإنسانية قيمتها ومكانتها وإسهامها الفكري والفلسفي في إثراء التراث الإنساني وربطه بالأنساق المعرفية والثقافية التي تؤسس للمعنى التداولي والتراكبي للمعارف والثقافات.
يتحدد التنوع الثقافي بالرجوع الى المنظومات المعرفية والثقافية للإنسان التي تحاول تشكيل معنى الهوية الثقافية وتحولاتها الخاضعة لصراع مختلف النماذج المعرفية، بما هي اعتزاز بالهوية الفردية وبحث عن الفرادة والتنوع انطلاقا من الانفتاح على الآخر، “فمفهوم تنوع الثقافات البشرية لا ينبغي تصوره بطريقة سكونية”، (ستراوس، 1983، صفحة 466) بل له طابع متحرك ومتغير حسب انماط الحياة ومختلف التحولات المعرفية التي تشكل الوعي الإنساني والثقافي في إطار تواصل فعال بين الأفراد والجماعات، وتشاركية معرفية تستهدف الانسان وشبكاته الرمزية التي تبني كيانه الثقافي، خاصة وأن تنوع الثقافات “مرتبط بالعلاقات التي توحد الجماعات أكثر مما يتعلق بعزلتها” (ستراوس، 1983، صفحة 467) .
يعكس التنوع الثقافي العطاء الفكري للعقل البشري على اختلاف ظروف نشأته وبيئاته الاجتماعية والثقافية “فالانثروبولوجي هو الشاهد الاثنوغرافي لهذا الواقع الاجتماعي الثقافي ” (يتيم، 1998، صفحة 36) حيث يجمع مفهوم التنوع بين الاعتراف بتعدد الثقافات والأفكار والتجارب الإنسانية، وبين وجود تجربة بشرية محددة، ليحافظ بذلك على السمات الخاصة بكل مجتمع، مهما اختلفت تجارب أفراده وخبراتهم، ويفتح مساحات تأويلية لبناء الحاضر الثقافي انطلاقا من التاريخ الإنساني.
فالتعامل مع التنوع الثقافي كمشترك إنساني هو اعتراف بالمشاركة الإنسانية في مسيرة الحضارة الحديثة، التي تعطي فرصة للتاريخ الثقافي والعرقي باعتباره حدثا متواصلا، وقد أكد كلود ليفي ستروس في مقارباته البنيوية على أهمية التواصل مع الثقافات الأخرى وضرورة تقبّل اختلافات الإنسانية وفق ما يتناسب مع النسبية الثقافية التي تربط بين الثقافة وخصوصية البيئة التي تنتمي إليها، معتبرا أن “لكل ثقافة أو مجتمع منطقه الخاص وتماسكه الداخلي اللذان يمكن في ضوئهما تفسير عاداته ومعتقداته” (سميث، 2009، الصفحات 676-677).
إن وجهة النظر الأنثروبولوجية تلغي سلّم التفاضلات الثقافية ليحل محلها التنوّع النسبي بين الثقافات، فكل ثقافة في حاجة إلى الثقافات الأخرى لتبني كيانها الثقافي وتصحح مسارها الحضاري، ليأخذ التنوع معنى التحالف الذي تحتفظ فيه كل ثقافة بخصوصياتها وممارساتها الاجتماعية، حيث “أصبح عدد من انثروبولوجيي اتجاه ما بعد الحداثة ينظرون الى الممارسات الاجتماعية والخطابية خاصة باعتبارها ظاهرة ثقافية جديرة بالدارسة” (يتيم، 1998، صفحة 36) توفر مجالا واسعا للتثاقف والتحاور وإزالة الحواجز بين الثقافات باعتبار أن التنوع الثقافي هو إرث الإنسانية المشترك ومصدر للتبادل والإبداع والانفتاح على الآخر.
بقدر ما يكون التنوع الثقافي مجالا لفهم الاخر والانفتاح عليه، بقدر ما يصبح نوعا من المساءلة لانعكاسات هذا التنوع على الخصوصية الثقافية وعلى الهوية الجماعية والفردية، وهنا “يجب ألا نخلط بين التعددية الثقافية ومجرد الاعتراف بوجود مجتمع متعدد الثقافات. لقد وُجدت، دائما، مجتمعات متعددة الثقافات، ويمكن، من وجهة نظر ما، أن نؤكد عمليا أن كل الدول-الأمم، سواء اعترفت بذلك أو لم تعترف، هي مجتمعات ذات تعدد ثقافي، بفعل تنوع المجموعات والسكان المكوّنين لها” (كوش، 2007، صفحة 184)
فالتنوع حياة وقيمة ووجود، يتجاوز الاختلاف لكونه مجرد وسيلة للتعايش والاشتراك ليصبح مصدرا لثراء الخطاب الثقافي الذي يؤطر آليات التفاعل والترابط الجماعي ويضفي حيوية وحركية على الحياة الجماعية، فعندما نناقش التنوع المتعلق بالبعد الثقافي، “فنحن نعنى الطرق التي يجعل الناس من خلالها حياتهم ذات مغزى، بشكل منفرد وبصورة جماعية، عن طريق التواصل مع بعضهم البعض” (تومليسون، 2008، صفحة 31) .
فالغاية من التنوع والتعدد الثقافي هي تنظيم العلاقات بين الجماعات وإرساء خطاب ثقافي يسائل مختلف السياقات التاريخية والثقافية والفكرية ويحرر الإنسان من النموذج الإيديولوجي لتعميق احترامه لطبيعة وإمكانيات هذا الوجود الإنسان ، فـ “غاية التعددية الثقافية هي الارتقاء بتساوي المعاملة تجاه مختلف المجموعات الثقافية الممثلة للأمة، تلك الّتي يعترف بكرامتها علنا. ويمكن أن يتمثل ذلك، في مستوى أول، في دعم شرعية التعبير الثقافي والسياسي لدى هذه المجموعات. ويمكن أن يبلغ ذلك، في مستوى ثانٍ، وضع برامج معاملة تفاضلية أو تمييز إيجابي تسمح بإدراك المساواة لكل المجموعات وتسعى إلى إصلاح آثار أوضاع التمييز السلبى المباشرة وغير المباشرة والتعويض عنها” (كوش، 2007، صفحة 185) لذلك فإن التنوع هو واقع وحتمية، أما التعددية فهي الإطار الّذي يتم من خلاله الاعتراف بهذا الواقع وعقلنته.
فالتعددية الثقافية لا تلغي التنوع الهووي بقدر ما تضمّنه داخل خصوصية التمثل الاجتماعي والسياسي لكل ثقافة ضمن نظريات تستجيب للتطلعات الانسانية الحديثة، وهو ما يدفعنا للتفرقة بين مفهوم الثقافة ومفهوم الهوية الثقافية، فرغم أن للمفهومين ” مصير مترابط، فإنه لا يمكن المطابقة بينهما بلا قيد أو شرط. يمكن للثقافة عند الاقتضاء، أن تكون من دون وعي هوياتي، في حين يمكن للاستراتيجيات الهوياتية أن تعالج، بل أن تعدل ثقافة ما بحيث لا يبقى لها الشيء الكثير مما تشترك فيه مع ما كانت عليه قبل. إن الثقافة تخضع، إلى حد كبير، لصيرورات لا واعية، أما الهوية فتحيل على معيار انتماء واع، ضرورة، إذ هو ينبنى على تعارضات رمزية” (كوش، 2007، صفحة 148)
اتسمت اركيولوجيا التنوع الثقافي بإمكانيات الحفر داخل ممكنات الخطاب الثقافي للبحث عن إنسانية الإنسان من منظور إبستيمولوجي يتفاعل مع مفهوم التحليل الثقافي باعتباره استراتيجية جديدة من استراتيجيات الحفر المعرفي التي تحاول اقتلاع الهوية الثقافية من مثالب التبعيات الكولونيالية. لتصبح عملية الاقتلاع نوعا من الثورة الاركيولوجية على المصير الانساني الذي بات محكوما بالتبعية اللامتناهية الأصل والامتداد، وهنا “ينبغي أن تفهم ثورة الاركيولوجيا من حيث أنها عندما تعلن عن زوال الانسان أو قرب زواله، إنما تقصد تلك القطيعة المنتظرة التي ستحل في نظام الانظمة المعرفية الذي اعتادت العلوم الانسانية أن تجعله كبطانة تغلف به منهجياتها ” (فوكو، 1990، صفحة 18) وتخفي به أزمات الهوية الثقافية الجماعية والفردية.
عرف المسرح الغربي عدة تجارب وأبحاث فنية ومقاربات انثروبولوجية انطلقت من الممارسات والعادات البدائية لتؤسس إلى نظريات فكرية تركت أثرا ملموسا في التمثلات الثقافية والاجتماعية، ويعتبر المخرج المسرحي يوجينيو باربا من أبرز من نظّر لأنثروبولوجيا المسرح عبر كتاباته النظرية وممارساته المسرحية التي شكلت نموذجا للتنوع الثقافي الذي لا يلغي خصوصية الآخر بقدر ما يسعى للاعتراف بها وتثمين وجودها على الركح المسرحي.
اهتم باربا بالظاهرة المسرحية والتفاعل الكامن بينها وبين الجانب الاجتماعي لحياة الممثل ومرجعياته الثقافية وما يمكن ان تفرزه من تنوع فوق الركح يعمق التعايش السلمي في فترة هيمنت فيها العولمة والحضارات الغربية، مما جعله يكتشف ثقافات مغايرة دخيلة على ثقافته، ترسخت في ذهنه وأسست لمنهجه، فدرس الأنثروبولوجيا والأدب وتاريخ الأديان، ثم توغل في البحث المسرحي والتحق بمختبر غروتوفسكي، وتأثر بأسلوبه وسار على خطاه ولكنه بلغ اتجاهه الخاص في المسرح الأنثروبولوجي الذي يتجاوز الرؤى الكولونيالية نحو الاعتراف بإنسانية وثقافة الآخر، حيث اعتمد على تجاربه الشخصية والاجتماعية وما تبناه من أنماط مسرحية مختلفة تركت أثرا في نفسه وكانت مصدر إلهام له.
يلامس التوجه الانثروبولوجي في المسرح التنوع الحاصل في الجوانب الاجتماعية والثقافية كما يوظف التاريخ الانساني والحضاري كجزء من الثقافة التشاركية التي يمكن من خلالها فهم الآخر والانفتاح عليه، حيث تختص أنثروبولوجيا المسرح في “دراسة سلوك الإنسان البيولوجي والثقافي في وضع تمثيل, أي الرجل الذي يستعمل حضوره الجسدي والعقلي بحسب مبادئ مختلفة عن تلك التي تسوس الحياة اليومية” (بافيس، 2015، صفحة 78)، لتتعامل مع الإنسان كمسلك علمي مسرحي في حالة أداء، فتترجم مرجعيته الانثروبولوجية حالته الوجودية أكثر من اهتمامها بالمنحى التعبيري والعاطفي.