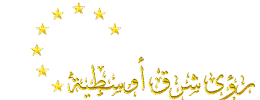يرتبط تعيين الذات بإدراك الاختلافات الموجودة فيها، وبالتالي، وضع المفاهيم الجاهزة عن الهوية والمجتمع والانتماء في ساحة النقاش والمساءلة والكشف، لنطرح هنا صراع الهوية والانتساب، بين الأوهام الايديولوجية في الفكر الفردي والجماعي، وبين واقع السوسيولوجيا وفق ما هو منشود وما هو موجود تحت وطأة الرؤى الكولونيالية بمختلف مظاهرها والتي سلبت من الهويات فعاليتها وتركتها عاجزة عن تمثيل ذواتها. فإذا كان للفرد خصوصياته وأفكاره وبنيته الشخصية التي تجعله يحقق كيانه ويستشعر وجوده، ويتبنى لنفسه قناعات وتصورات ونظرة إلى العالم من حوله، فهذا لا يعني أنه قد امتلك كل ذلك منفردا وبمعزل عن المجموعة، فالفرد بطبعه كائن اجتماعي، وبهذا المعنى لا نستطيع أن ننفي أن الفعل الابداعي للذات الفردية هو نتاج تفاعلها الجماعي وتشاركها مع المجموعة. إلا أن الهوية في تحديداتها وانبثاق فرديتها تتطلب الحياد عن المجموعة والاختلاف في تصوراتها التي تتفرد بها لتفصح عن كينونتها الوجودية، وإلا فإننا سنجد أنفسنا أمام أزمة هوية وتصدع خطير في الانتماء يلغي ذاتية الفرد ويحوله إلى كائن مستلب الإرادة والوعي والتفكير. وهذا ما سنحاول البحث فيه من خلال تقديم قراءة سيميولوجية لما يمكن استخلاصه من علامات بصرية وإيحاءات شكلية قادرة على استيعاب ما تطرحه لوحة “الخروج عن القطيع”(Deserter / Out from the herd) لتوماس ألان كوبيرا من أبعاد تأويلية لما يوجد في الواقع من مظاهر وسلوكيات اجتماعية تنفي الذات الفردية وتلغي وجودها.
تطرح هذه اللوحة ظاهرة التغيرات البنيوية من منطلق التعامل مع مصطلح القطيع النيتشي كمقاربة سيميولوجية تقدم قراءة نقدية للوعي الاجتماعي والايديولوجي ولدور ثقافة القطيع وتأثيرها على صناعة الذات، في قالب فني يراوح بين الشاعرية والسخرية، حيث يصبح الناس وفق هذه اللوحة “قطيعا من الغنم، ويفقدون القدرة على التفكير النقدي، ويشعرون بالعجز، ويصابون بالسلبية، ويتطلعون -بالضرورة – لظهور زعيم يدلهم على ما يفعلون، ويعرف ما لا يعرفون”[1] . وقد حاول الفنان توماس كوبيرا من خلال هذه اللوحة الوصول إلى العقل الباطن للمشاهد ليتمكن من التأثير في انتباهه بصريا وإدراكيا ويحفز فيه مدارك التفكير والتأمل بالرجوع الى ظاهرة القطيع باعتبارها “عملية مركبة، ومعقدة، وتستخدم فيها كل وسائل السيطرة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتربوية، والثقافية، والثواب والعقاب، بحيث يتم تنميط السلوك الجمعي، وتوجيهه”[2].
توماس كوبيرا، لوحة الهروب أو الخروج عن القطيع ألوان زيتية على قماش (71/91صم) 2004
(Deserter / Out from the herd) (Kopera, 2004)
تستعرض هذه اللوحة السريالية حشدا ممتدا من الناس لأجساد رمادية اللون بلا هوية ولا ملامح، لا نعرف بدايتها ولا نهايتها، تسير في تصلب وجمود، وكأنها ثابتة بلا حراك، على أرض صخرية جافة كأجسادهم المتصدعة من الجفاف ومن الاستلاب والتبعية العمياء، فحين “يصبح فكر القطيع من الثوابت في حياة الإنسان، فإنه يُشير إلى ظاهرة نفسية يسعى خلالها للحصول على القبول والتوافق والانسجام داخل مجتمعه عن طريق تبني آرائه الجمعية، بعيدًا عن أفكاره الشخصية وقناعاته وهويته الخاصة”[3] .
وفي مقدمة الحشد يحاول فرد الخروج عن تبعية هذا القطيع والانفصال عنه، ليشكله الرسام بألوان دافئة تراوح بين الأصفر الترابي والبرتقالي، وهو أقرب إلى لون البشرة التي بدأت تدب فيها الحياة، وبدأت ملامح هويته في التجلي تدريجيا، إلا أننا نلاحظ صعوبة هذا الاقتلاع البارزة في صرخة الفرد وتألمه، وكأن المجموعة تقاوم انفصاله وتجذبه إلى الخلف، إلى التبعية والانقياد مع الحشد حيث “تعمل الجماعات على منع الأفرادَ من رفع أصواتهم بوجهات نظرهم التقويمية الناقدة التي لا تحظى بالقبول أو التي تخرج عن المألوف”[4] .
وقد تناسب التوظيف السريالي مع فكرة العمل خاصة وأن السريالية هي في حد ذاتها انفتاح علی المجهول و علی الما وراء ، تسعی إلی تحرير القوی اللاشعورية المكبوتة، حيث تعامل توماس كوبيرا مع فكرة العمل بأسلوب السريالية السحرية التي تناولت مقاربات نقدية تمردية على الواقع باعتبار أن السريالية لم تكن أبدا مجرد مذهب فني بل هي موقف فكري يهدف إلى الجوهر الباطني للنظام الفكري، ضمن إطار إنساني، يتناول جوهر الهوية الإنسانية في بعديها الفردي والجمعي، ليبحث وسط سيرورات الوعي والهوية عن ذاتية الفرد وإنسانيته التي لا تسعى للتجرد من أصولها بقدر ما تحاول تأكيد ذاتيتها وحريتها واستقلاليتها الفكرية والفنية والهوية.
إن الانفعالات والحالات السيكولوجية التي انطلقت منها السيريالية ركزت أساسا على اظهار الجانب الخفي من الحقيقة البصرية باعتبار أن الظاهر ما هو سوى جزء من الواقع، وجزء من الحقيقة ذاتها، حيث ظهرت السريالية كحركة تمردية تعبر عن رغبة أفرادها في العبور إلى ما وراء الواقع الظاهري واعتماد اللامرئي واللامعقول كمنطلقات أساسية لفهم الذات البشرية ونقد واقعها وانتمائها. فاهتمام السيريالية بالمضمون لا ينفي تركيزها على هذا النوع التجديدي على مستوى الشكل كمنبع فني لاكتشافات تشكيلية رمزية منفتحة على اللامتناهي الدلالي وهو ما جعل أغلب أعمالها تتسم بالغموض والتعقيد والتشفير كمحفزات استكشافية تسعى إلى تنوير الفكر من خلال طريقة فهم جديدة محملة بمضامين فكرية وانفعالية تستفز فكر وإحساس الجمهور.
فالتصلب والجفاف الصخري الذي سيطر على نسيج المجتمع في الصورة يعكس تناقضا في العلاقة الطبيعية التي يطرحها السرياليون ذاتهم، وهي علاقة سيميائية تلغي طبيعية المادة لتحيل إلى رمزيتها، فالتصلب والجمود الذي تعرضه اللوحة يتجاوز الحجر المادي نحو الجمود الفكري، “إذ ليس الحجر الفلسفي شيئا آخر إلا ما يتيح لخيال الإنسان أن يثأر بقوة من الأشياء كلها، بعد قرون من تدجين الفكر والخضوع المجنون”[5]. فهذا التصلب الصخري الذي سيطر على أجساد المجتمع حولها إلى جثث مجمدة بلا ملامح كمقاربة استعارية للجمود الفكري والإبداعي الذي توقف عن النمو.
حاول توماس كوبيرا من خلال هذا التوجه السريالي الانطلاق من أشياء واقعية، هي أجساد جماعية استخدمت الجسد المفرد للارتقاء بالحلم والأمل إلى ما فوق الواقع المرئي حيث “عبَّرت اليوتوبيات الاجتماعية طوال تاريخها عن أمل البشرية في حياة أفضل، ورسمت صورا لمجتمعات خيالية مثالية”[6] ، كسبيل للبحث عن طريق يطرح معادلة غير متكافئة بين التبعية والخلاص، بين التفكير والتطبيع.. ضمن نظام تركيبي يجمع بين الروح المتأججة والمادة المتصلبة كإحالة الى العلاقة بين الفرد والمجتمع، من منطلق مركزية الفرد كنقطة عليا تختصر الواقع وتهيمن على بنائيته العلائقية، لتطلق العنان للفكر الحر ليشع وينطلق في اتجاه البعد الماورائي للحياة المرئية والخفية لتجديد حياة الفرد والمجتمع والانتصار على الواقع والتحكّم في المستقبل، لتنبثق من رحم السريالية حاجة إلى خلق واقع جديد ذو طابع تجديدي جذري يغير المفهوم الفني للواقع ويدخل ديناميكيات حياتية جديدة في عملية الخلق والتفكير.
[1] إيريك فروم، الانسان بين المظهر والجوهر، ترجمة سعد زهراني، المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، الكويت 1989 ص177
[2] مصطفى شغيدل، حشر مع الناس عيد- قراءة في سياسة القطيع، الطبعة الأولى، دار الورشة الثقافية للنشر والتوزيع، بغداد 2021 ص8
[3] ياسين المصري. (26 8, 2020). الحوار المتمدن العدد 6658. تاريخ الاسترداد 1 7, 2022، من ثقافة القطيع:
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689703
[4] نفس المرجع
[5] أدونيس، الصوفية والسريالية، الطبعة الثالثة، دار الساقي للنشر والتوزيع، بيروت، 2010 ص14
[6] عطيات أبوالسعود، الأمل واليوتوبيا في فلسفة ارنست بلوخ، مؤسسة هنداوي، 2021 ص331