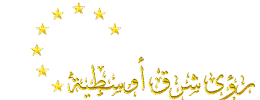في النرويج لم يسقط رئيسة البرلمان انقلاب، ولا تسريب ملفات كبرى، ولا صراع أجنحة داخل حزب حاكم. أسقطتها شقة صغيرة في أوسلو، ومسافة قصيرة على الطريق. القانون يمنح السكن الرسمي لمن يبعد منزله أكثر من أربعين كيلومتراً عن البرلمان، بينما منزلها كان على بُعد تسعة وعشرين كيلومتراً. حين ظهرت القصة للعلن، لم تدار المعركة بخطابات عن “المؤامرة” ولا ببلاغات عن “سوء الفهم”، بل بخلاصة واحدة، مساس بالثقة العامة. والثقة في تلك البلاد ليست شعاراً يُرفع، بل رأس مال الدولة الحقيقي. فكان الاعتذار، ثم الاستقالة، ثم الحديث عن رد ما ترتب من مال أو منفعة.
والغريب الذي يوقظ الوجدان أن “فضيحتهم” تبدو صغيرة على مقاييسنا، لكنها كبيرة على مقياسهم، لأنهم لا يقيسون الجُرم بحجم المال وحده، بل بحجم الإهانة التي تلحق بفكرة الدولة. هناك، متر زائد في امتياز عام يجرح صورة المؤسسة؛ فيبدأ النزيف من قمة الهرم قبل أن يصل إلى القاعدة. ولهذا لم تمنعهم وفرة المال من الغضب الأخلاقي؛ فهم يملكون واحداً من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وقد بلغت قيمة صندوقهم في نهاية الربع الثالث من عام 2025 نحو 20,440 مليار كرونة نرويجية. ومع ذلك، ظل “مبلغ شقة” كافياً لإسقاط منصب.
هنا يظهر اسم فاروق القاسم لا بوصفه حكاية مهاجر ناجح فقط، بل بوصفه عقل عراقي ساهم في أن يتحول النفط من لعنة محتملة إلى موردٍ منضبط بقواعد. الرجل وصل النرويج عام 1968، وحين حانت لحظة بناء “نظام النفط” لا استخراج النفط فحسب، اختير عام 1972 لكتابة المسودة الأولى لورقة حكومية تُرفع إلى البرلمان، واضعة مبدأ توزيع الأدوار، الوزارة تُعنى بالسياسة والتشريع والتخطيط والترخيص، والرقابة والتنظيم تُسند إلى مديرية مستقلة هي مديرية النفط (NPD) لضمان الحياد، بعيداً عن تضارب المصالح. وهو نفسه يصف لاحقاً كيف كان بناء تلك المؤسسة من الصفر واحداً من أكثر تحديات حياته إثارة ومشقة.
ولنكن صريحين، العراق ليس أقل ذكاءً من النرويج، ولا أقل ثروة نفطية في جوهره، لكن الفارق أن النرويج ربحت “معركة القاعدة”، بينما نحن ما زلنا نخسرها. عندنا لا تتحول المخالفة إلى استقالة، بل تتحول إلى “تسوية”، ثم إلى “صمت”، ثم إلى “سيرة طبيعية لمنصب جديد”. في بلدٍ يُفترض أن تسقط المليارات رؤوساً، كثيراً ما تسقط المليارات في فراغٍ بلا أسماء، أو بأسماءٍ تستعمل كبابٍ للنجاة لا كبابٍ للعدالة. وكي لا يبقى الكلام إنشائياً، يكفي أن نتذكر قضايا معلنة من نوع “الأمانات الضريبية” التي دارت حول اختفاء 3.7 تريليون دينار عراقي، أي قرابة 2.5 مليار دولار، وهي واحدة من أكبر فضائح المال العام في السنوات الأخيرة.
ثم يأتي الجرح الذي يوجع أكثر لأنه يمس الفقراء مباشرة، حديث رسمي وإعلامي متداول في أواخر نوفمبر 2025 عن اختفاء/سحب نحو 2.5 تريليون دينار من صندوق الرعاية الاجتماعية، وما تبعه من فتح تحقيقات وإقرارات بوجود نزاع بين مؤسسات الدولة حول ما جرى. هنا لا نتحدث عن رفاهية مسؤول، بل عن مظلة يفترض أن تحمي العاطلين والأرامل والمهمشين. إن كان الاتهام صحيحاً فهو كارثة أخلاقية قبل أن يكون مالية، وإن كان ملتبساً فالكارثة أكبر، كيف تبلغ الأموال هذا الحجم ثم لا يعرف الناس، ولا يعرف صاحب الصندوق، ولا تعرف الدولة أي رواية تصدق؟
ولهذا أقولها، المشكلة ليست أن لدينا فاسدين؛ الفساد داءٌ عالمي. المشكلة أن الفساد عندنا لا يدفع ثمنه أحد، وأن “الثمن” يُجبى من جيوب المواطنين وأعصابهم وأعمارهم. حين يسقط المسؤول في النرويج بسبب شقة، فذلك لأن الدولة هناك تبني جداراً بين المنصب والمنفعة، بين السلطة والامتياز، بين “المسموح” و”المتاح بالتلاعب”. وحين لا يسقط مسؤول عندنا بعد كارثة تمس قوت الناس، فذلك لأن المنظومة أقوى من المساءلة، ولأن شبكة الحماية أوسع من القانون.
فاروق القاسم لم يمنح النرويج نفطاً؛ النفط كان في البحر. هو ومن على شاكلته ساهموا في أن تُدار الثروة كعقدٍ اجتماعي لا كغنيمة. أما نحن فنعيش مفارقة موجعة، نملك الثروة، لكننا نفتقد آلية الردع، ونملك الكفاءات، لكننا لا نحميها حين تتكلم، ونملك شعارات النزاهة، لكننا لا نجعلها سيفاً على القمة قبل القاعدة.